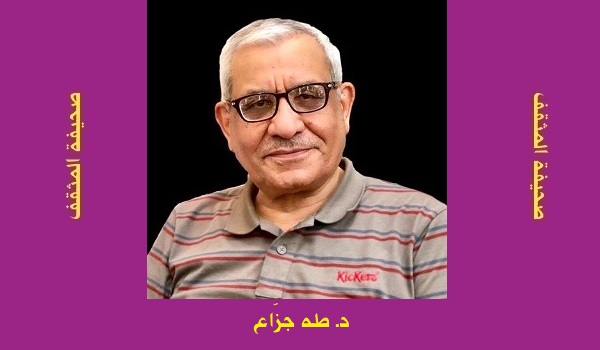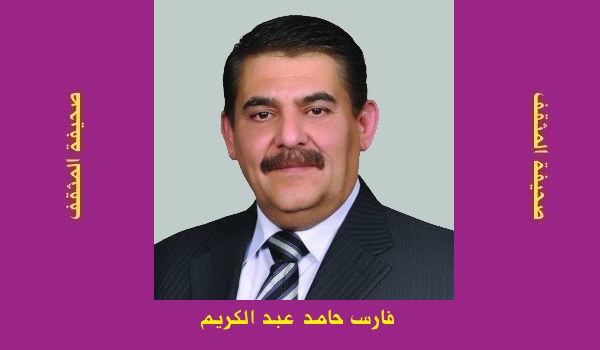قضايا
هدى لحكيم بناني: من الكدّ والسعاية إلى حقوق المرأة المعاصرة

مقاربة فقهية في ضوء التراث الإسلامي
يُعدّ موضوع الكدّ والسعاية من أبرز القضايا الفقهية التي تعكس عمق الشريعة الإسلامية في مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة. فهذا المفهوم يرتبط بحق المرأة في جُهدها ومشاركتها العملية داخل الأسرة وخارجها، سواء في الفلاحة أو التجارة أو تنمية الثروة المشتركة. ورغم أنّ الكثير من الفقهاء القدامى قد اختلفوا في تحديد مدى إلزاميته، إلا أنّه يمثل اليوم مدخلًا مهمًا لإعادة التفكير في موقع المرأة داخل البنية الاقتصادية للأسرة والمجتمع، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها.
لقد بُني هذا الحق على أساس فقهي معتبر، إذ استند إلى مقاصد الشريعة التي تروم تحقيق العدل ورفع الظلم. فالمرأة لم تكن مجرد مستهلكة في بيت الزوجية، بل كانت شريكة فعلية في الإنتاج وتحمّل أعباء الحياة اليومية. ومن هنا نشأ القول بوجوب الاعتراف لها بحق السعاية إذا ساهمت بعملها في تنمية أموال الزوج أو الأسرة. ويُعتبر هذا الاعتراف جزءًا من الوفاء بمقصد حفظ المال الذي لا ينفصل عن مقصد حفظ النفس والعِرض. فالشريعة في جوهرها ليست حصرًا على النصوص الجامدة، وإنما هي منظومة من المبادئ المرنة التي تستجيب للواقع.
وعندما نُسقط هذه الفكرة على واقعنا المعاصر، نجد أنّ النقاش حول حقوق المرأة الاقتصادية لا يزال يتجدد بأشكال مختلفة. فاليوم، تعمل ملايين النساء جنبًا إلى جنب مع أزواجهن أو أسرهن في المشاريع الزراعية والتجارية والخدماتية، ويساهمن في رفع مداخيل الأسر بشكل مباشر. ومع ذلك، قد تتعرض كثير منهن للإقصاء عند الطلاق أو وفاة الزوج، فلا ينلن نصيبًا عادلًا من الثروة التي ساهمن في بنائها. وهنا يظهر بوضوح أن تفعيل مبدأ الكدّ والسعاية ليس مجرد اجتهاد فقهي تاريخي، بل هو آلية قانونية وأخلاقية تضمن الاستقرار الأسري وتحقق العدالة الاجتماعية.
إنّ من أبرز تجليات هذا الحق أنه يُعيد تعريف العلاقة بين الزوجين باعتبارها شراكة متكافئة، وليست علاقة استهلاك من طرف واحد. فالزوجة التي تكدّ وتسعى وتعمل تستحق أن يُعترف بعملها كقيمة مضافة، لا كخدمة مجانية. وهذا الفهم ينسجم مع روح العصر التي تُطالب بالاعتراف بالعمل غير المأجور، وخاصة عمل النساء في الأسرة. كما أنّ هذا الطرح يفتح المجال أمام تطوير تشريعات أسرية تراعي واقع النساء اللواتي يتحملن أعباء مادية ومعنوية مضاعفة، فيتحقق بذلك مقصد رفع الحرج ومقصد تحقيق المساواة المنضبطة.
وإذا نظرنا إلى السياق العالمي، فإنّ النقاش حول العدالة الجندرية في توزيع الثروة يشغل حيّزًا واسعًا في المواثيق الدولية. غير أنّ ما يميز الفقه الإسلامي أنه سبق إلى الاعتراف الضمني بهذا المبدأ من خلال إقرار السعاية. فهذا يُظهر أنّ الشريعة ليست عائقًا أمام التطور الحقوقي، بل قد تكون مصدر إلهام لإرساء قواعد أكثر إنصافًا. ومن هنا فإنّ إعادة إحياء هذا الحق يمكن أن يسهم في تجاوز بعض الإشكالات المطروحة اليوم بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا وحمايتها من التهميش.
كما أنّ اعتماد هذا الحق لا يقتصر على البعد المالي وحده، بل يتجاوز ذلك إلى بُعد رمزي وأخلاقي عميق. فالمرأة حين يُعترف لها بحقها في الكدّ والسعاية تشعر بكرامتها واعتبارها كشريك كامل في مشروع الحياة، وليس كعنصر تابع. وهذا الاعتبار يعزز التماسك الأسري ويحدّ من النزاعات المرتبطة بالمال والإرث، إذ إنّ الظلم المالي غالبًا ما يكون مدخلًا لتفكك الروابط الأسرية. وبالتالي، فإنّ تطبيق هذا المبدأ يمثل استثمارًا طويل الأمد في استقرار الأسرة والمجتمع.
ولا يمكن إغفال أن الفقهاء الذين تناولوا هذه المسألة لم يكونوا بعيدين عن واقعهم الاجتماعي، بل كانوا يتلمّسون حلولًا لمشاكل حقيقية تعيشها الأسر المسلمة. وهذا ما يجعلنا اليوم مدعوين إلى قراءة اجتهاداتهم في ضوء التحديات الجديدة. فإذا كان الماضي قد شهد نقاشًا فقهيًا حول عمل المرأة في الحقول والمشاريع العائلية، فإنّ الحاضر يشهد عملها في الشركات والوظائف الرسمية والاقتصاد الرقمي. وهذا يفرض إعادة تأويل مبدأ السعاية بما يضمن اتساعه ليشمل صور العمل المستحدثة التي تقوم بها المرأة داخل الأسرة وخارجها.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ إعادة إحياء حق الكدّ والسعاية يحتاج إلى جهد تشريعي ومؤسساتي يترجم المبادئ الفقهية إلى قوانين عملية. وهذا يتطلب إدماج هذا الحق في مدوّنات الأسرة، وإيجاد آليات قانونية لتوثيق مساهمات المرأة المادية والمعنوية في تنمية أموال الأسرة. فغياب التوثيق غالبًا ما يؤدي إلى ضياع الحقوق، بينما يُعتبر التوثيق أحد مقاصد الشريعة لحماية المصالح وتجنب النزاع.
إنّ الموازنة بين النصوص والمقاصد في هذه القضية تبرز لنا حيوية الشريعة وقدرتها على التجدد. فالتشدد في الاقتصار على ظاهر النصوص دون اعتبار للمقاصد قد يؤدي إلى ظلم بيّن للمرأة، وهو ما يناقض مقصود الشرع. بينما الاجتهاد المنفتح على الواقع والمقاصد يُمكّن من استنباط حلول أصيلة تراعي التحولات الاجتماعية وتُحافظ على أصالة المرجعية الإسلامية. وهذا المنهج هو الكفيل بجعل الشريعة مصدر عدالة حقيقية في حياة الناس.
ويجدر التنويه إلى أنّ قضية المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بحقها في الحرية والمسؤولية، وكذلك حقها في الكدّ والسعاية، لم تكن غائبة عن المدونات الفقهية القديمة ولا عن الدراسات المعاصرة. فقد تناولت المدونة الكبرى للإمام سحنون إشارات إلى عمل المرأة في المال المشترك، كما خصّص الونشريسي في المعيار المعرب فصولًا لبحث المسألة ضمن اجتهادات المالكية في المغرب والأندلس. وفي العصر الحديث، جاء كتاب البشاري محمد حق الكدّ والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة ليعيد قراءة هذه المسألة من منظور مقاصدي وحقوقي، كما نجد إشارات متفرقة في كتب الأسرة مثل فقه الأسرة لعبد الكريم زيدان. ولا يقتصر الاهتمام بالموضوع على الإنتاج العربي والإسلامي، بل نجد دراسات أجنبية قارنت بين الفقه الإسلامي والمقاربات الحقوقية المعاصرة، مثل كتاب Women and Property in Morocco لـ Susan Gilson Miller، وكتاب Gender and Justice in Muslim Family Law لـ Ziba Mir-Hosseini، فضلًا عن أبحاث متخصصة في قضايا المرأة والعدالة في الفقه المقارن.
إن إدراج هذه الأدبيات في النقاش يُظهر أن موضوع المرأة في الإسلام، بما فيه الكدّ والسعاية، لا يزال مجالًا خصبًا للبحث والتطوير، بما يربط بين التراث الفقهي والواقع المعاصر، ويجعل من إعادة النظر في هذه الأحكام خطوة أساسية لتحقيق توازن بين أصالة المرجعية وحاجات العصر.
وعليه، فإنّ الحديث عن حق الكدّ والسعاية اليوم ليس مجرد استرجاع لمسألة فقهية قديمة، بل هو نقاش حول جوهر العدالة الأسرية والاجتماعية. وضمن التحولات الاقتصادية وزيادة الضغط على النساء، يصبح الاعتراف بهذا الحق تجسيدًا لمبدأ إنصاف المرأة وتمكينها من موقعها الحقيقي. كما أنه يرسخ ثقافة الشراكة داخل الأسرة ويُعيد الاعتبار لمفهوم المسؤولية المشتركة، وهو ما تحتاج إليه مجتمعاتنا بشدة لمواجهة التحديات الراهنة.
***
د. هدى لحكيم بناني