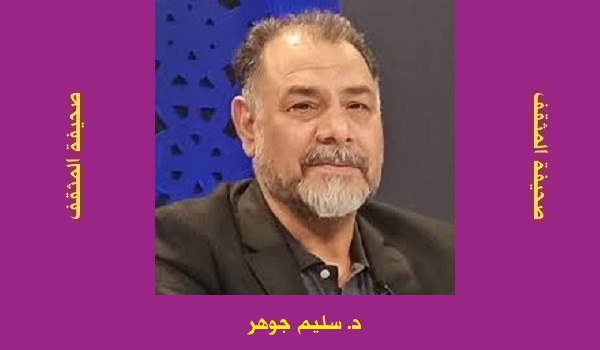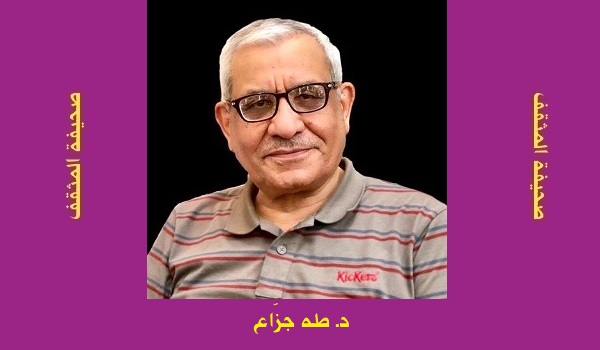قضايا
طاهر ناصر الحمود: ملاحظات عابرة حول الايمان بــ (الله، الدين، المذهب)

فيما يلي مجموعة من الأفكار التي سعيت أن تقدم إجابة عن تساؤلات مثارة بخصوص الايمان كحالة وجدانية (عقلية وعاطفية) وما يتصل بها أو يترتب عليها من مواقف عملية تبرئ ذمة المؤمن وتحقق اطمئنانه القلبي.
لم اَت بالجديد الكثير في هذه الأفكار التي سميتها (ملاحظات عابرة) فقد سبقني الى الكتابة في معظمها كثيرون، كما أني لا أنوي الإساءة من خلالها لثوابت الدين أو التعرض بأي شكل من الاشكال لضروراته الثابتة. حاولت من خلال هذه الملاحظات أن أبين أن الإيمان بالموضوعات الإيمانية (الله. الدين. المذهب) بوصفه يقيناً عقلياً او اطمئناناً قلبياً ليس أمراً مقطوعاً بصحته لجميع الأفراد وفي كل الأحوال والأزمنة مثل اليقين بالموضوعات المحسوسة، كالقلم في يدي أو الجدار أمامي، بل هو – في غالب الأحيان – حالة مركبة من الجهد العقلي والميل النفسي الظاهر والخفي. ومن الطبيعي أن تترتب على هذه المقدمة نتائج تتصل بالموقف من المختلفين معنا فكرياً أو عقائدياً وكذا الاحكام المرتبطة بهذا الاختلاف، كما أوضحت أن الحكم الشرعي ليس غاية بحد ذاته حتى يُتَعبد به في كل حال أو ظرف (زماناً أو مكاناً) بل هو وسيلة لتحقيق مقصد الشريعة في الحفاظ على النفس والمال والنسل وإحقاق الحق، وهذا مبدأ نظّر له علماء الإسلام قديماً وتابعهم عليه فقهاء ومفكرون وباحثون معاصرون.
أشير إلى أن ما حملني على الكتابة في هذا الموضوع - ضمن دوافع أخرى - هو حيرة شبابنا أمام هذا التدافع الهائل من الأفكار والمعتقدات وأمام وفرة لا حصر لها من المعلومات التي تهيئها التكنولوجيا الحديثة، والكثير الغزير منها يشكك في عقيدتهم ويطعن في موروثهم الذي تشربوا احترامه وتقديسه من الأبوين والبيئة الأوسع منذ نعومة أظفارهم.
لم تعد المعلومة محصورة بين دفتي الكتب أو على لسان رجل الدين بل أصبحت متاحة للجميع ولا يحتاج الوصول اليها سوى الى نقرة خفيفة على جهاز الحاسوب أو الهاتف ليكون المرء في مواجهة ما يريد وما لا يريد مقروءاً ومسموعاً ومرئياً وحين تتضخم الإشكالات وتكثر الملاحظات ويتم تغافلها يكبر التساؤل في الأذهان ويتحول الى شك ثم يصبح الشك إنكاراً للعقيدة وكفراً بها. الفضاء الالكتروني بما يوفره من ملايين المصادر والأفكار المتنوعة ليس مجرد أداة اتصال بل هو ساحة اختبار حقيقية لصدقية أي فكرة أو معتقد أو مشروع.
لكن ما نحتاجه اليوم أكثر بكثير من مجرد الرد على إشكالات مثارة أو الإجابة عن ملاحظات بخصوص هذه القضية أو تلك، ما نحتاجه فعل معرفي ضمن رؤية شاملة ترمم صورة الدين التي شوهتها قرون من التمازج بين ماهو تاريخي وبشري وبين ما هو ديني صرف، نحتاج الى مبادرات شجاعة تخرج الدين من المواجهة المفترضة مع العقل والكرامة الإنسانية وتفتح المجال لتوأمة حقيقية بين الدين والعقل. وقد أشرت في ختام (الملاحظات) إلى بعدين أحسبهما مهمين في هذا السياق:
الاول: احترام حق الاَخر – أي اَخر – في الاختلاف الفكري والعقائدي معنا دون قيود.
الثاني: إعادة النظر بأحكام الشريعة انطلاقاً من أن معظم نصوصها تاريخية ولا تصلح - على ماهي عليه – لكل زمان ومكان فلا معنى للتمسك بأحكام كلف البشر بالعمل بها زمناً ثم صارت عبئاً عليهم مع توالي الازمان وتبدل الأحوال:
(1)
إثبات المعتقدات والقناعات الدينية والمذهبية والوصول الى الحقائق المتعلقة بها يختلف عن اثبات صحة الأفكار في المجالين الطبيعي والإنساني. في المجال الطبيعي يمكن الوصول الى نتائج قاطعة إذا توفرت الشروط الموضوعية لذلك، وبنسبة أقل يمكن الوصول الى نتائج مماثلة أو قريبة من ذلك في المجال الإنساني. أما في مجال العقائد والقناعات الدينية فليس من السهولة اثبات ذلك عن طريق العقل وحده لأن العقيدة مصدرها الأكثر تاثيراً هو ألعاطفة وليس العقل رغم البناء المنطقي والعقلي الذي يقدمه المؤمنون بها.
(2)
الانسان يرث دينه ومذهبه كما يرث لون شعره وبشرته ولون عينيه، والدين اقرب الى ان يكون قدراً لافكاك منه، وهو بهذا المعنى جزء لاينفك عن تكوين الانسان النفسي والعقلي والعاطفي، ومن الصعب جداً على الانسان أن يخرج من دائرة التأثير المباشر او غير المباشر لدينه أو مذهبه. صحيح أن بعض الناس غيروا دينهم أو مذهبهم وانتقلوا الى دين اَخر أو مذهب أخر لكن هؤلاء لا يمثلون سوى شريحة ضئيلة للغاية اذا ما قورنوا بعدد الذين يظلون أوفياء لأرث الاَباء والأجداد، فضلاً عن أن هذا النفر القليل لا تكون غايته دائماً البحث عن الحقيقة بل إن قسماً من هؤلاء المتحولين قد تكون لهم دوافع أخرى من قبيل تحقيق المصلحة الشخصية أو يكون تحولهم نوعاً من ردات الفعل على مواقف أو سلوكيات لم تعجبهم في بيئتهم.
(3)
لا علاقة للمستوى العقلي أو الذهني للأشخاص بدرجة الخضوع لتأثير الدين فالفرد سواء كان عادياً أو مفكراً أو حتى عبقرياً ينحاز لثقافته الدينية حتى لو لم يكن متديناً. تجد أحيانا أشخاصاً في قمة الذكاء وربما العبقرية لكنهم يتصرفون كالرجل العادي إذا امتحنوا في قناعاتهم الدينية وتم تحديها أو الضغط عليها من قبل الاخرين.ويمكن القول إن الانسان منذ شبوبه عن الطوق يغلق باب البحث في معتقداته أو مناقشتها بطريقة مجردة وموضوعية بعيدة عن مشاعر الانتماء وماتفرضه هذه المشاعر من انحياز مسبق، ولهذا نرى أن القدرات العقلية المميزة لدى بعض الأشخاص يتم توظيفها بطريقة عقلية (مميزة) لإثبات صحة الموروث الديني أو تنقيحه جزئياً دون المساس بألاسس والثوابت.
(4)
ماذا لوتبادل اشخاص مميزون عقلياً بيئاتهم الدينية والمذهبية والاجتماعية ؟ كيف ستكون آراؤهم ومواقفهم العلمية والفكرية والعقائدية ؟ هل ستبقى هي هي أم تتغير تبعاً للبيئة الجديدة ؟ وماهي درجة التغير في هذه الآراء والمواقف ؟
ماذا لو وُلد الشيخ المفيد والعلامة الحلي في حرّان أو دمشق وَوُلد ابن تيمية وابن القيم الجوزية في الكوفة ؟
ماذا لو ولد الخوئي ومحمد باقر الصدر في نجد وولد محمد بن عبد الوهاب وابن باز في النجف وكربلاء ؟
لا أظن أنّ هناك مجالاً للاختلاف في أن ابن تيمية لن يكون قادراً على كتابة منهاج السنة في بيئته الجديدة المفترضة ولا العلامة الحلي سيكتب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد حين يولد حيث وُلد ابن تيميه.
ولو توجهنا بهذه الأسئلة الى المعنيين أنفسهم من كبار علماء الشيعة والسنة لأجاب الشيعي منهم أنه سيبقى شيعياً وإن ولد أصلا في بيئة سنية،
ولقال السني منهم أيضاً أنه سيبقى على سنيته أو سلفيته وإن ولد ونشأ في بيئة شيعية. ولو تحلى بعضهم بقدر أكبر من التواضع لأجاب: الحمدالله على نعمة الإسلام والتشيع أو التسنن والحمدلله الذي خلقني حيث أنا ورزقني نعمة الفهم والبصيرة !!!
(5)
ونطرح سؤالاً افتراضياً اَخر: لو أن المسلمين أو غيرهم فُرّغت ذاكراتهم من كل ماله علاقة بالدين أو ثقافة البيئة التي ينتمون اليها مع احتفاظهم بقدراتهم العقلية وقابلياتهم على الفحص والتحليل والتمييز تماماً كما هم الان لكنها ستكون حسب هذا الفرض، قدرات مجردة من أي معلومة أو انطباع عاطفي. ولنفترض ايضاً أن اعمار الناس تتسع للاطلاع على كل عقائد البشرية واديانها ومذاهبها قديماً وحديثاً فهل سيختار المسلم المولود في بيئة شيعية اثني عشرية دينه ومذهبه هذا نفسه بعد الفحص والتقييم والفرز لعشرات الالاف وربما اكثر من العقائد والمذاهب والأديان؟ وهل سيختار المسلم السني السلفي على مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب مذهبه هذا بعد البحث والتنقيب والاستبعاد للكم الهائل من الأديان والملل والمذاهب؟
قد تبدو الإجابة بديهية أن اختيار أحدنا للدين والمذهب الذي نشأنا عليه حسب هذا الفرض سيكون احتمالاً محدوداً، لكن هناك من لديه الاستعداد فعلا للجدال حتى في هذه البديهية. طرحت السؤال ذاته قبل عقود على صديق متحمس لشيعيته حد التعصب فأجابني بكل ثقة أنه سيختار دون شك الإسلام على المذهب الجعفري وإذا لم يفعل ذلك فسيكون مخطئاً! لقد اعتبر هذا الأخ وضوح الصواب في عقيدته الشيعية بالنسبة له مثل وضوح الشمس في رائعة النهار، وأن الخطأ في العدول عن اختيار هذه العقيدة يشبه الخطأ في تسمية الشمس حين يشار اليها !! ولاحاجة للقول ان هذا المستوى من اليقين واطمئنان القلب لصحة الاعتقاد ليس حكراً على طائفة أو دين أو مجموعة. إن هذا الأخ وامثاله من المؤمنين بالأديان والطوائف الأخرى – الا قليلاً منهم – يتوهمون أنهم انما صاروا مسيحيين أو مسلمين سنة أو شيعة بعد بحث وفحص ومراجعة واعتماد على العقل والمنطق وأنهم لم يؤمنوا بعقائدهم عن عاطفة أو تقليد لأسلافهم. يظنون ان الصيغة المنطقية التي تعرض فيها عقائدهم – أو يقدمونها هم أن كانوا من ذوي القدرة على ذلك - دليل على صحة هذه العقيدة متناسين أن النقوض اللاذعة التي يوجهها أرباب العقائد لبعضهم البعض والكثير منها صحيح تعري الأساس العاطفي الذي بنيت عَليه هذه العقائد وكذا الطابع التاريخي (الظرفي) لها زماناً أو مكاناً.
ولا ينتبه هؤلاء – عدا القليل منهم - الى ان هذا الاغفال لجوانب الضعف في العقيدة هو جزء من اَلية تلجأ اليها النفس البشرية لاستبعاد ما يؤلمها أو يخدش مشاعر الرضا والفخر بانتمائها..
(6)
تشيع عبارة (يجب البحث عن المعتقد الحق) على ألسن وفي أقلام من يتصدون للحجاج المنطقي والكلامي لإثبات أحقية الإسلام قبال الأديان الأخرى، ويعنون بها أن كل أنسان مكلف (بالغ عاقل) في العالم أياً كانت ثقافته وعلمه ومستواه الاجتماعي والبيئة التي ينتمي اليها والجغرافية التي يعيش فيها يتحتم عليه البحث عن الدين الحق، وان هذا البحث يجب ان ينتهي بالتوصل الى نتيجة واحدة وهي ان الإسلام هو الدين الحق الذي يجب اعتناقه ولايجوز تغييره أو تركه حتى الممات، وفي غير هذه الصورة فإن مصير هذا الانسان سيكون الخسران يوم القيامة ودخول النار استناداً الى الآية الكريمة (ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين).
المشكلة اننا نتعامل مع اللغة باعتبارها علامات أبدية على معان ثابتة مطلقة لا تتغير ولا تتبدل أياً كان الظرف أو الثقافة أو المجتمع، وان ما فهمه العربي المسلم في القرنين الثالث والرابع وما تلاهما من عهود الجدل الكلامي المستعر بين الفرق والمذاهب والنحل من هذه العبارة هو حجة على البشرية جمعاء في كل زمان ومكان وان اختلفت ثقافات مجتمعاتها اليوم وموقع الدين من هذه الثقافات.
الاحتجاج بـــ (وجوب البحث عن المعتقد الحق والوصول اليه للنجاة في الأخرة) يتجاهل حقيقة بديهية، هي ان هذه العبارة ذاتها
نتاج ثقافة معينة، وان ما يفهمه ابن هذه الثقافة ومن تشربت شخصيته بمفاعيلها من هذه العبارة يختلف كلياً عما يفهمه منها الشخص المنتمي لثقافة أخرى لا يمثل الدين سوى عنصر ثانوي في تكوينها.
الإسلام بالنسبة للمسلم يستغرق حياته بكل تفاصيلها. هو ليس عنصراً فحسب في ثقافته بل هو أساس هذه الثقافة، هو جذرها الذي يطبع حياة المسلم بطابعه الخاص في كل شؤونه فرداً أومجتمعاً، ومن الطبيعي ان يكون دين له كل هذه الأهمية في حياة الناس هدفاً يسعى للوصول اليه والايمان به
كل (المكلفين) لنيل السعادة في الدارين.
لكن المجتمعات التي لا يكتسي الدين فيها هذه الأهمية لا تفهم من العبارة
ما يفهمه المسلم، فالدين عندها ليس أكثر من عنصر ثقافي يندمج مع عناصر الثقافة الأخرى للأمة، وبعض هذه المجتمعات يتحول الدين لديها الى مكمل ثقافي كمالي وقد يمكن الاستغناء عنه.
وإزاء هذا الفارق في أهمية الدين تتفاوت دلالة العبارة (يجب البحث عن الدين الحق) بين الفريقين حيث يتوفر الحافز الثقافي للبحث عن (الدين الحق) نظراً لأهميته الحياتية لدى الفريق الأول بينما يضعف اِو ينعدم لدى الفريق الثاني الذي تقل أهمية الدين عنده قياساً بالفريق الأول. والحقيقة ان أعداد الذين توصلوا للدين الحق نتيجة (البحث الواجب) لا تكاد تمثل شيئاً بالمقارنة مع السواد الأعظم من الاتباع الذين دخلوا الإسلام إما وراثة او بشكل جماعي عن طريق الفتوحات التي دخل الناس فيها أفواجا في دين الله، أو عن طريق الدعاة والمبلغين الذي انتشروا في اصقاع العالم سواء كانوا تجاراً او علماء او بأية صفة كانت، ثم تحول الإسلام لدى هذه الشعوب بتعاقب القرون الى جزء حيوي من ثقافة المجتمع وبيئته الحضارية. ومن الواضح أن الذين دخلوا الإسلام عن طريق الفتوحات لم يفعلوا ذلك بسبب اخلاق الفاتحين او ميزات الدين الجديد فحسب بل إن نسبة مهمة من هؤلاء، وقد تكون النسبة الغالبة، أمنوا بالدين الجديد لإنه دين الغالب، والبلدان المفتوحة تنزع شعوبها المغلوبة في العادة الى تقليد الفاتحين في ثقافتهم ومنها الدين. وإنما لم يعتنق المسلمون دين المغول القاهرين بعد سقوط بغداد فلأن هؤلاء لم تكن لديهم ثقافة يبشرون بها او دين يدعون الناس اليه. كانوا بدواً غلاظاً يسعون وراء الغلبة والقوة وقهر الشعوب والاستحواذ على خيراتها. والدخول الجماعي للإسلام حصل حتى من خلال الدعاة الذين انتشروا في مناطق واسعة من العالم يومذاك فإنه كان يكفي أن يقتنع كبير القرية أو شيخ العشيرة أو الوجيه وصاحب المكانة بالحجج المعروضة عليه حتى يتبعه باقي أهل القرية أو أفراد العشيرة بالأيمان بالدين الجديد، ولم يكن الأمر ليحتاج ان تكون الدعوة دائماً خاصة بكل واحد من أفراد الجماعة. تجدر الإشارة الى ان كلا الدينين السماويين المسيحية والإسلام مارسا كلتا الطريقتين ؛ القوة مع الضغط السياسي والاجتماعي من جهة والتبشير مع الدعوة الى الدين الجديد من جهة أخرى، بصرف النظر عن مستوى العنف أو طبيعته لدى هذا الفريق أو ذاك، وبصرف النظر كذلك عن محتوى الدينين وملاءمتهما لاحتياجات الجماعة الروحية والعملية.
(7)
شغلت حقيقة وجود خالق للكون والحياة أو وجودهما دون حاجة لافتراض قوى غير منظورة، الفكر الإنساني منذ ظهور الانسان على وجه الأرض، ففي كل زمان ومكان يوجد – تقريبا – فريقان يؤمن احدهما بوجود خالق لهذا الوجود بينما ينكر الفريق الاخر وجوده أو الحاجة إليه أصلاً. ورغم تطور فكرة الاله على امتداد الأزمنة وتنوع الأمكنة ورغم اختلاف مستويات التفكير وتطوره لدى الجنس البشري كذلك الا ان كلتا الرؤيتين بقيتا شاهداً قائماً في كل عصر على استمرار هذه القضية المختلف عليها فلسفياً وعلمياً وعدم التوصل فيها
إلى رأي قاطع وحاسم، والأرجح أنها ستظل كذلك حتى أنقضاء الحياة على كوكب الأرض وفناء الجنس البشري.
ومنذ ظهور أولى أشكال التفكير الفلسفي لم تستطع الفلسفة حسم هذه القضية بشكل بات وجازم، كما لم تستطع اَخر الأفكار والمنجزات العلمية الوصول الى نتيجة حاسمة لهذا الخلاف، فرغم تراجع أهمية الفلسفة بمعناها الأكاديمي خلال هذا القرن والجزء الأكبر من القرن الماضي في حسم قضايا الفكر البشري الكبرى ورغم تعاظم دور العلم في كافة المجالات الا أن قضية وجود خالق من عدمه بقيت هي هي دون تغيير تقريباً. فقد تجد اشخاصاً يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة العلمية ولا تعوزهم النزاهة الأخلاقية لا يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون، بينما تجد أشخاصاً لايقلون عن هؤلاء كفاءة ونزاهة يؤمنون بوجود قوة عليا عاقلة مفارقة للمادة هي التي أوجدت الكون ومافيه، وبعض المحسوبين على هذا الفريق يؤمنون بوجود الخالق دون الايمان بالأديان والنبوات التي ظهرت في تاريخ البشرية، والبعض الاخر منهم يؤمن بالخالق ومايراه لوازم لهذا الايمان ؛أي الأديان والنبوات وماجاءت به من سبل الهداية للبشرية.
(8)
لدى علماء أصول الفقه قاعدة تسمى حجية القطع وتعني أن الجزم بالشيء يكون حجة بذاته على القاطع أو الجازم ولا يحتاج إلى دليل من الشارع عليه، فإذا جزمت بأن السائل الذي أمامك مباح وتناولته ثم تبين أنه محرم فلا شيء عليك ولاتكون مأثوماً. هذه القاعدة الأصولية تم الحديث عنها باستفاضة في كتب الأصول وعلاقتها بأفعال المكلفين وانطباقها على الاحكام الشرعية (الاباحة، الاستحباب، الوجوب، الكراهة، الحرمة).
ولايوجد أي مانع عقلي أو شرعي لتسرية هذه القاعدة العقلية وتوسيع مساحة انطباقها لتشمل العقيدة أيضاً، لأن العقل يعمل بطريقة واحدة في الحالتين، بمعنى أن القاطع حال قطعه لايمكنه الاقتناع بغير ماقطع به سواء كان المقطوع به محسوساً أو فكرة، ونتيجة لذلك لايمكن لأي جهة علوية أن تحاسبه على العمل وفق قطعه هذا، وهو ما يسميه علماء الأصول بــ (المعذرية) (1) أي أن المكلف يكون معذوراً اذا ما تصرف وفقاً لهذا القطع فالحجية هنا تكون أمراً ذاتياً للقطع ويستحيل سلبها عنه (2).
نعم هناك خلاف بين الأصوليين حول ما إذا كانت الحجية أمراً ذاتياً لا يمكن تغييره في كل حالات القطع او هي امر اعتباري يمكن تقييده أو رفعه في بعض الحالات، فيمكن للبعض ان يناقش بأن اختبار صحة العقائد أو فسادها يمكن ان يدخل ضمن هذا الحيز ؛ أي ان للشارع ان يتدخل في تحديد طرق الاثبات المعتبرة للعقائد بحيث يجعل القطع بالمعتقد الفاسد غير ملزم وكمثال على ذلك القطع الناشئ من القياس عند الامامية، فهذا النوع من القطع لا يلزم منه تنجيز ولا تعذير لأنه من طرق الاثبات غير المعتبرة عندهم.
لكن هذا التقييد لايقدم في الحقيقة أي عون لتمييز الفاسد من الصحيح لأنه هو بذاته يصدر عن مرجعية (ثقافية) (3) غير مجمع على صحتها او وجوب الاحتكام اليها، فالقول مثلاً ان للشارع ان يسلب الحجية من القطع الناشئ عن تقليد الاَباء والاجداد في مجال العقيدة لايعني شيئاً في الواقع سوى ان يكون الشارع ذاته منظومة ثقافية خاصة تلفظ مايتعارض مع متبنياتها وأسس انتمائها. ولاريب ان الشارع لدى هذه الجماعة يختلف عن الشارع لدى الجماعات الأخرى، فهؤلاء جميعاً يعتقدون ان الاَخر لم يحكّم عقله في خياره الديني والمذهبي وأنه جرى على ماكان عليه اَباؤه وأجداده في أمور الدين والمذهب، وفي هذه الحالة لايمكن لأي شارع أن يقيد حجية القطع أو يسلبها بأي شكل من الاشكال. ألقطع في حالة الايمان بالدين أو المذهب – وفي الكثير من الحالات الإله - ليس جهداً عقلياً خالصاً مثله مثل استخلاص النتائج من التجارب الحسية في المختبر، بل هو جهد مركب ومزيج من عوامل متشابكة بعضها عقلي والأخر عاطفي (شعوري ولاشعوري) دون ان نغفل بطبيعة الحال أن هناك قلة قليلة لايكاد يعتد بعديدها في كل جماعة لديهم الإرادة المخلصة والقدرة على الانعتاق من الموروث ومن ثم الوصول الى الحقيقة في هذا الحقل الوعر.
(9)
مادام الانسلاخ عن البيئة الاجتماعية والثقافية والتحول الى المعتقد الحق أمراً بالغ الصعوبة فإن هذا يقتضي أن يكون حساب الإنسان في الاَخرة على هذه الأمور مختلفاً عما نفهمه من النصوص الدينية
(القراَن والسنة) أو استقر في نفوسنا من صور العذاب والثواب. الحساب في الاَخرة لا يكون إلا على ما كان في وسع الانسان وطاقته أن يفعله ولم يفعله.
ومقتضى عدل الله ورحمته التجاوز عما كان خارج هذا الوسع والقوانين التي أودعها الله تعالى في النفس البشرية وخارج النزعات الخفية لهذه النفس. كما أن حكمة الله تعالى تقضي بأن تؤدي رسالات الله المبلغة للناس مقاصدها على مرّ الازمان ومختلف الأماكن وتنوع البشر، ومالا يصل الى الناس باللسان والقلم يصلهم بالفطرة التي فطر الناس عليها.
إذا كان الناس مختلفين في عقائدهم ومذاهبهم ونوع إيمانهم فهم جميعاَ – إلا من شذ وندر – متفقون على الإيمان بجواهر هذه الرسالات. متفقون على أفضلية العدل والرحمة وأرجحية الصدق والأمانة وضرورة أن تحب لأخيك الإنسان ما تحب لنفسك ووجوب الإتيان بكل الفضائل التي دعا إليها أنبياء الله وأولياؤه واجتناب كل الرذائل التي نهوا عنها وطالبوا أتباعهم بتركها.
الله تعالى أعدل من أن يعرّض أحداً لعذابه حين لا يستطيع الإيمان
بــ (الدين الحق) أو (المذهب الحق) لأنه لم يستطع أن يرى هذا الحق بسبب
(قصور) اقتضت حكمة الله أن يمازج تقويمه الأحسن كإنسان ويكون بعضاَ من فطرته تعالى التي فطر الناس عليها.
كيف يمكن ان يكون الأَوْلى بالجنة من لافضل له في إيمان سوى أنه ولد لأبوين مسلمين ولم يكن له الكثير مما يشرّفه في التعامل مع أبناء جنسه. وقد لا يكون له سجل اصلاً في هذا المجال، بينما يدخل النار من قضى حياته في خدمة الإنسانية لأنه لايؤمن بدين أو إله؟ وقد يكون بعض هؤلاء كرسّوا أنفسهم وأموالهم ودفعوا حياتهم ثمناً لهذا الغرض، ونحن نسمع ونقرأ عن كثير من هؤلاء الذين اختاروا حياة التقشف ووهبوا أموالهم وجهدهم لمحاربة الفقر والجهل والمرض في بلدانهم وخارج بلدانهم، وأوصوا ببقية أموالهم لمؤسسات خيرية أو لمن يستحقون ذلك بعد وفاتهم دون أن ينتظروا جزاءً من أحد أو إطراءً على ما يقدمونه.
التضحية بالمال والوقت والجهد وأحياناً الحياة من أجل الاَخرين عناوين للصدق مع الذات، ولايكون صادق مع نفسه إلاطالباً للحقيقة وراغباً في الوصول الى الحق، لأن التضحية من أجل الإنسانية والجحود للحق لايجتمعان في إنسان.
والعقيدة ديناً أو مذهباً أو إيماناً بما اشتملت عليه هذه العناوين من شريعة أو أخلاق إنما جاءت لخدمة الانسان وليس العكس، فغاية إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية هي هداية الناس إلى طريق السعادة وإرشادهم إلى ماينفعهم، واعتبار المفاهيم الدينية عقيدة وشريعة غاية بحد ذاتها دون اعتبار لمصلحة الإنسان ودون مراعاة لإنسانيته كمخلوق حرّ مسؤول عن عمله يجعل الانسان خادماً للدين ويمنح الله تعالى صورة تنافي حكمته وماكتبه هو على نفسه من الرحمة والعدل.
يتحول الله حسب مفهوم (الإنسان في خدمة الدين) الى إله نرجسي وسادي كإله التوراة وبعض اَلهة السومريين لايأبه لمصلحة عباده ولا إنسانيتهم إلا من زاوية مايرضيه هو، فلا تتحقق العبادة الحقة له إلا بإلغاء إنسانيتهم والتنازل عما ينفعهم، فلا يحق لمجتمع المؤمنين ان يفكروا بمخالفة تشريع اكتشفوا عدم ملاءمته لزمانهم، لأنه وحسب المفهوم نفسه لا الزمن ولاتغير الأحوال والظروف يبرر العدول عن تشريع نزل أو فُرض لمعالجة شؤون مجتمع عاش قبل 1400 سنة. ولايقتصر هذا على النص(الكتاب والسنة) بل يسري ذلك أيضاً على التشريعات التي أنتجها الفقهاء بعد انتهاء فترة الوحي وأنتقال الرسول الى الرفيق الأعلى، وتمثل الجزء الأكبر من التشريعات التي تشتمل عليها كتب الفقه، فيسمح هؤلاء لأنفسهم بمخاطبة الناس نيابة عن الله تعالى وينسبون أقوالهم واَراءهم الفقهية – عملياً – إليه سبحانه فيبدّعون ويكفّرون، ويعطون ويمنعون، ويفتون بما اقتضت ظروف زمانهم وأحيانا بما شاء حاكمهم ويفتئتون على الله أنّ مايقولونه هو حكم الله يثاب من عمل به ويعاقب من خالفه.
يعاقب من لايعمل بفقه السبي للإماء والعبيد – مثلاً – الذي انتجته قرون الاحتراب والصراع مع الاَخرين ومازال يُدَرّس في العديد من المعاهد والمؤسسات الإسلامية، ويتلقاه طلبة هذه المؤسسات على أنه حكم الله الذي لايُنازع، وقد جرّ هذا الفقه الويلات والماَسي على المسلمين وسواهم وقد رأى الجميع ما فعلته الجماعات الإرهابية في العراق وغيره خلال العقود الماضية.
مادام الدين غاية بحد ذاته ومادام الإنسان في خدمته وليس العكس فإن عليه إن اَمن بالدين الحق أن يغلق باب التفكير في احتمال العودة عن إيمانه وأن لايقيم وزناً لتفكيره أو (وساوسه العقلية). لامعنى لحرية التفكير هنا لأنها تتعارض مع الهدف الأسمى وهو أن يكون الدين، بشكله الرسمي والموروث، مخدوماً بالإنسان وليس العكس. فإذا قطع الإنسان لاحقاً بعدم صحة إيمانه فعليه أن يحتفظ بقطعه هذا لنفسه وإلا قطع رأسه. قد يستتاب من ارتد بعد إيمان سبقه كفر
وهو المرتد الملي قبل قتله، لكن المرتد الفطري وهو المولود لأبوين مسلمين يُقتل دون استتابة (4) وفي هذا التمييز بين المرتد الملي والفطري إقرار صريح بأن الدين إرث ينقله الاَباء للأبناء وليس خياراً حرّاً صادراً عن قناعة عقلية واطمئنان قلبي.
وقد يتضمن حكم الردة عند مدارس فقهية أخرى شكل الحجر الكامل على منافذ التفكير والتعبير لدى الانسان فيكون المرتد عندها من أنكر ضرورياً من الدين في قوله وفعله واعتقاده (5)
وغني عن البيان أننا لانعيب على قتل المرتد إلا حين تكون (الردة) تعبيراً عن قناعة عقلية استجدت لدى الشخص وتُعد خروجاً عن العقيدة السائدة شرط أن لاتقترن هذه القناعة بارتكاب جرائم يستحق بموجبها القتل.
فلو رجعنا إلى الذين قتلوا أو أهدر النبي دماءهم ممن ارتدّوا عن الإسلام لوجدنا أن هؤلاء جميعاً ارتكبوا مايوجب العقوبة عدا عن كونهم ارتدوا عن الإسلام، فعلى سبيل المثال أمر رسول الله بقتل عبدالله بن سعد
بن أبي سرح لأنه كان من كتاّب الوحي فخان الأمانة وارتد ثم رجع الى مكة، وكذلك أهدر دم عبدالله بن خطل لأنه قتل غلاماً له كان مسلماً ثم ارتد وهرب الى مكة، وأمر بقتل مقيس بن صبابة الكناني لأنه قتل رجلاً من الأنصار ثأراً لأخيه ثم هرب راجعاً إلى مكة، لكنه لم يأمر بقتل المنافقين الذين كان رؤوسهم – على الأقل – معلومي الحال لدى جميع المسلمين وأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.
وقد يكون من المفيد أن أورد مثالاً من الفقه له صلة بهذا البعد أي حرية التفكير والمعتقد، فقد اتفقت المذاهب الإسلامية على عدم جواز الاطلاع على (كتب الضلال) خشية على العوام من الافتتان بها أو التأثر بمضمونها، واستثنت من ذلك العلماء ومن لديهم قدرة الرد على
(أباطيل) هذه الكتب، فعدم جواز الاطلاع هنا يعني حكمين في الحقيقة أحدهما صريح وهو حرمة الاطلاع على كتب الاّخر الديني والمذهبي أو الالحادي، والثاني ضمني يترتب على الحرمة وهو تجريد الاّخر من حق الاختلاف معنا وكذا تجريد الأتباع أو (المكلفين) من حق الاطلاع.
والتجريد في كلتا الحالتين سلب لحق إنساني أصيل يُعَدّ شرطاً لأي نهضة أو تنمية إنسانية حقيقية، ولا تكون عاقبة التفريط به سوى التعصب الذي نرى اّثاره المدمرة على مجتمعاتنا، والجمود في الخطاب المؤدي للتخلف، والمزيد من الابتعاد عن الدين
1- المعذرية هي أحد أثرين لحجبة القطع والأثر الاخر هو المنجزية وتعني استحقاق المكلف للعقوبة أذا خالف العمل بقطعه.
2- استثنى الاصوليون (أو بعضهم) بعض أنواع القطع من الحجية وقالوا بإمكان سلبها عنه كالقطع الناشئ عن الوسواس أو قطع القطاع وهو الشخص كثير القطع.
3- ليس المقصود بالثقافة هنا المعنى الضيق المتداول والشائع منها، بل المقصود بها: كل نشاط انساني نظري أو عملي يميز الجماعة عمن سواها فتشمل الأفكار والفنون والمعتقدات والعادات والتقاليد والموروث الادبي والفني.... الخ. أي بأختصار هي تمثل هوية الجماعة التي تميزها عن الاخرين.
4- كما تنص على ذلك أحكام الردة في الفقه الجعفري.
5- كما تنص على ذلك أحكام الردة في المذاهب السنية الأربعة، وهو تعريف يلغي حقين أساسيين من حقوق الإنسان وهما حرية التعبير وحرية العقيدة.
***
طاهر ناصر الحمود – وكيل وزارة الثقافة سابقا