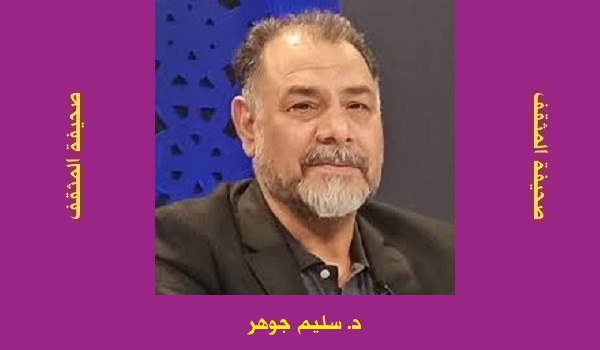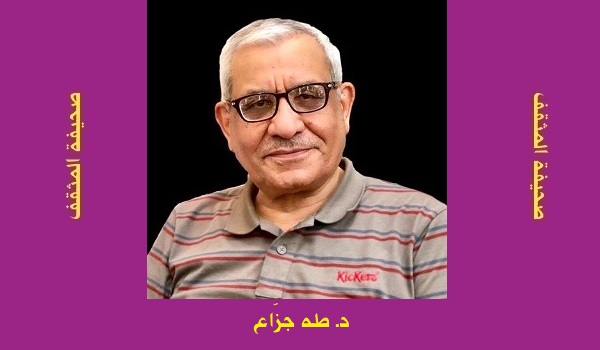قضايا
حيدر شوكان: التخصصات العلمية بلا أبواب

قبل أيام، شاهدت مشهدًا عبثيًا يتكرر بلا مسؤولية: إحدى المؤسسات تستضيف "أستاذة لغة عربية" لتتحدث عن "حكم العنف في الشريعة الإسلاميَّة". فأين العلاقة؟ ما الذي يربط بين اختصاصها اللساني وبين علم دقيق كعلم الفقه؟
وأكاد أجزم، أنه لو طُلب منها أن تعرّف ما الفقه؟ أو ما الحكم الشرعيّ؟ أو ما الأصول العمليّة ؟ أو ما الواجب العيني والتعيني لتعطلت اللغة على لسانها.
هذا المشهد ليس معزولًا. قبله بأسبوع، ظهر طبيب عيون يتحدث في ندوة ثقافية عن "تفكيك البنية السياسية للدولة الحديثة"، مستعينًا بمفاهيم مثل "السلطة الحيوية" و"السيادة المجزّأة"، بينما بدا واضحًا أنه اقتبسها من مقالة في الإنترنت دون أدنى وعي بموقعها الفلسفي أو سياقها النظري.
وفي مناسبة أخرى، ظهرت مؤثرة في مواقع التواصل، تقدم نفسها بوصفها "مدرّبة وعي كوني"، لتتحدث بثقة عن "نظرية التطور" و"الفيزياء الكوانتية"، لتؤسس رؤيتها حول "الطاقة الإيجابية"، وسط تصفيق الحضور الذين لا يميزون بين ستيفن هوكينغ وكتاب تحفيزي من فئة "الأكثر مبيعًا".
إنه مشهد من مسرح اللامعقول، إذ تتقاطع السلطات المعرفية وتشتبك دون حراسة منهجية. وفي ظل هذا الانهيار المنهجي، تُغتال الفروق الدقيقة، وتُزحزح المفاهيم، وتُمارس السلطة الخطابية بلا أي مساءلة معرفية.
أليس من حقنا أن نسأل: كيف تحوّل المجال العام إلى ساحة فوضى معرفية؟ ومن منح هذا "الحق الخطابي" لمن لم يُؤهَّل له؟ وهل نحن أمام نهاية جدّية للتخصص؟ أم أمام ولادة نمط جديد من "الوعي المقلوب"؟
قرأت للمفكر العراقي ماجد الغرباوي حديثًا حول ما يمكن وصفه بـ(العقل الأداتي) حين يتحول الخطاب الدينيَّ إلى وظيفة، وها نحن اليوم أمام العقل الاستعراضي، إذ يتحول كل خطاب إلى عرض مسرحي، وكل فكرة إلى فتنة مسرحية مبتذلة.
ومن تجليات الواقع المأزوم في تعاطيه مع المشاريع العلمية، أن تُسند مهامه إلى غير أهله من الخبراء، وهذا المعنى عانى منه العلامة طه جابر العلواني وذاق مرارته، في مشروعه في المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إذ ينقل الدكتور عبد الجبار الرفاعي، بعض تجليات الاستحواذ الذي هُمَّشَ بموجبه العلواني، قائلًا:" كانت إدارةُ المعهد العالمي للفكر الإسلامي وقتئذٍ تتألف من رئيس المعهد د. عبد الحميد أبو سليمان المتخصص في العلوم السياسية، مع مجموعة أعضاء لم يكن أحدٌ منهم متخصصًا في معارف الدين، إلا الشيخ طه جابر العلواني. وعلى الرغم من أنه أبرز مؤسسي المعهد، ومع مكانته الفكرية والفقهية، إلا أنه تعرّض للإزاحة بالتدريج عن قيادة المعهد، حتى أمسى منفيًا في أواخر من حياته. كنت كلما التقيت المرحوم العلواني يحدثني بمرارة ممزوجة بالأسى والسخرية عن استحواذ فريقٍ غير المتخصصين بالإسلاميات من زملائه على هذه المؤسسة المتخصصة بالمعرفة. وكان يشير بألمٍ إلى أن هذه الظاهرة أفسدت الفكر في بلادنا، بعد أن تسيد غير المتخصصين بالمعارف الإسلاميَّة وعلوم الإنسان والمجتمع، في مؤسسات ومراكز أبحاثٍ يُفترض بها أن تغني بالإسلاميات والمعارف الدينية، فأضحت هذه المؤسسات والمراكز يُخطط لها وتُرسم معرفتها من لا صلة معرفية له بذلك(1)."
اللافت هنا ليس فقط تهميش الكفاءة، بل استبدالها بمنطق "السلطة المؤسسية"، وهو منطق يُفرّغ المشروع من مضمونه، ويحوّل المعارف الإسلاميَّة إلى "سلعة رمزية" تُدار بلا وعي بجوهرها، مما يُفرز خطابًا مختل التوازن، لا هو أكاديمي دقيق، ولا هو شرعي رصين.
إن من أخطر ما نواجهه ليس فقط تهافت التخصص، بل ذوبانه في رغبة جماعية لإنتاج رأي متسرع وسهل وهشّ، لا يستند إلى تراكم، ولا يحترم حدود العلوم.
وهكذا، نصحو كل يوم على المزيد من المتطفلين على الفقه، والقرآن وعلومه، والفلسفة، والتاريخ، والفيزياء، والاقتصاد، لأن الساحة باتت بلا بوابات.
حضرتُ مؤتمرًا أكاديميًا عالميًا في إحدى الجامعات الأهلية، إذ اعتلى المنصّة رجلُ دين، لا بوصفه ضيفًا عابرًا، بل كصوتٍ واثق، يستعرض تاريخ العراق القديم، حضاراته، وآثاره، وكأنّ المعرفة قد اتخذت له سكنًا، وكأنّ التخصص الأكاديمي قد أُعيد تعريفه ليشمل من امتلك الحماسة ولباقة الخطاب. كان صوته ينساب فوق رؤوس الحاضرين كتيّار هادئ، ولكنّه – في عمقه – كان يغرق في بحر من التعميمات والاختزالات.
صادف أن جلس إلى جانبي أحد الخبراء الأركيولوجيين، من أولئك الذين تمرّسوا في الحفر، لا فقط في طبقات الأرض، بل في طبقات المعنى والدقّة. التفت إليّ، وعيناه تمتلئان بسخرية هادئة، وقال: "ما هذه المهزلة؟ أي علم هذا الذي يُدار هكذا؟".
كان الموقف برمّته تجسيدًا لما بعد الحداثة في أقسى صورها: انهيار الحدود بين التخصصات، وانفجار المعنى. في تلك الساعة، أدركت أنّ أزمة المعرفة- أمست ظاهرة عامة- ليست في نقص المصادر، بل في وفرة المتحدّثين .
ومن اللافت تأمليًا، ذلك التجلّي الصارم لاحترام المنهج عند علماء الإمامية في تعاملهم مع ظاهرة التعارض في توثيقات الرجال وتضعيفاتهم الروائية. فحين يقع التباين بين الشيخ الطوسي (شيخ الطائفة) والشيخ النجاشي، لا تُسلَّم الكفّة للأشهر أو الأوسع اشتغالًا، بل تُرجَّح كفّة النجاشي(2)، لا لاعتبارات رمزية أو سطوة تراثية، بل لأن الرجل اختصّ في علم الرجال وانغمس في فنونه، مكرّسًا له اشتغاله المعرفي. بينما الطوسي، وإن بلغ ما بلغ، فقد تفرّقت همّته على علوم شتى من الفقه والأصول والكلام والتفسير.
إنها ليست مفاضلة بين أسماء، بل بين منطقين: منطق التخصّص ومنطق التوزّع. يُقدَّم المُركِّز، لا لأن الانحصار يُفضي إلى ضيق، بل لأن التركيز يُنتج كثافة، وعمقًا، واستيعابًا بنيويًا للظاهرة.
***
أ. م. د حيدر شوكان السلطانيَّ
قسم الفقه وأصوله- جامعة بابل
................
1- د. عبد الجبار الرفاعي، الدين والاغتراب الميتافيزيقي، الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين – بغداد، الطبعة الثانية- 2019م، هامش 133.
2- ينظر: الشيخ جعفر سبحاني، دروس موجزة في علمي الرجال والدراية، الناشر: مركز المصطفى العالمي – إيران ،186.