قضايا
حيدر عبد السادة جودة: أزمة الخطاب الديني المعاصر
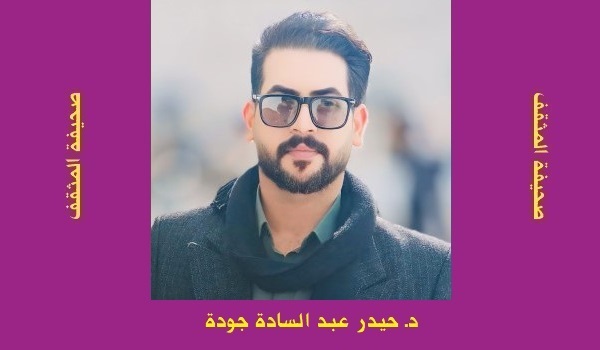
لا شك في أن أزمة الخطاب الديني المعاصر هي أزمة فكرية في لبها ومنطلقها، فالأمة الإسلامية في سائر شعوبها، وفي مقدمتها الشعب العربي، تعيش أزمة فكرية، تتجلى في شكل غياب ثقافي، وتخلف علمي، وكسوف حضاري، وتتجسد في عجز الخطاب الفكري المعاصر عن إيصال الخطاب الإسلامي السليم ومحتواه، قرآناً وسنة وشريعة وأخلاقاً. فضلاً ذلك فهي أزمة الافتقار إلى المنهج العلمي في ميدان الدراسات المختلفة. فمناهج التجديد مثلاً، تمثل المسارات السلوكية للجماعات وتوجه فعاليتها وطاقاتها، وكلما كانت هذه المناهج متقنة ومحكمة انعكس ذلك على تنظيم وحركة الفعاليات، وإن النظرة التقويمية لمناهج التجديد الإسلامي تكشف عن وجود أزمة ومشكلات حقيقية في منهج الخطاب. فلا زال الخطاب الديني المعاصر ينتمي إلى الماضي، ولا زال غالبية الوعاظ والدعاة أسرى للخطاب الماضوي والأساليب القديمة في التبليغ، وتتردد على ألسنتهم مصطلحات عفا عليها الزمن، ولم يبق لها وجود سوى في المعاجم اللغوية، وهجرها الناس لوحشيتها أو غرابتها وثقلها على الإسماع. والى ذلك يذهب (حسن الترابي) في أن مرد الإخفاق الذي كان مآل كثير من تلك الحركات يعود إلى أن دوافع الإيمان الثائر لم تكن توافيها وجوه فكر تهديها، ولا مناهج عمل ترشدها. لذلك نراه ينطلق في صياغة قراراته مستنداً أولاً وقبل كل شيء على المرجعيات الدينية وسلطة السلف، متجاهلاً الأساليب العلمية والمناهج المعرفية السائدة، وإذا كانت هذه المرجعيات قد أدلت بدلوها عن طريق الاجتهاد، فمن المحال أن تتحول هذه الاجتهادات إلى نصوص مقدسة، كما يسعى الخطاب الديني إلى تقديسها وتحويلها من نصوص ثانوية إلى نصوص أصلية تمتلك مشروعية النصوص الأصلية.
فتجديد مناهج الفكر ضروري، كون إن الانحسار والأزمة التي نعاني منها ناتجة عن أزمة فكر بالأساس، لان العطاء الفكري للحضارة الإسلامية وإسلامية المعارف قد توقف عند حدود العقول السابقة. حتى أصبح الهم الوحيد يكمن في كيفية فهم نتاج هذا العقل أو ذاك، وكأن سمة الإبداع والابتكار قد طُمست، وما علينا إلا أن نعيد هذه الأفكار التي تراكمت عليها الأزمان، والعمل على إحيائها كونها كفيلةً بإنقاذنا وتحريرنا من أزمتنا المعاشة.
لذلك كانت السمة الأساسية والمحددة للخطاب الديني تمثل في الجمود والعكوف على رواسب التراث، فلا تحبذ المراجعة النقدية لها، بل تتقاعس عن تلك المراجعة وعن الصيانة الذاتية لأنماط حركتها، ليتحول ذلك التقاعس إلى تقديس الإرث الفكري ليرتفع به دوغمائياً عن الممارسة النقدية. وبالتالي نراه أسير مفاهيم ومنطلقات أساسية جعلته حبيس أخطاء الماضي وانحرافاته دون القدرة على الفهم والتمييز وتصحيح المسارات، والغوص في أعماق القضايا التي يواجهها، وتحصيل اللباب من ورائها، حتى تنطلق المسيرة راشدةً واثقة باتجاه المستقبل، لا أن تقعد كفيفة مكبلة في زوايا الماضي الغابرة. وبالتالي فليس التراث هو الذي يقف عقبة أمام التجديد، وإنما تقديس التراث هو الذي يحول دون قيام التجديد. وما دام الخطاب الديني ينظر إلى الماضي بقداسة، ويسعى إلى استعادته واستنساخه برمته من دون تمييز بين غثهُ وسمينهُ، ثابتهُ ومتغيرهُ، مطلقهُ ومقيده، معتبراً أن سعادة الأمة وعزتها تكمن في ذلك، وأن تأخرها وهزيمتها بدأت عندما انقطعت عن تاريخها. فلا يمكن لقيام التجديد فيه.
وبالإجمال فإن الخطاب الديني يسعى إلى تحويل الاجتهادات والتأويلات العقلية إلى نصوص مقدسة لا يمكن المساس بها أو التقرب إليها، وكأن باب الاجتهاد قد فتح للسابقين دون اللاحقين. وهل من المعقول أن تكون تلك الاجتهادات التي مر عليها قرون عديدة تكون كفيلة بالتصدي إلى هموم وإشكاليات الواقع المعاش، في حين إن لكل عصر اجتهاداته ولكل جيل إبداعاته، كما يقول حسن حنفي.
***
د. حيدر عبد السادة جودة







