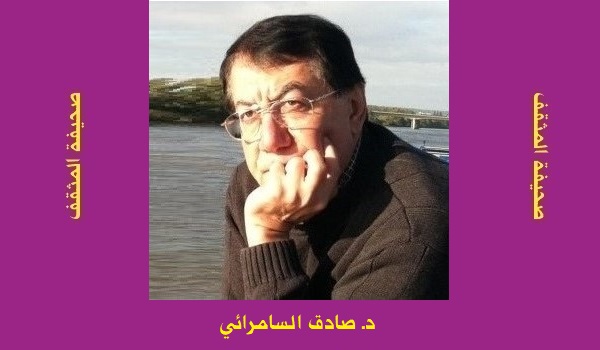قضايا
وسام حسين العبيدي: هل يمكن أن نكون من الهمج الرعاع؟

في مأثورنا العربي، كثيرة هي الحكم والأمثال التي ذهب أصحابها، وبقي فحوى تلك الحكم والأمثال يرنُّ في الأذهان ما بقي الزمن، وليس قول الإمام علي ع لكميل بن زياد، إلا واحدًا من تلك الشواخص الحية في الذاكرة العربية، ولا أريد استرجاع هذا القول بتفصيلٍ يعرفه الكثيرون، بقدر ما أريد الوقوف على هذا القسم الثالث من الناس، ممّن شبّه سلوكياتهم بنوعٍ من الذباب أو البعوض لصغر حجمه، يسقط على وجوه الغنم المهزولة والحمير وأعيُنِها، يُزعج الدواب بحركته العشوائية السريعة حول الوجه، ولعل وصفه بالهمج، جاء اشتقاقًا من الفعل "هجم" فهو لا يفتر عن هذه الصفة، ولكن هجومه يتصف بالعشوائية أو الفوضوية، ومنه جاءت الصفة "الهمجيّة" لتُدلل على هذا السلوك العدواني الفوضوي الذي يؤذي الآخرين حتى في التصدّي له؛ لأن من يتصدّى له لا يعرف الخطة التي يسير عليها مثل هذا العدوّ..!
وهنالك من اللغويين من رأى أنّ كلمة الهمج، تدل على الحمقى، فـ(الهَمْجَة من النَّاس: الأحمق الَّذِي لَا يتماسك، والهَمَج جمعُ الهَمجَة)، أو الجوع، وكلُّ هذه المعاني لا تتقاطع مع المعنى الأول الذي عرضناه آنفًا، إذ يجمع هذه المعاني دلالة الفراغ، والعبَثيّة، والاضطراب، وعدم الاتّزان في القول أو الفعل. ومن المؤكَّد بل اليقين، أنَّ فراغ الإنسان من عقلهِ، أو عدم الاحتكام إليه، يُفضي به إلى العَبَثيّة في السلوك، وكلُّ من يتّصف بهذا الوصف، فهو أحمق لا يملك قياد نفسه؛ لأنه مفتقرٌ إلى عقلٍ يُرشِدُهُ إلى الصواب.
والملفت أن الإمام علي لم يكتف بوصف هذه الفئة من الناس بالهمج، بل أردفها بصفةٍ أخرى لم تكن بأفضل دلالةً منها، إن لم نقل إنها جاءت مُفسِّرةً للوصف السابق، فوصفهم بالرِّعاع، ودلالة هذه الكلمة، تعني فيما تعنيه: "السفلة من الناس" . وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب، ذكرًا لهؤلاء، وذلك في قوله: "إن المَوسم يَجمع رَعاع الناس". أي غَوْغاءهم وسُقّاطَهم وأَخلاطَهم، وغيرها من الشواهد التاريخية التي تُدلِّل على هذا المعنى الذي أوضحناه آنفًا..
وإذا تمّ لنا هذا المعنى، فمن الطبيعي أن لا أحد يرضى أن يكون مصداقًا لهذه الفئة من المجتمع، فهي فئة لا يتشرف أحدٌ بالانتماء إليها. ولكن هل نتمثّل – لا شعوريا – سلوكيّات هذه الفئة...؟ ونكون في أعمالنا ضمن هؤلاء الذين نالوا استهجان الإمام علي الذي لا يختلف عليه اثنان في صلاحه ورجاحة عقله وحنكته وبُعد نظره وتدبيره، فقال عنهم: "أتباعُ كلِّ ناعقٍ، يميلونَ مع كلِّ ريحٍ، لم يستضيئوا بنورِ العلمِ، ولم يَلْجؤوا إلى ركنٍ وثيقٍ"، ومن الواضح أن تفصيله بيان حال هذه الفئة من المجتمع دون الفئتين السابقتين – العالم الربّاني والمتعلم على سبيل نجاة – لدليلٌ واضحٌ على التحذير من أن يكون سامعو هذا الخطاب العابر للزمن، مصداقا لهذه الفئة، بما جعله يُفصّل في أحوالهم؛ ليُلقي البيّنة لمن تورّطَ باتخاذ مسلك هؤلاء.
ولنا أنْ نتخيّلَ مقدار استشعار هذا الإمام الهمام، خوفه من خطر هؤلاء؛ لما أوقعوه من فتن في حياته قبل تسنمه الخلافة وبعدها، ولما سيكون حال المجتمع، حين يطغى أمر هؤلاء، ويكون لهم الغلبة والحول والطول، من اضطرابٍ في مقاييسه، وفوضى في شؤونه، وتفشٍّ لرذائل الأخلاق، وانتهاك لقيم الإنسانية النبيلة، وضياعٍ للمُثُل العليا التي ينبغي أن تكون الربّان القائد لسفينة كل مجتمع ينحو إلى الخير والصلاح.
وقد يقول القائل معترضًا: وما شأنُنا نحن بهذه الفئة التي لم يكن لها تأثير سلبي في المجتمع، ما لم يكن الجهل سيّد الموقف في تلكم العصور، فبحضوره "الوبيل" تنتعش بفضله طبقة "الهمج الرعاع" وتعشو في دياجيره آخذةً في التمدُّد والانتشار، ولكن لا يختلف اثنان أننا الآن نعيش عصر العلم، عصر التكنولوجيا، عصر التوثيق الرقمي، عصر الذكاء الاصطناعي، عصر العولمة والحواضر العلمية، والمؤتمرات، والمختبرات، والبراءات العلمية في مختلف مجالات المعرفة، فلماذا الخوف والحذر من "الهمج الرعاع" وهم إنما يطفون على السطح الاجتماعي، في غياب كل ما ذكرناه من معالم الازدهار العلمي...؟! ويمكن لهذا السائل، أن يرى – وفقًا لقناعته – انتهاء صلاحية ذلك القول، وانحسار تأثيره في عصورٍ خلت، عشعش الجهل فيها، وباض في صدور أتباعه وأفرخَ، ما جعلهم لا يفرقون بين الناقة والجمل بحسب وصف معاوية داهية عصره، فلا حاجة لنا أن نستعيد هذا القول، أو نتخوّف أصلاً من مضاعفات تفشي هذه الفئة..!
وإذا أردنا الجواب عن سؤال هذا القائل، فإننا لا نملك إلا إجابتين لا ثالثَ لهما: إحداهما بالإيجاب، والأخرى بالسلب، وواحدةٌ من هاتين الإجابتين، لا تتطلّب من صاحبها بذل الأدلة والبراهين على إثبات مصداقيتها، والأخرى بعكسها تماما؛ إذ ستعتمد الأولى على ما طرحه سؤال هذا القائل، من أدلة، وتكتفي بها لتوكيد فكرته برهانا على صحته، فما على المجيب بذل الجهد إلا في دفع قناعة هذا القائل بالضدِّ منها؛ ليترجّحَ لديه سيرورة فحوى قول الإمام علي عن هذه الفئة، واستمرار تمثُّلاتها إلى يوم الناس هذا، وليكن بعدها على حذرٍ أن يكون جزءًا منهم، وهنا يبقى المعيار في ترجيح إجابة على أخرى، لا ينطلق إلا من الواقع المعيش، وليس الخيال الذي نفترض عليه ما ينبغي أن نكونَ عليه، فمن الواقع كانت المشكلة، ومن الواقع ينبغي أن يكون الحل لتلك المشكلة، ولا يصحُّ بحال، أن تتعالى على الواقع، ونُؤسِّسَ إجاباتنا على "ما ينبغي"، وفي مقام التوضيح، نجد هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الوصف مختلفين لا عن بصيرة ووعيٍ، بل عن هوىً قاد كل فرقةٍ منهم إلى مسلكٍ دون آخر، وإلى جهةٍ لا تغني ولا تُسمن من جوع عن الأخرى، وأعني هنا بالجوع لا المستوى الماديِّ منه، بل المعنويّ، وهو الفكر، هذا الذي عبّر عنه الوائليُّ في إحدى أروع قصائده، بالقول:
فانهَد له بالفكرِ يخضُدُ جذرَهُ
فالفكرُ ليس بغير فكرٍ يُقرَعُ
*
وأغِثْ جياعَ عقيدةٍ فهُمُ إلى
فكرٍ يُسدَّدُ من طعامٍ أجوعُ
نعم، تجاذبَ الكثيرَ منّا الأهواء والميول، ولم يكن العقل دليلا لهم في ما اتخذوه من مذاهب واتجاهات، فما كان أسرعهم إلى الباطل، بوقوعهم أسرى في شباك العاطفة، وانهماكهم في إشباع غرائزهم، باتّخاذهم الهوى إلهًا يُعبَد من دون الله، وما العبادةُ سوى الطاعة والانقياد، وكأن القرآن الكريم تحدّث عن هؤلاء "الهمج الرعاع" في قوله الحكيم: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [القصص: من الآية ٥٠] ولا يخفى على المتأمِّل، ما تصفه الآية عن هؤلاء أنه لا يوجد أكثرَ ضلالةٍ منهم، وكأنَّ اتِّباع الهوى قرينُ الضلالةِ ومُؤدٍّ لها، والضلالة ليست إلا الضياع والتخبُّط بما يُنسي الإنسانَ قيمتَه العظيمة في هذا الوجود، ويجعله يسيء لهذا النظام الحكيم الذي سخّره الله لخدمته، شرطَ أن يكون سَوِيّ التفكير، سَوِيّ الوعي، سَوِيّ الفطرة، يبحث عن كل ما يرفع قيمته الإنسانية، ويربأ عن كل ما يشوِّهها أو يخدِّرَها أو يمسخها، ولعل من أوضح الأمثلة المؤلمة في واقعنا المعيش، أنَّ الكثير لا يأبه لأولي الفضل، من أهل العلم، فلا تجد لهم توقيرًا بين هؤلاء، ولا تعظيمًا لشأنهم، بعكس ذلك نجد الجهلة – أو الذين يلبسون مسوح العلماء وهم من الجهلاء – يلتفُّ حولهم الناس، ويتقاطرون عليهم، ويروّجون بضاعتهم، ويتهافتون لاقتناء ما يصدر عنهم، يتأثرون بهذا أو بذاك، من دون أنْ يكون لهم خيارٌ نابعٌ من دراية ومعرفة، فيتشبّثون بالآخرين، ويتّكلون على خياراتهم، فكانوا فعلاً كما وصفهم الإمام أنهم "همج رعاع أتباع كل ناعق"، ويُعقّب ابن أبي الحديد توضيحًا لهذه الفقرة بقوله: "ألا تراهم ينتقلون من التقليد لشخصٍ إلى تقليد الآخر لأدنى خيالٍ وأضعفِ وهمٍ..؟" .
وإذا نظرنا في واقعنا، وجدنا على سبيل المثال، ما يخص الجانب الثقافي، ففي المحالِّ المخصّصة لبيع الكتب، لا ترى الكتب المهمة تلقى اهتماما من الزبائن مثل كتب قراءة الكف أو تفسير الأحلام أو التي تتحدث عن أسرار الأبراج، أو كتب التنمية البشرية لمن هبّ ودبّ من أدعياء هذا المجال، أو الروايات والقصص المغمور أصحابها، والتي لا تحمل المضامين العميقة في مختلف جوانب الحياة، ولنُلقِ نظرةً أخرى في المجال السياسي، فهنا أيضا لا يختلف الحال عن سابقه، إذ الجمهور يميل إلى القائد الأكثر بذلاً للأموال والمغريات في سبيل الفوز في حملته الانتخابية، وهؤلاء الذين انقادوا لمغريات هذا المرشّح، لم يضعوا في حسبانهم أن صوتهم الانتخابيَّ أمانةٌ عليهم أن يُحسنوا الاختيار؛ ليكون مستقبلُهم ومستقبلُ أولادهم أفضل مما هم عليه الآن من بؤس وحرمان، فلم يُفكِّروا إلا في قضاء يومهم، وحالُهم بهذا الفعل المُتدنّي، "كَالْبَهِيمَةِ اَلْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا أَوِ اَلْمُرْسَلَةِ شُغُلُهَا تَقَمُّمُهَا تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلاَفِهَا وَ تَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا"، بحسب وصف علي بن أبي طالب في رسالته لعثمان بن حنيف عامله على البصرة. وهكذا الحال نفسه تجدهم في أغلب المجالات، إذا لم نقل جميعها، يغيب العقل والوعي وانعدام الثقافة والذوق في أكثر سلوكياتهم ومواقفهم، ويسيطر الجهل بما يُقدمون عليه من فعل لا يكترثون أن يعود وبالاً عليهم فيما بعد..! ولعل من الأوصاف التي تنطبق عليهم، ما ذكره المسعوديُّ في وصف أخلاق هذه الفئة "أن يُسوِّدوا غير السيّد، ويُفضِّلوا غير الفاضل، ويُقوِّلوا بعلمٍ غير العالم، وهم أتباعُ مَن سبق إليهم من غير تمييز بين الفاضل والمفضول، والفضل والنقصان، ولا معرفة للحق من الباطل عندهم، ثم انظر هل ترى إذا اعتبرت ما ذكرنا ونظرت في مجالس العلماء هل تشاهدها إلا مشحونة بالخاصة من أولي التمييز والمروءة والحِجى، وتفقُّد العامّة في احتشادها وجموعها، فلا تراهم الدهر إلا مُرْقِلين إلى، قائد دبٍّ، وضارب بدف على سياسة قرد، أو متشوقين إلى اللهو واللعب، أو مختلفين إلى مشَعبذ متنمِّسٍ مُخرِّق، أو مستمعين إلى قاصٍّ كذاب، أو مجتمعين حول مضروب، أو وقوفاً عند مصلوب؟ يُنْعَق بهم فيتبعون؟ ويصاح بهم فلا يرتدعون، لا ينكرون منكراً، ولا يعرفون معرفاً، ولا يُبالون أن يلحقوا البرَّ بالفاجر، والمؤمن بالكافر". وهذه الصفات والأحوال لا نستغرب من وجود بعضها ماثلةُ في سلوكيات من يعيشون في عصرنا الحالي، مع بعض الزيادات التي تتطلّبها متغيّرات العصر، فلكلِّ عصرٍ أدعياؤه من الزعماء والرموز، ومن الهمج الرعاع.
ولو تصفّحنا العالمَ الافتراضيَّ – بوصفه العالَمَ المُوازي الواقعي ويعكس صدى شخصياتهم فيه – لما وجدنا كبيرَ فرقٍ عن الواقع الذي يعيشه من ينطبق عليهم وصفُ "الهمج الرعاع"، فمن يُروِّجُ للمحتوى الهابط غير هؤلاء...؟ ومن يتهالك تملُّقًا لصفحات أهل الدنيا من سياسيّين كذبة، أو أثرياء تنامت ثروتهم من الحرام والشُبُهات، ومن منافقين يدّعون – كذبًا وزورًا – أنهم يُمثِّلون الوطنية أو الإنسانية أو التديُّن أو الفن أو الثقافة أو غيرها من الدعوات العريضة، وليس لها وجودٌ حقيقي يتجسّد في الواقع، إلا في الكلام، أو لغرض الإشهار والصعود بتلك المُشاهدات على رؤوس هؤلاء المخدوعين فيهم، أو قد تجد من يتمسُّك بالإشاعات الكاذبة ليرضي هواه، فيشارك خبرًا كاذبًا، أو صورةً مفبركةً، لا أساس لهما من الصحة، ولا نصيب لهما من الوثاقة، فيلهث وراء بريق الإعلام الزائف، وتنطلي عليه الأكاذيب، ويبثُّها على صفحته منساقًا وراء رعيلٍ من الموهوبين أمثاله بتلك الأخبار أو تلك الصور، مسرورًا بها، وهو لا يعلم أنه بهذا النشر، أو بذلك التعليق، يُسهم - من حيث يشعر أو لا يشعر - في تخريب المجتمع، وزيادة الطين بلةً في مسخ قيم الإنسانية النبيلة فيه، مُشاركًا في ترسيخ الرذائل وتطبيعها في المجتمع، بما يُضاعف حجم الداء، ويقطع الطريق أو يكاد لمن يسعى إلى النهوض بواقع لما هو أفضل، وهذا كلُّهُ لا يصدر إلا من "الهمج الرعاع" أيًّا كان شكلهم أو مراتبهم الاجتماعية، بما يُوحِّدهم في هذه الفئة، عبر هذه السلوكيات التي تُترجم مصداق هذا الوصف عليهم سواء أكانوا من فئات متدنّية معيشيًّا لم تُتِح لهم الظروف إكمال شوطهم في الدراسة، أم كانوا من المتعلِّمين، ولكن لم يعملوا بما علموا، ولم يكن علمهم وسيلةً يرتقون بها في حياتهم اليومية لما فيه كمالهم العقلي والأخلاقي والنفسي، وهؤلاء الذين وصفهم القرآن الكريم (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّـهِ وَاللَّـهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [الجمعة:٥] والحكمة من هذه الآية الكريمة أنها لا تقتصر في دلالتها حصرًا على من لم يعمل بآيات التوراة، بل تنطبق على كل من يحمل علمًا ولا ينتفع به، ولا يقوده إلى الخير والصلاح والإصلاح، إلى النور بعد أن كان في الظلام، وهذا ما يؤكده قول علي بن أبي طالب في حواره مع كميل عن هؤلاء، (لم يستضيئوا بنورِ العلمِ، ولم يَلْجؤوا إلى ركنٍ وثيقٍ) فهم جهلة فارغون من العلم، يلوذون بهذا أو بذلك من المُدّعين، يميلون مع كل ريح هوجاء – وهي رمز لكلِّ تيار أو اتّجاه أو رمز لا يمثِّل الخير والصلاح في مضمونه - لضعف معارفهم، ورخاوة وعيهم الذي بانعدامه يتعرضون لمثل هذه الاهتزازات في اختياراتهم، ولا يملكون الصمود إزاءها، أو لديهم من العلم ولكن لم يعرفوا كيفية الاستفادة منه، أو توظيفه ليضفي عليهم حصانةً فكريةً تقيهم شرّ الوقوع في شِراك الجهل أو من يقودون المجتمع لهاوية الجهل والتجهيل عبر تسطيح الوعي الجمعي وتخديره بأفكار تمحو شخصيته، وتمسخ هويته، وتزيُّن المنكر بشعارات جوفاء، بما آل حالهم إلى ما وصفهم الإمام علي .
***
د. وسام حسين العبيدي