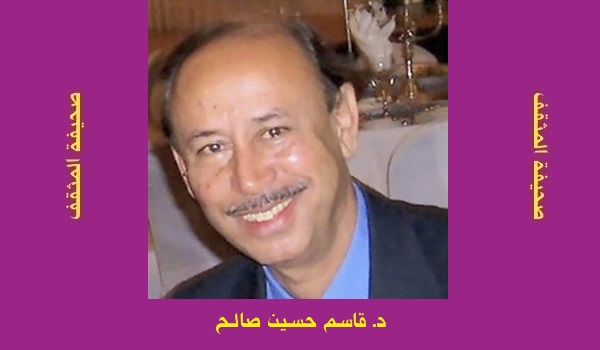آراء
ثامر عباس: النعرة "العراقية" لبعض المغتربين
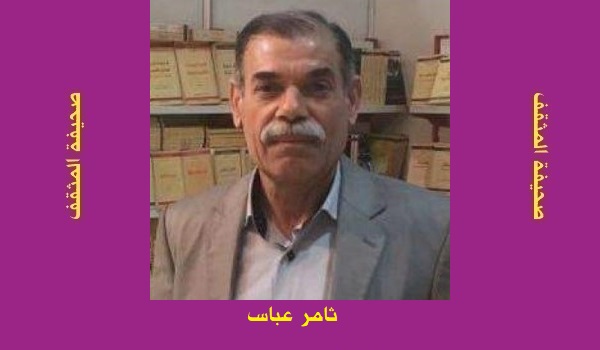
هل هي تعبير عن (حنين) وطني، أم (اغتراب) اجتماعي؟!
كثيرة هي قصص العراقيين (المغتربين) الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها – طوعا"أو كرها"- يعيشون في بيئات اجتماعية وحضارية مغايرة تماما"لبيئاتهم المحلية السابقة، والتي نشأوا في ربوعها وترعرعوا بين أحضانها، وتغذوا على قيمها وأعرافها، وتشربوا من عاداتها وتقاليدها. بحيث أضحى عليهم مقاومة العديد من الأحاسيس المختلطة والمشاعر المضطربة التي غالبا" ما يستشعرها المترحلون في فيافي الغربة.
وفي حديثنا عن هذه الظاهرة (النعرة) العراقية، التي ربما تكون ظاهرة (عامة) بين مختلف شعوب العالم التي تجوب جماعاتها (المهاجرة) بلدان وأوطان لم تكن لتفكر يوما"في زيارتها، ناهيك عن استيطانها والاستقرار فيها. ينبغي علينا أن نراع القضايا والمسائل المتعلقة بسيرورات وديناميات (المجايلات) الاجتماعية والثقافية، التي من شأنها خلق الكثير من التباينات السيكولوجية والاختلافات القيمية بين جيل (الآباء) وجيل (الأبناء) وجيل (الأحفاد). حيث ان تأثيرات (النعرة) المذكورة تبدو واضحة وجلية لدى أبناء الجيل الأول بحكم ترسبات تربيتهم السابقة، هذا في حين يبهت بريقها وتخمد جذوتها – بدرجات ومستويات - لدى أفراد الجيل الثاني، وذلك جراء اختلاط قيم آبائهم الموروثة بقيم مجتمعاتهم الجديدة المكتسبة. أما بالنسبة لأبناء الجيل الثالث فلا يكاد يكون لتلك النعرة (العراقية) أثر لا على صعيد الوعي ولا على صعيد الذاكرة، وذلك على خلفية انخراط واندماج هؤلاء في أتون عمليات بيداغوجية وإيديولوجية مكثفة، استهدف إعادة ترتيب أولويات (انتماؤهم) للمجتمع المضيف وأسبقيات (ولاؤهم) للدولة المستقبلة.
وفي إطار ما هو وارد في عنوان المقال، فإن الفئة الأولى من (المغتربين) هي المقصودة في المناقشة الحالية للموضوع، وذلك بناء على افتراض ما يزعم إن عناصرها ما برحوا يحملون بين جوانحهم فائض من (الحنين) لمرابض الصبا التي غادروها مكرهين منذ عقود، وهو الأمر الذي غالبا"ما يشعرهم بوطأة المعاناة النفسية والمكابدات الوجدانية. والحقيقة أنه في ضوء الكثير من المؤشرات والعديد من المعطيات التي تمخضت عن تجارب إعادة الارتباط ما بين الشخص (المغترب) من جهة، وما بين الواقع (الوطني) من جهة أخرى، إن مشاعر تلك النعرة (العراقية) التي تظهر لدى المغترب لا تتأتى بدافع (الحنين) لأرض الوطن كما يزعم، وإنما تتمظهر جراء طغيان الإحساس بحالة (الاغتراب) الاجتماعي التي يكابدها ذلك المغترب، بعد أن يكون قد (جرد) تماما"من كل تلك الصلات الأسرة والأواصر القرابية والعلاقات الاجتماعية التي كانت تغمره بحميميتها (العراقية) المعهودة.
نعم، قد يشعر الإنسان العراقي (المغترب) بلواعج (الحنين) للوطن – هل قلت وطن؟! - في بعض الأحيان، لاسيما حين تقع عيناه على لافتة كتب فيها ما يشير الى اسم (العراق) أو (بغداد) سواء على واجهة مطعم أو مقهى أو أسواق، أو يلتقي بشخص ما يتكلم اللغة (العربية) أو يرطن باللهجة (العراقية) عن طريق الصدفة، أو يستقبل مكالمة هاتفية عابرة من بعض أقاربه أو أصدقائه المقيمين في العراق. ولكن، ما أن تختفي تلك المنبهات الحسية والمثيرات النفسية والدلالات السيميائية والإيحاءات الرمزية التي استدعت تلك الإستثارات السيكولوجية الجيّاشة، سرعان ما يضمحل ذلك الشعور المفاجئ ويختفي ذلك الإحساس الخاطف في غياهب النسيان وكأن شيئا"لم يكن، على أمل أن تتم استعادته والانغمار فيه مرة أخرى في ظروف زمانية مختلفة وأحوال مكانية مغايرة.
والمفارقة التي يتميّز بها الإنسان العراقي (المغترب) عن سائر من يعيش نفس ظروفه ويكابد ذات معاناته، هي أنه ما يقرر (العودة) الى العراق - بعد أن لم يعد قادرا"على تحمل قساوة (الوحدة) الناجمة عن التفكك الأسري، وفشل تكيفه مع انقطاع سبل التواصل الاجتماعي مع أصدقائه ومعارفه - في الأيام الأولى التي تطأ قدماه أرض (الوطن)، ويلتقي بمن فارقهم طيلة مكوثه في بلاد (الغربة) من بقايا أفراد أسرته أو أقربائه أو أصدقائه، لا يلبث أن يخضع لسلسلة من التحولات الاجتماعية والنفسية والثقافية والرمزية، التي من شأنها إعادة جدولة بنى وعيه وأنماط سلوكه السابقة بما يتناسب وطبيعة أوضاعه وظروفه الجديدة. بحيث لم تعد الهواجس والمكابدات السابقة التي كانت تجتاح كيانه بين الحين والآخر تعبيرا"عن (الحنين) للوطن و(الاشتياق) للوطنية كما كان يزعم، وإنما حلت مكانها هواجس ومكابدات أخرى مختلفة في طبيعتها ومغايرة في مضامينها، ليجسّد من خلالها ما كان يعتقد أنه تغلب عليه وتجاوزه من أصوليات وعصبيات ونزعات.
واللافت ان هذا (المغترب أو المهاجر) العائد الى حضن (الوطن)، قد يتفوّق على أقرانه من العراقيين المقيمين في مجال تبرير سلوكياته وتسويغ تصوراته، استنادا"الى ما أتيح له من فرص وإمكانيات الانخراط في مضمار الدراسات الاجتماعية والإنسانية الحديثة، التي تمكن من تحصيلها خلال مكوثه في بلاد الغربة – لاسيما وان بعضهم يحملون شهادات جامعية متقدمة – بحيث تكونت لديه ترسانة من الحجج التي يدافع من خلالها عن آرائه ومعتقداته، والتي ربما تبدو مستهجنة وغير منطقية لمن لا يشاطره مواقفه السياسية وقناعاته الإيديولوجية. ولعل تبعات وتداعيات هذه الحالة تبدو واضحة أكثر على أولئك الذين ينحدرون من أصول ما يسمى ب(الأقليات) القومية والدينية والثقافية، التي عانت على مدى عقود من سياسات الإقصاء والاستبعاد والتهميش؛ إما لأسباب عنصرية / شوفينية، أو لدوافع طائفية / مذهبية، أو لدواعي حزبية / إيديولوجية.
وإذا ما نظرنا الى هذه الظاهرة / الحالة السوسيوسياسية، عبر منظار الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المزري الذي أنتجته تجربة الإسلام السياسي في العراق المعاصر، عقب زلزال سقوط النظام السابق وتصدع كيان الدولة المركزية، فإننا سنلاحظ ان هناك علاقة طردية ما بين الموقف (الوطني) للعناصر العائدة من ديار (الغربة) من جهة، وبين مدى انخراطها في العمل السياسي ضمن قوائم الأحزاب والتكتلات المهيمنة على المشهد السياسي العراقي من جهة أخرى. أي بمعنى انه كلما توغلت هذه العناصر في مضمار العمل الحزبي / السياسي المتطيّف، كلما تضاءلت حماستها (الوطنية) وتراجعت حميتها (العراقية)، وكلما أمعنت في استثمار سلطة موقعها الحزبية ونفوذ صلاحياتها الحكومية، لتعويض ما تعتبره تراكم (مظالمها) التاريخية مع الأنظمة السياسية السابقة بنوعيها الملكي والجمهوري.
ولعله من الضرورة بمكان الإشارة الى أن هناك قلة من هؤلاء (المغتربين) ممن قرروا العودة الى العراق، تعرضوا لوابل من الصدمات الكبيرة حين وجدوا ان (الوطن) الذي كانوا يتباكون على فراقه في بلدان (الغربة) ويحنون للعيش في ربوعه مجددا"، استحال خلال عقدين ونيّف من الزمن الى غابة موحشة لا تسكنها سوى الضواري المفترسة، وهو الأمر الذي دفع بهم الى إعادة التفكير في خياراتهم (الوطنية) المتهورة، ومن ثم استئناف حمل حقائبهم مجددا"لمغادرة أطلال ما كان (وطنهم) والعودة من حيث أتوا، ولكن هذه المرة بلا أوجاع فراق ولا حنين غربة !!
***
ثامر عباس