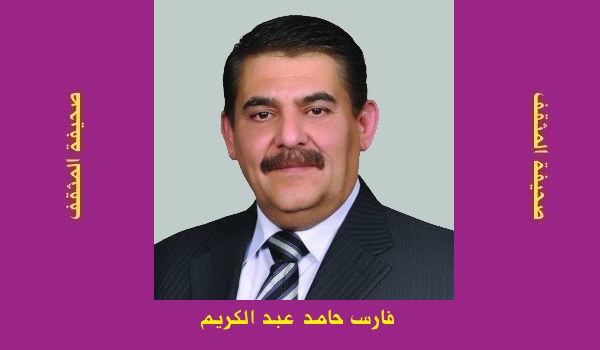مقاربات فنية وحضارية
جمال العتابي: التشكيلي أديب مكي.. لا يتهيب التجريب ولا يعترف بالسكون

يرتبط اسم الفنان التشكيلي أديب مكي بعائلة تنتمي للفن والثقافة، أغلب أفرادها فنانون تشكيليون، يكفي أن نقول ان الفنان النحات طالب مكي بمنجزه الفني الخالد أحد أفراد هذه العائلة شقيق الرسام أديب. ومعلّمه الذي درس على يديه الفن.
في سبعينات القرن الماضي، بدأ اهتمامه برسوم الأطفال، وكانت بداية مهمة ورائعة في " مجلتي" مع طالب مكي وفيصل لعيبي وصلاح جياد ووليد شيت ومؤيد نعمة وضياء الحجّار ورحيم ياسر وآخرين، واستطاع أن يثبّت أقدامه بينهم بشخصيته المميزة وأسلوبه في الرسم. واتّخذ هذا الاهتمام حيزاً واسعاً في تجربة أديب الفنية. فاشترك مع عدد من زملائة عام 1972 في تقديم أول فيلم عراقي لرسوم متحركة، لكن الأهداف والرؤى تغيّرت فاتّجه أديب لرسم وجوه النساء بأساليب وتقنيات مختلفة بهدف إثارة الرغبة في اكتشاف الغموض. واستخدم ألواناً مشرقة تعكس الروح الشرقيّة التي حدّدت معالم شخصيته وفنّه الإبداعي. ثم بدأ برحلة البحث عن معانٍ جديدة في التعبير عن تجربته في خامات مختلفة، وتطلّب الأمر استخدام مواد عديدة تحمل نبض البيئة المحلية، كالأخشاب والمعادن الصدئة والأقمشة، وأنواع أخرى من الأنسجة راح يعالجها بطرق مختلفة، وبفعل مهاراته التقنية تمكّن أديب من إدراك عناصر الجمال في هذه المواد متبنياً المزج بين الواقعية والتجريدية للتعبير عن نفسه.
غادر أديب مكي وطنه عام 1997 إلى عمّان ومنها إلى الولايات المتحدة ليقيم هناك، أقام في عمّان معرضه الشخصي عام 1999 ليشارك بعده في العديد من المعارض في الرياض وبيروت ثم الولايات المتحدة.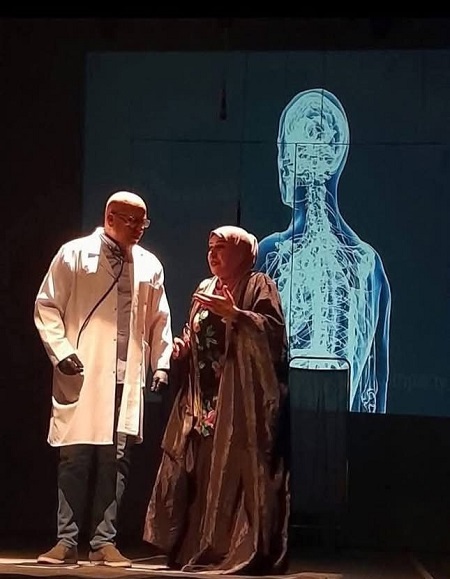
في تجربة أديب الفنية عدّة مستويات تشكيلية تتضافر وتشكّل بين مظاهرها جدلاً خاصاً وحميماً، وهي مستويات وأنساق لا تتقاطع بعضها ببعض، إنما تقوى وتنمو باتجاه حلم دائب للإمساك بـ (الشيئ الغائب) في العناصر والمفردات والأشياء، هاجسه الفني لا يقف عند الأطر الخارجية لها، إنما يسعى نحو المعرفة الأبعد والأعمق، نحو ما هو جوهري.
لا تخطئ العين بصمة الفنان اديب مكي، لأنها بصمة متحركة حيّة متطوّرة تحمل روح البحث والاستلهام والانطلاق نحو آفاق بلا ضفاف أو حدود فهي لا تقف عند مرحلة، ولا تتهيب التجريب ولا تعترف بالسكون الذي يؤدي إلى المحورية فالجمود.
ولكن هذه التجارب أفادته أعظم فائدة في تعلّم البناء وهندسة اللوحة وتماسك الشكل، والتكوين المحكم في العمل الفني، وقد كانت رحلته إلى الولايات المتحدة نقطة تحول في الاطّلاع على التجارب العالمية، ولاسيما طغيان الاتجاه التجريدي وانتشاره، وكان من العسير عليه أن يحقق تفرّده من دون إضافة شيء جديد إلى تجربته في الرسم عبر اشتغالات ورموز وتداعيات وأحلام ومشاهدات وهجرات.
يحاول أديب أن يقدّم مناخاً لونياً يثير السعادة في نفس المتلقي، وفي الوقت ذاته يكشف عن متناقض الحزن في داخله، يحاول أن يناكف حزنه الخاص بالفرح المتحقق في اللوحة، أو أن يقدّم جرعة متفائلة عبر منظومة تحيزت للألوان، تلك الجرعة التي أخذت مسارات متنوعة في الأداء وتنوّع طبيعة المادة. لوحاته تميزت بقدرتها على استحضار اللون بوصفها قيمة مستقلّة تضيء الأشياء من الداخل، وتعيد تركيب الحالات المرئية وغير المرئية.
في أعماله التجريدية الأخيرة تبسيط للخطوط يعطي إحساساً بالقوّة، اتّجه للتخلي عن الألوان المعتمة والقاتمة لتبتهج اللوحة بالخطوط الأفقية المستقيمة في وسط اللوحة، كثافة الخطوط ورهافتها تستجيب لامتزاج الألوان المنجزة بعناية تدلّ على أن الرسّام يحتفل كثيراً بميتافيزيقيا اللون، بحثاً عن دلالة ما فوق اللونيّة.
تلك المحاولة كانت بمثابة فترة تكوين ضرورية للفنان، فهو لم يبدأ التجريد كما يحصل لدى بعض الفنانين، إنما ظلّ يمارس الفن بأساليبه المتعددة، وفي الوقت ذاته لم تنقطع صلته بالتيارات الفنية المعاصرة، جرّب مدارس عدّة في أعمال متفرقة، مارس الانطباعية، والواقعية، وهو لم يتوصل من خلالها الى التعبير الفني المستقل والمتميز الذي ينشده، فهو ما يزال يواصل التجريب والبحث عن هويته الشخصية بمزاجية قلقة غير مستقرة.
ومنذ اختار أديب التجريد في ساحاته الفسيحة وتجاوز رسوماته الأكاديمية، فكأنما قد اختار الموسيقى معادلاً موضوعياً لألوانه وتشكيلاته التجريدية، فأعماله تحمل الإيقاع النغمي، وألوان تلك اللوحات فيها هارمونية تعلو وتهبط، تماماً كحركة الأمواج التي اكتنفت بَصَرَه وبصِيرته، وفي متتاليات مستمرة لا تهدأ.
التجريدية هنا في هذه الأعمال جذبته الى تلك الحرية المطلقة، إلى تلك المتعة الحسية وهو يعبّر عن ذاته والاحساس بالرضا. انها الوسيلة للتعبير عن الانفعالات والسعادة، انه معني بالقيم الجمالية والايقاعات الموسيقية التي تتضمنها، والأسرار الكامنة في اللون والخطوط، غايته أن يشاركه المتلقي في انفعالاته وخيالاته، إنه يخلق من أبسط الأشكال تكوينات وعلاقات تنفذ إلى أعماق المشاهد، فلا ينساها أبداً لأنها برغم بساطتها وهدوئها الظاهري مشحونة بعناصر القلق والصراع، توحي بالأعماق والأبعاد البعيدة. وفي تشكيلاته المختلفة تحليل تتجلّى فيه قوة البناء ورسوخه بإحساس الرسّام المتمكن، مما يشيع في أجواء لوحاته جواً من الطقوس والتعبّد.
لقد تخلّى الفنان إلى حدٍ ما عن الجانب الغنائي في أعماله، في سبيل التركيز على العنصر البنائي، بمعنى أنه لا يستخدم الألوان المتعددة المتراقصة في إيقاعات سريعة تشيع الإحساس بالطرب في عين المتلقي، إنما فضّل النفاذ إلى أعماقه من نفس مداخل التراجيديا التي تترك أثراً لا يمحى، لأن البنائيّة ترتكز على الكتلة وعلى الديناميكية النابعة من داخلها في غير إسراف لوني، فهو يحتاج إلى ألوان تغنّي.
هذا التحوّل في تجربة أديب، من الأكاديمي إلى التجريدي، ورسم الأشكال التي لا موضوع لها سوى الألوان والخطوط، لم يكن مجرد موقف فرضته اللحظة، إنما هو سعي نحو تحقيق الهوية، وكان من العسير أن يتحقق التفرد من دون إضافة شيء جديد.
أديب مكي لا يحاول أن يصل بالمشاهد إلى الإيهام، إنما يأخذ به الى الإبهار، وهكذا يتأكد التصميم الهندسي عبر الخطوط الأفقية ولا يخفت الإحساس بالديناميكية والحركة والحيوية في الأشكال، حريص على تنويعات لونية متضادّة ومتداخلة ثريّة الملمس، أشكاله كأنها سكك ممتدة نحو اللّانهائي، تشّع بالأضواء بشاعرية رقيقة.
بين هذه الخطوط المستقيمة وفضاءات اللون نوع من الحوار الموسيقي المتنوع كما في الأعمال السمفونية. لعلّ هذا الإيقاع في أعمال أديب هو سرّ جماليتها وجاذبيتها.
فحين تتجمع الطاقة الإبداعية في داخل الفنان تخرج الشحنة متدفقة، يتداخل فيها الوعي مع اللاوعي، إلى حد أنه بمجرد أن يفرغ من أدائه الإبداعي يتحوّل إلى متفرج يستقبل عمله بما يشبه الدّهشة وكأن شيطانه هو المبدع أو شاركه الإبداع.
أعماله الجديدة تمرّدت على المساحات الصغيرة، فاتّسعت لتستوعب شحنة التعبير. ويصبح اللون أكثر تماساً بفضاء اللوحة، وأكثر حيوية وتدفقا، تختصر في الوقت ذاته مساحات الظل النور، وتتحوّل إلى شظايا لونية، وومضات شفيفة، تجسّ جدل الحلم والذاكرة. لقد انجذب الفنان إلى تلك الحرية المطلقة والمتعة وهو يعبّر عن ذاته، من دون أن يتجاوز إحساس المتلقي بالرضا، كي يشاركه الدهشة.
***
د. جمال العتّابي