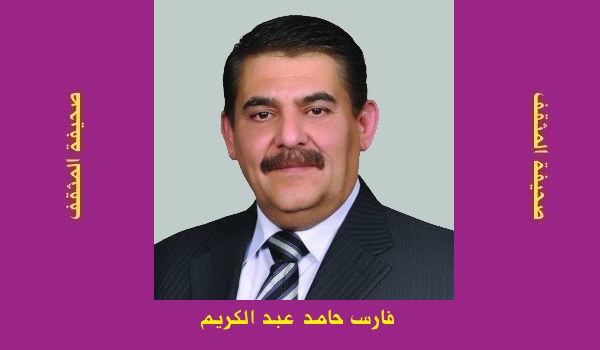مقاربات فنية وحضارية
سامي عبد العال: ترويض الطُقوس

هل تُؤثر الطقوس ثقافياً في حياة الإنسان؟ هل تحتل الطقوس منطقةً واضحةً أم غامضةً من تكويننا البشري؟ بأية معانٍ تسقط عباءةُ الطقوس هنا أو هناك داخل المجتمع؟ ماذا لو تمَّ تجسيدها فنياً؟
الخيط الناظم داخل أغلب لوحات الفنان محسن أبي العزم هو الطقوس. خيط امتدّ ضمناً وصراحة رغم اختلاف الموضوعات التي تجسدها. وهو الرابط الذي يتأصل وراء اللوحات التشكيلية نتيجة فهم عميق لمنطق الإنسان. إنه تعبير عن ثقافة المجتمعات العربية إجمالاً، مجتمعات(تستمدُ أسرارها) من الطقوس و(تصْنع الطقوس) إلى درجةٍ كبيرةٍ، حتى أنَّ الأحداث والمظاهر المؤثرة في ذاكرتها ذات طبيعة طقوسية مع رمي الخيط إلى منتهاه. فلكي تكون مجتمعاتُنا ذاتَ تأثيرٍ في الذاكرة، لابد أنْ تُدخِل فاعليها عبر طقوس حيةٍ. والطقوس هي أقرب الصور التي تتجلى خلالها نقاط إلتقاء بين (الدين والسياسة ورؤى العالم والحياة).
هذا الأمر يفكُ شفرات اهتمامنا المتواصل– نحن العرب والمصريين- بالطقوس (دينياً أو غيرها) بقدر تنوع مظاهر الحياة. في الدين طقوس، في السياسة طقوس، في الاقتصاد طقوس، في التعليم طقوس، في المناسبات طقوس، في المجال العام طقوس، في سلوك الأفراد طقوس. ولعل تلك سمة تميز المجتمعات البشرية لا العربية حصراً. وذلك لكي يواصل المجتمع ممارسة وجوده الرمزي أمام فاعليه طوال الوقت، فالمرجعيات تدخل من باب الطقوس إلى عقول ووجدان الناس. وهي أقرب وسيلة لإقناعهم بالأفكار والأفعال والانجذاب إلى نظام عام يؤطر الرؤى ويجدد المبررات التي تمسك وعي الأفراد.
حيث يمثل كيانُ الإنسان (هدفاً وإداءً)، (وسيطاً ومعنى) في الوقت نفسه. وتكشف الطقوس قدرتنا نحن البشر على انتاج الغموض كجزءٍ لا يتجزأ من وجودنا. الغموض هو المسافة التي تركها (البعدُ الميتافيزيقي) داخلنا أمام بعضنا البعض. فالإنسان مسكون بالمقدس، الاسرار، الألغاز، ولن يتعايش معها إلاَّ بالأداء الذي يجسد الأفكار. كل إنسان أسير لغموضه المأخوذ بتجليات حياته عبر أداء قلَّ أو كثُرَ. وفي المقابل، يؤكد ذلك أننا لم نعمق جوانب الإنسان الأخرى، لكي يختار صور حياته بشكل حر. وأنَّ مسئوليتنا العامة لم تعد محل ثقة إلاَّ بمقدار ولائه لأشياء واعتبارات أخرى مثل المعتقد والقوى الغالبة والمصالح. ونحن لم نرتق بعد إلى تأسيس مجتمعاتنا على عقد اجتماعي حُر يعطينا كل الحقوق ويأخد منا كامل الواجبات.
تستحضر الطقوس عدة أشياء:
1- الجانب المغيّب من الطقوس (عالم الغيب- المقدس – الأسرار – الإله).
2- نمط الطقوس مثل: (تحصين البيت من الجان- قراءة القرآن – إطلاق البخور – زيارة الأولياء – الرقية- التبرك – مراودة الأقدار).
3- الوسيط (الشيوح – العرافون- أهل البركة- الأولياء).
4- مظهر الطقوس بين الناس والقائمين بهذه الطقوس.
5- أداء الطقوس (الانهماك – الاستغراق – التجلي – التعبيرات الرمزية).
هي سمات توافرت في لوحة (الرُقية أو التعويذة incantation) التي يقدمها أحد الشيوخ لفتاة تعاني- فيما يبدو- من عثرات مقتبل العمر. والمشهد طقس ثقافي لا مجرد احضار لأحد الشيوخ بالمعنى الدراج. فالرجل مندمج في اشعال البخور ورسم الصورة وتلاوة آيات من القرآن أو من الكتاب الذي يقرأ منه. وتتفتح الفتاة مع التبخير الذي يتصاعد بين يدي الشيخ، وكذلك من جانب الخادمة الواقفة بالوراء والتي تعد جزءاً من الطقس. لم تشعر الفتاة بالحرج من وجود الشيخ الغريب، المجهول، بالرغم من أنَّ كيانها يدخل دائرة المحظورات، وكذلك لا يعبأ الشيخ بهذه الدائرة، لكونه منشغلاً بأسرار العمل. والثلاثة يرسمون دائرة من الطقس الملغز الذي يشد انتباه المشاهد.
ولكن ما الجديد الذي يجسده (طقس الرقية)؟ إنَّ الأسرار في مجتمعاتنا العربية – وبخاصة مجتمعنا المصري- لا يعلنها إلاَّ سرٌ آخر أكثر تأثيراً. الأسرار تزحم آفاق الإنسان وتتجاوب معها القوى الرائجة لديه. وكأن المسألة الإنسانية تظل طي الكتمان إلاَّ من إنفجار مخاوف البشر. فالحريم وحياتهن وأحوالهن وما يعانين منه .. موضوعات غير قابلة للمساس(المحرمات). ولكن استطاع الشيخ (القائم بالطقس) أن يدلف إلى تلك الدائرة المغلقة. ويرى الفتاة مكشوفة الوجه وبعض الجسم من غير حائل. وهو الانكشاف نفسه بالنسبة لمروضي السلطة حين يقتربون من بعضهم البعض باسم (التعاويذ) لطرد الشياطين والمناوئين.
كلُّ سرٍ مستغلق على الانكشاف عادة ما يُنتهك باسم الطقوس أحياناً، حتى أن جوف المنازل والبيوت يتعرى لمن لا يعنيه الأمر. وهذا ما يوجد بالطبع على الصعيد الاجتماعي والسياسي العام أيضاً. فالسياسة واقعة في مجتمعاتنا عبر دائرة المحظورات، ولن يدخلها أحد من غير حمل (مشاعل الأسرار)، ومن غير قدرته على التأثير النافذ، سواء أكان عن طريق سلطة مقدسة أم دنيوية أم مادية أم بشرية.
ولذلك يصل إلى المتلقي إحساسٌ بأن الطقس يتعلق بشيء متجاوز للواقع عادة. وأن الحقيقة ليست حاضرة لذاتها بالنسبة إلينا، فهناك شيء آخر يجعل الأسرار أكبر من وجود الإنسان. وهذا السبب في أن الإنسان يعرض نفسه للنظر مقابل غموض الأسرار. لأنه يعلم أنَّ هذا الإنسان ستأخذه الحقيقة أبعد من التفاصيل الضيقة. فالبخور مع التلاوة ونظرات الفتاة والخادمة في اللوحتين السابقتين يجذب المتلقي نحو واقع فائق على الوصف. وأن السر بإمكانه الانتقال الغامض إلى المتلقي بالنظر المدقق. وربما الفنان محسن أبو العزم يدرك هذه الفكرة إدراكاً فنياً يجعله يواصل هذا الخيط في أغلب إبداعاته الفنية. هو في لوحة أو اخري يسعى إلى ثلاثة مسائل:
أولاً: تشكيل طقسٍ ما حتى لو من مواقف إنسانية عامة.
ثانياً: إبراز الطقوس بوصفها مرتهنة ببنية المجتمع المصري.
ثالثاً: ربط الطقس بلاوعي المتلقي، وبالتذوفق الجمالي حين يعطي اللوحات عمقاً بخلاف الصور والألوان الجاذبة للرؤية المباشرة.
تأكيداً لهذا، فإن السمات الآنفة التي تميز الطقوس توجد في المشاهد الإجتماعية التي يترصدها الفنان إزاء مظاهر الحياة الشعبية الأخرى. فالإحتفال بميلاد طفل يأخذ الإطار والأداء نفسه الذي يفرزه الطقس الديني. إن الاثنين شعيرتان أحداهما ذات تجلي ديني غيبي والآخر تجلي إجتماعي ثقافي. والفنان يعبر عنهما بمنطق التكوين والحركة الثقافية التي تولد النتائج. فالطقوس الإجتماعية تجسد بدورها ما يلي:
1- قوة الانجذاب إلى الفعل (الحضور – الانشداد للمعنى- الإهتمام الوجودي).
2- التجسد (اخراج النوايا- التلقائية - العمل – استدعاء المغيب).
3- السرد (الاحداث المتشابكة – الصور المتداعية- الحبكة الدرامية).
4- الأداء الذي يشكل الواقع (حالة فرح– حالة تواصل- ممارسات شعبية – مشاهد من الحياة).
5- المشاركة الجماعية (النساء والأطفال والرجال وخلفيات المجتمع).
6- المعنى الكلي (تداعيات الثقافة - صورة المجتمع – الآثار البعيدة).
ففي المناسبات، يحرص الفنان أبو العزم على رسم جوانب الطقس الاجتماعي مع التفاعل بين عناصر المشهد، وتحويل السر من ورائها إلى معنى كلي يجب أن يتوافر بمساحة اللوحة – الحياة. لأنَّ اللوحة تأخذ جانباً طقوسياً هو الأعم للممارسة مما يعطي المتلقي مساحة لإلقاء المعنى إلى أبعد نقطةٍ ممكنةٍ. ففي اللوحة السابقة، يصور مجموعة من السيدات أثناء أحد الأفراح. تبدو الصورة معبرةً عن تبادل الفرحةِ كل بحسب ما تنخرط فيها. فهناك من تزغرد، وهناك من وضعت الحناء على يديها مع الحوار أو الشد والجذب. وهناك من تقف مشاركة في تجسيد المعنى وغيرهما تترقب المشهد ولا تبتعد عنه.
ورغم وجود نوع من المشادة بين النساء إلاَّ أن حناء اليد والخيمة المستعملة وبعض الآلات الموسيقية مثل طبلة الأعراس تشي بوجود مظاهر الفرحة. وهو التناقض الذي يحدث عادةً في الاعراس، فمع الأفراح تحدث بعض المشاكل التي تظهر على السطح كما هو حادث في اللوحة.
ومعنى الطقس يُبرز هذا التناقض، فالطقس يحتوي على الترهيب والترغيب. إن العرس يأخذ دلالة السعادة والفرح وكذلك لا يخلو من منغصات بين أطراف مختلفة. حتى ولو كانوا أطرافاً رئيسة مثل أهل الفرح أنفسهم. وهذا ما يحدث في الأفراح الشعبية عادة من ارتباطها بالعراك الذي يؤدي إلى أحداث أكبر. وهو مظهر كرنفالي عام.
ومعنى الطقس يدخل إلى اللوحة عبر صورة الكتاتيب الدينية، فالشيخ له كامل التقديس جالساً في مهابة لا تخطؤها العين. مهابة آتية من مكانة الدين في البيئات الشعبية بشكل عام، لأنه ركيزة في الخلاص من شظف العيش وتدهور الأحوال. وهي أمور بادية على مظهر التلاميذ داخل الكتّاب. بجانب التقديس يضع شيخ الكتاب رجل لمراقبة ومعاقبة التلاميذ، لأن الشيخ لا يرى. وقد يكون هذا المشهد فعلياً من أحد الكتاتيب(شيخ ضرير ويقف بجواره رجل مبصر)، لكن هذا الأمر له دلالة ثقافية، إذ أن الشيخ مصدر التقديس في الوسط المحيط به، ولكنه يترك آثاره من خلال مساعده الذي يمتلك النظر والقدرة على العقاب.
بدا العقاب ظاهراً، من قبل التلاميذ الواقفين وجها للحائط والآخرين المستبعدين أمام الباب والآخرين الذين بيشفقون على أنفسهم من مواجهة الشيخ (مصدر التقديس) وتحسباً لوقوع نظر مساعد الشيخ عليهم (مصدر العقاب) ويحمل الأخير عصا العقاب. وهي (عصا الطاعة) التي تجد مكانتها في الثقافة وتعد جزءاً من الطقس إجمالاً. وقد تجلى وجه اللوحة كزمن وحياة معاً، لم تكن اللوحة مظهراً لما يحدث ولا ناقلة لتفاعل الشيخ ومساعده مع التلاميذ في أحد الكتاتيب طي التاريخ، لكنها كانت مشهداً حاضراً لتوّه عن طريق دلالة الطقس. فالأخيرة لامست شغاف الثقافة من أعماقها وباتت حاضرة ومفسرة لما يجري.
استمر المعنى ذاته عند الفنان ليصنع طقساً من مائدة بين مجموعة من الناس. الطقس يتجلى في أسلوب تناول الطعام، فلا يوجد أحدٌ منهم لم يفتح فيه، وبدا الأمر لا يصور طعاماً بقدر ما يرسم الجوع والعوز، وكذلك أتضحت طريقة تعامل هؤلاء مع الطعام. فوجود الخيمة يدل على أنها مناسبة تقدم فيها الأطعمة سواء بجوار أحد الأولياء أم ضمن إحدى المناسبات.
لكن تناول الطعام يكشف مدى نهم هؤلاء الناس، فجميعهم يكشفون عن فقر ليس بالقليل. لأنَّ الرجل ميسور الحال ليس نهماً إلى هذه الدرجة، فالمفترض أنه يتمتع بإشباع احتياجاته ولو بالكاد. بيد أنَّ الفقراء يحددون طبيعة المجتمع ومكانتهم فيه كذلك. لأن الجوع هو جوع اجتماعي بالمقام الأول وإنْ تناول الفقير كافة الأطعمة. لا يشبع الإنسان الفقير أبداً، لكونه يجوع ثقافياً بقدر ما تعضه الفاقة ويقليه الاحتياج مرمياً بين الناس بلا قيمة.
إذن هؤلاء الناس يشعرون بالجوع الاجتماعي لا المادي، فالمظهر الخارجي باد للعيان. وكذلك الرجل الذي يقدم الطعام متعجب من المشهد، وكأنَّه يقول يوجد طعام كثير، ولكنه أُخذ بالتعبير متعجباً من درجة النهم والشراهة. وكذلك ذهب أحدهم لحمل حذاءه ليضرب كلباً أكله الجوع مثلهم تماماً. والبيئة التي تجوع فيها الحيوانات لا تخلو من مؤشرٍ غير طيب من جهة الفقر. فبالاقبال الشره نفسه على الطعام كانت يد أحدهم تمتد لتضرب الطلب بكل قسوة.
والسؤال: ما الخلفية التي تربط الطقوس بين الدين والاجتماع والإقتصاد؟ إنها السلطة، فالخلفية فيما بين السر والغموض والإجتماع والفقر والطعام هي القوة التي يتوسل بها الطقس لإفرازها أو لمحاولة استحضارها. والفنان محسن أبو العزم – ربما بلا قصد- كان يرسم في بعض لوحاته العراف ورجال الموسيقى بالزي العسكري والأطفال والنساء والراقصين وغيرهم داخل المجال العام(الشوارع). هذا الخليط الذي يترك للطقوس مساحة غير قليلة للإفضاء ولربط جنبات المجتمع تعبيراً عن الحالة السائدة.
لا يخلو معنى الطقس أيا كان من سلطة ما. وقد عبر الفنان عن ذلك بحضور قوى المجتمع: الدجل(رجل البخور)، الناس (القوة الصامتة)، الفن (القوة الرمزية)، المسجد في الأفق (مركزية الثقافة)، الاغنياء (قوة الاقتصاد السياسي) كما بدا في مظهر الرجل الذي يمتطي الخيل. والشكل العام يشي بكونه مرسوماً بفرشاة الطقس. وقد تظهر السلطة في أقل المشاهد وضوحاً من جهة علاقته بالسياسة مثلاً ولكنه مشهد سيكون على موعد مع هذه السلطة في أعماق الثقافة.
كما ظهر ذلك في شكل أحد العمداء المحليين عندما مثُل أمامه أحد الناس العاديين وسط مشهد يبرز تغول قوى السلطة على الإمساك بجوانب الحالة. وقد جعلت الصورة المشهد طقساً لا يخلو من معنى الهيمنة والأسرار التي توجد بشكل أو آخر.
لقد امتثل (المتهم المحتمل) أمام العمدة، بينما يضع الأخير الأرجيلة في فيه، والأرجيلة أداة عابرة للطقوس من خلال الدخان الذي يستمتع به أصحابها، وهو الدخان الموجود في طقوس التعويذة وإطلاقه مع فك السحر والأعمال المعقودة لدى إيقاع الاضرار بالناس وكذلك موجود مع نيران انضاج الطعام في المناسبات والأعياد.
ويطفح مشهد العمدة بالجانب التمثيلي، لأنَّ كل طقس لا ينضب تمثيلياً وسيظل قابلاً للأداء بمقدار السر المنطوي عليه. والعمدة يمثل السلطة السياسية في مكانه ومكانته. أي يتاح له دائماً إقامة طقوس السلطة بمعناها الأوسع، وكذالك له الإمكانية التي تأخذها الأخيرة (أي السلطة) في تفاصيل المجتمع. والطقس هاهنا يجري كشعائر بعد اقامة المراسم واستحضار الأسرار واختزال كيان الإنسان كمجرد متهم يأخذه التعجب من وقوفه الطويل دون داعٍ. ويتعامل العمدة مع المحيطين به ومع الناس باعتباره سراً ملغزاً يصعب فك شفراته. ومن ثمَّ، فإنَّ أنفاس العمدة التي يلتقطها من الأرجيلة تغلي في الأفق العام للوحة كاستحضار لمعاني الغموض والقوة في المجتمع جنباً إلى جنبٍ.
وليس أوضح إزاء التمثيل والأداء من مشهد مُروض القرد (إحدى لوحات أبي العزم)، حيث يطوف الرجل بالقرد أمام الناس للاستعراض والفرجة ويجرى وارءه الأطفال محصلاً ما يدفعونه من قروش قليلة لتوفير قوت يومه. وهذه - في عصره- كان مشهداً مألوفاً داخل الحارات والأزقة والمناطق الشعبية. غير أن المشهد في مناخ الطقس العام يطرح دلالات طريفة. فالقرد أساساً – سواء بوعي الفنان أو بدونه - رمز الأداء والتمثيل والمحاكاة البلهاء. فلو تم تدريب القرد على أداء مشاهد معينه من القفز والحركات الخاطفة والجري هنا وهناك وسرعة الأكل، فلن يكف عن تكرار العملية، كي ينال بعضاً من التصفيق وبعضاً من حبات الفستق والموز والفول السوداني إنْ وجدت. والطقوس الاجتماعية تأخذ المسار ذاته، من حيث التكرار والقدرة على الأداء الذي ينال تصفيق سلطة المجتمعات، وتجديد الثقة في الأسرار وتوسيع مساحةَ الغموض من حياة الناس.
اختصاراً ثمة مفارقة فحواها: أنَّ الفنان جسد الأداء الطقوسي في عناصر لوحة (مروض القرد)، حيث خلع ملامح القرد على وجه صاحبه وعلى وجوه الأطفال من حوله، بينما أخذ وجه القرد ملامح الإنسان. هذا التبادل الفني يوضح أن ممارسة الأفعال دون فهم وبلا وعي والانخراط في طقوس مكرسة لحالات الركود أمرٌ لا يخلو من تروض الإنسان كترويض القرود. إنَّ ثقافة الطقوس لا تليق إلاَّ بغير الإنسان، وليس تجني المجتمعات من ورائها سوى بعض المكاسب قصيرة النظر. لكن الإنسان تليق به حياة إنسانية حرة، تفجر طاقاته وابداعاته وتليق به صناعة عالمه الرحب في المقام الأول.
***
د. سامي عبد العال