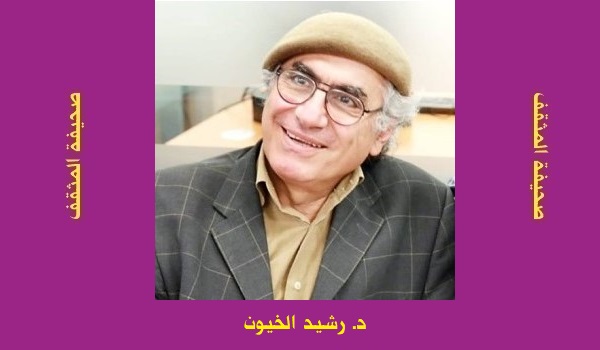أقلام حرة
رابح بلحمدي: العبور واليقين.. سفرُ المعرفة من التجربة إلى العقل فالإيمان بين

لم يُلقَ الإنسان في هذا الوجود ليكون شاهدًا محايدًا، ولا رقمًا عابرًا في سجلّ الطبيعة، بل كائنًا مُسائِلًا. والسؤال ليس عيبًا في الإنسان، بل علامته الفارقة. غير أن السؤال، إن لم يُهتَدَ به إلى غاية، انقلب عبئًا، وإن لم يُحاط بالفكرة الهادفة، صار قلقًا لا ينتهي. من هنا يبدأ الخلاف القديم المتجدّد:
هل تكفي التجربة؟
هل يكتفي العقل بذاته؟
هل الإيمان تعطيل أم اكتمال؟
وهل نفي الغيب تحرير للإنسان.. أم عزله في كونٍ بلا وجهة؟
التجربة تفتح باب المعرفة، لكنها لا تُقيم فيها. نختبر النار فنعرف أنها تحرق، لكننا لا نعرف لماذا الإحراق قانون.. نرصد حركة الكواكب، لكننا لا نفسّر لماذا لا تختلّ. الكون، في أدقّ تفاصيله، يعمل بنظام سابق على الملاحظة، وكأن التجربة تصل متأخرة دائمًا عن الحقيقة ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾.
ليست وصفًا شعريًا، بل تقريرًا كونيًا: الحساب سابق على الرصد. التجربة تقول ماذا يحدث، لكنها تعجز عن قول لماذا ينبغي أن يحدث. العقل أعظم أدوات الإنسان، لكنه ليس إلهًا. وحين ظنّ بعض الفلاسفة أن العقل مكتفٍ بذاته، انتهى إلى أحد طريقين:
إما عبثٍ كونيّ لا معنى له، أو أخلاقٍ بلا أساس، تُبرَّر بالمنفعة أو القوّة. العقل يستطيع أن يبني آلة، لكنه لا يستطيع أن يفسّر لماذا يجب ألا تُستخدم للقتل ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. ليست تقليلًا من شأن العقل، بل وضعه في موضعه الصحيح العقل بلا غاية كالسفينة بلا بوصلة؛ تمخر البحر، لكنها لا تعرف أين ترسو.
حين يُقال: الإلحاد ليس عيبًا، فهذا صحيح لغويًا، وخادع فلسفيًا. العيب ليس في التسمية، بل في النتيجة الوجودية.. الإلحاد لا يكتفي بنفي الإله، بل ينفي العلّة الأولى، والمعنى المتجاوز، والغاية النهائية. ثم يطلب من الإنسان أن يصنع معنىً مؤقتًا، وهو يعلم أنه سينهار أمام الموت، والظلم، والفقد ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾.. سؤالٌ ينسف العبث من أساسه...
أما الماركسية، فقد أرادت عدالة بلا غيب فحولت الإنسان إلى وظيفة في صراع والأخلاق إلى نتيجة اقتصادية والتاريخ إلى آلة لا ترحم وحين تعارض الإنسان مع الفكرة، سُحِق باسم المستقبل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾
آية لا يمكن لأي فلسفة مادية أن تُبرّرها أو تُحافظ عليها. الإيمان، في جوهره القرآني، ليس قفزة فوق العقل، بل عبور به إلى أفقه الأقصى.
إبراهيم لم يؤمن قبل أن يسأل: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ هذه فلسفة وجود كاملة: ما يزول لا يستحق المطلق والقرآن لا يخاطب الغريزة، بل العقل ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.. الإيمان هنا ليس نقيض الفلسفة، بل نقيض الغرور الفلسفي الكون لا يصمت، بل يهمس. كلّ ذرة تسبّح، وكلّ نظام يشير، لكن العين وحدها لا تكفي. ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾
فالآفاق تُقنع الحسّ، والأنفس تُوقظ التجربة، ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ وهنا يصل العقل إلى حدّ الاعتراف. المؤمن لم ينكر العالم، بل رآه أثرًا لا غاية. والفيلسوف المؤمن لم يقتل السؤال، بل أعاده إلى موضعه الصحيح. المعرفة سفر، تبدأ بالتجربة، تمرّ بالعقل، وتكتمل بالإيمان. من توقّف عند الحسّ، عاش سطحيًا. ومن توقّف عند العقل، عاش متكبّرًا. ومن نفى الغيب، عاش قلقًا. أما من سأل ثم آمن، فقد بلغ الطمأنينة. ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾. ليست دعاءً فحسب، بل إعلانًا فلسفيًا أن المعنى أصل الوجود. وهنا فقط، لا يعود الإيمان هروبًا، ولا العقل خصمًا، بل يصبح الإنسان شاهدًا واعيًا . على كونٍ لم يُخلق عبثًا، ولا يُفهم إلا بنورٍ يجمع العين، والعقل، والقلب.
***
بلحمدي رابح