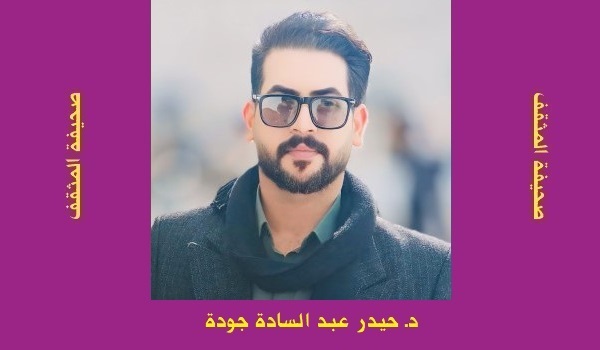أقلام حرة
نورالدين حنيف: مقالة في الكتابة الانهزامية

كم هو مؤسفٌ أن يجد الباحث بعض الكتابات المحسوبة على الفكر الإسلامي تنبري إلى الدفاع عن التراث الإسلامي وكأن هذا التراث مقدّر عليه أن يدافع، وأن يظلّ يهشّ بعصاه الإيمانية على ذئاب الفتنة الغالبة بفعل تغول الأزمنة المقلوبة. وقد تقول بعض هذه الكتابات: إن هذا الدفاع موقفٌ مشروع بحكم الحملات المسعورة المسلّطة على الإسلام في كلّ المحافل. نقول: نعم... ونقول: لا... ودليلنا في هذا التنازع أن بعض الكتابات لا تدرك أن الآخر في بعْضِه وليس في كُلِّه، هو آخرُ موسومٌ بالحقد التاريخي الذي لا يني يجرّنا إلى هذه المعارك الخاسرة منذ البدايات. والجوابُ: إن الإسلام المحفوظ من لدن الله الحكيم العظيم، لا يُخاف أو يُخْشى على بنياته القوية التي تمتح قوتها من المرجعية الربّانية القاضية بحفظه حفظا متينا مطلقا (إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون)
إلا أن قولنا ب (نعم) هو القولُ المشروطُ بالضرورة، ونقصد بها أن المجتمع الإسلامي في تصوّر النظرية المعرفية الإسلامية، دائما ما يفتح المجال لكل من تفقّه في الدين أن يبيّن للناس ما جهلوا وأن يذود عن التراث ما وسعه الذود، كما يفتح أبوابه مشرعةً للاجتهاد في قراءة الراهن قراءة معرفية، في اتّزانٍ علمي ومنهج متّزن.
وفي التركيب الأخير، لابد من لنا من غرس ثقافة فقه الردّ، وهو أن يكون ردّا مستحقا لا ضربا في خواء ولا انجرارا وراء معارك مبرمجة من هناك وهيَ المحسوبةُ نتائجها دائماً لصالح هذا الهناك.
كانت هذه مقدّمة ضرورية لبيان أن الحديث عن الظاهرة الفكرية الجامعة بين الذات والآخر لابد أن نتناولها من موقع امتلاكنا لقوّة نوعية، وهي القوة التي أعزّنا الله بها، رغب من رغب وكره من كره. وهي القوة التي يسعى الآخر سعيا حثيثاً وحريصا على أن يسلبنا إياها، أو على أقل تقدير منه، أن يشككنا فيها.
الكتابة من منظور الهزيمة كتابة انتكاسية، تُعلِن عن الراية البيضاء مجانيا قبل الاحتدام، وتُنجزُ المنجز في إعاقته لا في استوائه. وقدرها أن تجترّ ذاتها في مواسم التنازلات الفكرية والمبدئية... وهلمّ جرّا...
ومن هذه التنازلات على سبيل التمثيل، نذكر التنازل عن النديّة والحضور التاريخي والاستشراف الحضاري. وهذه لعمري مضارب قومٍ إذا ما أبانوا عن عراءٍ في بعض جبهاتها أصابهم ما يصيب من تخلّى عن حماه وترك تراثه للتسيب يعيث فيه منْ شاء كيفما شاء.
ونحن لا ندّعي في هذا المقام سبقا ولا استثناء ولا تميزا، إذ الساحة الثقافية مليئة بالاجتهادات الفكرية والأطروحات الأكاديمية التي تُغني القارئ الباحث عن أجوبة للسؤال الفكري العربي والإسلامي. ولكن، مقابل ذلك، نقول إننا نمتلك رؤية خاصة لطرح وجهة نظرنا إزاء قضايا تمس الذات العربية والإسلامية، وتتاخم الأجوبة على أسئلتها الكبرى. من هنا، حقّنا في المساهمة وقدرتنا على الدفع بالسؤال إلى ممكنات حدوده، حسب طاقتنا في التفكير الذي نتوخّاهُ سليما وبعيداً عن كل "شوفينية" ضيقة وعن كلّ تحامل مجاني على رأيٍ يخالفنا أو نظرٍ يناقضنا.
إذا كانَ دأبُ التصور الإسلامي التأكيد المعرفي على موقع العقل وقيمته في اختراق حجب الوجود من منظور ربّاني يرسم الحدود لتأكيد موقع الإنسان وقيمته، فإن بعض الفكر البشري، وخاصة المناوئ منه، دأب على تقزيم دور العقل والتقليل من شأنه لتحويل الإنسان المسلم إلى ظاهرة متشيئة فارغة من كلّ دور إلا دور الاستهلاك.
ويكادُ هذا التوصيف (الاستهلاك) ومن باب الألفة أن يبدو أمرا بسيطا لا خطر فيه ولا تهديد. إلا أن الناظر بعمق سيكتشف أن المسألة أكبر من حالاتِ تبضيعٍ لسلوك البشر. إن الأمر يتجاوز ذلك إلى تبضيع القيم. وما أدراكَ ما القيم. إن القيم هي الصمّام الذي يؤكد إنسانية الإنسان، وإنسانية العلاقات الكليّة بينه وبين الآخر، إذ في غياب عنصر العلاقة فلا قيمة للقيمة. ويكفينا لندرك قوة الحضور العلاقي القيمي أن نضرب مثلا يقارِن بين زاهدٍ متعبّدٍ في صومعة معزولة عن سياق الاجتماع وبين زاهِدٍ يختلط بالناس ويصبر على أذاهم. إذن فشتّان بين من يكرّس للقيمة داخل الاختبار وبين من يعزلها عن أتون الاحتكاك والتدافع الحامل لقوة الاعتبار.
وفي تبضيع القيمة، لا نخسر الإنسان المسلم فقط، في استوائه المطلوب لعمارة الأرض، وحسب، بل نخسر أيضاً قدرته العقلية التي بها يكون ويشارك ويبدع ويضيف إلى المشهد الإنساني ما يمكنه أن يضيف. ونخسر معها إرادته، إذ سرعان ما نكتشف أن مسلسل التبضيع لا يقف عند حدود النتائج المادية البائنة، وإنما يتجاوز ذلك إلى صناعة إنسان مجرد من إرادته، في صورة استلابية تعجز عن تفعيل الإرادة في جوهر الاستقلالية، وبالتالي، يستدعي هذا التخريج حصول التبعية بمفهومها السيكولوجي القاضي على آخر معاقل المقاومة في الإنسان المبضّع.
***
نورالدين حنيف أبوشامة\المغرب