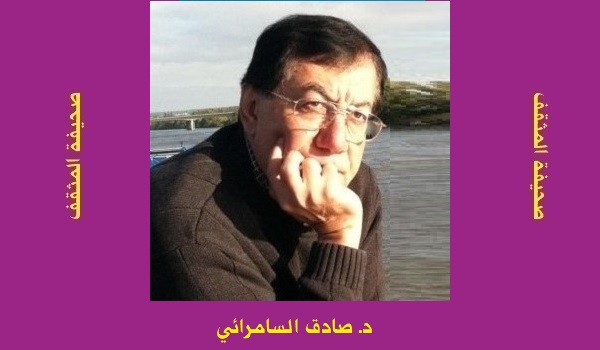أقلام حرة
عبد السلام فاروق: الأهرام.. لتعود عظيمة من جديد

«الأهرام» ديوان الحياة المعاصرة، هي ذاكرة قومية عمرها قرن ونصف، مؤسسة تجاوزت حدود الورق والحبر لتصبح إحدى علامات مصر الكبرى.
منذ أن خرجت للنور عام 1875 على يد الأخوين سليم وبشارة تقلا، وهي تنسج خيوط الوعي القومي، شاهدة على تقلبات العصور، وحاملة لنبض الوطن في لحظات مد الثورة وجزر الانكسار. كانت «الأهرام» صدى لعقول الكبار: من طه حسين والعقاد وسلامة موسى، إلى توفيق الحكيم وهيكل ويوسف إدريس. لكنها اليوم تقف على مفترق طرق حاسم، لا يهدد مكانتها كمنبر بل كفكرة، بينما تواجه تحديات ثلاثة كبري: المنافسة، والاستقلالية، والتطور التقني.
قوة غير مستغلة
رغم امتلاكها لقدرات هائلة، وقوة ذاتية تراكمت لها عبر سنوات من الخبرة والترقي، إلا أنها لا تستغل كل طاقتها وإمكاناتها الكامنة، بل تترك الروتين الحكومي والبطء يتسلل لأروقة العمل بها، في الوقت الذي تتناسل فيه الأخبار إقليمياً وعالمياً بسرعة الضوء!
نحن اليوم نعيش عصر السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية السريعة حيث لم تعد الصحف الورقية تحظى بنفس النفوذ الذي كانت تتمتع بهقديماً. صحيح أن الأهرام حاولت مواكبة هذا التحول عبر إطلاق موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، إلا أنها لا تزال تعاني من بطء في التكيف مع ثقافة "الخبر الفوري" التي يفرضها العصر.
وإذا تركت الصحافة الرصينة نفسها نهباً لتيارات الزيف تتقاذفها، فسوف تضيع الحقيقة بين ضجيج الشاشات ومنصات التواصل، فتبدو «الأهرام» وكأنها تصارع جراحها في صمت نبيل.
فهل ما زالت الأهرام تحمل راية الفكر؟ أم أصبحت أسيرة الخطاب الواحد، تحيا على فتات المصداقية المتآكلة؟ لقد كانت في يوم ما « ضمير الأمة»... فهل تقبل اليوم أن تُختزل إلى ملحق حكومي تقليدي لا يملك حق العمل الصحفي المحترف المستقل؟
تحولات هائلة وتقدم بطئ
لا جدال أن عصر الصحافة الورقية يوشك على الأفول، و«الأهرام» لم تكن استثناء. ورغم خطواتها المتأخرة نحو الرقمنة، لا تزال تحبو في ميدان صار يتطلب سرعة الضوء ومرونة الموجة. موقعها الإلكتروني أقرب إلى مرآة باهتة لنسخة مطبوعة، لا روح فيه ولا جرأة. أما وسائل التواصل، فتستخدم عندها كأنها مروحة في مواجهة إعصار.
هناك تحولات حادة حولنا: في السياسة والحوكمة والتقنيات وحتي في الفكر الجمعي، ومع ظهور منصات إعلامية جديدة، بعضها خارجي التمويل، أصبحت "الأهرام" في سباق غير متكافئ. فبينما تعتمد هذه المنصات على لغة جذابة وخطاب أكثر جرأة، تظل "الأهرام" محكومة بقيودها التاريخية كصحيفة رسمية ترتدي بذلة ريدنجوت أنيقة وسط شباب يرتدون الكاجوال!
وإذا كنا كجريدة لديها التزاماتها وتيارها العام الذي لا يمكن أن تحيد عنه، لكن يمكننا دائماً توسيع نطاق هذا الالتزام للسماح ببعض المساحات المغايرة المواكبة للتحولات: ففي جانب السياسة التحريرية يمكننا السماح بمساحة أكبر للنقد البناء والرأي المختلف. فالصحافة التي لا تخضع للمساءلة ولا تسمح بالاختلاف تفقد مصداقيتها مع مرور الوقت. ومؤسسة بحجم "الأهرام" لا يمكنها أن تظل بمنأى عن روح العصر. ومن حيث التيارات الصحفية؛ ينبغي الاهتمام بالاستثمار في الصحافة الاستقصائية؛ فنصنع في أروقة الأهرام ألف "هيكل" جديد يعرف كيف يأتي بالخبر الطازج المؤكد من أعمق نقطة خفية، ماذا لو عادت "الأهرام" إلى جذورها، وكرست فريقًا للتحقيقات الاستقصائية الجادة، بهذا ستستعيد جزءًا كبيرًا من مكانتها. فالقارئ اليوم يتوق إلى الحقيقة، لا إلى النفاق والمداهنة.
حين يمتنع السؤال!
الصحيفة التي لم تعد تطرح الأسئلة الوجودية، تفقد مبرر بقائها شيئا فشيئا. فكيف يطلب من القارئ أن يثق بمن لا يجتهد في نقد الذات؟
وإذا كانت «الأهرام» قد اعتادت لزمن طويل أن تكون صوت الدولة الرسمي، فهل تستطيع اليوم أن تكون صدى الوطن؟ ذلك التوتر القائم بين الولاء المهني وحرية التعبير، هو ما يحدد مصيرها. فالمصداقية لا تشترى بالتاريخ، بل تُستمد من نبع الواقع الجرئ.
لطالما عُرفت الأهرام كـ"صحيفة النخبة"، يقرؤها المثقفون وصناع القرار، ويستشهد بها الباحثون، بل كانت أرشيفًا حيًا لتاريخ مصر. لكن مع التحولات الجذرية في المشهد الإعلامي، أصبحت الصحافة الورقية في تراجع مستمر، كما وكيفاً.، وصارت "الأهرام" تواجه سؤالًا وجوديًا: هل يمكنها أن تظل تحتفظ بمكانتها العظيمة في عصر الطوفان المعلوماتي؟ أم أن قدرها أن تصبح مجرد ذاكرة ورقية في زمن الشاشات؟
نعيش اليوم في عصر "اللايقين"، كما يسميه علماء الاجتماع، حيث الحقيقة ضائعة بين زحام الزيف، والثقة في وسائل الإعلام تقلصت إلى أدنى مستوياتها. في هذا السياق، تبرز معضلة "الأهرام" أو قل فرصتها: أن تعود للبوليفونية، وجذب الشباب، والاستقلالية، وقوة وعمق الرصد. هذا حدث في دول كثيرة؛ إذ نجحت صحف حكومية غربية في إعادة اختراع نفسها، مثل "لوموند" الفرنسية التي تمت خصخصتها دون أن تفقد دورها ومكانتها ومصداقيتها، أو "الجارديان" البريطانية التي حافظت على استقلاليتها رغم التحديات المالية. فلماذا لا تكون "الأهرام" نموذجًا جديداً لأسطورة أعادت إحياء ذاتها؟
الصراع الداخلي الصامت
ثمة جدال مكتوم داخل أروقة «الأهرام» لا يقل أهمية عن تحديات الخارج. جيل قديم يرى في الورق قداسة، وجيل جديد يريد أن يطير بالمؤسسة نحو العالم الرقمي، وثالث - من الشباب - يتساءل بدهشة: لماذا نقرأ أصلاً، أي ما الجدوي للاستمرار؟ هذا التنازع يعكس أزمة هوية: هل «الأهرام» صحيفة؟ أم مؤسسة فكرية؟ أم متحف عتيق لذاكرة الوطن؟
ليست المشكلة في الورق، بل في الروح. إن استعادة «الأهرام» لمكانتها يتطلب منها أن تتحول إلى ذاكرة متحركة، لا إلى أرشيف باهت. أن تعود إلى الناس، لا أن تنغلق داخل القوالب. أن تواكب العالم دون أن تفقد ذاتها. أن تكتب كما لو أن الوطن على المحك، لا كما لو أن شيئًا لم يكن.
حبذا لو تتخلص"الأهرام" من قوقعتها التقليدية لتخاطب الشباب بلغة العصر، عبر مقاطع الفيديو والبودكاست والمحتوى التفاعلي، دون التخلي عن عمقها الفكري.
باستطاعة "الأهرام" استعادة عظمتها من جديد، ولتفعل هذا ليس أمامها إلا التجدد. لا أتحدث هنا عن مجرد تغيير في الشكل، بل ثورة داخلية في المفهوم والدور. عليها أن تعيد تعريف نفسها كمنصة معرفية، تشرح الخبر لا تنقله فقط، وتفتح صفحاتها للحوار لا للمونولوج الذاتي، وتستثمر في الصحافة الاستقصائية لا في الإعلان. عليها أن تُخاطب العقول الحرة، لا الآذان الخانعة.
إن الشارع اليوم يصنع آراءه داخل منصات «تويتر» و«تيك توك»، لا في أعمدة الرأي. ومع ذلك، فإن الإعلام الجديد، رغم زخمه الزائف، يفتقر للعمق والمصداقية، وهنا تتجلي فرصة «الأهرام»: أن تجمع بين السرعة والرصانة، بين لغة الجيل الجديد وروحها المتجذرة. فلتكن الأهرام الجسر الذي يعبر عليه الناس لأحلامهم، لا الجدار الذي تتكسر عليه تلك الأحلام.
تحديات وحلول
أكبر تحد يواجه "الأهرام" اليوم هو أنها لم تعد تعكس تنوع المجتمع المصري، فلو أرادت "الأهرام" استعادة دورها، عليها أن تفتح صفحاتها لوجهات نظر مختلفة، لا أن تكون منبرًا لرأي واحد. فمصر أكبر من أن تختزل في سردية وحيدة، وشعبها أعمق من أن يُقدم في قوالب جاهزة.
إن الاستمرار في النموذج التقليدي الجامد يؤدي حتماً للانزواء، بينما التجدد هو ديدن الحياة ذاتها، وباستطاعة الأهرام أن تجدد نفسها من خلال: بناء صحافة استقضائية، واستقطاب أقلام جديدة من الشباب وكبار المفكرين والكتاب، وتحويل موقعها الإليكتروني لمنصة تفاعلية، والاهتمام بالنبض الحقيقي للشارع المصري الذي يتردد فى الصحيفة بصوت خافت، بينما ينفجر صارخاً فى مواقع التواصل بلا ضوابط!
لم يعد الجمهور ينتظر الصباح ليقرأ تحليلات الأهرام، بل يصنع رأيه الخاص عبر فيسبوك وإكس وتيك توك. وهذا يطرح تحديًا وجوديًا: ما قيمة صحيفة مطبوعة في عصر لا يملك الناس فيه صبرًا لقراءة أكثر من تغريدة؟
هناك مساحة فارغة من الفكر إن لم تحتلها الأهرام ومثيلاتها من الصحف القومية الراسخة، فلسوف تأتي منصات أخري، رقمية أو ورقية، تملأ هذا الفراغ. وعلينا أن نقتنص اللحظة ونواجه أنفسنا بالمثالب والنواقص والتحديات.
في النهاية، تظل «الأهرام» مؤسسة عظيمة، يليق بها أن تكون صوتًا لا صدى، منبرًا لا مرآة. فإما أن تنهض من كبوتها، فتستعيد دورها كضمير أمة، أو تختار أن تذوي ببطء، كورقة تسقط من شجرة التاريخ، دون أن يكترث لذبولها أحد! القرار ليس سهلًا، لكنه لا يحتمل التأجيل.
فإما أن تحيا الأهرام كما كانت: واحة للعقل وملاذًا للحقيقة...وإما أن تتحول إلى مومياء في متحف الصحافة العتيقة!
***
د. عبد السلام فاروق