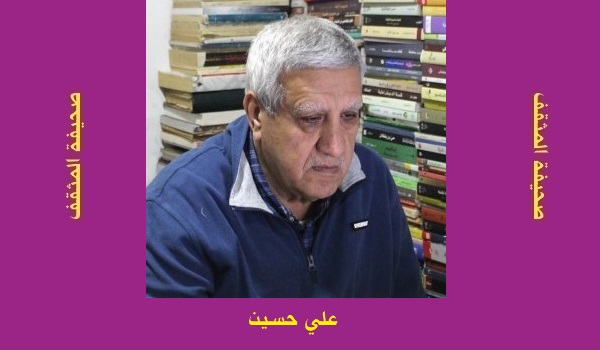أقلام فكرية
حمزة مولخنيف: في شروط إمكان السؤال الفلسفي داخل زمن السرعة واللااكتراث

لم يكن السؤال الفلسفي في جوهره العميق، مجرد أداة معرفية لاستجلاء المجهول أو آلية ذهنية لملء فراغات الجهل، بل كان دوما علامة على قلقٍ أنطولوجيّ أصيل، وعلى توترٍ خلاق بين الإنسان والعالم وبين الوعي وما يتفلّت عنه وما يُعاش وما يُفكَّر فيه. لذلك فإن التساؤل عن إمكان السؤال الفلسفي اليوم لا يُحيل فقط إلى وضعية الفلسفة داخل منظومة المعرفة المعاصرة، بل يطال مصير الذات المفكِّرة نفسها داخل عالم يتسم بالسرعة والتشظي والانغمار الدائم في الحاضر اللحظي. فالسؤال هنا ليس تقنيا ولا بيداغوجيا، بل هو سؤال عن شروط التفلسف بوصفه نمطا في الوجود قبل أن يكون ممارسة فكرية.
لقد نشأ السؤال الفلسفي تاريخيا في فضاء التمهّل والدهشة، كما عبّر عنه أرسطو حين جعل من التعجب مبدأ التفلسف، والدهشة لا تُختزل في انفعال عابر، بل هي تعليقٌ مؤقت للمألوف، ومسافة نقدية بين الذات والعالم، حيث تسمح للرؤية بأن تتجاوز سطح الظواهر. غير أن العالم المعاصر كما يصفه هارتموت روزا هو عالم التسارع الشامل، حيث لم تعد الأشياء تُعاش بعمق بل تُستهلك بسرعة، ولم يعد الزمن فضاءً للتراكم الوجودي، بل سلسلة من اللحظات المتجاورة التي لا تترك أثرا. يبدو السؤال الفلسفي غريبا، بل معطِّلا لإيقاع الحياة السائد، لأنّه يتطلب الصمت والتريث والتردد، وكلها قيم أصبحت تُقابل بالريبة داخل منطق النجاعة والإنجاز.
ومع ذلك فإن إعلان موت السؤال الفلسفي سيكون تسرعا لا يقل سطحية عن السرعة التي ينتقدها. فالفلسفة كما يذكّرنا كانط ليست نسقا من الأجوبة الجاهزة، بل هي ممارسة دائمة للسؤال النقدي، ومساءلةٌ لحدود العقل وشروط إمكان المعرفة ومعنى الفعل وأفق الأمل. وإذا كان العالم قد تغيّر، فإن أشكال القلق الإنساني لم تختف، بل ربما ازدادت حدّة وتعقيدا. إنّ الإنسان المعاصر رغم فائض المعلومات، يعيش مفارقة الفقر المعنوي، ويعاني من اغترابٍ جديد لا ينتج عن القهر المباشر بل عن التشتت وفقدان المعنى والتماهي مع أنماط حياة لا يُسائلها.
إن السؤال الفلسفي اليوم لا يُلغى بوفرة الأجوبة التقنية، لأن هذه الأخيرة تعالج كيف نعيش لا لماذا نعيش ولا بأي معنى. وقد نبّه هايدغر إلى هذا الخلل حين فرّق بين التفكير الحِسابي والتفكير التأملي، معتبرا أن سيادة الأول لا تعني اكتمال العقل، بل ربما دلالته على نسيان السؤال عن الوجود. فالعالم السريع لا يُقصي السؤال الفلسفي فحسب، بل يُنتج نمطا من الوعي المبتور، الذي يتعامل مع الوقائع دون مساءلة أفقها، ومع المعطيات دون تفكير في دلالاتها. وهنا يبرز الفرق بين الفكر الفلسفي كعملية نشيطة وبين المعرفة كحاصل صرف، إذ الأولى تفكك الافتراضات، والثانية قد تعيد إنتاجها بطريقة تلقائية.
لكن السؤال الجوهري يظل متعلقا بإمكان نشوء السؤال الفلسفي داخل هذا السياق، لا بوصفه ترفا ثقافيا، بل كضرورة وجودية. إن الفلسفة لم تكن يوما ابنة المؤسسات وحدها، بل هي قبل ذلك انبثاقٌ فردي من تجربة العيش، من الصدمة ومن الفقد ومن الإحساس باللاجدوى أو التناقض. ولعل ما يتغير اليوم ليس الحاجة إلى السؤال بل أشكال التعبير عنه ومسالك ظهوره وفضاءات تداوله. فالسؤال الفلسفي قد يغادر المدرّجات الأكاديمية ليظهر في أشكال أدبية أو فنية أو نقدية دون أن يفقد جوهره. بل ربما يجد في هذه الأشكال الجديدة حرية أوسع للتجربة الفلسفية، إذ لم يعد مقيدا بقوالب منهجية جامدة، بل بالقدرة على إعادة صياغة المعنى في كل مرة.
غير أنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في تحوّل أشكال التفلسف، بل في تطبيع اللامساءلة، وفي تحويل الفكر إلى وظيفة، واللغة إلى أداة تواصل فارغة من الكثافة الدلالية. وقد نبّه أدورنو إلى أن أخطر أشكال السيطرة ليست تلك التي تُمارَس بالقوة، بل تلك التي تجعل الأفراد يقبلون بالواقع كما هو، دون مقاومة فكرية. وهنا يصبح السؤال الفلسفي فعل مقاومة صامتة، لا ضد سلطة سياسية بعينها، بل ضد تسطيح الوجود، وضد اختزال الإنسان في مستهلك أو رقم أو ملف. فالفلسفة ليست فقط تأملاً نظريا، بل فعلا يوجّه النظر إلى ما يمكن تغييره في العلاقة بين الذات والعالم، بين الفرد والمجتمع والمعنى والزمان.
إنّ السؤال الفلسفي الممكن اليوم ليس هو السؤال الكلاسيكي نفسه، ولا هو استعادة حنينية لصيغ ماضية، بل هو سؤال يعيد التفكير في شروطه ويُراجع لغته ويُدرك محدوديته دون أن يتنازل عن جرأته. وقد أشار بول ريكور إلى أن الفلسفة الحيّة هي التي تقبل بالهشاشة، وتشتغل داخل التوتر بين الشكّ والإيمان بالمعنى والنقد والتأويل. فالسؤال لا يعيش إلا داخل هذا التوتر، لا في يقين مغلق ولا في نسبية عدميّة. والأهم أن هذا التوتر لا يضعف الفلسفة، بل يمنحها طاقتها الدائمة على إعادة فتح المسائل من جديد، وإعادة تشكيل الأسئلة التي تُعدُّ جوهر أي حياة فكرية نشطة. كما أنّه يسمح بمساءلة الأنظمة الفكرية والاجتماعية التي يمكن أن تُغلق إمكان التفكير، ويمنح الفيلسوف القدرة على الانتقال من السطحيات إلى الجوهر، ومن العملي إلى القيمي، ومن المعرفة إلى الوعي النقدي.
كما أن إمكان السؤال الفلسفي اليوم مرتبط بإعادة الاعتبار للذات المفكِّرة، لا باعتبارها مركزا مطلقا، بل باعتبارها كائنا متناهيا تاريخيا منخرطا في العالم. وهنا يكتسب السؤال بعدا أخلاقيا، لأنّه ليس فقط طلبا للمعرفة، بل تحمّلا لمسؤولية التفكير. وقد كتب ليفيناس أن السؤال عن الآخر يسبق السؤال عن الذات، لأن التفلسف الحقيقي يبدأ حين ينكسر الاكتفاء بالنفس، وحين يُستدعى الضمير قبل المفهوم. ومن هنا نفهم أن التفلسف المعاصر حتى في زمن الانغماس في التقنية لا يفقد أهميته، بل يصبح أكثر حساسية تجاه ما يمكن أن يُغفل في حياتنا اليومية من أبعاد أخلاقية وإنسانية. فالوعي بالآخرين وبالفضاء الاجتماعي المحيط هو ما يمنح الفلسفة أهميتها الحية، ويجعل من السؤال الفلسفي فعلا حيويا يتجاوز حدود الذات إلى العالم، إلى القيم المشتركة وإلى المعنى العميق للوجود الإنساني.
وفي عالم تُهيمن عليه الخوارزميات وتُوجَّه فيه الرغبات وتُصاغ فيه الاختيارات، يبدو السؤال الفلسفي كفعل تحرير بطيء لا يعد بالحلول، بل يفتح أفقا للتفكير المختلف. إنّه لا ينافس العلوم ولا التقنية، بل يرافقها نقديا، ويكشف افتراضاتها المضمَرة وحدودها الصامتة. وقد أكّد يورغن هابرماس أن العقل الأداتي حين ينفصل عن العقل التواصلي، يُنتج تشوهات في الفعل الاجتماعي، وهنا تتجدد وظيفة الفلسفة بوصفها حارسة للمعنى. ولم يعد التفلسف يُفهم بوصفه ترفا معرفيا، بل أضحى ضرورة فكرية لفهم العالم وإعادة مساءلة موقع الذات داخله. فالفلسفة لا تقتصر على كونها بناءً نظريا أو نسقا مفاهيميا مجردا، وإنما تتجسد كممارسة فكرية نقدية تستلزم حضور الذات ويقظة الوعي، وتنهض بمسؤولية تحليل ما يشهده المجال المجتمعي من قوى سياسية واقتصادية وثقافية.
إن مصير التفلسف داخل عالم سريع بلا تأمل ليس الزوال، بل التحوّل الصعب والمؤلم. فالسؤال الفلسفي لا يُلغى، لكنه يُحاصَر، ولا يُمنع لكنه يُهمَّش، ولا يُكذَّب لكنه يُعتبر غير نافع. غير أن الفلسفة منذ سقراط، لم تُقِم وزنا لمعيار النفع المباشر، بل جعلت من إزعاج البداهات رسالتها. ولذلك فإن السؤال الفلسفي يظل ممكنا بقدر ما يظل الإنسان قادرا على التوقف، وعلى قول لا لما يُقدَّم له كأمرٍ بديهي. بل إن المسألة تتعدى الإنسان الفرد إلى المجتمعات، لأن مجتمعات بلا سؤال، أو بلا مساحة للتفلسف، معرضة لتقليص حرية التفكير، وإضعاف قدرة الثقافة على الاستمرار في مساءلة نفسها، وفي مساءلة العالم الذي تنتمي إليه. والفلسفة هنا ليست مجرد أداة نقدية، بل هي ممارسة للحياة نفسها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة مكتملة إذا لم يشارك في مساءلة ما يُطرح أمامه من حقائق وأوامر وقيم.
ولعل الرهان الأكبر اليوم ليس في الدفاع عن الفلسفة كمادة أو تخصص، بل في الدفاع عن الحق في السؤال، في الشك وفي التردد وفي التفكير غير السريع. إنّ التفلسف ليس امتلاكا للحقيقة بل شجاعة في مواجهتها، وهو ما يجعل السؤال الفلسفي رغم كل شيء ممكنا وضروريا، بل مصيريا في عالم فقدَ القدرة على الإصغاء إلى ذاته. يصبح التفلسف فعل مقاومة وجدلية في آن، إذ يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وعالمه والمعرفة والحياة، وبين القيم والواقع. إن هذا الضرب من التفكير عصيٌّ على الاختزال، منفرٌ بطبيعته من الإجابات الجاهزة، إذ لا يكتفي بتفكيك السطح بل ينفذ إلى العمق، ويفرض على الفيلسوف — ومن خلاله على المجتمع بأسره — أن يقف عاريا أمام الأسئلة الكبرى، بلا مواربة وبلا التفاف وبلا احتماءٍ بحلولٍ سهلة تُسكِّن القلق بدل أن تفهمه.
إن إمكانية السؤال الفلسفي اليوم تتطلب الوعي بمحدودية أدواتنا المعرفية، وبتعقيد الواقع وبتداخل المعنى بالوجود. فحتى الفلسفة التي تبدو بعيدة عن التطبيق العملي تحمل داخلها إمكانية التحرر من الأنماط المعرفية المألوفة، وتتيح إمكانية إعادة صياغة الأسئلة الكبرى حول الإنسان والمجتمع والعالم. ومن هنا يظهر أن التفلسف في زمن السرعة ليس رفاهية فكرية بل ضرورة وجودية، لأنه يواجه تحديا لم يسبق له مثيل، وهو كيف نحافظ على عمق السؤال وإمكانيته في عالم يُغرقنا في المعلومات واللحظات العابرة، وفي تقنيات توهمنا السيطرة على الواقع بينما تقطع الصلة بين الذات والمعنى؟.
ولا يمكن فهم إمكان السؤال الفلسفي اليوم بمعزل عن التحولات الكبرى التي عرفها الوعي الإنساني منذ القرن العشرين حتى اليوم. فالحداثة وما بعدها لم تُنتج تغييرات معرفية وتقنية فحسب، بل أطلقت أيضا أزمة في العلاقة بين الإنسان والزمن والإنسان والعالم، وبين الإنسان وذاته. لقد لاحظ هايدغر منذ زمن أن الإنسان الحديث أصبح غارقا في ما سماه “العقل الأداتي”، بحيث تتراجع القدرة على التفكير التأملي والتوقف عن الانجراف وراء الأحداث. والتسارع في حياة الأفراد والمجتمعات لم يعد مجرد مسألة تنظيم أو كفاءة، بل أصبح آلية تأثير على جوهر السؤال الفلسفي نفسه. فالإنسان الذي لا يتأمل، والذي لا يترك مساحة للدهشة، والذي يختزل تجربته في فعل الإنتاج والاستهلاك، لا يترك مجالا لإمكانية التفلسف، لأن التفلسف بطبيعته يتطلب حضور الذات ووعيا بالمفارقات ومقاومة للسطحية وتقبلاً للتعقيد.
وهذا يقودنا إلى رؤية أن التفلسف لم يعد مرتبطا فقط بالمعرفة النظرية أو الفلسفة الجامعية، بل أصبح اختبارا لوجود الإنسان في زمنه. فالفيلسوف المعاصر سواء أكان أكاديميا أو كاتبا أو فنانا، مطالب بأن يكون واعيا بالمحددات التاريخية والاجتماعية، وأن يدرك أن السؤال الفلسفي لا ينشأ في فراغ بل في سياق يفرض عليه الإبداع، ويضعه أمام مسؤولية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في مفهوم التفلسف نفسه، فهو ليس مجرد نشاط عقلي، بل ممارسة حياتية تجمع بين الفهم والنقد والإحساس، بين ما يُعرف وما يُعاش. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الفلسفة المعاصرة لم تعد تقتصر على مواجهة الأفكار أو النظريات السابقة، بل تمتد إلى مساءلة الطريقة التي نعيش بها، والطريقة التي نختبر بها معنى حياتنا، والعلاقات التي نبنيها مع الآخرين.
ومن منظور آخر، نجد أن إمكان السؤال الفلسفي اليوم مرتبط أيضا بالقدرة على مواجهة تضارب المعارف، والقدرة على التشكيك في “اليقينيات” التكنولوجية والعلمية والاجتماعية. فكما أشار ميشيل فوكو أن كل معرفة تحمل في طياتها شبكة من القيم والسلطات، ومن ثم فإن السؤال الفلسفي يتطلب جرأة على تحليل هذه العلاقات، وعلى كشف الافتراضات الخفية التي تتحكم في حياتنا اليومية وفي تصورنا للواقع. يغدو السؤال الفلسفي والحال هذه، أكثر من مجرد نزوعٍ إلى المعرفة، إذ يتحول إلى أداة نقدية لتحرير الفكر والمجتمع، وإلى ممارسة تأملية تعيد مساءلة معاني الحرية والمسؤولية، والإنسانية ذاتها، كما أن التفلسف المعاصر لا يمكن أن يغفل البعد اللغوي للمعرفة. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي أداة تشكيل للواقع، وأداة للتفكير النقدي. وقد بين هيجل وسوسير وأدورنو أهمية اللغة في بناء المفاهيم وفي صياغة السؤال الفلسفي. فإعادة صياغة السؤال بلغة دقيقة ومتماسكة تسمح بفتح أفق جديد للتأمل، وتكشف عن أبعاد لم تكن واضحة في البداية. وهذا يتطلب وعيا دقيقا بالعلاقات بين الكلمات والمعاني والمفاهيم والتجارب الحياتية، وبين السؤال والجواب المحتمل.
يواجه السؤال الفلسفي اليوم تحديا مزدوجا، تحدّي التسارع التقني الذي يرهق التفكير العميق ويقصيه لصالح الاستجابة الفورية، وتحدّي اللامبالاة الاجتماعية والثقافية التي تُفرغ التساؤل من قيمته وتحوّل التأمل إلى ترفٍ هامشي. ومن ثمّ لا يعود التفلسف المعاصر مجرد ممارسة فردية منعزلة، بل يغدو فعلا جماعيا، يقاس بقدرة المجتمعات على ابتكار فضاءات للحوار والتفكير النقدي، وعلى صون السؤال بوصفه عنصرا مؤسِّسا في الحياة الثقافية والفكرية. فحين يَخبو السؤال الفلسفي في مجتمع ما، تخبو معه قدرة الإنسان على مواجهة رهاناته الكبرى، وعلى وعي أبعاد وجوده في عمقها ومعناها. تتجلى أهمية الفلسفة كفضاء للتأمل النقدي، فضاء يسمح بالعودة إلى الجوهر وبإعادة تقييم القيم، وبالتفكير في مستقبل الوجود الإنساني. فالفلسفة اليوم ليست مجرد أداة نظرية، بل ممارسة عملية تهدف إلى تحرير الفكر، وإعادة تشكيل الوعي، وتوسيع قدرة الإنسان على إدراك تعقيدات العالم وحقيقة وجوده. يتخذ السؤال الفلسفي طابع الضرورة والحيوية، لكونه السبيل إلى مجابهة السطحية المتفشية، والتحرر من الخضوع الأعمى لتراكم المعلومات، واستعادة ملكة التفكير النقدي العميق التي تمنح الوعي معناه وتحرره من الاكتفاء بالتلقي. وليس بخاف أن التفلسف في العصر الحديث يكتسب بعدا وجوديا أكثر حساسية من أي وقت مضى. فالأزمات البيئية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية تحتم على الفيلسوف أن يتساءل عن معنى الحياة، وعن العلاقة بين الإنسان والعالم، وعن شروط العدالة والحرية، وعن أفق القيم في مجتمع معقد ومتسارع. وهذا يجعل السؤال الفلسفي ليس فقط ممكنا، بل ضروريا للبقاء الإنساني والثقافي، لأنه يتيح لنا إدراك حدود المعرفة ومواجهة المجهول والتفكير في معاني الفعل والمسؤولية.
إن التفلسف المعاصر يتجاوز الأسئلة التقليدية ليصبح وسيلة لفهم الذات والآخر والعالم بشكل متكامل، وهو بذلك يعيد تأكيد دوره الحيوي في حياة الإنسان المعاصر.
يظل التفلسف فعلا يفرض على الإنسان التأمل في ذاته، في ماضيه وفي حاضر العالم وفي المستقبل المحتمل. فالسؤال الفلسفي لا يتوقف عند حدود المعرفة النظرية، بل يتعداها إلى مساءلة التجربة الإنسانية والتفكير في القيم وفي الغاية وفي المعنى.
يبرز السؤال الفلسفي بوصفه عملية متواصلة لا تنغلق على لحظة بعينها ولا يحدّها زمن محدد، بل تمتد لتخترق كل تجربة حياتية وكل انعطاف معرفي، وكل مواجهة مباشرة مع الواقع. إن السؤال الفلسفي رغم كل تحديات العصر الحديث، لا يزال ممكنا وضروريا، بل يمثل قلب الحياة الفكرية والمعرفية، لأنه يتيح للإنسان إعادة تقييم ذاته وعلاقته بالعالم، ومساءلة الافتراضات المهيمنة، وإعادة صياغة المعنى في زمن السرعة والانغماس. فالفلسفة ليست رفاهية فكرية، ولا مجرد معرفة نظرية، بل هي ممارسة حياتية، ونمط من التفكير النقدي، ومساحة لإعادة الاتصال بالوجود.
ينهض السؤال الفلسفي بوصفه علامة حيّة على وعي الإنسان وعلى إدراكه العميق لمحدودية المعرفة، وحاجته الدائمة إلى التأمل وإلحاح البحث عن المعنى في قلب تعقيدات الحياة المعاصرة. ورغم ما يواجهه التفلسف اليوم من تحديات غير مسبوقة، فإنه يظل فعلا ممكنا لأنه يتجاوز الظرفي والعابر، ويعيد تأسيس السؤال كركن أصيل في تجربة الوجود البشري، محوّلا التفكير إلى ممارسة للمقاومة والإبداع والمسؤولية الوجودية في آن واحد.
وبذلك يكون السؤال الفلسفي ليس مجرد قضية نظرية، بل ممارسة حية وفعلا إنسانيا متجددا قادرا على مواجهة التسارع والتشتت والانغماس وإعادة الإنسان إلى ذاته، وإعادة العالم إلى أفق التأمل، وإعادة المعنى إلى مركز التجربة الإنسانية. فمصير التفلسف ليس الزوال، بل إعادة اكتشاف القوة الداخلية للسؤال، وإعادة تأسيسه في قلب حياة الإنسان وفي قلب المجتمعات، وفي قلب كل فعل فكر يهدف إلى مواجهة الواقع وفهمه بعمق ومسؤولية
***
د. حمزة مولخنيف