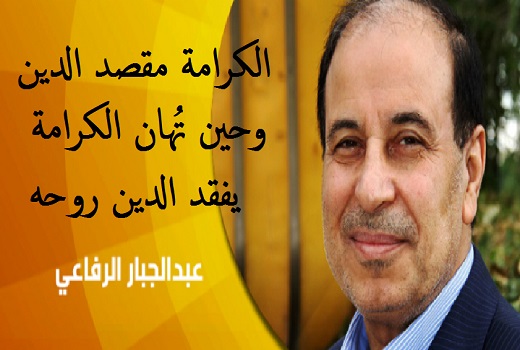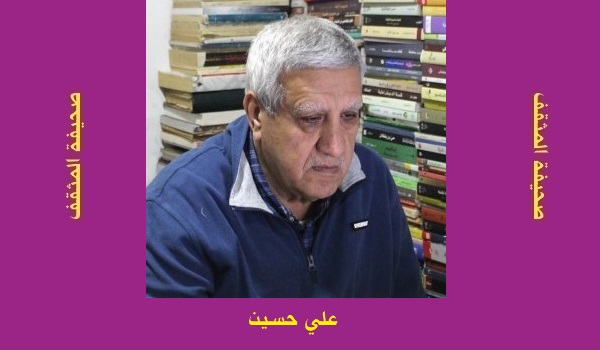أقلام فكرية
علي محمد اليوسف: فلسفة اللغة
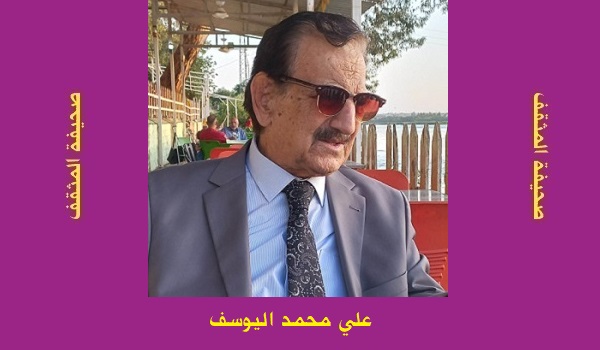
البنية اللغوية في موازاة الواقع
هل تراجعت اللغة كنسق نظامي مستقل في تعبيرها عن الوجود؟، وهل أصبحت جوهرا محايدا في فلسفة اللغة وتيارات فلاسفة التاويلية والتفكيكية والتحليلية المنطقية في تعبيرها عن المعنى الدال وتراجعت مهمة التواصل المجتمعي الى مرتبة ثانوية في خلق اللغة عوالمها الموازية لعالم الواقع الحقيقي لا تقاطعه ولا تحتدم معه بصراع ولا تتناغم معه كتكوين متموضع تجديدي؟ هل تنازلت اللغة عن مهمتها في تحقيقها الإدراك الشيئي القائم على مطابقة الدال اللغوي مع المدلول الشيئي مطابقة تامة تجعل من المدركات الشيئية بديهيات معرفية لا تقبل التشكيك بها، بعدما إكتسبت تلك الاشياء البداهة الحدسية الموجودية في مطابقة الدلالة اللغوية مع وجودها الشيئي زمكانيا.؟
فلسفة اللغة أدخلت مبحث اللغة في دوامة من المتناقضات التي إعتبرها فلاسفة اللغة وعلوم اللسانيات وفلاسفة مبدأ التحول اللغوي علي يد كل من فريجة ودي سوسير، وفلاسفة اللغة، ونظرية القراءة الجديدة وحفريات النص في تقصّي البحث عن فائض المعنى اللغوي . المعنى غير المكتشف في ثنايا تداولية اللغة بمثابة محاولة عملية إنقاذ فاشلة لمباحث الفلسفة من تقليديتها الخاوية المفرغة من مرحلة الاحتضار والموت البطيء التي كانت تعانيه طيلة قرون طويلة في دورانها المتمركز حول الانسان والمعرفة والوجود والطبيعة والعلاقات البينية بين تلك المباحث وغيرها.. ما اقصده هنا هو تشخيص الاعتلال والمرض لا يعني إمكانية الشفاء منه كما حاولته تيارات ومدارس فلسفة اللغة والتحويل اللغوي وفشلت.
الحقيقة التي لا يمكن القفز من فوقها أن التيارات الفلسفية التي عمّت وسادت اوربا وامريكا بعد أفول نجم البنيوية التي رافقت بكل إمكاناتها طروحات مرحلة ما بعد الحداثة، لم تحقق الطموح الذي كانت تتوخاه من عملية التحول اللغوي وإعتماد علوم اللسانيات وفلسفة اللغة وما يتفرع عنها في محاولة إدخال فلسفة اللغة في كل مبحث فلسفي أو مبحث معرفي حتى وصل الحد تجاوز إدخال الفلسفة بعلوم الفيزياء الى إدخالها في علوم الرياضيات وباقي العلوم الطبيعية التي تمتلك خصائصها النوعية التي تقاطع منطق الفلسفة تماما. ليس في إختلاف شكلية التعبير اللغوي بين الفلسفة التي تعتمد اللغة الابجدية الصوتية، وبين العلوم الطبيعية التي يكون تعبيرها اللغوي هو علامات ورموز ما يسمى بالمعادلات الرياضية . إنما الإختلاف أبعد من ذلك حول إهتمامات ما يشغل التفكير العلمي في تقاطعه مع ما يشغل مباحث الفلسفة. ولو نحن إستقصينا في جردة سريعة الإخفاقات التي رافقت فلسفة اللغة وعلوم اللسانيات ولم تنجز اليسير مما كان يمّثل طموحا مرتجى صدر عنها وأعلنت هي عنه، فلا البنيوية ولا التاويلية ولا حتى نهايات الوجودية الحديثة، ولا التفكيكية، ولا العدمية ولا التحليلية المنطقية الانجليزية جميعهم منفردين ولا حتى متداخلين لم يتمكنوا من إسعاف بعضهم البعض ولا إستطاعوا إنجاز ما كانوا يأملونه من توظيفات فلسفة اللغة وعلوم اللغة واللسانيات بما لا يمكن حصره من مباحث وقضايا كانت فلسفة اللغة على الدوام توازيها ولا تتقاطع أو تتداخل معها حينما كانت غارقة في مثالية إعتماد مركزية اللغة هي الحل السحري لمشاكل وقضايا تاريخ الفلسفة المستعصية أو الميئوس منها..
أغلب المطلعين على مباحث فلسفة اللغة يدركون جيدا أن المبدأ العام في المنطق النظري الذي طرحته فلسفة اللغة وعلوم اللسانيات كان في تمام المقبولية والإقرار بحقيقة أن معنى اللغة أضاع على مباحث الفلسفة الوصول الى مثابات إرتكاز تجديدية لم تتحقق عبر تاريخها الطويل وبقيت مباحث الفلسفة التقليدية تراوح مكانها إجترارا تقليديا لا معنى حقيقي له بات مركونا بالظل في غياب توافر ملء الفراغ التجديدي له. وقالوا مشكلة الفلسفة اولا واخيرا مشكلة تعبير اللغة في تضليلها العقل وخيانتها المعنى.
فلسفة اللغة حديثا شطرت مباحث الفلسفة شطرين: الاول أن مباحث فلسفة اللغة هي ليست الابحار العميق في تقليب صفحات تتوخى تصحيح نحو اللغة وقواعدها التركيبية لإعطاء كمال المعنى باللغة المجردة عن كل قصدية قبلية سابقة تروم وصولها.
والثاني وجدوا في مباحث فلسفة اللغة أنها لم تكن غاية بذاتها بل وسيلة تصحيح مسارات مباحث الفلسفة الغارقة في مستنقعات الإعادة والتكرار في مواضيع تتوزعها مباحث الوجود ومباحث الابستمولوجيا والمعارف، ومباحث القيم الاخلاقية الاكسيولوجيا.
لذا نجد أول من تنبّه تحاشي هذا المنزلق الخطير هم فلاسفة البنيوية التي ركنت مباحث فلسفة اللغة جانبا بعد أن كانت ألسبّاقة الاولى في فتحها فضاءات فلسفة اللغة والمعنى على مصاريعها، كما وركنت البنيوية مباحث الفلسفة التقليدية ثانيا لتقوم بطرق أبواب مباحث فلسفية جديدة لم تكن ذات إهتمام عند الفلاسفة طيلة قرون، كما نجد ذلك عند فوكو والتوسير ولاكان ودي سوسير وليفي شتراوس وباشلار وهكذا في اشتغالهم على مباحث فلسفية لا علاقة ترابطية تداخلية لها مع مركزية فلسفة وعلوم اللغة.
أبدأ بسؤال: هل فلسفة اللغة أغنت مباحث الفلسفة القديمة والحديثة التي جاءت بها؟ أم عملت على تشتيت إهتمامات الفلسفة في السير وراء تجريدات من الاشتغال على بنية اللغة كنصوص تتداولها الفلسفة بما هي لغة تشكيل علاماتي يتكوّن من نحو وقواعد وصرف خاصة باللغة شكلا ومحتوى؟ أم أن فلسفة اللغة فتحت أبوابا بحثية فلسفية كانت موصدة ولم تحقق المرجو المطلوب منها حيث أضحى تراشق تهم خيانة اللغة وبراءة الفكر في أولويات مداخل مباحث الفلسفة اللغوية التي أصبحت في متراكمها الكمّي والنوعي متاهات من التجريد الذي جعل من اللغة إنفصالا تاما عن كل ما هو جدير بالإهتمام في الحياة والانسان والعقل ناهيك عن العلم بكل تجليّاته.
هنا ربما يساء الفهم أننا نطالب أن تكون مباحث فلسفة اللغة وعلوم اللسانيات ايديولوجيات تعبوية ملتزمة قضايا الانسان في حياته اليومية.من هذه النقطة الاخيرة نستعير كلمات بول ريكور في إدانة إنفصال اللغة عن الواقع الميداني، والمفارقة الغريبة هي أن بول ريكور هو الآخركان يسبح في مغطس تضليل الفلسفة بإسم الإحتماء خلف فلسفة اللغة في تاويليته. في الهورمنطيقا لكنه ربما أراد ترقيع الفتق الفاصل بين فلسفة اللغة والفلسفة ; كسردية منطقية بما أطلق عليه التاويلية أو الهورمنطيقا التي لم تغادر محكومية الإنقياد وراء فلسفة اللغة لها بمعزل تام عن قضايا الواقع والحياة في مباحث الفلسفة التقليدية.
أمام حقيقة الاصطدام أن فلسفة اللغة أصبحت إنفصالا تاما عن التزامها التعبير عن الواقع الخارجي الحياتي للانسان، وصف بول ريكور فيلسوف التاويلية إدانته الفلسفة البنيوية التي خرج من تحت عباءتها قائلا ما معناه التفكير البنيوي النسقي في البنيوية كان يتخّبط في نمطيّة كليّة من التفكير في عالم اللغة الداخلي الذي يتخّطى جميع الاشتراطات المنهجية الذي ينشدها عالم الانسان الخارجي، عليه لم تعد اللغة بعدها توسيطا بين العقل والاشياء بل البحث عن تشكيل بنية عالم لغوي منفرد خاص باللغة وحدها.
بهذه النظرة رفض بول ريكور الفكرة الأساسية التي كان دافع فينجشتين عنها بإلحاح حينما كان أحد اعضاء فلسفة تحليلية اكسفورد في وجوب التعامل مع اللغة بوصفها صورة حياتية تنمو وتتطور من خلال طبيعتها المجتمعية، وفي وجوب جريان ينابيع اللغة مع دفق الحياة في سيرورتها الدائمية. وكأنما كانت هذه الدعوة من فينجشتين هي تكفير عن ذنب إرتكبه وخرجت معالجته من بين يديه. وحتى ريكور رغم إدانته الصحيحة للبنيوية فهو عجز عن إعطاء بديل عنها.
بول ريكور في الهورمنطيقا سبق جميع التيارات الفلسفية السابقة عليه في رفضه إتجاهين فلسفيين رئيسيين أحدهما متمثلا بالفلسفة التي كانت تنادي في إصلاح معنى اللغة تمهيدا لإصلاح قضايا الفلسفة عامة في وضعها على سكة معالجتها قضايا فلسفية تكون فيها اللغة ليست بنية نسقية في تنظيم نفسها باستقلالية تامة عن عالم الانسان الخارجي والحياة والإتجاه الثاني أن اللغة كبنية نسقية تبني نفسها بنفسها كي لا تكون سلوكا نفسيا ولا نزوعا فطريا يسكن الفرد يتطور ذاتيا بمعزل أن يكون للمجتمع دورا تكامليا معه.، فأصبحت فلسفة اللغة لا علاقة لها مع وجوب معالجة قضايا إنسانية هي خارج تشكيل إستقلالية بناء نسق لغوي من التجريد لا يمكن تطبيقه ولو جزئيا على ضروب معرفية سوى ما جرى على مستوى نقد الادب كما فعل رولان بارت، وغيره من المتاثرين بتفكيكية جاك دريدا ممن وجدوا في معالم التفكيكية وبعض موروثات البنيوية إمكانية أن تكون منهاجا تطبيقيا تجديديا في ضروب مناهج النقد الادبي...
ربما يبدو مصادرة فكرية قولنا كان سعي بول ريكور تاسيس بنية لغوية هي إكتفاء لغوي ذاتي يقوم على إعتماد تطورات اللغة في مجمل التناقضات والاختلافات والفروقات القائمة داخل النظام اللغوي المستقل عن العالم الخارجي.. النسق اللغوي المكتفي ذاتيا الذي إخترعه ريكور ودريدا بفارق ليس جوهريا، هو خلق نسق لغوي إغترابي تعسّفي داخل نظام اللغة ما جعل الفلسفة الغربية تدور في مناخات البحث عن التجديد الذي قفلته مباحث فلسفة اللغة الخالية من مضمونية شكل اللغة بما هي قواعد نحوية فقط.
البنيوية واللغة
رغم أن البنيوية اشّرت وظيفة اللغة في فلسفة العقل ونظرية المعنى، أن وظيفة اللغة لم تعد تلك الوسيلة المعرفية لفهم الواقع والتعبير عن مشكلاته، وخرجت اللغة أن تكون وسيطا علائقيا بين الأفكار والاشياء. نجد بول ريكور شنّ هجوما على البنيوية من حيث أنها تعاملت مع اللغة خارج منطق اللغة في التعبير المستقل عن ذاتيتها.
فالبنيوية لم تحاول مسك تلابيب الواقع الخارجي وتوظيف نظرية المعنى في جعل علاقة اللغة بالواقع علاقة جدلية مثمرة وليست منفصمة كما أرادت البنيوية وريكور ذلك. البنيوية منذ بدايات دي سوسير عام 1905 لم تعمل على ترسيخ حيوية اللغة في ربطها بالواقع كما تبنّى فينجشتين هذا الطرح لاحقا قبيل وفاته، وكان تحذيره من انزلاق الفلسفة نحو انشاء بنيّة كليّة تجعل من اللغة اكتفاءا ذاتيا لا يؤثر بالواقع الخارجي ولا يتأثر به ويكون خطرا لم تتم معالجته. ما عدا إلتماعات متناثرة تبنّاها جورج مور في دعوته من داخل الفلسفة المنطقية التحليلية الانجليزية الى أن يكون أصلاح قضايا الفلسفة إنما يكون في إصلاح نظام اللغة التي إنحرفت الفلسفة عموما به ودعا مور الى أهمية اللغة العادية المجتمعية في تطوير الفلسفة من جهة وتطوير مباحثها من جهة أخرى.هذه الدعوة ذهبت أدراج الرياح في إصرار كلا من بيرتراند رسل أن تكون مباحث فلسفة اللغة تقوم على الرياضيات والمنطق حسب وصّية فريجة نصا وأقنع راسل فينجشتين بذلك ايضا. وكان لوايتهيد عالم الرياضيات الانكليزي دورا هاما في دعمه بيرتراند رسل واشتراكهما معا في تاليف كتابهما( مباديء لرياضيات العامة).
وإهتمام راسل بمبحث الرياضيات بشكل استثنائي يوازي لابل يفوق إهتماماته الفلسفية والمنطقية ما جعله يتنقل في مؤلفاته من مبحث لآخرفي تنويعة بدت لبعض المهتمين بالفلسفة متناقضات. والى جانب ذلك برزت مدرستي التوليدية اللغوية الفطرية لدى نعوم جومسكي، وأخرى مناوئة لها أطلقت على نفسها فلسفة السلوك اللغوي روادها ودعاتها هم الفلاسفة الاميركان ابرزهم سكينر حصرا نأتي على ذكرهم لاحقا.
الوعي واللغة
طرح الباحث اللغوي عبد القادر البار تساؤلا هاما على صعيد إشكالية اللغة مع الفلسفة. قائلا: أين يوجد معنى اللغة؟ هل يوجد في أذهان البشر؟ أم يوجد في العالم الخارجي المشترك بينهم؟ وهل يمكن للمعنى أن يتكون وينمو خارج المكونات التقليدية الخاصة بما لا يمكن تجاوزه بسهولة ؟
نجد في محاولة مقاربة فتح هذه المسالك الفلسفية أن نبدا بالوعي كمفردة مفتاحية للدخول في معترك تلك الاسئلة المتداخلة...فالوعي يمكننا تصنيفه الحذر أنه حلقة في بايولوجيا منظومة العقل الادراكية ليست لها ميزة فيزيائية غير تجريدية كما هو حال الفكر واللغة. والوعي الذي أصبح له فلسفة خاصة به. الوعي الذاتي أي تعبير ذهن الانسان عن مدركاته إنما يمتلك معان مستمدة من الاحساسات يمكن أن تكون إضافة نوعية تثري المعنى اللغوي في تعبيره.
في أغلب الاحيان لا يطابق معنى الذهن معنى الموجود المادي في واقعه الاستقلالي، كون جوهر الذهن هوإنطباعات عشوائية خارجية وليس جوهر الذهن افكارا إكتسبت كامل اليقينية، فهل نلجأ الى تفعيل دور الوعي أن يكون وسطا بين المدرك المادي ومعنى التعبير اللغوي عنه؟ الوعي يتداخل تخارجا بينه وبين ما يمتلكه الذهن من معنى لم يأخذ حيّز التنفيذ الإفصاحي لغويا له، لذا يكون الوعي توسيط بين الذهن في نقله الانطباعات المؤقتة، والمعنى الدلالي اللغوي عن الشيء المقصود. والوعي كما أشرنا هو خصيصة إدراكية ذاتية منفردة، بمعنى حينما نقول الوعي الجمعي أو الوعي المجتمعي فهذا لا يتحقق على صعيد التفكير التجريدي المنفرد بل يتحقق على صعيد التوافق غير المعلن لمجموعة من الناس في التعبير عن قضية أو عن موضوع يجمعون عليه سواء أكان ماديا أو غير مادي معين. وما يدركه الذهن من معنى هو إدراكات إنطباعية لتداعيات تفارقه بسهولة. ألذهن ليس مستودعا لتخزين الانطباعات ولا حتى الافكار. والوعي لا يعمل في فراغ ولا يعّبر عن معنى غير قصدي يمكن التأكد منه.الذهن ليس ذاكرة من جهة، ولا هي عقل تفكيري ينوب عن العقل من جهة ثانية، واخيرا الذهن ليس مستودعا لتخزين الافكار فيه.
الوعي هو معنى لغوي وحلقة غير منظورة في منظومة العقل الإدراكية، هذه المنظومة الادراكية بعضها بايولوجي عضوي وظيفي مثل الحواس والجهاز العصبي ومحتويات تكوين الدماغ، وبعضها الآخر له مناطق عصبية مسؤولة عنه في القشرة الإمامية للدماغ، وهي في حقيقتها الإفصاحية بالدلالة إنما هي تعبيرات من الفهم الادراكي التجريدي مثل الاحساسات، الاحاسيس، الذهن، الذاكرة، المخيلة، الوعي، الادراك، الفكر، واللغة. والوعي لا يكون تعبيرا أفصاحيا ذاتيا عن اشياء خارجية مادية فقط وإنما الوعي يكون إستجابة إدراكية داخلية أيضا في التعبير عن النفس والعواطف والضمير والاخلاق والسلوك وغيرها.
الوعي الفلسفي
الوعي مصطلح فلسفي تجريدي – بيولوجي غامض الولادة، والخوض في معتركه لا يسلم صاحبه من الأخطاء لكن مع هذا فالدراسات والابحاث الفلسفية العديدة بدأت التركيز على بسط الوعي كمبحث فلسفي يستحق الإهتمام الإستثنائي به. خاصة بعدما تراجعت مباحث الفلسفة امام انبثاق فلسفة اللغة والتحول اللغوي.
ومنذ منتصف القرن العشرين حينما أصبحت فلسفة اللغة هي الفلسفة الاولى، نشأ الاهتمام الملتبس حول الوعي الفلسفي، وأكثر الفلاسفة إهتماما بالوعي هم الفلاسفة الاميركان المعاصرين يتقدمهم جون سيرل وريتشارد رورتي وسيلارز وكواين يسبقهم الانجليزي جلبرت رايل فيلسوف العقل 1900- 1976 الذي انكر ان يكون هناك شيء اسمه العقل...حين وجدوا في فلسفة العقل واللغة، الارضية المناسبة للاهتمام بدراسة الوعي من الناحية الفلسفية إذ لم يروا مناسبا طغيان التحول اللغوي على مباحث الفلسفة في هيمنة الفلاسفة الفرنسيين على المشهد الفلسفي اوربيا ويبقى الفلاسفة الاميركان متفرجين، فعمدوا الى إستعارة مفهوم الوعي من عميد البراجماتية الامريكية وليم جيمس عالم النفس وفيلسوف الذرائعية الذي لخّص فهمه الوعي:
- اولا الوعي يقوم على أساس أنه ليس جوهرا مستقلا بل هو وظيفة.
نزع صفة الجوهر عن الوعي في إعتباره وظيفة فقط لا يقلل من أهميته أنه حلقة إدراكية غير فيزيائية تعبر عن جوهر العقل الذي ليس هو ماهية مفكرة فقط، لذا فالوعي يستمد جوهره من العقل بإعتباره وظيفة ملحقة لا غنى للعقل عنها. فالوعي إفصاح ادراكي وسيلته التعبيرية الفكر واللغة.
رب تساؤل يقول مالفرق بين وظائف العقل والوعي والذهن والذاكرة، وهل بمكنة وإستطاعة الوعي الإنابة عن العقل بالوظيفة الإدراكية؟ لكي نجيب:
- الوعي لا يقوم بمهمة العقل التفكيرية بل هو الوسيلة لتلك الخاصيّة العقلية..
- الوعي إستجابة ناقلة لردود أفعال العقل، وكذلك وظيفة ناقلة لإنطباعات الذهن الى العقل.
- يشترك العقل والوعي بوسيلة الفكر واللغة في الافصاح التعبيري عن مدركاتهما.
- ما يدركه العقل يدركه الوعي بالضرورة، بفارق العقل جوهر كليّ والوعي جوهر وظيفي جزئي حلقة في منظومة العقل الادراكية.
الصفة الثانية للوعي حسب وليم جيمس أن الوعي تجربة صرفة لا يمكن تجزئتها الى أفكار واشياء، والوعي ليس تجربة عقلية ولا طبيعية . وتعقيبنا عليه هو:
الوعي تجربة صرفة يمكن تجزئتها الى أفكار إدراكية لاشياء بإعتباره حلقة تابعة لمنظومة العقل الإدراكية. كل حلقة في منظومة العقل الادراكية هي جزء يمّثل نفسه بدلالة مرجعية العقل له، لكنه لا ينوب عن العقل في دلالة الادراك الكامل عن الاشياء منفردا والتعبير اللغوي عنها..
الوعي هو فكر وإحساس عن شيء شأنه شأن ووظيفة كل حلقة إدراكية مرجعيتها العقل. وليم جيمس كونه عالم نفس وفيلسوف اراد أن يجعل الوعي إنطباعا نفسيا حين يصفه ليس تجربة عقلية ولا هو تجربة طبيعية.
لا يمكن الحكم على الوعي انه ليس تجربة عقلية ولا طبيعية وهو حلقة توسيط ادراكية للعقل للاشياء.الوعي تجربة عقلية في مرجعية العقل له وليس هناك وعي يريد الافصاح عن ذاتيته من غير وصاية العقل عليه. في ذلك تعجيز وظائف العقل.
نعت وليم جيمس الوعي انه ليس تجربة عقلية ولا طبيعية في تعبير خاطيء بوضوح، فالوعي يستمد سمته العقلية من جوهر العقل الادراكي التفكيري الذي يرتبط به الوعي، ولا يمكن أن يكون للعقل مخرجات معرفية يصدرها العقل عن شيء لا يكون الوعي ناقلا لها بمعزل عن وعي العقل لمدركاته هذا محال.
قول وليم جيمس الوعي ليس تجربة طبيعية غير صحيحة، فالطبيعة وكل ما يدركه العقل يجري وفق تراتيبية نظامية طبيعية للعقل والوعي جزءا من تفكير العقل التجريدي، وليس طارئا منفصلا عنه .. والوعي هو إدراك متعال على الطبيعة وليس ناتجا عنها.كما هو شأن العقل بعلاقته بالطبيعة هو جزء منها متعال بذكائه المعرفي الخصائصي المعروف عنها.. في امتلاكه وعي الذات والموضوع معا، امتلاكه اللغة، امتلاكه الخيال، احساسه بالزمن.
اذا إعتبرنا مع وليم جيمس الوعي ليس تجربة طبيعية بمعنى ليس تجربة فطرية مرتبطة بفطرية العقل الادراكي يحوزها الانسان كجزء من تكوين العقل في وظيفته غير الفيزيائية كون الوعي تجريد لغوي يحتوي الفكر التجريدي بينما العقل تجريد ناتج عن منظومة عضوية بايولوجية هي جزء من تكوين جسم الانسان تسمى العقل الوظيفي العضوي الدماغ ومحتوياته من المخ، المخيخ، النخاع الشوكي، ومنظومة شبكة الاعصاب الناقلة والمستلمة للاحساسات والمثيرات...لا يشترط أن يكون ما هو طبيعي جزءا من الطبيعة غير منقاد لها وهو ما ينطبق على الوعي كونه حلقة إستدلالية معرفية تطال كل موجود في الطبيعة ولا تكون جزءا منها متموضعة فيها..
الوعي واللغة
تعتبر الكتابة في أبسط تعبير لها هي عملية تدوين الافكار اللغوية من حالة المشافهة المنطوقة صوتيا لسانيا الى حالة التدوين الكتابي المقروء أو المنظور الصامت. ويعتبر إختراع الكتابة طفرة نوعية في اللغة ترقى الى مستوى إختراع الانسان لغة الكلام. ويرى "غودي "أن الكتابة هي إرتقاء الى شكل جديد من أشكال التقنيّات الفكرية وبالتالي الى شكل جديد من العقلية ".بهذا المعنى تكون الكتابة هي الخروج من الخاص الى الفضاء العام بأن لغة الكتابة تصبح من حصة المجموع اولا، وتصبح الافكار المكتوبة تدوينا عابرا للتاريخ باقيا على مر الاجيال من غير إندثار بخلاف لغة الكلام الشفاهي التي تندثر في فترة زمنية محدودة.ونستطيع القول أن اللغة أوالكلام الشفاهي هو كل ما لا نتمكن من حفظه تاريخيا زمانيا الا بوسيلتي التدوين الكتابي أو التسجيل الآلي للغة المشافهة صورة وصوت. بخلاف اللغة المكتوبة التي تعتمد تدوين تفكير العقل لها.
نتساءل الآن هل توجد لغة في ما وراء المدلول الشيئي.؟
هناك ظاهرة يصفها علماء اللغة بمصطلح ما "فوق لغوية" وهي إمتلاك بعض الشعوب تجربة تقنية لغوية من دون تعلم مسّبق لقواعد ونظام نحو تلك اللغة، فمثلا عندنا في لغتنا العربية نجد الشعراء العرب نظموا الشعر موزونا مقفى بضوابط بحور الشعر قبل وضع العبقري الخليل بن احمد الفراهيدي المتوفي سنة 170 هجرية نظام العروض الشعري. أي بعد مضي قرون طويلة على تداول العرب الشعر الجاهلي وهم لا يعرفون ما معنى بحور الشعر بل كانوا يفهمون الشعر بالسليقة كلاما له ضوابط تميّزه عن النثر. كما يذهب علماء اللغة المحدثين "عدم وجود علم لغة الا اذا كان هناك علم ماوراء لغوي، اي عندما يكون لدينا لغة ماورائية ما وراء اللغة هي لتمثيل لغة اخرى تكون هي اللغة الموضوع " ومعنى ذلك إن فنون اللغة(الشعر والنثر) تنشا قبل علوم وضوابط ونحو اللغة. أي كما ذكرنا لا يشترط الابداع في اللغة أن يقوم على مدى إتقان قواعد تلك اللغة، لكنما برأينا نجد هذا الحكم نسبيا بالنسبة للغات منها اللغة العربية. حين قام الخليل بن احمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري بتنقيط المصحف الكريم المكتوب في وضعه علامات الحركات في ملازمتها الحروف كصوت لغوي الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون، والشدّة والتنوين لم يكن أحدا من عرب ذاك الزمان يلحن في لفظ المفردات العربية و لا يعرف بالفطرة المتوارثة الفرق بين المرفوع، والمنصوب، والمجرور، والفرق بين الاسم والفعل والحرف وما يتفرع عنها في صياغة الجمل والعبارات. هذه الظاهرة هي مايسمى فوق اللغة. اي في القدرة على التعامل الفطري باللغة قبل معرفة ضوابطها النحوية وخصائصها المميزة لها.
فينجشتين والوضعية المنطقية
في الوقت الذي ذهب فيه فينجشتين في الوضعية المنطقية مجموعة فيّنا، التي جرى تعديلها لاحقا فلسفيا في التحليلية المنطقية الانجليزية بزعامة بيرتراند راسل، وجورج مور، وايتهيد، فلاسفة جامعة اكسفورد والتي إنضم لها كل من كارناب، وفينجشتين الذي كان استاذا للفلسفة في جامعة كامبريدج.كان لفينجشتين رأيه الخاص في إعتباره اللغة منطق قوانينه قبلية مستقلة عن التجربة لكنها أيضا تحصيل حاصل أنها لا تعني شيئا. ولا تدل على شيء في التجربة. فما قوانين المنطق إلا قواعد نحوية تنّظم تنظيما ميّسرا بفضاءات التجربة الحسّية . وأضاف أن المنطق يتكوّن من قواعد تركيبية أي تنّظم تركيبا وهذه القواعد تستخرج من مباديء تم إخيارها بطريقة تحكميّة.
التحليل النقدي والتعقيب
- كل ما هو قبلي معرفي تجريدي مستقل عن التجربة الإدراكية لا معنى له ولا يعبّر عن مدرك حقيقي مادي ولا عن موضوع خيالي.
- أصحاب الوضعية المنطقية الجدد من الانكليز وجدوا إمكانية التحدّث عن اللغة بوسيلة إستخدام لغة ثانية أطلقوا عليها "لغة اللغة" والتفلسف ما هو إلا شرح معنى لغوي بمعنى لغوي آخر. لغة شارحة بعدية للغة قبلية سابقة عليها في ملاحقة فائض المعنى.
- اللغة هي إحساس نسقي منّظم لا علاقة له بالإدراك الشيئي حسب فلسفة اللغة ونظرية المعنى، وإحساس اللغة يكون إحساسا زائفا حينما لا يكون تعبيرا لمعنى واضح الدلالة حسب المناطقة.
- بحسب المناطقة الجدد لا فرق بين زيف الإحساسات حينما تكون تعبيرا لغويا لا معنى له. ولا يمكن التحقق من صدقيته، لذا يبقى الإحساس موضع شك.
- العديد من المباحث المفاهيمية لا ينطبق عليها المنهج التجريبي النقدي الذي تنادي به الوضعية الجديدة. فكل شيء بمفهوم العلم هو موضع شك، يتطلب تبيان جوانب الإدانة فيه وتصويب أخطائه.
كارناب وربط اللغة بالعلم
يميز رودولف كارناب 1891- 1970 بين عدة وظائف للغة إما أن تدل على معنى أو تعبّر عن رغبات وعواطف. ومن واجب الفلسفة حسب المنطقية الوضعية الانجليزية أن تحصر نفسها في تحليل لغة العلم باستخدام المناهج المنطقية التي أساسها الرياضيات، وما عدا هذه المهام فاللغة تبقى مبحثا له اكثر من مدلول وخارج ميدان مباحث الطبيعة. وأدان كارناب فلاسفة اللغة الذين يضعون قيودا على الإستعمالات اللغوية، بدل الإهتمام بتجديد الشروط التي تطابق اللغة معناها.
تعقيب تحليلي
- هذه المهام للغة التي لخصّها كارناب لا تقول جديدا ما عدا ما يجب أن تقوم الفلسفة على تحليل لغة العلم بمنطق الرياضيات كما اسّس له فريجة وتبّناه بيرتراندراسل مع وايتهيد ومن قبله دي سوسير. فليس سهلا أن تكون الفلسفة تابعة للعلم بمجرد أنها تمتلك منطقا منهجيا تحليليا للعلم. وهذا لا ينفي بل يؤكد حقيقة تاريخ الفلسفة انها لم تكن تابعة للعلم تقتفي آثاره بل كانت توازيه على الدوام وتتداخل معه في نطاق ضّيق.
- العلوم الطبيعية قاطبة وليس فقط العلوم الانسانية تقوم على مبدأ إستقلالية منطق تجريدي إشاري علاماتي من المعادلات الرياضية لا يخضع الى نقد لغوي عادي سردي كما يجري في لغة نقد سرديات الادب والايديولوجيا وعلم الاجتماع والاديان التي أطلقت عليها ما بعد الحداثة السرديات الكبرى..
- أدان ريشنباغ وهو من فلاسفة الوضعية توّجه كارناب وأشياعه قائلا: أنهم يخطئون حين يحاولون البحث عن يقين مطلق، حيث ليس هناك من بديل، وإنما مجرد إحتمال. ومّيز ريشنباغ بين التحقق التكنولوجي في عصر ما، والتحقق الفيزيائي الذي لا يتعارض مع قوانين الطبيعة،.
- إنتهى كارناب في أخريات تطوره الفلسفي الفكري الى أنه يجب التوّصل الى تعريفات دقيقة للمفاهيم الاساسية التي يستخدمها العلم في إطار لغة صورية منطقية تماما.
- كما إنتهى جورج مور على العكس من لغة المنطق ضرورة العودة الى لغة الناس العاديين الجارية المتحاورة معتبرا ذلك الشرط الاساسي للتحليل العلمي الصحيح. وربط التحليل الفلسفي بكل من الإدراك العام أو الإدراك الفطري.
***
علي محمد اليوسف