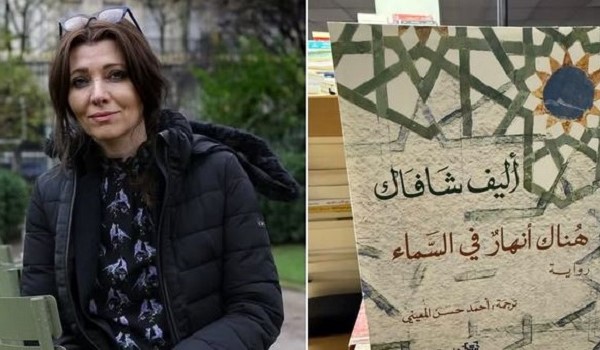أقلام فكرية
ابراهيم ماين: المدرسة قوة ناعمة.. النقد الماركسي للمدرسة عند لوي ألتوسير

مثلما أنه يستحيل أن نتصور جسم الإنسان بدون عضو من الأعضاء التي تكونه في صيغة تكاملية، يستحيل – بنفس الدرجة تقريبا – أن نتصور مجتمعا مبتورة أحد أعضائه التي تدب فيه الحيوية وتمنحه الحركة، ولو أن هذه المقاربة البيولوجية المنتعشة في الأدبيات السوسيولوجية الوظيفية قد توصلت إلى فهم آخر لما يمكن أن يكون عليه المجتمع حتى ولو فقد أحد أعضائه، فكما أن الإنسان إذا فقد أحد أذنيه تتقوى عنده حاسة السمع ضعفين في الأذن التي بقيت عنده سالمة، وكما أنه يستعين بحواس أخرى لديه يعوض بها وظيفة ما فقده، فإن المجتمع كذلك إذا فقد أحد أعضائه فإنه يلوذ بالبحث عن بدائل وظيفية يسد بها الفراغ الذي خلفه العضو المفقود، وهذه القدرة الحيوية التي يتمتع بها المجتمع – أي القدرة على التعويض والتخليف Compensation– تكسبه قوة كبيرة على الحفاظ على استمراره وتحصين بقاءه من أشكال الصراع والنزاع الكفيلة بتمزيقه إلى أشلاء إذا ما لم يتم التعامل معها بطريقة عقلانية وتنظيمية ونسقية، وإننا نعني بالأعضاء هنا مختلف المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية التي تحتضن الأفراد وتضمهم إلى نسق اجتماعيSystème social يعج بالمعتقدات والمعايير والأخلاق والتمثلات الرائجة داخله، بما يحافظ على بنيته ويصون مستوى الانسجام والتناسق فيه .
ينظر إلى هذا النسق – في المقاربة الصراعية السوسيولوجية – كسجن رمزي يحتجز في داخله الأفراد ليمارس عليه قهرا ماديا تارة ورمزيا تارة أخرى، ويفهم هذا القهر على أنه سلطة تملي عليهم ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله بالترغيب والترهيب، فكل نظام، وكل نسق لا تكون له قائمة ولا تصنع فيه صانعة إلا إذا احتوى في داخله سلطة ما متمثلة في مجموعة من الضوابط والقواعد والمعايير التي ترشد السلوك وتوجه التصرف على جهة الفعل، وفي نفس الوقت توحي للأفراد وحيا يشكل – ليس أفكارهم فقط – بل الطريقة التي يجب أن يفكروا بها، والمواضيع التي تستدعي التفكير من جهة التمثل، وإن نحن هنا نتحدث عن مملكة السلط – أي المجتمع – فسيكون طوبى يتهم المؤتي بها بالزيغ والانحراف أن ننادي بالحرية والاستقلالية والإبداع والابتكار، والحق أن هذا النداء الطوباوي أشبه بوسوسة الشيطان لأن اتباعه يؤدي حتما إلى نوع من التفرقة والتشرذم داخل المجتمع بين من يتغيا أن يحقق الحرية داخل مجتمع لا يتقبل فكرتها حتى، وبين من يتشبث بترسانة القيم والمعايير التي تشربها زمانيا ومكانيا من بني مجتمعه، وهذا مما لا يؤمل حصوله في مجتمع ولا يرجى حدوثه بين أفراده .
إن الوظيفية مع دوركهايم تناشد الفرد الذي ينغمس انغماسا تاما في منظومة مجتمعه، ويطيع المجتمع – الإله ولا يحيك حياكة عشواء للخروج عن طاعته وعصيانه، وإن هو فعل، فإنه يتعرض لما يسمى ب " الضبط الاجتماعي Contrôle social " بحيث يجري إعادة إدماجه قسرا في البنية، وإن استعصى ذلك وقاوم فإنه حتما يقذف خارج البنية الاجتماعية وكأنه جرثومة اخترقت جسد المجتمع وتعين على مؤسساته أن تعمل على استئصاله .
أما الصراعية فإنها تساند الفرد الذي يدأب على النفاذ خارج النسق السلطوي، وعلى التحرر من الأغلال الاجتماعية التي تكبل نزوع الإبداع عنده ومن الأصفاد المعيارية التي تطوق ميوله الطبيعي إلى التفكير العقلاني والسلوك الأخلاقي، إنها ضد كل ألوان التعسف في استعمال السلطة لتطويع الأفراد لقوتها إن وعيا منهم وإن من دون وعي، إن علما منهم كما هو الشأن مع المؤسسات الاجتماعية التي تعمد إلى القمع كمؤسسة الأمن (الشرطة، الدرك، العسكر، القوات المساعدة) وإن جهلا منهم كما هو الشأن مع المؤسسات الاجتماعية التي تعيث الأيديولوجيات وتنفث سمومها الملوثة في كل مكان ليستنشقها الأفراد بدون أن يستشعروا ضررها ولا أن يتحسسوا أثرها عليهم، وإن فضح هذه الأيديولوجيا الثاوية خلف المؤسسات الاجتماعية التي تتكلف بشكل خفي بترويجها وإذاعتها هي مهمة اضطلعت بها المقاربة الصراعية ممثلة في مجموعة من علماء الاجتماع والفلاسفة، لعل أبرزهم هنا – ولن نجد أخير وأنسب منه في توظيفه ضمن موضوعنا – الفيلسوف الفرنسي والماركسي الكبير لوي ألتوسير .
1 . الإنتاج في البنية التحتية وإعادة الإنتاج في البنية الفوقية:
يتكون المجتمع حسب كارل ماركس من بنيتين : بنية تحتية متعلقة بالقاعدة الاقتصادية التي تحكمها علاقات الإنتاج ووسائل الإنتاج من أجل تكثيف عملية الإنتاج بغية تحقيق الأرباح، وبنية فوقية متعلقة بالقاعدة الاجتماعية التي تحكمها السياسة ممثلة في الدولة والقانون ممثلا في القضاء والمؤسسة الأمنية من جهة، والأيديولوجيات السياسية والدينية والأخلاقية والاجتماعية من جهة أخرى، وحق لنا في مستوى البنية الفوقية أن نميز طبقا لما وضحناه آنفا بين ما يظهر وما يضمر، فالظاهر هو ما يقع في الواجهة، بمعنى أنه يمكن أن نلاحظه ونستشعره، ويتجلى بشكل واضح في معتقدات الناس حول الدولة والقانون، إذ ينظرون إلى الأولى على أنها المسؤولة عن المؤسسات، إذ أن نجاعة هذه الأخيرة رهينة برصانة التخطيط التدبير السياسي، وأن فشل التدبير إنما ينذر بإخفاق المؤسسات عن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وينظرون الى الثاني – أي القانون – على أنه الوسيلة الوحيدة الممكنة لبسط السلم والأمان وتخويل الحقوق لهم بما يتماشى وسياسة السلم الاجتماعي، وحتى القمع الذي يصدر من الجهاز الأمني بذريعة تطبيق القانون لا يعاب فيه شيء طالما أنه يخدم الغاية التي ترجى منه، وهي غاية الاستقرار الاجتماعي، فلا غرابة – وفق هذه المقاربة – أن يقمع كل من تجاسر وتطاول على الرموز الاجتماعية والدينية والسياسية على اعتبار أن التطاول عليها إنما هو – بالدرجة الأساس – ضرب من ضروب الانحراف والشذوذ، ذلك أنه إذا تواكف الناس جميعهم شأن المتمرد الثائر على بني مجتمعه فإن حالة من الفوضى والاختلال ستسود، فلن يكون لنا بمقتضى هذه الحالة شرعية لكي نتحدث عن مجتمع، ومنه يتعين علينا أن نقر بأن الظاهر في القانون بالنسبة إلى عامة الناس هو الحفاظ على النظام والاستبقاء على التوازن وإدامة السلام وصون الحقوق وإقرار الواجبات .
أما الضامر من البنية الفوقية فهو ما يتخفى وما يتوارى خلف ما يظهر، إن الأمر أشبه بجبل الجليد، يظهر منه جزء صغير على السطح، لكنه في الأعماق ممتد يصعب استكشافه، وهذا الجزء الخفي هو ما يسمى بالأجهزة الأيديولوجية، وعلى غرار تشبيهنا لها بجبل الجليد، فقد شبهها لوي ألتوسير بالمسرح في مقالته " الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة Idéologie et appareils idéologiques d'État "1، إذ يقول فيها : " أعتقد أنه وراء مشهد جهاز الدولة الأيديولوجي السياسي – الذي يحتل خشبة المسرح – فما أعدته البرجوازية حقا وكان أداتها الأولى – في الكواليس – هو الجهاز التعليمي، والذي حل في حقيقة الأمر محل جهاز الدولة المهيمن السابق، ألا وهو الكنيسة، وللمرء أن يضيف هنا أنه قد حلت ثنائية (المدرسة / الأسرة) محل (الكنيسة / الأسرة)"، ولا يجب أن ننسى بأن هذا الجزء الخفي يغطي ما يحلو لنا أن نسميه ب " العنف اللطيف "، وقد أطلق عليه صاحبه ومنظره السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو اسم " العنف الرمزي Violence symbolique " وذلك من أجل إحقاق وظيفة هي أشبه بالقانون الطبيعي هي إعادة الإنتاج، بينما الظاهر من البنية الفوقية تستعمل العنف المادي والقمعي وذلك قصد – كما بينا من قبل – إحقاق السلم الاجتماعي، وصح أن نقول أن الأول ينطوي على ديناميكية Dynamique بينما الثاني يحمل في ثناياه استاتيكية Statique، وهنا نعود إلى قول ألتوسير أعلاه بخصوص المدرسة لنتساءل حول موقعها ضمن هذا النسق الأيديولوجي، فهل هي تنتمي إلى الظاهر أم إلى الباطن؟ هل تسعى إلى الديناميكية أم تهدف إلى فرض الاستاتيكية؟ هل العنف فيها رمزي ناعم أم مادي قمعي؟ هل هي متحكمة أم متحكم فيها؟ هل هي عاكسة أم معكوسة؟ وماذا تكولسه (كولسة) المدرسة؟ هل يمكن اعتبار المنهاج الدراسي والتعليمي تجسيدا لهذه الكولسة؟ ثم كيف تعيد المدرسة إنتاج الطبقات الاجتماعية إذا ما افترضنا أنها تهدف إلى التحريك بدل التجميد؟
2. المدرسة.. قوة أيديولوجية ناعمة !
انطلاقا من فصلنا وتمييزنا بين الأجهزة القمعية للدولة التي تعتمد على العنف والقمع كوسيلتين أساسيتين لضمان شرعية وجودها وتقوية تماسكها الداخلي من جهة وصون حرمتها " المقدسة " من جهة ثانية، ونخص بالذكر هنا جهاز الأمن وجهاز السجن ... وبين الأجهزة الأيديولوجية للدولة والتي تعول على مؤسسات اجتماعية وسياسية لتمرير أفكار وقيم ومعتقدات كفيلة بأن تبرر وضعا قائما أو تزيفه وتشوهه، ونذكر هنا مؤسسة الأسرة ومؤسسة القانون ومؤسسة الإعلام ومؤسسة الدين ... إلا أنه – يقول ألتوسير – ضمن هذه الكوكبة من الأجهزة الأيديولوجية هناك جهاز دولة أيديولوجي واحد له الدور المهيمن، وإن كان لا يكاد لا يوجد من يعير لحنه سمعا، إنه المدرسة!
و هنا نطرح سؤالا: ما معنى أن تكون المدرسة جهازا أيديولوجيا؟
سيكون من المروع حقا أن نشاهد صورة المدرسة المنمقة أمام أعيننا تتبدد وتنفرط، خصوصا إذا علمنا مسبقا أنه ما كان للمجتمع أن يقبل نقدا ولا اتهاما يتجه رأسا إلى هذه المؤسسة التي ظلت النزاهة والمصداقية صفتان لازمتان لها إلا وكان هذا الاتهام هو المتهم نفسه، حتى أن قيم التعليم والتربية باتت متأسسة عليها، أو لنقل – على سبيل المغالاة الجائزة – ما كان ينعته إيفان إليتش ب " مأسسة القيم L'institutionnalisation des valeurs "، بمعنى حصر القيم الأخلاقية والتربوية في نطاق بناية مكونة من حجرات ومرافق، بحيث أن كل ما يقع خارجها إنما هو باعث على ما يخالف قيمها التي تروجها، فتقع في محضور النخوة الزائفة، أين تترفع عن كل نقد وتتأبه عن كل مراجعة ونظر، وهذا مرتع الأيديولوجيا الخصب، إنها تستمرئ عمل مؤسسة عبر التلميع من صورتها وربط مجموعة من القيم النبيلة بها، فلا غرابة مثلا أن نجد قيمة الصدق لصيقة بمؤسسة الإعلام، وقيمة العلم مقترنة اقتران اللزوم بدور الثقافة والجامعات، وقيمة العدل مندسة في مؤسسة القانون، وقيمة التواصل بمؤسسة السياسة، ومن ثمة تمنحها قبولا عند فئة عريضة من الناس، ومعلوم أن الإنسان إذا قبل بشيء وحضي عنده باستضافة رحبة فإنه يقبل منه بالتالي أي شيء آخر يصدر منه، وينتج عن هذا القول أن المجتمع الذي يحمل تمثلا إيجابيا عن المدرسة لابد له من أن يقبل بكل ما ينبع منها، دون أن يستشعر أو " يشم " رائحة العنف الرمزي الذي تمارسه على المنتمين إليها من جهة الميكرو، وإعادة الإنتاج الاجتماعي الذي تخدم به الطبقات المسيطرة من جهة الماكرو، ومؤدى القول هنا إلى أن من لا يستشعر الضرر الذي يلحقه ويقبل به إنما هو في حالة تنويم أو بالأحرى تسكين، ولما لا والقوة التي يتوسدها في منتهى النعومة واللطافة، فأين تتجلى هذه القوة الناعمة؟.
يشجب ألتوسير الضغط الذي يتناوب على ممارسته على التلاميذ جهازين : جهاز الدولة الأسري وجهاز الدولة التعليمي، إن الأطفال – التلاميذ يقعون موقع الوسط بين هاتين القوتين اللتان تسحقانه سحقا يصيبه بشتى أنواع الإرهاق والإنهاك النفسي والبدني، ما يخلف عنده هشاشة تكاد لا تفارقه طوال مشواره الدراسي ومساره الاجتماعي، فضلا عن الخوف الذي ينتابه في كل اختبار أو امتحان يحكم بموجبه على مستواه، فإن أفلح فيه نال التقريظ والثناء، وإن هو أخفق، يقذف بأشكال عديدة من التشنيع والإهمال، وهذا بالطبع ما يمكن أن نسميه عنفا رمزيا بلغة بورديو، وهو عنف أشبه بالمرض الذي ينخر في جسد الإنسان وهو لا يحس به .
كما استفظع لوي ألتوسير ظاهرة إعادة الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي التي تشرف المدرسة على إشاعتها وإفشائها، وتتبدى هذه الظاهرة الخفية بشكل جلي فيما يمكن تسميته بالمنهاج المضمر، وهو منهاج يحتوي على مجموعة من التوصيات التي تنص على ما يجب تعليمه وما لا يجب تعليمه، فما يجب يندرج ضمن المحددات الرئيسية التي تضمن للمجتمع درجة عالية من التماسك والتلاحم، زيادة على الحاجيات الاقتصادية التي يتوخى سد ثغراتها، والحق أن هذه الحاجيات لا تلزم الاقتصاد في التنصيص على شيء طالما أن اليد العاملة موجودة، لكن تدخل الجانب الاقتصادي في المنهاج التعليمي المضمر كانت تستدعيه ضرورة اجتماعية أساسية، وهذه الضرورة تتحدد أساسا في الحفاظ على الطبقات والفوارق الاجتماعية الموجودة ودرء الحراك الاجتماعي، والدليل على ذلك – وعلى حسب الدراسات السوسيولوجية التي أجراها بيير بورديو – هو أن خريجي المدارس يبحثون عن وظيفة أو عمل كفيل بأن يمنح لهم العيش الكريم، لكن، من الاستثناء الضئيل أن تجد خريجا من المدرس يطمح لأن يكون وزيرا أو رجل سياسة أو يطمع في أحد المناصب الريادية في الدولة، وفي ذلك يقول ألتوسير: " وفي سن السادسة عشر تقريبا يخرج كم هائل من الأطفال إلى الإنتاج : ها هم العمال وصغار المزارعين (...) وأصحاب الياقات البيضاء من العمال والتنفيذيين الصغار والمتوسطين، والبرجوازية الرثة بأشكالها ... " .
إننا إذا لاحظنا هذه الوظائف والمهن التي ذكرها ألتوسير لا نكاد نجد فيها ما يمكن أن ندعوه بالعمل الحر، أي العمل الوحدوي الذي لا تتخلله علاقة الاستغلال الجامعة بين مستغل (بكسر الغين) ومستغل (بفتح الغين)، ومنه يمكننا أن نستنتج أن ما يتم تدريسه من معارف ومعلومات لا يرقى إلى المستوى الذي يخول للخريج أن يوظفها ويستعملها في حياته بحرية، بل هي معارف يمكن أن تستثمر فقط حين يكون الخريج منخرطا في علاقة الاستغلال تلك، لأن هذه المعارف " ملفوفة في غلاف ناعم من الأيديولوجية الخاصة بالطبقة الحاكمة، يعاد إنتاج علاقات الإنتاج في التكوين الاجتماعي الرأسمالي، أي علاقات الخاضع للاستغلال بمن يستغله، والقائم بالاستغلال بمن يستغلهم، الآليات التي تنتج هذه النتيجة المهمة للنظام الرأسمالي مغطاة ومخفية تحت طيات الأيديولوجية العالمية المهيمنة الخاصة بالمدرسة، وهي مهيمنة على الجميع لأنها من الأدوات الأساسية لأيديولوجيا البرجوازية الحاكمة: هي أيديولوجية تمثل المدرسة بصفتها بيئة محايدة تخلو تماما من الأيديولوجيا".
والواقع أن كل المآخذات التي أعقبت النقد الماركسي الذي وجهه ألتوسير الى المدرسة إلا أنه لم يطالب – شأن إفان إليتش – بإلغائها أو التخلص منها والبحث عن بدائل لها، بل بالعكس من ذلك، رأى أنها مطلب طبيعي لا غنى لنا عنه مهما ابتكرنا من أدوات ووسائل جديدة للتعليم والتربية، فالمدرسة تبقى الحضن الوحيد الذي يحتوي جميع اختلافات وتناقضات وتفاعلات المجتمع والسياسة والاقتصاد، أكثر مما تقدر أي مؤسسة أخرى على احتواءه .
***
ابراهيم ماين - باحث في الفلسفة وعلوم التربية بالمدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس بالرباط .
.....................
Louis ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’État. la revue La Pensée, no 151, juin 1970