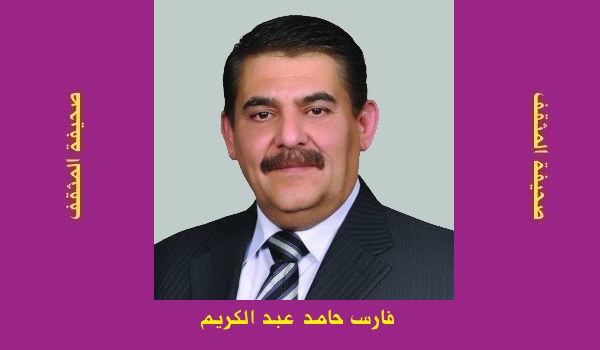أقلام فكرية
محمد سيف: اشكالية الفهم الديني التقليدي.. والمقاربات العلاجية المتأخرة

ما نعرفه عن التاريخ الإسلامي بكل حمولته إنما وصل إلينا عبر التدوين الرسمي وبشقّيه غير المتزامن والمتزامن، فالأول ما كان تدوينه بعد الأحداث بفاصل زمني طويل، ويصدق على الفترة النبوية وما بعدها حتى زمن التدوين الرسمي، وأما الشق الثاني فهو التدوين الذي تزامن مع حركة الاجتماع الإسلامي، هذه الحمولة تتخذ أشكالا عدّة: الموروث النصّي والتأويلي، والنصتأويلي!
فالموروث النصّي لدى المسلمين يصدق على ما بين دفتي المصحف، إضافة إلى الروايات المنسوبة للنبي ولجيلين بعده - أكثر الأقوال حتى ٢٤٠هـ أو ٣٠٠ هـ - فالنص الأول محل اتفاق، وما عداه فيه نزاع سواء من حيث مدى ونوع حجيته أو صحة نقله.
والموروث التأويلي لا أعني به صرف المعنى عن ظاهره لقرينة، بل الفهم بمعناه الواسع وتوجيه أنواع النصوص المذكورة أعلاه، ويصدق على جميع مدونات الفقه (المسائل العملية) والكلام (المسائل العقدية) وما دار في فلكها.
والموروث (النصتأويلي) - هذا المصطلح نَحَتُّه من كيسي - وأعني به القناعة التي تم تقديمها في صيغة نصّ ولكنه مفبرك بغرض تأييد رأي على آخر وشرعنته، فالرأي الذي يأتي نصًا من شأنه أن يقطع حجة الخصم! وهذا هو الحال العام للمدونة الروائية.
بعد هذا الترسيم نأتي فنقول: المصحف نصٌّ مفتوح دلاليًا، وقد أثبت النظر أنه يستوعب كل تلك الدلالات من أقصاها إلى أقصاها، وهذا تحدٍ حقيقي؛ لأن الاحتكام إلى النص مفتوح الدلالة هو إحالة على محتمَل، بدليل أن كل الاختلافات بتناقضاتها واتّساع الهوّة بينها، تستند للنص ذاته، حتى عند استحضار ما يُطلق عليه آيات محكمات، فأول تحدٍ يتم مواجهته هو تقديم تعريف جامع مانع لها متفق عليه، ثم وجود مجموعة محددة متفق عليها لتلك الآيات، وهذه المعضلة أثمرت إمكانية تعلُّق كل أصحاب توجّه بمصدرية نصيّة واحدة سواءً أكان قديما أو مُحدثا.
وإزاء هذا الانفتاح الدلالي فإنه لا يمكن وضع حدّ له فضلا عن صرفه إلى معنى محدد مهما بدا واضحا جدا، فانصراف الدلالة في نص ما لمعنى بعينه في نظر البعض لا ينهض سدا يمنع الآخر من استخراج دلالة أخرى أو حتى مضادة، وبعبارة أخرى: الوضوح الدلالي لا يعني بالضرورة انسحابه على الجميع، فالحتمي عند أحدهم قد يكون محتملا عند ثانٍ وملتبسا عند ثالث ومستحيلا عند رابع، وهكذا دواليك. مع التنبيه إلى أنّ الانفتاح الدلالي لا يعني حصرا الإضافة التراكمية التي تسع الجميع بالمعنى الإيجابي، بل يعني فيما يعنيه كذلك الإلغاء والتضاد بين الدلالات بعضها ببعض؛ ومن هنا نشأت أحكام التفسيق والتبديع والتكفير؛ ولهذا فالانفتاح الدلالي للنصّ مُربك.
إن التدوين - بما عليه من تحفّظات على دقته التاريخية؛ للاعتبارات الدينية والسياسية - يقدم لنا ممارسات دينية متباينة من حركة الاجتماع البشري الإسلامي، وفق توجّهات مشرعنة دينيا بِغضّ النظر عن مدى صحتها، ولكنها واقع ممتدّ من اللحظة التي أعلن فيها النبي نبوّته وحتى اللحظة الراهنة، فالصوفية تصدّر مقالتها الدينية من النصّ، وحركات الإسلام السياسي هكذا تفعل، وحتى تنظيم الدولة وحركة طالبان تصنع الصنيع نفسه، ولا نجد خطابا دينيا رسميا ينكر صنيعهم بل تصدر بين الفينة والأخرى خطابات التأييد والمباركة ممن يمثلون الخط المعتدل مقارنة بتلك الحركات، وأيضا المشبّهة والمنزّهة يرجعون لنص واحد، بل حتى القراءات الباطنية للنصّ الديني تجد بُغيتها فيه. إنّ الكل يصدر من إناء واحد، ومشكاة النص تسع مصابيح جميع القوم، ومهما تنازعوا في ادّعاء الحق إلا أنه لا يمكن استبعاد أي منهم من المنظومة الإسلامية، فكل التوجهات المذهبية والتيارات الحركية الإسلامية تمثّل نسخة إسلامية، وتستوعبها المصادر الإسلامية الرئيسة، وبعبارة أدقّ: الإسلام هو كتلة من إسلامات متحركة بمرور الزمن تنبثق من النصّ ذاته. ولكن بوجه عام فإنّ الفهم التقليدي للدين في منطقته المشتركة بين كل تلك التحزبات يُصَدَّر على أنه الأكثر تمثيلا للإسلام.
ما تَقدَّم آنفا ما هو إلا توطئة لسؤال المقال الإشكالي، وهو:
ما هو وضع المقاربات العلاجية المتأخرة من هذا الفهم الديني التقليدي؟
إن مسلم اليوم يواجه أسئلة جذرية مصوّبة تجاه دينه في إطاره العام أو إطاره المذهبي الضيق، أسئلة محرجة إنسانيا وعلميا واجتماعيا ومنطقيا، وإزاء هذه الأسئلة يسلك المسلمون سُبُلا ثلاثا مُجملا:
أولا: الجمهرة الكبيرة تستمرئ تلك الإشكاليات وتبرر موقفها منها، وترى أنّها مجرد أسئلة يبثها مرجفون ومَن في قلوبهم مرض، لا يمكن أن تزعزع تصوّرها الديني، وتنحاز توكيديا لكل ما يعزز إسلامها وترفض ما عداه ولو جاء من المصدر عينه.
ثانيا: تأخذ تلك الأسئلة على محمل الجدّ، وتسير معها، غير أنّها لا تصل لإجابات مُرضية شافية مقنعة، فلا تجد بُدا حينئذ من الخروج عن ربقة المذهب أو الدين بالكلية.
ثالثا: ترى أنّ تلك الأسئلة المحرجة غير متعلقة بأصل الدين بل في أمر آخر، حيث تُعتبر الإشكاليات الواردة متصلة بفهوم تبنّاها المسلمون خلال القرون الماضية بادئ الأمر ثم استقرّ الحال عليها، لكنها فهوم - كما يرون - مغلوطة ولا تعد الممثل الأمثل للإسلام.
وأصحاب هذا الاتجاه الثالث وما قدموه من مقاربات، ينقسمون إلى قسمين رئيسين باعتبار أسلوب المعالجة:
القسم الأول: يقدّم جوابا عريضا لعلاج تلكم الإشكاليات، عنوانه تاريخيّة النص، فتتركّز مقاربته في أنّ تلك الأحكام المتصلة بالنصّ التي هي محل الأسئلة المحرجة صحيحة لكنها مؤقتة بمفردات حركة الاجتماع البشري آنذاك زمانا ومكانا، ومرتهنة بظرفيتها التاريخية، وأن النصّ الوارد فيها ميت الآن، ولا يتبقى إلا مفاهيم القيم العليا ومساحة ثوابت ضيقة للغاية، فيزيحون عن كاهلهم تبعات تلك الأحكام التي تصطدم بالمعرفة الإنسانية الحالية.
القسم الثاني: ينافح عن صلاحية النصّ الذي ينظرون إليه بأنه عابر لكل زمان ومكان، غير أنهم يرون أنّ الإشكال الحقيقي متعلق بدلالته، فينطلقون من النص القرآني، وبعضهم يسحب ذلك على ما وافقه من المدونة الروائية، فيحاولون أن يطرحوا فهمًا يتّسق وآخرَ ما توصّلت إليه المعرفة الإنسانية على مختلف الأصعدة.
إن سؤال المقال الإشكالي مرتبط بهذا القسم الثاني من الاتجاه الثالث من اتجاهات تعاطي مسلم اليوم مع الأسئلة الكبرى المُلِحّة.
أنصار هذا الفريق استيقظ على واقع لا يمكن دفعه، ومُعطى ماثِل لا يمكن ردُّه، وحقيقة لا يتأتّى التملص منها خلال الفهم الديني التقليدي الذي ورثه، فعَمَدَ إلى النظر في النص بإكراهات متعددة وواسعة، مستثمرين كل الإشارات الخاطفة الداعمة من موروث ديني تراكمي متضخم وتداخلات ثقافية أوسع من أي وقت مضى، ومختلفة بطبيعة الحال عن مسلم الأمس.
هذا النظر خلُص إلى تقديم مقاربات جديدة في فهم الدين، حتى إنّ بعضها غالى لدرجة أن أصبح أقرب ما يكون إلى أديان جديدة، واضطره النظر إلى الوقوع في تأويلات باردة مكتظة بالتعسّف، وبعيدة يشوبها الكثير من التكلّف، ورغم أنّ الواقع الديني لجمهور المسلمين ما زال متشبّثا بما درجت عليه الأجيال التي سبقته، ألا وهو الفهم التقليدي الديني، إلا أن المبدأ الذي تستلهم منه هذه المقاربات انطلاقتها أنّه لا يمكن قصر الفهم على ما تم تلقّيه من فهومات مشوّهة قُدِّمت على أنها الفهوم النهائية، بل يمكن تقديم فهوم جديدة للدين منسجمة مع مختلف جوانب المعرفة الإنسانية، وعليه ترى هذه المقاربات العلاجية أنه لا يمكن اختزال الدين الإسلامي في تجربة محصورة زمكانيا، بحيث تكون الممثل الشرعي الوحيد أو الصحيح له.
غير أنه مع الواقع المعقّد لتفاعل حركة الاجتماع البشري الإسلامي مع الموروث الديني فإنّ المقاربات الجديدة يَرِدُ عليها جملة من الملاحظات الإشكالية، من بينها:
هل تسوّغ هذه المقاربات العلاجية المتأخرة نزع صفة (الإسلام) من النسخ الدينية التي يغصّ بها الموروث الإسلامي، وخصوصا أهل الفترات الزمنية المحيطة بزمن النبوة؟
إنّ دافع هذه المقاربات الجديدة إنما تولّد نتيجة الصدمة المعرفية والهوة بين المقاربات الموروثة والتطوّر الهائل الذي وصلت إليه حقول المعرفة، وهذا يعني أنه مع استمرار التطور ستتّسع معه الفجوة؛ وتاليا تنشأ مقاربات جديدة أخرى تسد الثغرات الجديدة، إلى ما لانهاية؛ الأمر الذي يدعونا إلى التفكير مليا في أن المقاربات التقليدية الأولى هي المتأهّلة لتمثيل الإسلام، وما عداها فهي محاولات دائمة لتكييفه وفق المعطيات التي تطرأ، والتي لا تنفكّ تكشف عن ثغرات جديدة؛ كونها عملية ترميمية لا تتوقف!
لو أنّ دولة حديثة قامت أسسها على إحدى المقاربات التقليدية بالكليّة، ألا يمكن للآخرين وصمها بأنها دولة إسلامية؟!
ماذا عن معتنقي اليوم للفهم التقليدي الديني؟ أليسوا على نسخة تمثّل الإسلام؟
هذه الأسئلة تدفع بنا إلى اعتبار أن المقاربات التقليدية هي الأكثر تمثيلا للإسلام، وهي - وحدها - من تُلزَم بتقديم الإجابات المتماسكة حول الأسئلة الإشكالية التي تتناول الدين.
أمّا المقاربات العلاجية المتأخرة للنصّ الديني فهي أقرب للصدمة المعرفية منها إلى مجرّد الصيرورة إلى دلالةٍ دونًا عن بقية دلالات النصّ.
***
بقلم محمد سيف