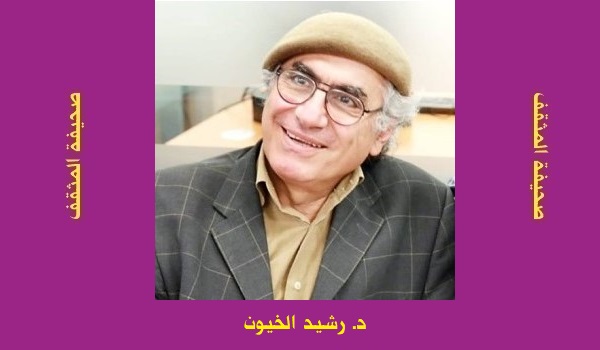أقلام ثقافية
زهير ياسين شليبه: رسائل من زمن الحصار لكاتب مجهول

الرسالة الثانية /3: الرسالة الجَلجَلوتية!
آب/ أغسطس 1992
عندنا يعاملون البشر مثل البهايم
***
عزيزي يونس!
حدثني أحد أصدقائي، قال:
في إحدى المرات عندما كنا في بداية التسعينات ننتظر في معسكرات اللاجئين الحصولَ على الإقامة، فوجئت بشاب طويل القامة ضخم الجثة يأكل فيها السبع كما يقال، والله أتذكر أنه كان على جَمال رجولي يجلب انتباه حتى الرجال، فيه العينان الواسعتان الكحيلتان اللامعتان السوداوان، والسن الباسم والشعرالكث، والطول والرشاقة، والشياكة والأناقة والقيافة، والله العظيم لو كنت مخرجًا مسرحيًا لأعطيته دور قائد عسكري أو روحي، ملهم، يقود الجماهير، لكنه لم يكن كذلك، سبحان الله، كاد أن يطير من الفرح، لم يستوعب "صدمةَ" الخبر المفرح، صار يتراكض ويتراقص ويدبك ويهز وسطه ويدورهنا وهناك جذلاً فاقدًا السيطرة على جسمه ويهذي ويجمجم بكلمات غير مترابطة كأنه يعاني من نوبة فرح جنوني لا يدرك ماذا يفعل وكيف يسيطرعلى مشاعره كأنه نشوان سكران يتهاوى أصيب بهيستيريا، سألت الآخرين بهدوء وثقة بالنفس كأني مديرهم أو مسؤول نزلتُ عليهم مشرفًا "من فوق"، أو من كوكب آخر لا يعلم ماذا يجري هنا: يا جماعة الخير، اشصار بيه، هذا الشاب؟ ربح مليون ؟"، قالوا لي إنه حصل على إقامة، "هَلّا وصلت إقامته"، هَمهَمتُ مستفسرًا: "وصلت إقامته؟ بالسيّارة؟ شر البلية ما يُضحك! إن لله في الخلق شؤون، وشنو يعني إقامة؟"، بينما كانت عيناي تتطلعان بسخرية إليه وهو يتابع دبكاتِه ورقصاتِه، والآخرون يضحكون.
تَمتَمَ أحد كبار السن من طالبي اللجوء الفلسطينيين، كان جالسًا إلى جانبي، يبتسم: "حقه يفرح ويرقص كمان، ما هُوْو أردني، المفروض يزغرد لأن الأردنيين ما بيحصلوا على الإقامه بسهوله زيكم العُراقيين، أنت مش عارف؟ وإلا؟ إحنه الفلسطينيه قبل كانوا بيعطونا الإقامه بنص ساعه، هسّاع صاروا يأخّرونا، أكثريتنا هنا صار لنا ثلاث سنين ننتظر، عشان هيك هُوْو فرحان، أصلاً ما كان بيتوقع ياخذها، لأنّه أردني، وزي ما خبرتك ما بيعطوش للأردنيين إقامه عشان بلدهم آمن، وفيه دمقراطية واحترام لحقوق الإنسان، هُوو صار له أربع سنين ينتظر، لكن هُوو ما كان سائل عليها، يشتغل هنا وهناك، جزار وخضرجي، يجي هون للمعسكر بس يستلم معاشه شهريًا ويروّح، إيه شو بدّه يعمل؟ يروّح على بلاده؟ مش معقول يترك هالبلاد الخضراء الحلوة والشغل والرفاهية ويروح، لا عنده شهاده ولا شغل ولا عمل هناك، ما تقول لي وطن! لا وطن ولا بطيخ، شو فائدة الوطن إذا ما فيه لقمه الواحد يأكلها؟ مستحيل! مضبوط كلامي والاّ لا يا باشا؟".
وَجّه سؤاله الأخير متطلّعًا إليّ بعينين حزينتين مستفسرتين بينما أخرج سيجارتين من علبته، قدّمَ واحدة لي وأخرى وضعها بين شفتيه الذاويتين ليدخنها، وصدره يخرخش ويسعل وهو يتمتم بين نفسه كأنه يشك بما يقول: "أنا عارف! والله الواحد يحتار شو بيحكي، الوطن عزيز، لكن الظروف تحكم الناس، والاّ شو يخلّي واحد شاب مثل هذا يترك أهله وديرته"؟
تناولتُ السيجارة شاكرًا وأنا أتطلعُ إلى تضاريس الجغرافية والتاريخ والرحيل والقدوم والمغادرة والوصول والسفر البادية في ملامح وجه هذا الفلسطيني المبتسم الهادىء، وكأن المثل العراقي "المبلّل ما يخاف من المطر" ينطبق عليه، هو بالأساس لاجىء في لبنان ليس له حقوق. واستمرَّ يتكلم بصوتٍ خافتٍ كأنه يعاتب نفسه "شوف كانت هناك بناية قديمه عالية، هي مش كثير تعبانه، بس هم درسوا الموضوع وقرروا يهدّموها ويبنوا مكانها عماره جديده، حاطّين صوره كبيرة تورجيك كيف راح يصير شكلها في المستقبل، ماشفتها؟ في شارع الكومونه، وفعلاً هدموها، على اساس هي خرابه! ههه! وراح يبنوا سوبر ماركت جديد وشقق سكنية ولا احلى منها! واحنه؟ خراب وسراب وشتائم وسباب!
عندنا يعاملون البشر مثل البهايم، هذا هيك عمل وهذه هيك عملت! وعلى اقل حاجة تبدأ اتهاماتهم وتخوينهم وتكفيرهم! شو بدّي أقول؟ أنا عارف؟ والله مش عارف شو أحكي؟ هَيْهم الناس إهنِي عايشين أحسن حياة ومرتاحين! ليش احنه هيك وضعنا؟ ليش ما نصير مثلهم؟ نبني ونعمّر بلادنا وبيوتنا؟ شوف يا مَحلى شوارعهم وبيوتهم، واحنه خراب وتراب، نكد بنكد، حروب إلها أول ما إلها آخر من داحس والغبراء حتى يومنا هذا، وأطفالنا وشبابنا يُقتلون قدّام أعين كل البشر، لكن لا مهزوز ولا محزوز، ولا نعرف شو راح يحصل بالباقين تهجير قسري أم "تحرير" أمري! وإلى متى نبقى بها الحال! الله اعلم!
كادت عيناي أن تدمعا، لو كان الأمر بيدي لفضّلتُ هذا الفلسطيني على نفسي وأعطيته الإقامة بدلاً عني، هذا طبعًا إن منحوني إيّاها بسرعة باعتباري عُراقيا كما يقول. أفكّر في كلامه وأقول لنفسي لا وطن بلا عمل ورعاية وحماية، ولا اندماج في مجتمع يدير للإنسان ظهره!
دعنا في المهم يا حبيبي يونس، نتذكركم في كل مناسبة وغير مناسبة، في كل لقمة نضعها في أفواهنا متردّدين بمضغها أو لوكها، وفي كل مرة نضحك قليلاً، نقطعها ونتوقف عن الابتسام خوفًا من لومة لائم أو تأنيب الضمير.
الطبيعة والمرابع الخضراء والسواقي والأنهار والأهوار لم نرها في بلاد الرافدين إلا في دروس الجغرافية والتعبير، هل تتذكر معلّم اللغة العربية عبد الحسين الحمداني؟ الطويل القامة ذا الشفتين، المتدليتين والنظارة السوداء، كان بارعًا في تدريس العربية ،علّمنا عبارات لم نكن نشعر بها، نصحنا أن نستعملها في موضوعات مثل: "صِف رحلة"، كنا نسميها كلائش: ولبسَت الأرض حلتها الخضراء متشحة بأحلى الألوان الزاهية، مرتدية أجمل الأزياء، أو: أخذت السيارة تنهب بنا الأرض نهبًا بينما كنا نتطلع من نافذتها إلى الأبقار والأغنام والخيول والدجاج والبط والنوارس والطيور الأخرى وعصافير الدوري في المراعي والمروج والبساتين العامرة بالنخيل المتفاخرة بأعثاقها، نشم عبق الروائح الطيبة العطرة مع مهب الرياح الدافئة بشمس الربيع الساطعة ووجوه الفلاّحات مبتسمةً.
حلوووو! هلو عيني! هلو داد هذا شلون نفخ! كنّا في الصف السادس الابتدائي، وكان علينا أن نصف مناظرَ طبيعيةً لم نطلع عليها يومًا، بأجمل العبارات والألفاظ والصفات الجميلة الجاهزة!
بشرفك انت شفت مثل هذه الطبيعه في بغداد بحياتك؟ أنا شخصيًا لم أرَ أرضًا خضراءَ، أقصد بساتين وغابات غنّاءة وأشجارًا باسقة في بغداد إلا ما ندر، مثلاً في منطقة صدرالقناة ومقبرة الإنجليز أو الأتراك، لم أعد أتذكر، كنا، المفروض ندرس فيها، وأشجار الكاليبتوس في شوارع بغداد القديمة، مثل الوزيرية والصرّافية وراغبة خاتون وطبعًا كورنيش الأعظميه وبيت المميّز على الشط، كنا نسبح فيه وكاد أن يغرق فيه أحد زملائنا نوري النحيف الصُغيّر "الزعيجون" لولا أن أنقذه صاحبه صباح، هل تتذكر تلك الحادثة؟ والعطيفية، الله ما أجمل تلك الظلال في الظهيرات القائظة، وفي حدائق منازل يسكنها ناس محظوظون.
ولا أزال أتذكر مدى فرحي عندما زرعوا "الثيّل" الأميركي الأخضر في السبعينات على "سفحِ" سدّة ترابية كان يمر عليها القطار ما بين أكاديمية الفنون الجميله والجسر الصغير قرب كلية التربية ودار الكتب في بغداد، تحول لون التراب إلى أخضر جميل زاهٍ غمرني بالسعادة.
يا ترى هل لا تزال سدّة القطار خضراء؟ عشرون سنة تفصلني عنها، منها ثماني سنوات حرب مع الجارة إيران!
لا أزال أتذكرهذه السدّة الخضراء، أحنُّ إليها كلما أشتاق إلى أمّي.
***
الدكتور زهير ياسين شليبه