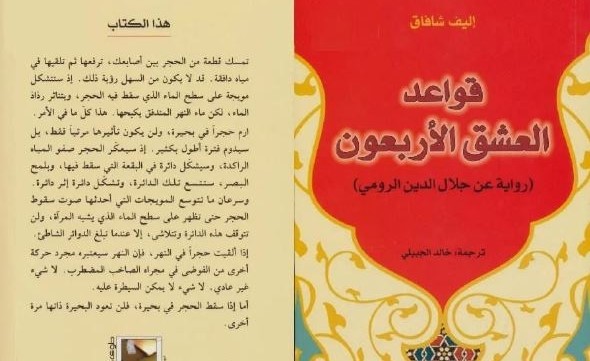دراسات وبحوث
طاهر ناصر الحمود: أهل الحرم وسنام العرب

دراسة في دور "القرشية" وآثارها العميقة في تاريخ الإسلام
يشهد تاريخ الرسالات والأديان السماوية - بل تاريخ كل الأفكار الإصلاحية - أن محتوى هذه الرسالات، عقائدها، قيمها، تعاليمها يبدأ كما أراده الله نقياً صافياً يخاطب الفطرة ويعالج مقتضياتها ثم يأخذ صفاء هذه الرسالة بالاعتكار ونقاؤها بالتغير، فينحرف مسارها عن الطريق الذي أراده الله إلى حيث أدت له عوامل الانحراف وأسبابه.
وليس هذا عيباً في الرسالة أو الفكرة - مالم تكن مجانبة للفطرة أو بعيدة عن مقتضيات الإنسانية وحاجاتها – بل العيب في الإنسان الذي تلقى هذه الرسالة ولم يرتفع إلى حيث أرادت له الارتفاع مع توفر إمكانات السمو لديه ووجود أدوات التجاوز عنده، توفرها في قوة الفكرة ونصاعة القيم، ووجودها في استعداد الإنسان اللانهائي على التفاعل مع الرسالة والعطاء بلا حدود.
العيب في الإنسان الذي يعبر بأهوائه وغرائزه والتصاقه بالأرض، عن النقص بأجلى صوره. والعيب في الإنسان الذي لم يستطع ان يداني المثال الممكن أو يمازج المطلق القريب، فالرسالة بقيمها وأفكارها ليست صورة بعيدة عن التناول او أنموذجاً يتغنى – وحسب - بجمال معناه وسمو أفكاره. بل الرسالة أفكار للعمل وقيم للحياة. والرسالة قيمة يؤمن بها عقل المؤمن، ويحنو عليها قلبه، وتمازجها جوارحه في الحياة سلوكاً وممارسة.
وهكذا كان تاريخ الإنسان في علاقته برسالات الله، استعداداً لتلقي الرسالة وحملها أول الأمر، ثم ضعفاً عن هذا الحمل ونوءاً بثقل الأمانة.
فالمسيحية تحولت من ديانة توحيدية مجردة إلى ديانة مليئة بالرموز والطلاسم، واليهودية كذلك تحولت من رسالة ذات أهداف إنسانية إلى ديانة قومية تستأثر برحمة الله كلها لليهود وتضن بها على الآخرين.
وأما الإسلام فبالرغم من أن صورته العقائدية بقيت بشكل عام سليمة من الأذى، وظلت صورة العبادات فيه كذلك على حالها دون أن يطرأ عليها تغيير أساسي، كما أن القرآن الكريم بقي بحفظ الله مصوناً من التحريف وبعيداً عن العبث الذي طال الكتب السابقة، فإن تحدياً أساسياً واجه هذه الرسالة في مرحلة التطبيق وتحكيم القيم الجديدة. وهو نوع من التحدي ينبثق من خصوصية الرسالة الإسلامية وطبيعتها الشمولية. فالإسلام ليس عقيدة تستقر في ضمير المؤمن وتضم الى جانبها وصايا أخلاقية تنظم السلوك الفردي فحسب، بل هو عقيدة وأخلاق ينبثق عنهما تشريع يعالج مختلف شؤون الحياة. تشريع يستتبع وجود جهاز لتنفيذ أحكامه وبنوده، ومن هنا جاء التحدي الأكبر للرسالة.
ومع اعترافنا بالدور الهام الذي لعبته التيارات الفكرية والخصوصيات الثقافية للأمم والأعراق التي اشتملت عليها الأمة الإسلامية، أو تلك التي احتكت بها الأمة عن بعد في الابتعاد بصورة الإسلام عن بساطته الأولى وإضافة ما لا ينبغي من الألوان والظلال لهذه الصورة. فنحن نرى أن التصور المطروح يومذاك لقضية الإمامة والمقاييس التي اعتمدت في تحكيم هذا المفهوم وتطبيقه في الحياة كانت السبب الأكبر لكل ما ابتليت به الأمة بعدُ من مظاهر الانحراف والابتعاد عن قيم الإسلام وينابيعه الصافية. فالذي يملك زمام الحكم يملك إلى حد بعيد القدرة على تطويع كل شي، تطويع العقول والقلوب، وصياغة الأفكار، والعقائد، والقيم.
ولا نريد أن نستبق النتائج ونصدم القارئ الكريم بهذه الطريقة المباشرة في البحث، بل أردنا الإشارة إلى حقيقة اجتماعية يمكن رصدها بتتبع تاريخ العقائد والأفكار وملاحظة تطورها والتحولات التي طرأت عليها. فهذه العقائد لم يحمل أمانتها ملائكة مجردون إلا من الإخلاص، بل تحمل مسؤولية أخذها والعمل بها بشر عاديون لهم حاجاتهم وأهواؤهم وطموحاتهم، وقد أضاف هؤلاء من أفكارهم وظروف عصرهم ومقتضيات بيئتهم ما حوّل الرسالة - على المدى البعيد - إلى شيء مختلف، قليلاً او كثيراً، عن الأصل او الصورة الحقيقية لهذه الرسالة.
والرسالة الإسلامية ليست بدعاً من الرسالات ولا استثناءً منها في هذا السياق، وإذا كان هناك من فارق بينها وبين غيرها فهو في الخصوصية التي أشرنا إليها، وكذا في خصوصية المجتمع الذي تحمل بدءاً مسؤولية هذه الرسالة وحملها إلى الآخرين.
حملة الرسالة
أنزل الله تعالى كتابه على نبيه وأمره بتبليغه الناس ودعوتهم إلى الإسلام، ولم يكن الناس المخاطبون يومئذ إلا عرباً يعيشون ما عاشه العرب مذ عرفوا الاجتماع من قيم وأخلاق وسنن وأنماط في التعامل والنظر إلى قضايا المجتمع وشؤون إدارته.
كما لم يكن المخاطبون أول الأمر سوى أهل مكة والمحيطين بالحرم، والمكونين من بطون قريش الاثني عشر وهؤلاء هم عمار بيت الله والمجاورون لحرمه، وهذه ميزة نالوا بها احترام الناس من حولهم والسيادة عليهم كما اكتسبوا بها احتياج الناس لهم وقصدهم إياهم، فمكة لم تكن يوم ذاك مجرد مكان يحتضن الكعبة ويقصده العربي للحج والطواف وحسب، بل كانت سوقاً اقتصادية يؤمّها ذوو الحاجات والتجار في مواسم الحج وغيرها، كما كانت سوقاً ثقافية ومكاناً تحل فيه قبائل العرب مشاكلها وتسوي خلافاتها.
وقد هيأ هذان العاملان، وهما: عمق تأثير التقاليد القبلية التي تذهب إلى تبني الحكم الوراثي، وترى الحكم والإدارة شأنها شأن المال وغيره، يورث للأبناء وذوي القربى. ونظرة القداسة والاحترام التي حظي بها أهل مكة من جانب العرب الآخرين، هيئا لقبيلة قريش دوراً متعاظماً في تاريخ الرسالة الإسلامية منذ بزوغ فجرها ومنحاها امتيازاً خاصاً في تشكيل الإطار السياسي لهذه الرسالة ومن ثم تحديد مسارها.
ويمكن ملاحظة هذا الدور وانعكاسه بوضوح في أدبيات النظرية السياسية وحيثيات الفكر السياسي لتلك الفترة، فقد تحولت (القرشية) من خلال هذا الفكر إلى امتياز يعطي لصاحبه حقاً إضافياً يميزه عن الآخرين ويتفوق به عليهم. وهذا الحق هو أهلية القرشي دون سواه من المسلمين للخلافة وتسنم منصب الإمامة.
والحقيقة ان اصطلاح (الأهلية) قد لا يكون معبراً بدقة عن حقيقة الدوافع في طرح مفهوم القرشية وإبرازه كمفردة ذات قيمة موضوعية محددة في قاموس الفكر السياسي بقدر ما يعبر عن الاتجاه التبريري في منهج هذا الفكر وسعيه لإضفاء الشرعية على واقع يراه مقدساً ويرى مواقف رجاله وأفعالهم حجة على أبناء الرسالة جيلاً بعد جيل.
ولم يكتف هذا الفكر بتوفير الغطاء الشرعي لتقرير أهلية القرشي وحده لمنصب الخلافة، ولم يقف عند طرح الأحاديث والمناسبات التي تبين هذه الأهلية وتفرض على الأمة القبول بها. بل تخطى ذلك إلى الإمعان في إبراز مفهوم القرشية والتأكيد عليه بحيث كاد هذا المفهوم أن يتحول إلى معادل لمفهوم الإيمان من بعض النواحي. ونستطيع أن نفهم ملامح هذا الاتجاه من خلال بعض الأحاديث التي تعطي امتيازاً دينياً خاصاً للقرشي. ولعل أوضح مصداق على هذه الحقيقة ما اشتهر على الألسن من أحاديث التبشير بالجنة. فقد تحدثت هذه الروايات عن أنّ
رسول الله (ص) بشّر مجموعة من أصحابه (وعددهم عشرة) بدخول الجنة. وهؤلاء الصحابة المبشرون جميعهم من قريش وليس فيهم أحد من الأنصار أو من المهاجرين من غير قريش. وهو أمر لافت للنظر، فبعض المبشرين بالجنة ليسوا أفضل حالاً من عدد من المهاجرين من غير قريش، كما أنهم ليسوا أفضل حالاً من عدد كثير من الأنصار ممن آووا ونصروا وكان لهم تقدم على هذا البعض في السابقة والجهاد ونفاذ البصيرة وحسن الرأي.
ومع أن هذا الأمر لا يتنافى عقلاً مع أصل فكرة التبشير لهؤلاء العشرة بالجنة، إلا أن كون هؤلاء المبشرين جميعاً من قريش يعد من (المصادفات) التي لا يجود واقع الحياة بها كثيراً والتي لا يمكن المرور عليها دون الوقوف على خلفياتها وما تستبطنه من دلالات وإشارات، خصوصاً إذا عرفنا أن نصف هؤلاء المبشرين كانوا أبطالاً لأخطر الأحداث وأكثرها عنفاً في تاريخ الإسلام بل أشدها تأثيراً في مساره وتداعيات فصوله، الأمر الذي يجعل وضعهم جميعاً في مستوى واحد من الإيمان بالرسالة والوفاء لمبادئها هو من قبيل الجمع بين الشيء ونقيضه، ويصور الويلات التي حلت بساحة الإسلام والكوارث التي جرّها بعض هؤلاء المبشرين على الأمة وكأنها مزحة لا يترتب على القيام بها أي مسؤولية أمام الله، وَلِمَ المسؤولية مادام أعداء اليوم إخواناً على سرر متقابلين غداً؟!!
وتأسيساً على ما تقدم يمكننا الزعم ان فكرة عصمة الصحابة (من الناحية العملية) والحكم ببراءتهم جميعاً، وعدم جواز اتهام اي منهم او تحميله مسؤولية ما وقع من الأخطاء والتجاوزات على الرسالة وقيمها هو في الحقيقة تعبير مُمّوه عن هذا المفهوم (حصانة القرشي). فالصحابة الذين أحيطوا بهذا السياج المحكم من القداسة والاحترام لم يكونوا (في الغالب) ألا أولئك الذين يمكن أن يرد عليهم نقد أو اتهام بسبب دورهم في الأحداث التي أشرنا إليها، وفي غيرها مما يتصل بشؤون الحكم وأموره. ولم يكن هؤلاء الصحابة ذوو الحصانة سوى رجال من قريش كانوا يمارسون (حقهم) في ميراث رسول الله ويطالبون بنصيبهم من سلطانه!
إنّ هذا التباين بين صورة الصحابي القرشي المصون وبين الأحداث والتجاوزات التي ارتكبت في سلطان هؤلاء أو في سعيهم للوصول إلى السلطان من ظلم وتجاوز لتعاليم الرسالة وقيمها، وسفك للدماء أظهر الحاجة لافتراض عناصر ومؤثرات ومخارج تنأى بهذه الصورة عن الظنة والاتهام وتبقيها عند مستوى العصمة العملية. وقد تهيأت هذه المخارج في عنصرين:
الأول: عنصر التأويل. فالصحابة الذين تصدوا لخوض تلك الأحداث وما يتصل بها من ممارسات وتصرفات كانوا متأولين مجتهدين، وهم مأجورون على اجتهادهم سواء كانوا مصيبين فيما شجر بينهم أم مخطئين.
الثاني: العنصر الخارجي. فما وقع بين الصحابة لم يكن نتيجة لانحراف عن الإسلام أو استهتار بقيمه وتعاليمه، وإنما كان نتيجة لدسيسة عناصر من خارج مجتمع الصحابة وتحريض هذه العناصر وإيقاعها بين الصحابة. ويرد في هذا السياق اسم عبد الله بن سبأ كعنصر خارجي لابد من وجوده لتحميله مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت بين المسلمين.
ولا باس ان نشير هنا إلى ما قاله ابن خلدون في هذا الصدد وهو يلقي ضوءاً فاحصاً على هذين العنصرين ويدفع عن قريش ومن تابعها مسؤولية إيقاد الفتنة وما نجم عنها. قال عن العنصر الأول: (والأمر الثالث شان الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين فاعلم أن اختلافهم إنما يقع في الأمور الدينية وينشا عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة، والمجتهدون اذا اختلفوا، فإن قلنا إنّ الحق في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين، ومن لم يصادفه فهو مخطئ، فإن جهته لا تتعين بإجماع، فيبقى الكل على احتمال الإصابة ولا يتعين المخطئ منهما والتأثيم مدفوع عن الكل إجماعاً. وإن قلنا إنّ الكل حق وإنّ كل مجتهد مصيب فأحرى بنفي الخطأ والتأثيم. وغاية الخلاف الذي بين الصحابة والتابعين أنّه خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حكمه)[1]. وقال عن العنصر الثاني:
... مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن وتميم وقيس من مضر، فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم والتمريض في طاعتهم والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية والعدل في القسم عن السوية وفشت المقالة بذلك وانتهت إلى المدينة وهم من علمت، فأعظموه وأبلغوه عثمان فبعث الى الأمصار من يكشف له الخبر[2].
وواضح أنّ ابن خلدون هنا يلقي مسؤولية الفتنة على القبائل التي تنفس على قريش سلطانها وتدعو إلى الانتقاص من هذا السلطان، وهو يجري في هذا التفسير وفقا لنظريته في العصبية كما ستأتي الإشارة أليه.
وأما الذين أوردوا اسم عبد الله بن سبأ سبباً لما وقع من الأحداث بدءاً من التململ على عثمان والإنكار عليه وانتهاء بمقتله وما أعقبه من أحداث، فأنهم حققوا بهذا الافتراض غاية مزدوجة، فهم من ناحية أبعدوا المسؤولية عن قريش، بل عن مضر كلها حين افترضوا لهذا الرجل أصلاً من اليمن ومنحوه اسماً يوحي بهذا الأصل. ومن ناحية أخرى طبعوا الاتجاه المعارض
لــ (أصحاب الحق) في السلطان بطابع المؤامرة والكيد، وهي الصفة التي حرص كثير من المؤرخين على إشاعتها من خلال اتهام المنقضّين على حكومة عثمان بالسبئية، والذين كانوا يمثلون جزءاً رئيسياً من جيش عليّ، وهذا يعني تمهيد الأرضية لاتهام حملة الراية العلوية مستقبلاً بانتمائهم إلى جذور السبئية المتآمرة على الإسلام!
الإسلام والواقع القبلي
هدف الرسالة الإسلامية – ككل الرسالات السماوية – هو تربية الإنسان ووضعه على طريق الهداية والتكامل، وقد سعى الإسلام لتحقيق هذا الهدف من خلال تغيير الواقع الاجتماعي المنحرف وإزالة القيم والمواضعات الأخلاقية وهدم كل المؤسسات والبنى التي يستند اليها ذلك الواقع، ومن ثم إحلال قيم وأسس جديدة لبناء واقع إنساني جديد في علاقاته ونظرته للحياة.
جاء الإسلام والمجتمع العربي مقسم إلى مجموعة قبائل لا يضمها نظام سياسي قوي ولا يجمعها سلطان موحد. وتمثل مجتمعات يثرب ومكة والطائف وحدها – ربما – استثناء في درجة التنظيم الاجتماعي وشكل الإدارة النافذة فيها. فالأول مجتمع زراعي نال درجة من الاستقرار من خلال الارتباط بالأرض، وحقق نزوعاً متقدماً – نسبياً – لإنشاء نوع من الحكم السياسي الموحد، فرغم الصراعات العنيفة والدامية بين الأوس والخزرج كان هناك اتجاه لتتويج شخص يكون ملكاً على يثرب كلها قبل ظهور الإسلام وهجرة النبي إليها، وتذكر كتب التاريخ أنّ عبد الله بن أُبَيّ كان أحد المرشحين لتولي هذا المنصب.
والمجتمع المكي حظي أيضاً بمثل هذا التنظيم، فاستقرار هذا المجتمع في حمى بيت الله وانشغال أبنائه في مهنة التجارة التي تتطلب درجة عالية من الذكاء الاجتماعي وخبرة خاصة في العلاقات العامة حفزه على إيجاد نوع من التنظيم الإداري المتوازن بين فروع قريش وبطونها الاثني عشر، وقد كانت دار الندوة هي التعبير المؤسساتي لهذا التنظيم، حيث كانت مكاناً تناقش فيه الأمور التي تهم مجتمع قريش وتتخذ فيه القرارات اللازمة.
كما لم يكن مجتمع الطائف بطبيعته الزراعية – التجارية بعيداً عن هذا الشكل الإداري المتطور قياساً بما كانت عليه غالبية الجزيرة العربية.
غير ان هذه المظاهر الإدارية المتقدمة نوعاً لم تستطع أن تؤثر – على الإطلاق – على الروح القبلية لهذه المجتمعات، بل لم تكن هذه المظاهر سوى إجراءات اقتضتها طبيعة الاستقرار الجغرافي والعلاقة بالأرض. وأما القيم والعادات السائدة فيها فلم تتغير قط، وبقي الطابع القبلي هو الحاكم في هذه المجتمعات، فلا تجد فرقاً بينها – في هذا الأمر – وبين العرب الرحل الذين كانوا يمتهنون الرعي والحرب وسيلتين لكسب الرزق.
ان أبرز ما كان يفرضه الانتماء القبلي على الناس يومذاك هو قوة الشعور بهذا الانتماء وتقديم رابطة الدم التي تربط بين أفراد القبيلة كلهم على ما سواها من الروابط والعلاقات.
وهذا الشعور أملته ظروف الحياة القاسية واستدعته الحاجة إلى التكتل في مواجهة الإخطار التي كانت تهدد حياة الناس. وقد كان الاحتماء بهذا النوع من الرابطة الحسية تعبيراً عن حالة غريزية يلجأ إليها الناس عادة في أطوار حياتهم البدائية وقبل ان ينجحوا في إيجاد علاقة بينهم تقوم على أسس قيمية وأخلاقية.
هذه العلاقة بلغت من القوة والرسوخ لدى عرب الجاهلية بحيث تحولت القبيلة بمصالحها مقياساً للحق والباطل، فليس للحق مفهوم مجرد، بل الحق هو ما حقق فائدة للقبيلة وكان فيه نفع لأبنائها. ومن هنا كانت فكرة وقوف أبناء القبيلة إلى جانب بعضهم في الشدائد والمحن وفي مواجهة الآخرين، بقطع النظر – في أكثر الأحيان – عما إذا كان المُنتَصَر له مُحقّاً في موقفه أم غير محق ظالماً كان أم مظلوماً.
الإسلام سعى إلى استثمار هذه الحالة استثماراً إيجابياً تصب عوائده في صالح الرسالة ويدفع عنها الأخطار التي كانت تهدد وجودها. فاللحمة القبلية والتماسك بين أفراد القبيلة والذي تحول لدى عرب الجاهلية إلى قيمة أخلاقية تستحق التضحية وتحمل الشدائد كان هدفاً للتوظيف من جانب الرسالة.
فبنو هاشم الذين ينتسب رسول الله (ص) إليهم والذين يمثلون فرعاً لأقوى بطون قريش، بطن بني عبد مناف لهم من القوة والمنعة، والمكانة المعنوية ما يجعلهم ظهيراً قوياً لرسول الله في مواجهة قريش بصرف النظر عن إيمان هؤلاء برسالة النبي او عدم إيمانهم بها، فالعرف القبلي وحس القرابة ورابطة الدم كلها تفرض عليهم مثل هذا الوقوف وتحمل نتائجه. لهذا أمر الله تعالى نبيه بالانفتاح على عشيرته الأقربين أولاً ودعوتهم إلى الإسلام، ليكونوا له ظهيراً وسنداً في توسيع قاعدة الدعوة ومخاطبة الآخرين بها.
يحدثنا التاريخ أن رسول الله دعا بعد نزول قوله تعالى {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}[3] قومه إلى وليمة وأمر عليّاً بتهيئة طعام يكفي أربعين رجلاً كلهم من بني عبد المطلب. وفي هذه الوليمة خاطبهم رسول الله ودعاهم إلى الإسلام ونبذ عبادة الأوثان، كما دعاهم الى المؤازرة والنصرة وتحمل عبء الدعوة وما يكتنف طريقها من الصعاب. ومع أن أحداً منهم – باستثناء عليّ – لم يُجِبْهُ بشكل صريح ومباشر إلى ما دعاهم له، فإن أحداً منهم أيضاً – باستثناء أبي لهب – لم يقف من هذه الدعوة موقف العناد والعداء، وقد كان لهذا الموقف أثره البالغ على مستقبل الرسالة وحرية رسول الله في الحركة والدعوة إلى الله، فقد أُحيط النبي منذ ذلك الإعلان بالرعاية والحماية من قبل عشيرته وأهله الأدنين، مع أن عدداً من هؤلاء لم يكونوا قد آمنوا بالإسلام بعد. وقد سجل التاريخ مواقف كثيرة لبني هاشم في هذا الصدد نذكر منها موقفين اثنين:
الأول: بعد أن يئست قريش من التأثير على أبي طالب ليمنع رسول الله من الاستمرار في سب آلهتها والمضي قدماً في دعوته، قررت فرض المقاطعة بكل أشكالها على بني هاشم، وقد اختار هؤلاء جميعاً مؤمنهم وكافرهم – حاشا أبي لهب فانه كان مع قريش على قومه –[4] الذهاب إلى الشِعب وتحمل أعباء المقاطعة يقدمهم شيخهم أبو طالب، معبرين في هذا الموقف عن تضامنهم مع رسول الله وقرارهم في الوقوف إلى جانبه.
الثاني: حين آمن عدد من أهل يثرب من الأوس والخزرج بالإسلام وبايعوا رسول الله في العقبة على ان يمنعوه ان هو قدم إليهم مما يمنعون أنفسهم وأهليهم وأموالهم كان المتحدث عن رسول الله (ص) في هذا الموقف الخطير هو عمه العباس بن عبد المطلب الذي لم يكن أعلن إسلامه في ذلك الوقت. وقد اخذ هو نفسه على المبايعين العهود والمواثيق على الوفاء ببيعتهم وما ألزموا به أنفسهم.
إن هذين الموقفين وأمثالهما كثير من قبل عصبة النبي وأهله الأقربين تبين بوضوح قوة رابطة القرابة وعمق تأثيرها في ذلك المجتمع بحيث طغت على رابطة الدين السائد يومذاك، كما تبين من جهة أخرى إفادة الإسلام من هذا الظرف واستثماره لخدمة الرسالة وقيمها، من دون ان يعني ذلك إقراراً بواقع يتنافى مع هذه القيم او مساومة على حساب المبادئ. فالإيمان بالله قبل القرابة والعشيرة وهو يلغيهما ان تعارضتا معه. ولا يسعنا هنا ذكر ما جاء به القران الكريم او صدر عن الرسول الأمين في التأكيد على قيم الإيمان والإخوة المستندة إليه في نسيج مجتمع الرسالة، وكذا التحذير من الوقوع في حبائل الجاهلية وكبرها المقيت.
ولكننا نشير فقط إلى ان مفهوم الأهل والقرابة والعشيرة صار ينظر إليه في المجتمع الجديد باعتباره نوعاً من صلة الرحم التي دعا إليها الإسلام وأكد عليها بإلحاح والتي تعني التعبير الايجابي عن حالة عاطفية غريزية من غير تجاوز على حقوق الآخرين او بخس لأشيائهم.
هذه هي نظرة الإسلام للحالة القبلية وطريقته في التعامل معها، فكيف اتجه التعامل بعد رحيل رسول الله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ هل اكتسح مفهوم الإيمان والعمل الصالح مفاهيم العشيرة وأولي القربى حين يفرض عليهما ان يكونا في مواجهة بعضهما؟ ام ان مفاهيم الإيمان والسابقة والجهاد تراجعت أمام قيم تجذرت في أعماق مجتمع الرسالة فكانت الغلبة في النتيجة لقيم الجاهلية على قيم الإسلام؟!
مهاجرون فقط ام قرشيون مهاجرون؟
لنعد إلى يوم رحل فيه رسول الله (ص) إلى يوم السقيفة حيث اجتمع الأنصار أوسيهم وخزرجيهم، وثلاثة من المهاجرين من قريش هم ابو بكر وعمر وابو عبيدة يبحثون في أمر الأمة بعد رحيل نبيّها ويقررون مصير خلافته (ص). وإنها – والله – للحظات تخشع لخطرها القلوب ويصمت لهولها التاريخ. ففي هذا المكان المنعزل المتواضع، في سقيفة بني ساعدة سيتقرر مصير الأمة – بل البشرية كلها- وما سيتعاقب عليها من الأحداث والوقائع في توالي الأيام والعصور، وسيتحدد في ضوء ما يتقرر نصيب الرسالة من النجاح وحظ قيمها من التحقق، فلنَرَ كيف سيدلي المجتمعون بحججهم وهم يقررون ما يرونه في شأن الخلافة وما هي المقاييس التي سيتبعونها في قرارهم الخطير هذا.
يذكر المؤرخون أن الأنصار اجتمعوا بعيد الإعلان عن وفاة رسول الله (ص) في سقيفة بني ساعدة ليقرروا بأنفسهم مصير خلافة الرسول، ويضعوا بقرارهم هذا الآخرين أمام الأمر الواقع. ويذكر هؤلاء أيضاً أن المجتمعين قرروا مبايعة سعد بن عبادة بالخلافة، غير أنّ عمر وأبا بكر وأبا عبيدة علموا بأمر الاجتماع، فسارعوا في الحضور إلى السقيفة للمشاركة ولمنع الأنصار من الانفراد بالأمر. وفي السقيفة كان سعد بن عبادة يتحدث عن مناقب الأنصار وتقدمهم في السابقة والنصرة والجهاد ليعرّج بعدها على أهلية الأنصار واستحقاقهم الخلافة دون غيرهم. فيرد عليه أبو بكر قائلاً:
فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهلٌ وإنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وهم أوسط العرب داراً ونسباً!
وفي رواية أخرى أنه قال: فهم (أي المهاجرون من قريش) أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول هم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم.
ثم قام الحباب بن المنذر ليؤكد حق الأنصار في الخلافة فإن أبى المهاجرون ذلك فلا أقلّ من اقتسامها بينهما مناصفة او كما قال: منا أمير ومنكم أمير، فرد عليه عمر بقوله:
هيهات لا يجتمع اثنان في قرن... من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدلٍ بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هَلَكَة.
ثم قام بشير بن سعد الأنصاري وقال: ألا إنّ محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى. وأَيمُ الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم![5]
بعدها حسم القرشيون الثلاثة الأمر لصالح قريش، وبايع الناس أبا بكر.
ولنتمعن الآن في هذه الكلمات:
أبو بكر: وهم (أي المهاجرون) أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده.
عمر: من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته.
بشير بن سعد الأنصاري: ألا إن محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى.
ما الذي نستنتجه من هذه العبارات؟
ما نستنتجه هو أن الناس ليسوا سواء في نسبتهم إلى رسول الله، فهناك من هو أحق برسول الله وتراثه وأقرب إليه من الآخرين، بحيث يصح أن يقال في مقام الاحتجاج: (نحن) و (أنتم) ولكن بأي مقياس؟ هل هو مقياس السابقة في الإيمان والتقدم في الجهاد؟ مقياس التقوى والعمل الصالح والارتقاء إلى مستوى الرسالة وقيمها؟ لا. فإن هذا كله من الفضل وهو مما يُحمدُ عليه المرء وينال به الاحترام، ولكن لا علاقة لهذا بشؤون الحكم والسلطان. أو على الأقل هو لا يكفي وحده للاقتراب من سدة الحكم وحيازة السلطان. المعيار في هذا الأمر هو أن يكون المتصدي للحكم منتسباً للمتوفى بصلة القربى والانتماء للعشيرة كما تنص عليه التقاليد العربية التي كانت تجعل الحكم حقاً صرفاً يرثه أهل الحاكم المتوفى وذوو قرباه. وهذا مبدأ عام وشائع في جميع أنظمة الحكم وأشكاله، ليس لدى العرب وحدهم، بل لدى غيرهم من الأمم كذلك، بقطع النظر عن درجة التطور الاجتماعي أو رقي التنظيم السياسي لهذه الأمم. ومازال هذا النوع من الحكم شائعاً في أماكن عديدة من العالم.
والسؤال أو الأسئلة التي نثيرها هنا ونترك الإجابة عنها للقارئ الكريم هي: ألا يُعَدُّ الالتزام بتقليد جاهلي في مثل هذه القضية الخطيرة نكوصاً عن المبادئ التي أقرّتها الرسالة الإسلامية وتراجعاً عن قيم المجتمع الإيماني التي سعى القران الكريم والرسول الأمين لإشاعتها وتحكيمها في أفراد هذا المجتمع؟ ألا يُعَدُّ التعبير ب (نحن) و (أنتم) تجاوزاً لأهم انجازات الرسالة التي جمعت أولئك الناس الممزقين على صعيد الأخوة الإنسانية المستندة إلى أسس الإيمان بالله والعبودية له مصداقاً لقوله تعالى {إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}[6]؟
وهل يُعَدُّ من مقتضيات مبدأ الشورى عزل أحد شِقَّي الأمة يومذاك – الأنصار وهم من هم! – عن ممارسة الحكم بحجة عدم انتسابهم لعشيرة النبي وذوي قرباه؟
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأنصار كانوا هم بدورهم واقعين تحت تأثير فكرة الأهل والعشيرة هذه، فكانوا – أو عدد منهم على الأقل – يحسّون في قرارة أنفسهم أن المهاجرين – أهل النبي وعشيرته – أحقّ منهم بالخلافة و(وراثة) النبي. يدل على هذا سرعة تراجعهم عن موقفهم الأول والداعي إلى مبايعة سعد بن عبادة واقتراحهم أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير. كما يدل عليه بوضوح أكثر كلام بشير بن سعد الآنف الذكر والذي يتضمن (اعترافاً) بأحقية قريش في سلطان محمد وإمارته! دون ان نغفل –بطبيعة الحال- أثر الأحقاد الدفينة بين الأوس والخزرج في إضعاف موقف الأنصار وترجيح كفة قريش في هذا النزاع.
نُحّي الأنصار وأُبعدوا عن الحكم منذ تلك اللحظة التي صفق فيها عمر يد أبي بكر مبايعاً إياه بالخلافة. وكُتِبَ عليهم من حينها أن يكونوا وزراء ويكون القرشيون هم الأمراء كما شاء أبو بكر. والوزير في عرف ذلك الزمان يُستشار ويُستَنصَح فحسب وليس له من ممارسة السلطة شيء.
استمرت قريش تمارس (حقها) في سلطان رسول الله قرشياً عن قرشي حتى آل الأمر إلى رجال من قريش لم تكن لهم سابقة أبي بكر وعمر ولا غيرهما من المسلمين الأوائل. بل لم يكن لهم ما يشرّفهم في الموقف من الرسالة منذ صدع رسول الله بها، ولم يكن لهم ما يميزهم عن غيرهم من المؤمنين، بل إن بعض من ولِي أمور المسلمين من قريش كان ممن جيّش الجيوش وكاد الرسالة وأهلها، وكان رمزاً للكفر ومحادّة الله ونبيه، ولم يكن هذا بالأمر المستغرب أو الحادث المؤسف غير المنتظر، بل كان نتيجة منطقية لتحكيم مبدأ ((والعرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش))[7] فهذا المبدأ يستتبع – ورغماً عن كل المبادئ الأخلاقية وروح المساواة التي جاء بها الإسلام – أن يكون ذوو الشرف في الجاهلية ذوي الشرف في الإسلام أيضا، فكأن القرشية – على هذا المبدأ – تجبّ ما قبل الإسلام وتمحو ما يَصِمُ التاريخ الشخصي لهؤلاء (الأشراف) في قبال الرسالة.
مات ابو بكر وأوصى لقرشي من بعده هو عمر. ثم مات عمر وأوصى بالأمر من بعده لستة قرشيين فرض عليهم أنْ يختاروا واحداً منهم. فإن انقسموا وتعادلت الكفتان رُجّحت الكفة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. وهكذا كان واختير عثمان. فلنستمع إلى عليّ وهو يشخص بدقة نزعة الاستئثار بتراث محمد (ص) السياسي لدى قريش بعد اختيار عثمان (إنّ الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها وتقول: إنْ وُلِيَ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم)[8] وتداولوها بينهم حتى آل أمرها الى صبيان قريش وسفهائها!
وانظر كيف تتقارب الرؤى وتتداخل الخنادق في ضوء (والعرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) و (من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته).
روى الطبري بإسناده عن ثابت قال: لما استخلف أبو بكر قال أبو سفيان: مالنا ولأبي فصيل[9] إنما هي بنو عبد مناف!
قال: فقيل له إنّه قد وَلّى ابنك. قال: وصلته رحم![10]
فلئن كان الأمر أمر {نحن أولياؤه وعشيرته} فبنو عبد مناف _ لَعَمرُ الله _ أمسُّ رَحِماً وأوصل قرابةً برسول الله من بني تيم، تيم التي لم يكن شيخها غافلاً عن هذا الحق فأسند عملاً لأحد أبناء أبي سفيان عميد البيت الأموي المتفرع من عبد مناف.
ثم انظر كيف يصل هذا الفهم إلى مداه ويؤول تصور الحق في السلطان إلى غايته، فيتحول الأمر على لسان المبشَّرين بالجنة إلى تيمية وعدوية ومنافية.
روى البلاذري بإسناده عن عبد الله بن عباس أن عثمان شكا عليّاً إلى العباس فقال له: يا خال إنّ علياً قطع رحمي وألّب الناس ابنك. والله لئن كنتم يا بني عبد المطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعَدِي، فبنو عبد مناف أحق ألا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم
عليه.[11]
فاعتراض عليّ وابن عباس على سياسة عثمان – في نظر عثمان وذوي قرباه – كان حسداً هاشمياً ليس غير! وكان أولى بهذا الحسد ان يوجّه الى تيم وعَدِي حين استلم ممثلاهما
أبو بكر وعمر مقاليد الأمور وهما الفرعان البعيدان عن بني هاشم، لا أن يوجه إلى أبناء عمومتهم من بني أمية الذين هم أقرب إليهم من تيم وعدي ويلتقون معهم عند جدهم الأعلى عبد مناف!!!
ومع ما بين أبي بكر وعمر من جهة وبين عثمان وذوي قرباه ومن انتصر لدمه من جهة أخرى من التفاوت في السياسة والسلوك الشخصي، إذ لم يعرف عن الشيخين استئثار بمال ولا إيثار لآل، بل ماتا دون أن يخلفا وراءهما من المال أكثر مما يخلفه غيرهما من أواسط الصحابة، بل حتى ضعافهم. فلقد كانت الأموال تُجبَى لعمر وكنوز الفتوح تصل المدينة أرسالاً فتبهر الألباب وتأسر القلوب، فلم يستأثر لنفسه ولا لخاصة أهله منها بشيء، بل كان حديداً عليهم شديداً في معاملته إياهم شدة تجاوزت الحد في كثير من الأحيان نقول: ومع هذا التفاوت بين الجهتين إلا أنّ المبدأ الذي اعتمده ابو بكر وعمر في التعامل مع قضية الحكم وتصورهما عما ينبغي أن يكون عليه رجاله والقائمون عليه لم يكن ليفضي إلى غير هذه النتيجة أو يؤدي إلى غير ما حصل وأخبرنا به التاريخ.
فوفقاً لمبدأ (من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته) يصعب التوفيق والموازنة بين ملاكات السابقة في الإيمان والجهاد والعمل الصالح وبين المؤهل الأساسي في السلطان وهو انتماء المرشح للولاية او الإمارة لقريش عشيرة النبي وأهله، فإن اعتماد مبدأ سار عليه الناس قبل ظهور الإسلام أزماناً متمادية يعني إقراراً رسمياً لهذا المبدأ واستمراراً على العمل به وأن التغيير الذي حصل بمجيء الإسلام لن يؤدي - بعد وفاة رسول الله- إلى أن يخسر ذوو الشرف والمكانة مواقعهم السابقة، ولن يُفسِح المجال –كما ينبغي- للجيل الجديد الذي بنته الرسالة وتشبّع بمبادئها. فأياً كان حرص أبي بكر وعمر على تطبيق مبادئ الإسلام وتحكيم قيمه فإنه لن يسمح –في كل حال- في ان يتولى أمور المسلمين عبد حبشي ذو زبيبة[12] أو حتى حر غير قرشي وإن فاق غيره في السابقة والجهاد. ولن يمنع أن يلي أمور المســلمين من لاحظَّ له في سابقة إيمان أو بلاء في جهاد. وإنّ حرص الرجلين - بالغاً ما بلغ- لن يتعدى أثره حياتيهما ماداما قد أضفيا الشرعية على تقليد جاهلي عريق، فأتاحا بذلك لقريش أن تستعيد مرة أخرى ثقتها بنفسها، وأن تعيش من جديد مشاعر الاستعلاء والفخر والكبر.
روى الطبري بإسناده عن الحسن البصري قال:
كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجر في البلدان إلّا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقام فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سنَّ البعير... ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده، ألا فأمّا وابن الخطاب حيّ فلا. إني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحُجَزِها أن يتهافتوا في النار.[13]
ولكن ما إن أُرسِلت حلاقيم قريش وحُجَزُها بعد وفاته حتى انطلقت في البلاد – بعد أن مهد عمر نفسه ومن قبله أبو بكر لها الطريق- تخذم مالَ الله خذم الإبل نبتة الربيع[14]وتستأثر لنفسها بالنفوذ والسلطان، حتى تحول الحكم على يد أكثر فروعها دهاء واستهانة بالقيم الى ملكية صريحة يرث فيها الابن أباه والرجل ابن عمه القريب. لقد ضاقت قريش – ممثلة بالفرع الأموي – بالقيود الأخلاقية التي استدعاها قرب العهد بالوحي وصاحب الرسالة و(الميوعة) السياسية التي أظهرها عمر في إيلائه العهد لستة قرشيين موزعين على بطون: بني عبد مناف، بني زهرة، بني أسد بن عبد العزى، بني تيم. كما ضاقت ذرعاً من قبل بتسلط بني تيم وبني عدي[15] واغتصابهم سلطان بني عبد مناف. فأعادت الأمر إلى (نصابه القديم) ملكية لا غبار عليها يستوفي فيها بنو عبد مناف حقهم كاملاً لا يشركهم فيه أحد. ولكن ماذا عن بني هاشم أبناء عمومتهم الألداء وشركائهم في عبد مناف؟
هؤلاء تكفيهم النبوة، وهل من العدل أن يجمعوا بين النبوة والخلافة وتبقى قريش خاضعة لهم إلى الأبد؟!
وللإنصاف نقول: إن هذا (أو بعضه) لم يكن رأي بني أمية وحدهم، بل كان رأي قريش كلها كما عبر عنه بوضوح كامل كلام عليّ السابق بعد اختيار عثمان خليفة على المسلمين. وكما صرح به عمر نفسه في لحظة من لحظات المكاشفة في حديث له مع عبد الله بن عباس عن سبب إقصاء عليّ عن الخلافة مع استحقاقه لها بقوله: (لقد كرهت قريش لكم ان تجمعوا بين النبوة والخلافة).[16]
ان المتتبع بتجرد للنظرة إلى الحكم لدى القائمين عليه منذ وفاة رسول الله، وتطور هذه النظرة من الشورى إلى الملكية لا يجد فرقاً كبيراً – من حيث الأصول والمنطلقات – بين ما صار يعرف في التاريخ بالخلافة الراشدة من جهة وبين الكسروية التي يرث فيها الابن أباه او الأخ أخاه من جهة أخرى.[17] فلقد بدأ الأصل في السقيفة قبلياً موسعاً يشمل
- من حيث المبدأ – كل بطون قريش وفروعها ويستبعد من سواهم من المؤمنين، وانتهى قبلياً ضيّقاً – على أيدي الأمويين – لا يشمل غير بني أمية أحد فروع بني عبد مناف من قريش.
وبهذا نعرف أن استخدام اصطلاح (المهاجرين والأنصار) لدى الحديث عن السقيفة وما وقع فيها من تجاذب في المواقف وتنافر في الرؤى هو استخدام مضَلّل إلى حد بعيد، ولا يعبر عن طبيعة المنطق الذي قاد المواجهة بين الطرفين. فإن النزاع بين الفريقين لم يحسم بالتأكيد على أنّ الأَولى بالخلافة هو من تحمل عبء الهجرة وآلامها دون من آوى ونصر، وإنما تركز على منطق: هل ان عشيرة النبي وأهله أولى بخلافته من غيرهم أو أن غيرهم أولى بها منهم؟ وقد كان المنطق القبلي هذا من القوة والنفوذ بحيث تمكن ثلاثة من القرشيين وأحد مواليهم فقط من فرض رأيهم على الحاضرين في السقيفة التي كانت تغص يومذاك بوجوه الأنصار وسادتهم من الأوس والخزرج.
وبناءً على ما تقدم يمكننا القول: إن الكسروية في التاريخ الإسلامي ألقى بذرتها أبو بكر وعمر في السقيفة – دون أن يريدا ذلك أو يخطر لهما ببال – وأفرعت شجرتها بدم عثمان وانحيازه لبني أمية، واستصفى ثمارها بنو صخر بن حرب وبنو الحكم بن العاص.
القرشية والفكر التبريري
تعامل المفكرون والمؤرخون مع هذه الحالة باعتبارها شيئاً لابد من حصوله مادام الصحابة أرادوا ذلك. وما على هؤلاء المفكرين وذوي الرأي سوى تفسير هذه القضية وإيجاد المبررات لظهورها في التاريخ على النحو الذي يُظهر هذا التاريخ مبرّءاً من العيب ونقياً من الغلط، فيأخذ هذا التفسير مكانه في البناء الهندسي المتقن والدقيق لتاريخنا الذي حرص هؤلاء المفكرون والمؤرخون على عرضه للأجيال عقلانياً وجميلاً، حكيماً وأخلاقياً. فالقرشية وفقاً لهذه الرؤية ليست شيئا طارئاً على الرسالة أو انحرافاً عن مبادئها، بل هي جزء من مبادئها، جزء من الرسالة وواحدة من مفردات ثقافتها. فلنستمع إلى أقوال منظّري (القرشية) كيف ينظرون إليها؟ وما هو رأيهم في موقعها من قضية الإمامة؟
قال الماوردي في الأحكام السلطانية:
(وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيها سبعة (ثم ذكر منها ستة وقال: والسابع: النسب) وهو ان يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوّزها في جميع الناس)[18].
والغريب أن الذين تعرضوا لذكر أحداث السقيفة من المؤرخين والمحدّثين لم يذكروا أن المهاجرين احتجوا على الأنصار بوجود نص يحصر الإمامة في قريش ويدفعها عن غيرهم، بل ذكروا أن احتجاج هؤلاء انصب على أنهم أهل النبي وعشيرته، وهم – لهذا – أولى من الأنصار بوراثته والقيام بخلافته. بل إن ابن خلدون نفسه الذي قال في مقدمته (وأما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك واحتجت قريش على الأنصار بقوله (ص): الأئمة من قريش) لم يخرج في إيراده خبر السقيفة في تاريخه عما ذكره الطبري حول هذا الموضوع وليس فيه احتجاج بنص او استناد لوصية. فكأن مدوني الفكر السياسي لتلك الفترة شعروا أن واجبهم هو معالجة المشاعر الفائرة للصحابة من قريش وإعادة صبها في شكل مواد قانونية ملزمة من خلال النظر إليها كشرط لا بد منه من شروط الإمامة.
ونود في ختام البحث أن نشير إلى رأي ابن خلدون في مسالة القرشية، وهو رأي جدير بالنظر حقا، فهذا الرجل الذي تمكن من صياغة نظرية متكاملة في أصل الاجتماع وقدم حوله آراء تدل على فكر ثاقب وذهن (تأصيلي) مبتكر جعل فكرة العصبية محوراً تدور حوله مظاهر الاجتماع وأشكاله، وانتقال المجتمع من حالة البداوة الى الحضارة، ومن الخشونة إلى الترف ومن ثم التحلل. وقد جنح ابن خلدون في مقدمته الى تفسير القرشية في ضوء نظريتــه عن العصبية، مبتعداً في ذلك عن نظرة من تقدمه من المفكرين الذين أضفوا طابعاً دينياً من خلال طرحها كشرط أبدي لابد من توفره في الإمام. قال في المقدمة:
(وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزّة بالكثرة والعصبية والشرف، فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردَّهم عن الخلاف)[19].
فالقرشية – حسب هذا النص – شرط في الإمام مادامت قريش قوية بعصبيتها وشرفها، وقادرة على قمع الخارجين على الحكم ولجم المتمردين عليه. أمّا حين تنحسر قوتها وتضعف العصبية لديها فلا يعد الانتماء إليها شرطاً في الإمام كما يقول في كلام قريب من النص المنقول، فابن خلدون يتخطى هنا – كما هو بيّن – عقبة القداسة التي وضعها من تقدمه من المفكرين.
فالقرشية عنده ليست شرطاً لازماً في كل حال، أي حتى إن ضعف القرشي عن القيام بشؤون الحكم ومهامه كما يذكر ذلك الماوردي [20] نقلاً عن بعض الفقهاء، ولا في كل زمان، بل هي شرط في حال قوة قريش فقط. وبهذا تكيّف القرشية عند ابن خلدون وكذا النصوص التي دُعِمَت بها تكييفاً براغماتياً يجعل من الفائدة والمصلحة مقياساً لاشتراطها في الإمام أو عدمه. ولا ريب أن للعصر الذي عاشه ابن خلدون والذي شهد تفتتاً في الحكم وضعفاً في القائمين عليه على امتداد البلاد الإسلامية، كما شهد اندثاراً لقريش وعصبيتها، تأثيراً كبيراً في رؤيته هذه عن القرشية والنظر إليها كتراث يُفسّر في سياقه الزماني والمكاني ويُقَيّم في ضوء ملابساته التاريخية وظروفه الموضوعية.
على أن نظرة أدق إلى رأي ابن خلدون هذا في القرشية يجعلنا نرى أن براغماتيته المشار إليها لم تقف عند حد الالتزام بالقرشية أو عدم الالتزام بها بحسب الفائدة من ذلك أو عدمها، أو عند مجرد تفسير النصوص المساقة في القرشية في ضوء هذه الفائدة او عدمها[21] بل تخطت ذلك كله الى التضحية بالقيم التي جاء بها الإسلام على مذبح الحكم واستقرار أركانه، فإن اعتبار استتباب الحكم وغلبة أهله على من سواهم هدفاً بحد ذاته، وحصر هذه القدرة بقريش وعصبيتها سيؤدي إلى تبرير إبعاد المخلصين ذوي الكفاءة من غير قريش والى تسويغ ما يقع في ملك قريش من الأخطاء والانتهاكات مادام الغرض منه هو الحفاظ على هيبة الحكم ووحدة الكلمة، وهو الأمر الذي اضطر إليه ابن خلدون اضطراراً لدى حديثه عن حكم بني أمية.
***
طاهر ناصر الحمود
كاتب عراقي، وكيل وزارة الثقافة العراقية سابقا.
.........................
[1] - عبد الرحمن ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (مقدمة ابن خلدون)، (دار الفكر، بيروت، 1981)، ط1، ج1، ص 266.
[2] - المصدر نفسه، ص 268.
[3] - الشعراء، 214.
[4] - ابن خلدون، مصدر سابق، ج2، ص 414.
[5] - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)، (دار المعارف، مصر، 1967)، ط2، ج3، ص 205، و218-221.
[6] - الأنبياء، 92.
[7] - جزء من خطبة أبي بكر في السقيفة.
[8] - تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج4، ص233.
[9] - الفصيل: ولد الناقة. وهذا تعريض بكنية ابي بكر التي تؤدي كلمة (بكر) فيها نفس المعنى.
[10] - تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج3، ص209.
[11] - أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، (دار الفكر، بيروت، 1996)، ج6، ص116.
[12] - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، (دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ)، ج1، ص140. حيث اخرج البخاري في صحيحه عن عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.
[13] - تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج4، ص396.
[14] - من خطبة لعليّ يصف فيها ما فعله عثمان وذوو قرباه من التصرف ببيت مال المسلمين الذي أثار المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار.
[15] - قال أبو سفيان يوم بويع أبو بكر: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آلَ عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان عليّ والعباس؟ ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قريش. ينظر: عز الدين ابن الأثير، الكامل في التاريخ، (دار الكتاب العربي، بيروت، 1997)، ط1، ج2، ص187، حوادث سنة 11 هـ. وراجع أيضاً كلام عثمان السابق ذكره للعباس بن عبد المطلب. وينقل أبو حنيفة احمد بن داود الدينوري في كتاب الأخبار الطوال، (دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1960)، ط1، ص187، وعند تناول وقعة صفين: ان معاوية كتب إلى عليّ يقول: نحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل.
[16] - تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج4، ص223.
[17] - لا يملك المراقب المنصف سوى الإذعان إلى أن خلافة عليّ كانت استثناءً من هذا الحكم. فهو الوحيد – من بين الأربعة – الذي تحقق الإجماع الساحق على خلافته حين انثال الناس عليه زرافات يطالبونه بتولي أمورهم بعد مقتل عثمان، فكان كهفاً للأمة وملاذاً للمهاجرين والأنصار. فلم يصحب خلافته تهديد بالقتل او بحرق البيوت كما حصل في خلافة أبي بكر لمن امتنع عن بيعته فقد امتنع عبد الله بن عمر عن البيعة ولم يرغمه أحد عليها. ولم يوصِ به من سبقه في الحكم كما حصل في خلافة عمر. ولم تصل إليه الخلافة نتيجة لمناورات قبلية وحسابات قرشية كما حصل في خلافة عثمان.
[18] - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (الماوردي)، الأحكام السلطانية، (دار الحديث، القاهرة، بلا سنة طبع) ج1، ص20.
[19] - ابن خلدون، مصدر سابق، ص 244.
[20] - الماوردي، مصدر سابق، ص6-7.
[21] - ابن خلدون، مصدر سابق، ص 241 – 245.