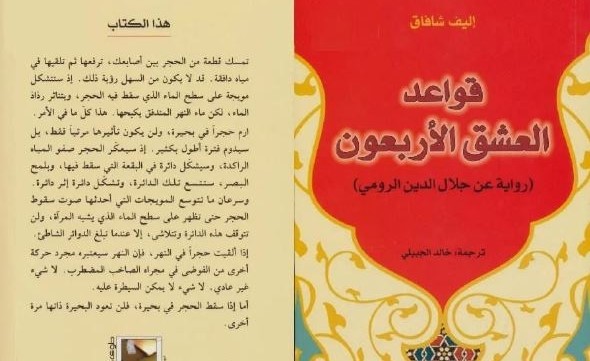قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: من ظاهر الدلالة إلى باطنها

جدليّةُ «المعنى» و«معنى المعنى» في عبقريّة العربية
ليست اللغة العربية مخزناً للألفاظ بقدر ما هي هندسةٌ للوعي، ولا تُقاس قيمتها بعدد مفرداتها فحسب، بل بقدرتها العجيبة على أن تجعل اللفظة الواحدة باباً إلى عوالم متعددة. ومن هنا نشأ التمييز الدقيق بين المعنى بوصفه الدلالة المباشرة التي تدركها الحواس، ومعنى المعنى بوصفه الأفق التأويلي الذي يتولد من المجاز والاستعارة والتصوير البلاغي، حيث يغدو الكلام أكثر مما يقول، ويصير الصمت نفسه جزءاً من البيان.
لقد أدرك فقهاء اللغة والنحو والبلاغة منذ وقت مبكر أنّ الكلمة لا تُستنفد عند حدودها المعجمية، وأنّ النص الحقيقي يبدأ حين تتجاوز العبارة ظاهرها إلى إشعاعها الدلالي.
أولاً: المعنى بين الإشارة والعبارة
المعنى في صورته الأولى هو ما يدلّ عليه اللفظ مباشرة؛ فإذا قيل: طلع القمر، فالدلالة الحرفية واضحة لا التباس فيها. غير أنّ العربية لا تكتفي بهذا المستوى، لأنّ العقل العربي — شعراً ونثراً وقرآناً — كان يبحث دائماً عن الطبقة الثانية من الإدراك.
فحين يقول الشاعر:
طلع القمر في وجهها.
لم يعد القمر جرماً سماوياً، بل صار رمزاً للجمال والاكتمال والنور الداخلي. هنا يولد «معنى المعنى». إنه انتقال من الواقع إلى التخيل، ومن التقرير إلى الإيحاء.
ثانياً: عبد القاهر الجرجاني واكتشاف العمق الدلالي
بلغ هذا المفهوم ذروته النظرية عند الإمام البلاغي الكبير عبد القاهر الجرجاني الذي جعل البلاغة قائمة على النظم لا على المفردة المفردة. فقد رأى أنّ المعنى الأول لا قيمة له إذا لم ينتظم في علاقة تُنتج دلالة ثانية.
فالقول:
"رأيت أسداً."
قد يكون خبراً عادياً.
أما:
"رأيت أسداً يخطب في الناس."
فإن الذهن ينتقل فوراً إلى الشجاعة والفصاحة والهيبة.
الأسد هنا ليس الحيوان، بل ما وراء الحيوان.
وهذا هو «معنى المعنى»؛ أي أن يصل المتلقي إلى مقصد المتكلم عبر طريق غير مباشر.
ثالثاً: النحاة وبناء المعنى قبل البلاغيين
ولم يكن البلاغيون وحدهم من وعى هذه الحقيقة؛ فالنحاة أنفسهم أسّسوا لها دون أن يسمّوها بهذا الاسم.
فالإمام سيبويه حين جعل السماع أصلاً والقياس تابعاً له، إنما أقرّ بأنّ الاستعمال البشري أوسع من القاعدة، وأنّ العرب قد تختار تركيباً لأنه أبلغ في الإيحاء لا لأنه الأيسر قياساً.
وكذلك فعل اللغوي العبقري ابن جني حين رأى أنّ اللغة فعلٌ عقليّ قبل أن تكون أصواتاً، وأنّ العدول عن القياس أحياناً حكمةٌ دلالية لا خطأ.
فالانحراف المقصود عن الأصل قد يكون الطريق الأقصر إلى المعنى الأعمق.
رابعاً: المجاز بوصفه اقتصاداً في الفكر
المجاز ليس ترفاً بلاغياً، بل اقتصادٌ معرفي.
فاللغة تختصر تجربة كاملة في صورة واحدة.
حين يقول العربي:
"اشتعل الرأس شيباً."
فهو لا يصف لون الشعر فقط، بل يستدعي الزمن والقلق والتجربة والانتظار.
جملة قصيرة تحمل عمراً كاملاً.
ولهذا كان البيان العربي يميل إلى التصوير؛ لأن الصورة تسمح بتعدد القراءة.
وهو ما فهمه الأديب الموسوعي الجاحظ حين جعل البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لا مجرد زخرفة لفظية. فالكلمة عنده تنجح حين تصيب النفس قبل الأذن.
خامساً: علماء الصرف ودلالة البنية
حتى الصرف — الذي يبدو علماً تقنياً — شارك في صناعة «معنى المعنى».
فالفارق بين:
قاتل.
قتّال.
مقتول.
ليس صرفياً فحسب، بل نفسياً أيضاً.
فزيادة الحرف زيادة في المعنى.
والوزن الصرفي يلمّح أحياناً إلى الكثرة أو المبالغة أو الاستمرار، فتتحول البنية إلى موقفٍ شعوري.
ولهذا قال علماء العربية إن الأبنية قوالب للمعاني، لأن الصوت نفسه يحمل دلالة.
سادساً: القارئ شريك في إنتاج المعنى
لا يولد «معنى المعنى» من الكاتب وحده، بل من القارئ أيضاً.
فقراء اللغة — من الأدباء والمتذوقين — هم الذين يوسّعون النص بقراءاتهم.
إن القارئ الذي يقف عند ظاهر العبارة يرى خبراً.
أما القارئ الذي يمتلك حساسية التأويل فيرى عالماً.
ولهذا تختلف قراءة النص الواحد باختلاف الثقافات والخبرات.
فالمعنى ثابت نسبياً، أما «معنى المعنى» فحيّ متجدّد.
سابعاً: العربية لغة الاحتمال الجميل
إن أعظم ما منح العربية قدرتها على البقاء هو هذا التوازن بين الضبط والانفتاح.
النحو يحرس المعنى من الفوضى.
والبلاغة تحرسه من الجمود.
فلو اقتصرت اللغة على المعنى المباشر لصارت تقارير.
ولو غرقت في الإيحاء وحده لصارت غموضاً.
بين الاثنين تولد العبقرية.
خاتمة: اللغة حين تصبح رؤيةً للعالم
إن «معنى المعنى» ليس مجرد مصطلح بلاغي، بل هو إعلان أن الإنسان لا يعيش بالوقائع وحدها، بل بتأويلها. فالكلمة العربية تشبه مرآةً ذات طبقتين: ترى فيها الشيء كما هو، ثم تراه كما يمكن أن يكون.
وهكذا ظلّت العربية — عبر فقهائها ونحاتها وبلاغييها وقرّائها — لغةً لا تكتفي بأن تُسمّي العالم، بل تعيد خلقه؛ لأنّ المعنى فيها بداية الطريق، أمّا «معنى المعنى» فهو أفقه المفتوح على احتمالات الروح والعقل معاً.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين