قراءات نقدية
قصي الشيخ عسكر: منابع الرمز في شعر طارق الحلفي
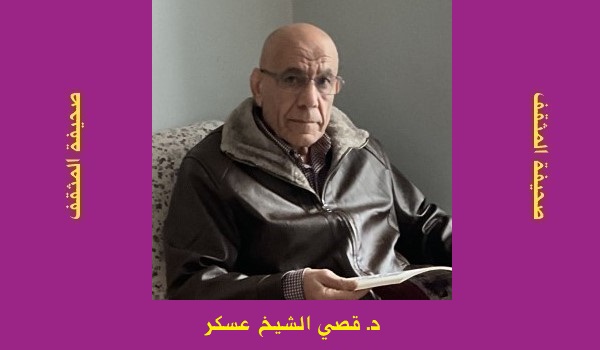
قراءة في مجموعة (وأنا كلّ الكلام)
طارق الحلفي شاعر مهم من الشعراء الذين يعيشون خارج العراق منذ فترة طويلة تبدأ من عام 1976 حبت عاش في الوطن في حالة مطاردة انتهت بالسجن زمن جمهورية الخوف وانتقل في عدة بلدان إلى أن استقرّ في المانيا، وفيها أصدر ثلاث مجموعات شعرية، اخرها مجموعة (وأنا كلّ الكلام) التي بين يدي للدراسة الآن فقد قرأت المجموعة منذ صدورها عام 2024 قراءة مستمتع والقراءة الثانية قبل بضعة أيام وكانت قراءة ناقد أو بعبارة أدقّ قراءة متأمل منسجم مع نفسه ومع الشعر الذي بين يديه.
لقد عكس الشاعر طارق الحلفي حياته التي عاشها زمن الخوف في جمهورية الرعب، وحياته في أكثر من بلد في شعره وصوره وخياله، فلجأ إلى الرمز العميق الثري بالمعاني عبر وسائل متعددة سأقف عند كلّ وسيلة وأبيّن أبعادها وما تحمله من دلالات، واخصّ بذلك الطبيعة المتجسّدة في عالمي النبات والحيوان.
أولا: دلالة الزهر والنبات:
1. النرجس
لأنني أحتاج بوح غياهبي
فلي الأصائل نرجسا/ ص20
لم يأت ذكر النرجس للدلالة الجمالية فقط كما نجده عند الشاعر (وليم وورد وورث)الذي تحدث عن جمال النرجس في قصيدة عنوانها (Daffodils ) التي أصبحت نموذجا جماليا لشعر الوصف ومازالت تدرس في أقسام قسم اللغة الإنكليزية في العراق إلى الآن .إن الشاعر طارق الحلفي انطلق في قصيدته التي جاءت بعنوان (لأنني) وهو عنوان يلفت النظر كونه يُعنى بالسببية سببية الوجود أو المتكلّم ذاته - انطلق من البعد الجمالي الى بعد آخر مسكون بالرمز، فنذكّر أنّ النرجس يرمز إلى حبّ الذات، وتجدّد الطبيعة لأنّه يتفتح في نهاية الشتاء، فهو يمثّل الولادة، تلك البداية جعلها الشاعر تتمركز في النهاية المشار إليها بكلمة أصيل، فالمعروف أنّ الأصيل لغة هو الوقت من بعد العصر إلى المغرب، وتعريفه يدلّ على أنّه ختام نهار، وارتبط في القرآن الكريم بعلاقة الفرد مع الله من خلال العبادة : (وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ).2، أمّا في التجليات الغيبية التي تحمل البشرى بزهو وجمال النرجس والأمل الآتي في المستقبل فإنّ النرجس اسم من أسماء أمّ مخلّص البشريّة من الجور والظلم المهدي المنتظر الموعود لذلك نجد الشاعر يلتزم برمز النرجس ويحوّله عبر معاناته من أسطورة تحمل معنى الإيجاب والسلب (الجمال والولادة وحب الذات) إلى واقع:
نرجسا كانت خرافاتي
وبعضا من ظنوني
بالمحصلة إن النرجس يدلّ على معاناة الشاعر من خلال المثلث الذي يحمله وهو الولادة والجمال والأمل الموعود في الخلاص من العالم السلبي عبر توحد الأسطورة بالواقع.
2. الدفلى
أداة أخرى سخّرها الشاعر في تعزيز الرمز ليحتلّ موقعا مركزيا في مجموعته، يقول:
إني ابتدأت
والبدايات اشتهاء
والمكان
زهرتا دفلى
وموسيقى فارسيّة
حين نتتبع سيرة حياة شجرة الدفلى يهمّنا شيئان اثنان هما المكان وسرّ الجمال، في المكان الذي يبحث عنه الشاعر وأشار إليه بوضوح أن الدفلى كما تدلّنا المصادر جاءت من القوقاز، ومكان الشاعر العراقي الحلفي في البدء كان البصرة ثم مكان القلق والتحدي كردستان التي قضى فيها شطرا من حياته وهو يتأمل مدن شمال الكرة الأرضية، والنموذج الذي لسمه في ذهنه القوقاز والاتحاد السوفيتي، إزاء هذه الحالة - حالة التحدي والقلق والحلم بالجمال - اشتق من المكان ثنائية نظن أنّه قصد بها الرجل والمرأة اللذين عبر عنهما بشجرتي الدفلى، مع ذلك وهو طفل صغير حذّره أهله من شجرة الدفلى كما حذرني أهلي فأنا كنت مفتونا ومزهوا بجمالها، في البصرة نسمى الدفلى شجرة أصابع العروس، يخطفنا جمالها الباهر بزهورها الحمراء والبيضاء والذهبية فيردعنا أهلنا ألا نلمسها لأنها سامة، كانت البصرة عامرة بهذه الشجرة شجرة أصابع العروس، فهي شجرة للنظر لا أن تُلمس، وبقي سمها نموذجا للجمال القاتل في شعر السياب الذي يقول في المومس العمياء:
وتفتحت كأزاهر الدفلى مصابيح الطريق
كعيون ميدوزا تحجّر كل قلب بالضغينة
فكأنّها نذر يبشر أهل بابل بالحريق3
المصابيح تدلّ الزبائن في مدينة البغاء إلى العواهر فكأنها في تفتحها تشبه شجرة الدفلى السامة جمال المصابيح الذي يشتت الظلام هو نفسه السم المتوهج جمالا في زهور الدفلى، ويربط الشاعر صورة الدفلى بصورة حسية يستلها من تشكيل بصري نراقبه عن بعد وهو حريق بابل العريقة، في حين يركب الشاعر الحلفي صورته من تشكيلة بصرية هي الدفلى وسمعية ألا وهي الغناء الفارسي، صورة تقابل الماضي العريق فيتحول السلب عنده عبر الصوت والأذن إلى بارقة أمل، فالموسيقى الفارسيّة حسبما يرد في تعريفها موسيقى عريقة جدا وآلاتها مميّزة، وكان الملوك الميديون والساسانيون يترنمون بها4،وأرى أن الشاعر وجد فسحة أمل عبر الموسيقى للخروج من تناقض الجمال الذي يجلب الشرّ والموت عبر تغيير المشهد من مرئيّ إلى مسموع.
3. الزعفران
هناك تداعيات لنبات الزعفران توحي بمعانٍ رسمها الأقدمون هي: الرفاهيّة.. الفخامة والجمال، وقد ورد الزعفران في نشيد الإنشاد (أنت نبع مغلق، بستان رمان.. بالحناء والناردين.. والناردين والزعفران)5 ونميل إلى أنّ العهد القديم جعل الزعفران بتشكيلته اللونية الزاهية نموذجا جماليا راقيا ولم يرد ذكر الزعفران في العهد الجديد، ولا القرآن أما في السيرة فقد نهى النبيّ محمد(ص) الرجال عن أن يصبغوا به، ونظنّ أن نهيه جاء مطابقا لفكرة العهد الجديد من خطابه للمحبوبة في أنها جميلة وراقية ومرفهة وتلك صفات تليق بالنساء أكثر من الرجال، وربما هذه الصفات جعلت المرأة البصريّة(بالانتساب الى مدينة البصرة) تكتب بماء الزعفران تعويذتها لتسهّل لها عمليّة الولادة وتخفّف عنها آلام المخاض، يقول الشاعر:
بين قلب
شفتاه الفجر
والنبض المندّى بلهاث الزّعفران
الفجر ولادة يوم جديد واللهاث - لهاث الولادة - يلتصق بالزعفران فتخفّ الآلام أيضا يمكن أن يضاف الزعفران إلى مادة حسية راقية:
وانسللت
كصدى دقات قلبي في البعيد
فتناثرت غماما من عقيق الزّعفران
العقيق يدلّ أيضا على الجمال والرفاهية لكن له تأثيرا آخر هو إضفاء العزيمة والقوة على حامله
لهاث الزعفران (ولادة)(تعب)\\عقيق الزعفران (جمال قوة عزيمة)
والإثنان ضمن الإطار الجمالي برابط المعاناة التي يعيشها الشاعر بدليل تناثره غيوما تمنح الأرض الخير الذي يعني الولادة، وهو الأمل الذي راوده قبل أن يغادر بلده ويحمل السلاح في كردستان.
4. النخل
في قصيدته صديقي الساهم يتمثل الشاعر الحلفي سيرته بصورة مكثفة موجزة، ولكي يحقق المطلوب فإنّه بدأ القصيدة بومضة نثر من فن قصيدة النثر استمرّت ثلاثة أسطر كمقدمة للقصيدة:
تتمدّد الأيام وتتضرج بالذكرى
باللهب كدليل على شجرة الكلام
قبل أن تبيض غصونها المفرطة بالأمل
ولكي يحقق سيرته عبر قصيدة موجزة فقد تبين بصفته شاعرا محترفا أمرين يحققان له مقصده هما البحر الذي تشدنا موسيقاه إلى السيرة بهدوئه وعنفه، والرمز القوي.. في مسألة البحر اختار بحر الرمل:
ساهما كنت وتبقى ساهما
بين عينيّ وثوب المرحلة
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
التقديم النثري كان لابدّ منه من حيث التفاعل مع فنية السيرة، والبحر يحقق التناغم الموسيقي بين النثر
والشعر، فقد اعتاد اّلعربيّ القديم أن يقحم أحيانا النثر في شعره ليزيده قوّة.. البيت التالي المنسوب إلى الإمام عليّ (ع) يؤكّد قولنا:
أشدد حيازيمك بموت فإنّ الموت لاقيكا
فكلمة اشدد زائدة والبحر من تفعيلتين هما: حيازيمك للموت: مفاعيل مفاعيلن مفاعلين مفاعيلن
الأمر الثاني فهو اختيار النخلة لتصبح رمزا عاما يشكل التداعيات التي يحتاج اليها زمن السيرة الذي بدأه الشاعر بالنثر من قبل:
يا صديقي كان في بستاننا نخل وتين
ثم يقول
وبقينا
نكتب النخل ونرسم
عند معلولة شهرا ص 101 \ 102
الأفضل أن نلجأ إلى المنهج النقدي الذي تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة ويتلخّص في أن نقف عند أي بيت يعجبنا أو يلفت نظرنا ثمّ نستدرج الأبيات التي قبله والتي بعده، بعدّه البيت المركزيّ إذ اخترت بيت مميز في ص 102
للنخل تداعيات قديمة وردت في الأساطير وكتب والأديان وربّما في العلم يقول العلم والخبرة معا إن النخلة الشجرة التي تشبه الإنسان في حالة إذا قطعت رأسها تموت، منها أن النخلة مباركة ورد اسمها في القران بخاصة في قصة مريم وولادة المسيح ،ومباركة النبي محمد (ص) لها في قول: أكرموا النخلة، ولا أبالغ إذا قلت أن الشاعر الحلفي حقق مفعول الرمز القوي حين جمع النخل في البداية مع التين ذلك الذي يرد في الأديان السماوية بصيغتين مختلفتين، فلسان المسيح أشار إلى تينة حمقاء، وملخص ما رواه مرقس أن المسيح طلب ثمرا من التينة في غير وقت الثمر فلم تعطه فدعا عليها ويحاول اللاهوتيون المسيحيون أن يؤلوا القصة لا على الحقيقة بل تأويلا رمزيا يرى في أن شجرة التين تعني اليهود الذين دعاهم المسيح للإيمان به فرفضوا فدها عليهم، في حين نجد صورة أخرى للتين في الأدب المعاصر يرسمها الشاعر إيليا أبو ماضي بعنوان (التينة الحمقاء) ومفاد القصة أنّ تينة في حقل ترفض فلا تورق ولا تثمر كي لا تعطي خيرها للآخرين وعندما يراها الفلاح من دون ثمر ولا أوراق بقطعها! ونحن نتساءل أيّ اتجاه نحا إليه الرمز في سيرة الحلفي من خلال الرمز، فنجد المسار انساب على الشكل التالي:
بدأ بعموم الشجر في المقدمة
انتقل إلى خصوصية الشجر (النخل)
ثمّ جمع بين النخل والتين.
هنا يخرج الشاعر الحلفي عن إلحاق الرمز بالشر (اليهود) حسبما ورد في التأويل المسيحي بل ألحق شجرة النخل بالتين وهو مقدس في الفكر الإسلامي إذ أن الله أقسم به في القرآن: (والتين والزيتون)، وبين الاستخدامات الثلاثة المسيحية والإسلام والشعر المعاصر بإلحاق شجرة التين بالنخل حتى تكتسب عمقا أبعد لا يستغلّ التراث بل يتفاعل معه بتفاؤل.
لقد ترعرع الشاعر في بيئة كانت تعج بالنخيل على ضفتين شطّ العرب وهما العشار والبصرة وأبو الخصيب يقابلها الضفة الأخرى وهي قضاء شطّ العرب، غابات تمتدّ على الضفتين بشكل هادئ رزين مهيب صورها السياب في قصيدة (أنشودة المطر) بشكل مذهل:
حيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينآى عنهما القمر
من خلال الإسقاطات التاريخية والدينية يمكن أن نقارن بين قدسية النخلة وقدسية الأم، عينا الأم والحنان فيهما والنخلة تطعمنا مثلما ترضعنا، في ذلك الزمان كان الطفل يأكل التمر بعد حليب أمّه
اما الشاعر الحلفي فقد تابع مشهد مأساة النخل في سيرته الذاتية الشعرية حيث تعرض غابتا السّيّاب إلى قتل وتخريب وابادة ونفي فبعض النخل اقتلع وعدد آخر تم تصديره الى دولة صحراوية، ولم يكن أمام الشاعر سوى أن يهاجر\ يهرب\يحمل معه نخلته لتصبح مطرا يسقي الظمأ:
النخل يهتزّ
وتهتزّ الغصون
ألا يذكِّرنا التعبير أعلاه بما ورد في القرآن الكريم (وهزي إليك بجذع النخلة)؟ ومادامت النّخلة تمثّل عماد الحياة بصفتها مقابل للأم والعطاء والحنان فإنّ الشاعر يحملها معه وفي يده سلاحه يسافر بها في مكان مقدّس يليق بالنخلة:
نكتب النخل ونرسم
عند (معلولة) شهرا في الخنادق
فلا يليق بالنخلة إلّا معلولة الآرامية ودير مار تقلا، وتقلا هي قديسة ولدت عام 30م لأبوين وثنيين تتلمذت على يدي القديس بولس ويحتفل بها المسيحيون يوم 23 ديسمبر، لذلك كانت النخلة التي هزتها مريم تهاجر من مدينة البصرة فتحلّ في هذه البلدة وأراها بلا شكّ نقطة جميلة ولوحة من اللوحات التي رسمها الشاعر الحلفي بالرمز.
ثانيا: الطير والحيوان
ذكر الشاعر بعض الطيور في قصائده فجاءت رمزا يعزز صوره ولوحاته الشعريّة ومنها:
1. الهديل
هو ذكر الحمام، وقد طار في أحد الأيام فافترسه جارح من الجوارح فأخذت الحمامة تنوح عليه، هكذا ورد الأسطورة وهي أسطورة عربية قديمة، اتكأ عليها الشاعر في تركيب لوحته:
لأنني ذكر الحمام وأنت لي
أنثاه جمرا
والهديل سناك
يصوّر الشاعر مأساته على وفق الشكل التالي:
هو نفسه الهديل، وهو ضحيّة العنف والتسلّط، لا حلّ الا بالعوامل المذكورة محلّ الجارح المفترس.
الشاعر (ضحيّة)|| الهديل(ضحيّة)
الحمامة (تنوح)|| المرأة (تنوح)
صوت || نار
إنّه يحوّل أحد الأطراف من صوت مدرك بالسمع (نواح) إلى سناء أو نار أو نور، ومن قبل حول المرأة التي تقابل الحمامة أنثى ذكر الحمام إلى جمر، ليعزز من أثر الرمز ضمن عملية التبادل السمعي البصري.
2. الهدهد واللقلق
في التراث والفكر العربي نجد للهدهد مدلولين:
الأوّل مفهوم ما قبل الإسلام ويشير إلى أن الهدهد بار بأمه كان يحملها وما هذه القنزعة التي على رأسه إلا التاج الذي كوفئ به.
المدلول الثاني المفهوم الإسلامي حيث ارتبط الهدهد بالمقدّس ـ النبي سليمان والملكة بلقيس.
أما اللقلق فيعني في الفلسفة المصرية القديمة الحكمة، وفي المسيحيّة تفاعله مع مريم في ولادة المسيح.
لقد جمع الشاعر الحلفي في قصيدة واحدة عنوانها (فريضة العمل) بين الهدهد واللقلق:
وهدهد التاريخ في أسرة القصب
يعير رحلة الجهاد
مرة لريبة الجسد
ومرة لعمة الرمد
ونحن في بوصلة المغيب
لقالق الهجرة للأبد
لا شكّ أن المحور، محور خير، فقد التقى حول خيرية الهدهد أو إيجابيته في الاسلام والمسيحية، إن حركته أعطت للحياة طعما فبفضله عرف النبي سليمان بلقيس، ولو أمعنا النظر في المقطع لوجدنا أن الشاعر الحلفي ينقل حركة الهدهد من حركة ظاهرة محسوسة إلى حركة خفية
هدهد التاريخ.. التاريخ هو القدم والطائر الهدهد متحرك لكن هذه المرة في أسرة القصب، من عنوان القصيدة ندرك أنّ حضارة السومريين والمصريين ارتبطت بالقصب، سومر الأهوار والفراعنة الكتابة على القصب.
وهناك الحركة الخفية في السرير، حركة لقاء الرجل بالمرأة.
فليس هناك من جمود بل هي الحركة الخفية التي تسري هذه المرة من داخل عمق الإنسان والتاريخ ليلتقي الهدهد ناقل الخبر بقديم مثله ودال على الخير وهو اللقلق، وفي التراث العالمي يقال إن اللقلق يورث القديم الذي بناه للأجيال الجديدة، أو إن حركة الهدهد الخفية التي تسري في القصب استطاعت أن ترتقي من جديد إلى أعلى لتلتقي باللقلق الذي يتخذ من الأماكن العالية مقرا له، فتظهر من جديد واضحة للعيان.
إن الشاعر لم ينظم الشعار الذي يقول (من لا يعمل لا يأكل) بصورة مباشرة إذ أراه ليس بشاعر شعارات بل هو فنان كثف صورة شعار مشهور بطائرين خيرين هما الهدهد واللقلق ليضفي على قصيدته حالة من التفاؤل الفنّي على الرغم من المأساة التي عاشها.
3. الغراب والغرانيق
مرة أخرى يجمع الشاعر الحلفي في قصيدة واحدة بين اسمي طيرين لهما مدلولات رمزية في الفكر العالمي هما الغراب والغرانيق. الغراب في أساطير الشمال: الدنمارك والسويد يدلّ على الحكمة، وعندنا في المجتمع العربي يعدّ علامة للتشاؤم على وفق ماورد في الفكر الجاهلي واستمرّ هذا الاعتقاد إلى الآن على الرغم من أن الأسلام أشار إليه إشارة إيجابيّة في قصة ابني آدم هابيل وقابيل حيث علم قابيل كيف يدفن أخاه وهو إلى مفهوم الحكمة عند الإسكندنافيين، وإن كان الغراب في قصة طوفان نوح قد خان الأمانة.
فمنـ منطلق تعامل الشاعر الحلفي فيمع الغراب؟ يقول:
اقطفي لي من سواد الليل شمسا أبديّة
واكتبي كلّ الحكايا
منذ أن مرّ غراب البين يوما
في فضاء الأبجديّة
يبتدأ القصيدة من التناقض بين الأبيض والأسود وفي النص التفاتة إلى مفهوم يتعلق بالوجود. الكون نفسه ابتدأ بالظلام، (في البد كان هناك ظلام وكان روح الله يرف على العالم)، وكما تشير التوراة، وفي الفلسفة الإسلاميّة نجد أن الظلام هو الأساس بل إن الله كان موجودا في العماء قبل أن يخلق الكون، فمن الظلام انبثق الضياء والكون، إن الغراب ذو لون أسود يجئ في القصيدة في المرحلة الثالثة:
الظلام الأصل
البياض المنشق عنه (الشمس)
الكتابة المرحلة الثالثة
يعني الشاعر بكلمة الكتابة الفكر، ولا شك أن الفكر الذي جاء بعد الشمس هو فكر المحبة والسلام والإيمان والخير، لكن غراب البين الأسود أو الريح الهوجاء هبت على الحروف\الأبجدية ويقصد بذلك الفكر الشوفيني الذي شرد الكثير من يساريين وغيرهم عندئذ يستعين بقوة عظمى:
أدركيني
قوة الأنثى، الأم، العقيدة
حيثما هبت أعاصير الضلال الهمجية
كلما نحن سقطنا
كالغرانيق نطير
ابتهاجا في فضاءات يديك
فالغراب، الريح السوداء توصلنا إذ تلبس لبوس الطائفية، والهمجية إلى مرحلة الغرانيق تلك الخرافة التي نسجها بعض المؤرخين، ومفادها أن الوحي عندما نزل على النبي محمد (ص) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى فألقى الشيطانُ على لسانه :تلك الغَرانيقُ العُلى وشفاعتُهنَّ تُرتَجى ماورد أفرح أهل مكة، والغرانيق في الأصل هي طيور كما تعرفها معاجم اللغة، لقد استعمل الشاعر قصة الغرانيق استعمالا ذكيا فقلب الصورة التقليدية إلى وجه آخر مثلما اشتق من الظلمة النور. الغرانيق نفسها انقلبت إلى طيور حب وخير، إنها تحولت من حالة الألوهية التي تمثلها العزى واللات ومناة إلى طيور بريئة استطاعت بقوّة الفعل أدركيني أن تصبح أليفة دالة على الفرح والخيريّة.
4. الذئب / الكلب الديك
قد يدلّ الذئب في الأساطير العالمية على الشرّ، ففي الأسطورة الاسكندنافية نجده يقطع يد الإله تير بعضة منه، وفي الفكر العربي نجد مثالا له في قصّة العربي الذي وجد فرخ ذئب فعطف عليه وأخذه إلى شاته لترضعه وعندما كبر وثب على الشاة فافترسها حيث نُظِمت هذه القصة شعرا، اوهناك صورة أخرى للذئب إيجابية إذ تراه العقلية العربية يطارد والجن تخاف منه، ويرسم له الشاعر الأحيمر السعدي صورة إيجابية:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
وصوّت إنسان فكدت أطير
ولربما يكون أدق تعبير على جماليّة الذئب وإيجابيته في الفن المعاصر ما وجدناه في الشريط السينمائي (الرقص مع الذئاب) الذي حاز على جائزة أوسكار.
مع قضية الذئب سأشير أن السطر الذي ورد فيه ذكر الذئب احتل الرقم 32 وهو السطر الذي بدا المركز او المغناطيس الذي تنجذب إليه جميع الأبيات بدءا من البيت الأوّل في القصيدة التي عنوانها (العراق):
متجمعا بين ارتعاش القلب والذكرى
وما ولوا عليه غير أولاد الذئاب سطر 32
قبل سطر الذئب تحتشد الأسطر بالعنف والجريمة والصور المخيفة
المراثي\الموت الضياع\ الاستلاب الايقاد الكره... الحروب... الدماء... لتنتهي تلك الحوادث المتمثلة لا مفردات القاسية عند الذئب، فهل اختار الشاعر عفوية الذئب وبراءته التي حدثنا عنها القرآن الكريم، أم رمز الشر، إن المفردات السابقة لم تتطهر حين جذبها الذئب إليه بل انسجمت فيه واندمجت بعنفه وشراسته لتتحذ صورتين أخريين تنتهي عندهما القصيدة هما الكلبة والذئب.
لا داعي أم نذكّر أن الكلب بالمفهوم العربي والعالمي يرمز إلى الوفاء، ومن الطريف أن نذكر أن هناك كتابا قديما ألِّف عن الكلاب عنوانها (تفضيل الكلاب على الكثير ممن لبس الثياب) لكن في الوقت نفسه هناك نزعة في الفكر العربي تميل إلى احتقار الكلب وتعده نجسا فإذا ماراد شخص سبّ آخر قال عنه (ابن كلب)، أما الديك فيرمز عند المسلمين إلى الفجر والصلاة والنقاء الروحي، الديك يذكرنا بالصلاة لكن نستطيع القول إن الكلب والديك لم يحافظا على صورتيهما الإيجابية فالحوادث السابقة تشبعت بالذئب لتصبح هي نفسها فيهما: الكلب يدل على الوضاعة والخسة اتخذ هيئة حصان:
منذ أن شدّوا على أنثى الكلاب
سرج إكسير الأماني والخداع
*
أما الديك فقد بدأ يصيح بمفهوم آخر مناقض للصلاة
وهم الديك الذي يعلن في كل صباح:
*
ربنا زد فحشنا يسرا لنثري
سعة في طمع الدنيا
وتيها وغواية
ومادامت القصيدة من (العراق) عنوانا له فرمز الديك الفاسق والكلب والذئب ينطبق على من يحكمون اليوم.
***
قصي الشيخ عسكر – روائي وناقد
......................
1ـ أذكر أن قسم اللغة الإنكليزيّة كان يدرّسها في جامعة البصرة ويطلب من الطلاب ترجمتها وقد حضرت من باب الفضول أو الرغبة للتعلم واشتركت مع أحد الأصدقاء في ترجمتها.
2ـ الاعراف 205
3ـ ديوان انشودة المطر/ ص 145. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
4 ـ راجع ويكيبيديا: الموسيقى الفارسيّة.
5ـ سفر نشيد الإنشاد 4 / 12 ـ 14
6ـ ديوان انشودة المطر/ ص 123. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة







