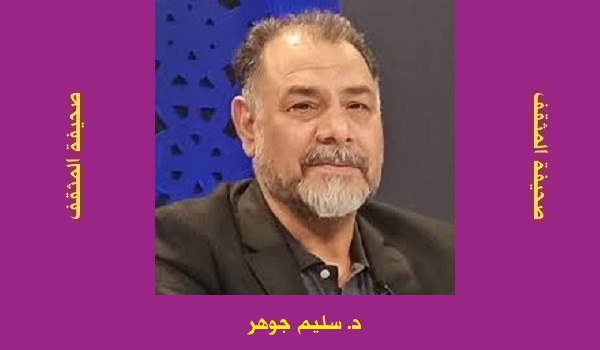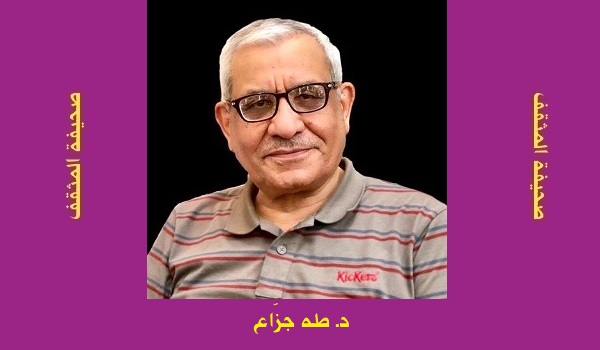قراءات نقدية
إبراهيم برسي: حين يتوسل الجسد المغفرة.. تأملات في الطهر المنكسر

وقراءة في سردية “عزازيل” ليوسف زيدان
توطئة: ليست هذه القراءة دعوة إلى تأويل يقيني، ولا محاولة لاقتناص مفتاح سردي يُغلق الرواية بإحكام. بل هي انزلاقٌ حرّ في الهوامش التي تركها يوسف زيدان مفتوحة عمدًا، كأنّه يعرف أن الحكاية ليست في ما كُتب، بل فيما لم يُكتب، في ما خُبّئ خلف سطور الراهب، وفيما ارتجف بين الجسد والمغفرة دون أن يُقال.
“عزازيل” ليست رواية تُقرأ كأنها وثيقة، بل كأنها مرآة: من نظر فيها طلب الحقيقة، ومن تَأملها خاف من الوجه الذي رآه فيها.
مقدمة:
في لحظة مفارقة، حين يختلط اللاهوت بالنزيف، والمقدّس بالحسّي، يولد النص الذي لا يريد أن يشرح شيئًا، بل أن يحرّض على التورط. سردية “عزازيل” لا تُحاكم عقيدة ولا تؤرّخ لانشقاق، بل تُقيم في المنطقة الرمادية بين الله والإنسان، بين الرغبة والتوبة، بين الحبر واللحم.
هنا لا يتكلّم يوسف زيدان بوصفه مؤرّخًا ولا هيبا بوصفه شاهدًا، بل يتناوبان معًا على الحفر في قاع الإنسان: ذلك الكائن الذي عُلِّم كيف يخاف جسده، ويُقدّس صمته، ويتوسّل الغفران لأجل قبلةٍ لم يستطع أن ينساها.
في هذه الدراسة، لا نبحث عن حكم، بل عن تأمل، لا عن خلاصٍ جاهز، بل عن سردية مكسورة تُطل من وراء الكلمات، لعلّها تجد فينا قارئًا لا يطلب إدانة الراهب، بل يفهم ارتباكه، ويعترف، سرًا، أنه يشبهه.
ثمة أشياء لا تُكتب لكي تُفهَم، بل لكي تُلامَس. ليست الرواية هنا إلّا جلدًا قديمًا تركه التاريخ على حبل الغفران، ليرتديه من يشاء، لا ليحتمي من البرد، بل ليعرف كيف يرتعش.
عزازيل، في دلالته الأولى، ليس اسمًا لشيطان كما درجت التفاسير، بل هو التسمية التي تُطلق على المجهول فينا، ذاك الصوت المُهمَل، المُبعد، الذي كلّما أنكرناه، ازداد حضورًا. في الرواية، لا يظهر عزازيل كشخصية بل كاهتزاز داخلي، كظل لا وجه له، كصوتٍ يخرج من أعمق نقطة في الذات حين تهتز الأرض تحت يقينها. هو مرآة لا تعكس، بل تُكسر.
هيبا، ذلك الراهب الذي يُمسك القلم ليكتب سيرته، لا يفعل ذلك لأنه يريد أن يروي، بل لأنه لا يعرف كيف يصمت. لم ينجُ من الحرب، ولم ينجُ من اللاهوت، ولم ينجُ من ذاته. الرجل الذي جاء من جنوب الصعيد ليحتمي بالكنيسة، كان يركض، في الحقيقة، من شيء أعمق من الاضطهاد: من جسده، من صوته، من تلك الرعشة التي لم يستطع أن يسميها حبًا، ولم يجرؤ أن يعترف بها كفهم.
ومارثا؟ ليست امرأة. بل اختبارٌ مكتمل. اختبارٌ للجسد حين يتورّط في الحنان، وللطهر حين يفقد تعريفه القديم. مارثا ليست غواية، بل مفردة جديدة في قاموسٍ لم يكن يعرف سوى مفردتين: الطاعة والعقاب. مارثا هي اللحظة التي يُحسّ فيها الراهب بأن الله لا يسكن فقط في المذابح ولا في الجدران المذهبة، بل في جلد إنسانٍ يرتعش، في عينين تسألان بصمت: هل الحب خطيئة؟ وهل المغفرة فعلٌ فردي؟ أم أنها امتياز تحتكره المؤسسة؟
الرواية تُسلّط الضوء لا على صراع العقائد كما يبدو، بل على التمزق الذي يحدث حين يصبح الإيمان سكينًا موجهًا ضد الجسد. يوسف زيدان لا يُدين الراهب، ولا يُبرّئه، بل يتركه في منتصف الطريق، عارياً من الحُكم، محاطاً بأسئلته، لا لكي يصل، بل لكي يتأمّل الحافة.
حين يقول هيبا عن علاقته بمارثا: “لم تكن خطيئة كما ظننت، بل كانت لحظة صدق نادرة”، ينفتح الجرح. لا جرح الفعل، بل جرح التأويل. كأن الطهر، في جوهره، لا يعني الامتناع بل الصدق. كأن الجسد، إن كُتب بصدق، يكون صلاة. وهذه الجملة وحدها كافية لتقوّض مئات الصفحات من التراتيل التي صاغتها السلطة لتجعل من الإنسان تابعًا لرغبتها في تعريف النجاة.
من خلف ذلك، يتردّد صدى أصواتٍ بعيدة، أصواتٍ لم تكن لتصمت لو أتيح لها الكلام. صوت إرنست بلوخ حين كتب عن الرجاء بوصفه بوصلة الإنسان نحو “ما لم يُولد بعد”، صوت سيمون فايل وهي تكتب أن “العقيدة التي لا تعبر عن الجرح، ليست أكثر من سلطة متنكّرة”. في هذا الإطار، تُصبح الكتابة نفسها – عند هيبا – نوعًا من الاعتراف الذي لا يبحث عن عفو، بل عن إعادة ترتيب المعنى. وكأن السردية ليست توثيقًا لما جرى، بل لما كان ينبغي أن يُقال ولم يُقل.
الرواية لا تُنهي هيبا، بل تُبقيه بيننا، بوصفه احتمالًا لكل من ظنّ أن التديّن يعني قمع الرغبة، أو أن الله لا يُرى إلّا من خلف حجابٍ من جلد. “عزازيل” تفتح الباب لتأويل الطهر نفسه، لا بوصفه قيدًا بل بوصفه ساحة صراع. الطهر، في هذه الرواية، ليس نقيض الجسد، بل طريقه الآخر. والراهب الذي ظنّ أنه يهرب من الخطيئة، كان – دون أن يدري – يهرب من سؤال لم يعرف كيف يواجهه: ما معنى أن تحب، دون أن تُحاسَب على شعورك؟
يوسف زيدان، دون أن يصرّح، ينسف جوهر العلاقة بين اللاهوت والجنس، بين المقدّس والغريزي، ليعيد الاعتبار للإنسان بوصفه كائنًا هشًّا، لا كاملًا، كائنًا يرى الله من زاوية منخفضة، لا من برجٍ عقائدي. والمغفرة التي يتوسلها الجسد، ليست مطلبًا من السماء، بل رجاءٌ بأن يسمح له الزمن بأن يُكتب من جديد، بعيدًا عن الجُدران التي علّمتنا أن نكره أنفسنا لأننا نشعر.
ولذلك، لا تنتهي الرواية كما تنتهي الحكايات، بل تبدأ عند النقطة التي يكتب فيها هيبا دون وجل، أن الجسد – حين لا يُخاف – يُصبح أصدق من العقيدة، وأعمق من النبوة، وأشدّ صلةً بالله، إن كُتب بدمٍ لا يستأذن الكهنة.
***
إبراهيم برسي – باحث وناقد سودني