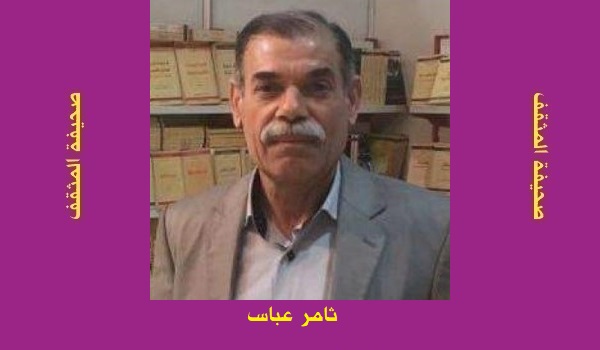قراءات نقدية
حنان أوراق: التفكير البلاغي عند العرب خلال القرون الستة الأولى

لا شك أن مفهوم البلاغة، شأنه شأن عدة مفاهيم، قد تشبّك وتدرج صوب اكتمال دلالته عبر عدة محطات. فعلى وفرة التعاريف وتنوع مشاربها، بين من ربطها بوظيفة الإفصاح والبيان، ومن حصرها في الأسلوب، ومن ركز فيها على المقاصد العقائدية والجدلية متأثرا بالخطابة اليونانية، إلا أنها والحال تلك قد افتقرت إلى تعريف يستعرض تمام خصائصها ويتصدى لمجمل غاياتها. غير أن ما يستدعي الاهتمام هنا هو مبعث هذا التباين المتمثل في تنوع البيئات -فلسفية ولغوية وكلامية- التي نشأت فيها البلاغة العربية وتبلورت، وما وفرته من غنى وزخم على مستوى الروافد الفكرية والأدبية.
وعليه، فإن مقصد تتبع أطوار التفكير البلاغي عند العرب، والوقوف على أهم محطات تطوره، يستدعي تنقيبا في القضايا الكبرى التي شغلت المجتمع العربي طيلة ستة قرون الأولى، ومحاولة رصد العوامل الثقافية والحضارية التي حكمته، لذلك يأتي كتاب "التفكير البلاغي عند العرب" للأستاذ حمادي صمود، محاولة يُشهد لها تمكنا وتفصيلا في هذا السياق، وهو المورد الذي سنعتمده أساسا ومنطلقا لهذه الورقة. فما هي المحطات الكبرى لتاريخ الفكر البلاغي العربي خلال قرونه الستة الأولى؟ كيف يطارح صمود مميزات كل مرحلة؟ إلى أي حد تبلورت الأفكار، استغلقت وانفتحت، نمت وتشذبت، لتخصب وتزهر فكرا بلاغيا مكتملا؟
يعد الجاحظ نقطة فارقة، بصمت واقع التأريخ للبلاغة العربية، فمؤلفاته حول ضوابط الكلام البليغ هي أقدم ما وجد، لهذا قُسّمت أطوار البلاغة إلى: طور ما قبل الجاحظ، وطور الجاحظ، ثم طور ما بعد الجاحظ. ما يؤاخذ على الطور الأول هو أن الاشتغال البلاغي فيه ظل -على أهميته - جزئيا ومتناثرا غير مطّرد، أقرب منه إلى مادة خام، تبوأ الشعر في مستهله مركز الاهتمام، فكان على حد قول ابن خلدون "ديوان علوم العرب وأخبارهم"1، وكان الشعراءُ كما قال الخليل "أمراء الكلام"2، التفتوا إلى تجويد القصائد وتحسينها والمفاضلة فيما بينهم انطلاقا منها، ناهيك عن إسهام كل من اللغويين والنحاة في الاتجاهين معا النقدي واللغوي. ولعل هذه -إن شئنا- أولى بوادر النظر في خصائص الشعر اللغوية، والوعي بضرورة انطلاق الأحكام من داخله.
غير أن مركزية الشعر سرعان ما ستتراجع ليحتلها حدث مجيء القرآن، متحديا فصاحة البيئة العربية، ليصير محور المجهود الفكري والعقائدي، موجها التفكير إلى قضايا اللغة وأحوالها، باعثا على الجدل والنقاش بين الفرق الكلامية، ومجتمع المسلمين كافة. إذ يقول المعتزلة بمبدأ الصِّرفة، وبفكرة الإعجاز في القرآن، ويخوضون دروب التأويل اتجاه الآيات التي يخالف الظاهر فيها الباطن، وتتجذر وتتفرع المحاولات في اتجاه إغناء الجهود وتعميق البحوث واتخاذ المجاز والتأويل منهجا تنضبط له إشكالات القرآن.
فارتباط البلاغة بغاية فهم النص القرآني، جعل منها كما يقول العسكري:" أحق العلوم بالتعلم، وأولاها بالتحفظ -بعد المعرفة بالله جل ثناؤه-"3. هذا الاهتمام بالبلاغة، سواء من خلال النص القرآني أو الشعري، أسفر عن الحاجة إلى تقعيد اللغة وضبط خصائصها البنيوية والفنية. فتطابق نواميس اللغة ومقولاتها مع مقولات المنطق، يصب قطعا في صالح القضايا العقدية. أضف إلى ذلك حدث انفتاح الثقافة العربية على الفلسفة اليونانية. وما خلفه ذلك من تأثير مباشر على مبحث البلاغة، سواء على صعيد النظر في غاياتها ووظائفها، أو على صعيد حركة التأليف، فبعد نشاط حركة الترجمة، واتصال العرب بكتب أرسطو، خاصة كتابي: "الشعر" و"الخطابة" خلال منتصف القرن الثاني، ظهرت مجموع محاولات لربط التفكير اليوناني بالتفكير العربي في فنون القول وخصائص الشعر، سواء من طرف اللغويين أو الفلاسفة في اتجاه شرح نصوص أرسطو أو تلخيصها كمحاولات ابن رشد والفارابي وابن سينا وغيرهم، إنما على خلاف الخطابة لدى اليونان، اتجهت البلاغة العربية صوب دراسة خصائص الكلام عوض الإقناع.
ثم يُفتتح الطور الثاني مع الجاحظ، كأول من أرسى القواعد البلاغية الأساسية، على حد قول المهتمين بمجال البلاغة والنقد العربيين، ويأتي في هذا الباب كتابه "البيان والتبيين"، المؤلف الأدبي الأهم في مجال التفكير البلاغي. يقول الحسن بن رشيق: "وقد استفرغ أبو عثمان الجاحظ –وهو علامة وقته- الجهدَ وصنع كتاباً لا يُبلغ جودة وفضلاً"4. تقصّى فيه تصاريف اللغة وضروبها. ومن بين المسائل التي استأثرت باهتمامه، هي دراسته الصمت والنطق، فيشيد ببصيرة نافذة بمحاسن النطق وأضرار الصمت، ويقيس في ذلك الأمور بمعيار براعته قائلا: "والرواة لم ترو سكوت الصامتين كما روت كلام الناطقين"5، أو قوله: "الرسالة السماوية جاءت كلاما ولم تأت صمتا"6. وغيرها كثير. لقد تمكن بذكاء وحس فلسفي من وصل حياة اللغة بحياة الفكر، وضخ الحياة في المعاني بإخراجها للوجود، غير مدخر القول للتحذير من الإسهاب المتكلف كإشارته: "ليس الصمت كله أفضل من الكلام كله، ولا الكلام كله أفضل من السكوت كله"7. لقد أولى الجاحظ في تأليفه البلاغي-عظيم الاهتمام لظاهرة الكلام من حيث هي الوجود العملي للغة، ولا مرية في ذلك "فالبلاغة، أية بلاغة، لا تعدو أن تكون "كلاما على الكلام" عنه تصدر وإليه ترجع"8 كما عبر عن ذلك حمادي صمود. غير أن الجاحظ تناول الخطاب اللغوي من زاوية كونه عملية تواصلية، قناتها المشافهة وأقطابها: المتكلم، والسامع والكلام. لهذا، فبالإضافة إلى اشتراطه مجموعة شروط في المتكلم بوصفه طرفا هاما في العملية اللغوية كرباطة الجأش وحسن الطلعة وما إليه، اهتم أيضا بوظائف اللغة وجعل على رأسها وظيفة البيان والتبيين أو الفهم والإفهام. مشيِّدا بذلك مجمل مادته البلاغية على قاعدة متينة هي وصل المقال بالمقام، وضرورة ملاءمته لمقتضى الحال. فالبلاغة هي ضبط ميزان القول مع غايته، أي الاهتمام بظاهرة الملفوظ التي تمثل بنية النص وخصائصه، وظاهرة التلفظ بوصفه فعلا يرتبط بمتكلم معلوم ضمن زمان ومكان معينين.
استأثر الجاحظ بحقبة التأسيس، التي انتهت تقريبا في النصف الثاني من القرن الثالث، متمخضة عن إرث كبير، ومادة بلاغية هامة. أي نعم، افتقرت إلى الحس المنهجي بالشكل الذي تتواضع عليه العلوم اليوم، إذ جاءت متفرقة، متناثرة، غير مخصصة في مؤلف بعينه، إنما لكل مرحلة خصوصيتها ولا يحق بأي حال محاكمتها بمنطق مراحل أخرى.
أما الطور الثالث فيؤرخ له ابتداء من أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ولأن التأليف كان محدودا في الفترة السابقة فقد صار علامة فارقة بهذه المرحلة. فابن قتيبة على سبيل المثال من العلماء الذين عرفوا بموسوعيتهم ووفرة مؤلفاتهم، ألف كتاب "تأويل مشكل القرآن"، الذي اشتمل على تحليل متسق ورؤية واضحة ومادة بلاغية غزيرة. ومؤلف "الشعر والشعراء"، وهو من معالم النقد الأدبي رغم محدودية المادة البلاغية فيه، وليس هذا إلا إشارة على أن التفكير البلاغي لم يشتد عوده بعد، سار الكتاب على نحو ما سبق مع الجاحظ فتناول فكرة ثنائية اللفظ والمعنى. فابن قتيبة وإن استفاد من مجهودات اللغويين والأدباء قبله، فان البلاغة لم تتطور على يديه، إذ لم يشذ في طرحه عن الطروح السابقة لأبي عبيدة والفراء والجاحظ، إنما تحسب له إثارته بعض القضايا كدفاعه عن المجاز واعتباره مسلكا في التعبير. أما المبرد، فهو أول من أدرج لفظ البلاغة في عنوان رسالة من رسائله، ولو أنها لا تتناول علم البلاغة درسا وتبويبا، وإنما هي مجموع آراء في جودة الشعر والنثر في موضع مقارنة بينهما، ولقد اهتم بشكل كبير بأسلوب التشبيه وأفرد له بابا خاصا، لاقتناعه بأنه الممارسة الأكثر انتشارا عند العرب. وقد مهدت مؤلفات كل من ابن قتيبة والمبرد وآخرون لنقطة تحول في مسار الدراسات البلاغية والنظرية الأدبية عند العرب، من خلال كتاب "البديع" لابن معتز، والذي يعد أول مؤلَّف اقتُصِر فيه على استعراض نماذج من الأساليب البلاغية، والمحسنات اللفظية، فجاءت غايته واضحة وهي محاولة إرساء البلاغة على أسس عربية صريحة، لذلك صُنِّف إلى جانب "البيان والتبيين" نواة لعلم البلاغة العربية. ورغم أن كل القضايا التي عالجها الكتاب تطرق إليها سابقوه، غير أن هذا لا يرفع عنه قيمته المتمثلة في الرؤية الواضحة في التأليف، وغايته البلاغية الصرفة، فقد جاء مختصرا، مشذبا، خاليا من كل حشو واستطراد.
يتسارع سبق التأليف ويتشابه، عبر توالي المؤلّفات إلى أن يأتي الجرجاني في القرن الخامس بمؤلفيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" فيبث في البحث البلاغي نفسا جديدا، وروحا متفردة. فبعدما تشبع بما أبدعه السابقون عنه، أعاد فيه النظر بحس عقلي وذوق أدبي رفيع فقال بفكرة "معنى المعنى." ولأن النزعة العقلية هي ما يميز مؤلفات الجرجاني،فإن العلاقة بين المعنيين تتطلب النظر الدقيق، فانفصل بذلك عن السابقين، ووصل المجاز بمعنى اللفظ لا باللفظ ذاته. فالألفاظ حسب الجرجاني لها وجود مستقل عن المعاني، مدللاً على ذلك بإشارته إلى التعالق الحاصل بين النص وتأويله، فاللّفظ واحد في حين أن التأويل متعدد. فإن كان اهتمام الجاحظ قد توجه أساسا إلى علاقة المتكلم بالسامع، ومطمح تحقيق الفهم والإفهام، فإن الأمر الملح مع الجرجاني صار حول الرسالة ذاتها وعلاقة الشكل بمضمونه.
وكما لا يخفى، فالجرجاني هو صاحب نظرية النظم، أي نعم جذورها عميقة في التراث العربي، إنما إليه يعود أمر بنائها بمتانة على أسس لغوية متطورة، تتقصد وصف عملية الكلام البليغ ودواعي بلاغته، ميز فيها بإحكام ودقة وبعد بصيرة بين اللغة والكلام، تمييزا يقارب ما وصل إليه علم اللسانيات الحديث. منطلقا في هذا التمييز من فكرة مرجعية المفاضلة بين كلام وآخر ضمن نفس اللغة، فيقول الجرجاني: "ليس الغرض من نظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل"9. إذ أن غاية الكلام لديه تتجاوز ما ضمته اللغة من معاني ثم قوله: "واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب والفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة"10. يشي هذا بتبصر عميق وفهم للتحول الحاصل في الظاهرة اللغوية، فبعدما كانت قيمة النص تتحدد في مقدار تفنن الكاتب في تضمينه صور المجاز وضروب البديع، وكانت نجاعة النص ترتبط بمدى تأثيره المباشر في المتلقي لوضوح اللفظ وجلائه، صار العقل هو وسيلة إدراك المعاني وتدبرها وتصويب الفهم.
رغم تعدد الروافد الفاعلة في بلورة التفكير البلاغي العربي على مر ستة قرون، سواء تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، داخليا مرتبطا بالمجتمع العربي الإسلامي وبيئته الثقافية والفكرية والعقائدية والسياسية والأدبية، أو خارجيا من خلال تلاقح الثقافات عبر الترجمة والحركة الفكرية، إلا أن التفكير في جمالية اللغة وأغراضها الفنية الصرفة لم يحظ بحظ وافر في الأطوار الأولى حيث احتكمت اللغة إلى الوازع الديني، وصارت وسيلة إلى فهمه، فأنتجت هذه المرحلة مادة بلاغية متهافتة ومتفاوتة الأهمية. ليأتي الجاحظ بعدها بعمق في الرؤية ومقدرة تجريدية مستبقة، ويضع أهم القواعد التي سيقوم عليها التفكير البلاغي لاحقا، وهي وظيفة البيان والتبيين. لينضج الوعي رويدا بعدها عبر محاولات عديدة لبلاغيين ولغوين ونحاة تمخضت عن نظرية النظم للجرجاني كبصمة بارزة وراسخة في التراث البلاغي العربي. هذا حال البلاغة وقد دارت في فلك الشعر والقرآن، فأي حال كان سيكون لها لولاهما؟
***
حنان أوراق - المغرب
...................
[1] حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، السلسلة السادسة، المجلد 21، 1981، ص24.
2 نفسه، ص31.
3 نفسه، ص44.
4 نفسه، 153.
5 نفسه، 180.
6 نفسه، 180.
7 نفسه، 182.
8 نفسه، 251.
9 نفسه، 507.
10 نفسه، 504.