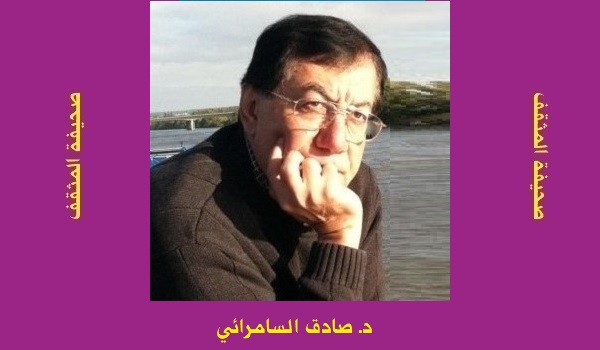قضايا
حمزة مولخنيف: الزمن الأخلاقي في عالم متسارع.. نحو فلسفة للبطء والمسؤولية

يشهد الإنسان المعاصر تحوّلا عميقا في علاقته بالزمن، بحيث لم يعد فيه الوقت مجرد إطار محايد لتتابع الوقائع، بل غدا قوة ضاغطة تعيد تشكيل الوعي، وتوجّه أنماط العيش، وتعيد تعريف معنى الفعل والمسؤولية. ففي عالم تحكمه السرعة وتُدار إيقاعاته بمنطق الأداء والفورية، يتآكل المجال الداخلي للتأمل، ويضيق الحيز الأخلاقي اللازم لاتخاذ القرار الواعي. لقد صار الزمن نفسه جزءا من منظومة السيطرة، وتحوّلت العجلة من حالة عرضية إلى قيمة مركزية، تُقاس بها الكفاءة، ويُعاد عبرها ترتيب سلم الفضائل.
ينطلق هذا المقال من فرضية مفادها أن الأزمة الأخلاقية الراهنة ليست ناجمة عن غياب القيم بقدر ما هي نتيجة اختلال الإيقاع الوجودي للإنسان، أي فقدان “الزمن الأخلاقي” الضروري لتكوّن الضمير واستقرار المعنى. ومن ثم يسعى إلى مساءلة بنية التسارع في الحضارة الرقمية، وتحليل آثارها على الذات المعاصرة، قبل اقتراح أفق فلسفي بديل يقوم على إعادة الاعتبار للبطء بوصفه ممارسة نقدية ومسؤولية وجودية، تُمكّن الإنسان من استعادة علاقته بذاته وبالآخر وبالعالم.
ولم يعد الزمن في التجربة المعاصرة، مجرد بعد محايد تتحرك فيه الأحداث، ولا إطارا فيزيائيا تتعاقب ضمنه الوقائع، بل صار قوة ضاغطة ونظاما قهريا وبنيةً مهيمنة تعيد تشكيل الوعي الإنساني وأنماط العيش وأفق المعنى. لقد انتقل الزمن من كونه شرطا للوجود إلى كونه سلطة على الوجود. وهذه النقلة الدقيقة هي التي تجعل سؤال “الزمن الأخلاقي” سؤالا فلسفيا ملحا، لا بوصفه مسألة نظرية مجردة، بل باعتباره معضلة وجودية تمس جوهر الكائن الإنساني في علاقته بذاته وبالآخر وبالعالم.
فالإنسان الحديث لا يعيش الزمن بل يُستنزف فيه. لا يسكن اللحظة، بل يُدفع دفعا من لحظة إلى أخرى. لا يتأمل الامتداد، بل يُقذف في تعاقب محموم من الوقائع حيث تصبح السرعة قيمة والتأخير رذيلة والتريث ضعفا والبطء علامة على التخلف. وكأن الحضارة التقنية قد نجحت في تحويل الزمن إلى سلعة، وفي اختزال التجربة الإنسانية إلى سلسلة من الاستجابات السريعة.
لقد سبق لهنري برغسون أن فرّق بين الزمن الفيزيائي القابل للقياس، والزمن المعاش الذي سماه “المدة” ، مؤكدا أن الزمن الحقيقي ليس ما تقيسه الساعات، بل ما تعيشه الذات في عمقها الشعوري. غير أن عالم اليوم يبدو وقد أطاح بهذا التمييز لصالح زمن واحد مسطح، متجانس، رقمي، تُختزل فيه التجربة إلى وحدات إنتاج واستهلاك. إننا نعيش كما يقول بول فيريليو، في “ديكتاتورية السرعة”، حيث لا يعود المهم هو ما يحدث، بل سرعة حدوثه.
هذا التحول ليس تقنيا فحسب، بل أخلاقي في عمقه. فالزمن السريع يعيد تشكيل منظومة القيم، يفضّل الفعل على التأمل والإنجاز على المعنى والحضور الافتراضي على العلاقة الحية، ويُقصي كل ما يحتاج إلى صبر أو إنضاج أو تراكم بطيء. هكذا يصبح التفكير عبئا، والذاكرة عائقا، والضمير ترفا لا وقت له.
في هذا السياق، يغدو سؤال الزمن الأخلاقي سؤالا عن إمكانية المسؤولية في عالم لا يمنحنا وقتا كافيا للتفكير في عواقب أفعالنا. كيف يمكن للضمير أن يشتغل في فضاء متسارع؟ كيف يمكن للقرار الأخلاقي أن يتشكل في ظل ضغط الإيقاع؟ كيف يمكن للإنسان أن يتحمل تبعات أفعاله إذا كان كل شيء يُطلب منه فورا؟.
لقد أدرك إيمانويل كانط في مشروعه النقدي، أن الأخلاق تفترض زمنا داخليا للتأمل، وأن الإرادة الحرة لا تنفصل عن القدرة على التريث. فالواجب الأخلاقي لا يُستجاب له آليا، بل يتطلب مسافة بين الدافع والفعل. وهذه المسافة هي جوهر الحرية. غير أن الحضارة المعاصرة تعمل باستمرار على تقليص هذه المسافة، عبر تسريع الإيقاع وتكثيف المنبهات وتحويل الإنسان إلى كائن ردود أفعال.
ولذلك ليس من قبيل المصادفة أن ترتبط الحداثة المتأخرة بأشكال جديدة من القلق الوجودي، وبانتشار الاكتئاب، وبالشعور المزمن بالاستعجال. فالذات المعاصرة تعيش في حالة طوارئ دائمة. كل شيء مستعجل وكل شيء قابل للتجاوز وكل شيء مؤقت. وكما لاحظ زيغمونت باومان، فإننا نعيش في “حداثة سائلة”، حيث لا تستقر القيم ولا تدوم العلاقات ولا يثبت المعنى.
لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا التسارع لا يقتصر على المجال النفسي أو الاجتماعي، بل يمتد إلى المجال الأخلاقي ذاته. فالقرارات الكبرى تُتخذ بسرعة، والسياسات تُصاغ تحت ضغط اللحظة، والحروب تُدار عبر شاشات، والمعاناة الإنسانية تتحول إلى أخبار عابرة. لقد فقدت المآسي زمنها الخاص. ولم يعد للألم إيقاعه، ولا للحزن مداه، ولا للتوبة أفقها.
هنا يستعيد قول هيدغر راهنيته القصوى حين اعتبر أن جوهر الأزمة الحديثة يكمن في نسيان الوجود. فالإنسان لم يعد يسأل عن معنى الكينونة لأنه غارق في تدبير الموجودات. ولم يعد يصغي لصمت العالم، لأنه محاصر بضجيج الشبكات. لقد صار الزمن مجرد مورد يُستثمر، لا تجربة تُعاش.
ومن ثم، فإن الحديث عن “الزمن الأخلاقي” ليس ترفا فلسفيا، بل محاولة لاستعادة البعد المفقود في التجربة الإنسانية. الزمن الأخلاقي هو ذلك الزمن الذي يسمح للفعل بأن يُفكّر فيه، وللآخر بأن يُؤخذ بعين الاعتبار، وللعواقب بأن تُستحضر. إنه زمن المسؤولية وزمن التمهل وزمن الإصغاء.
وقد عبّر إيمانويل ليفيناس عن هذا المعنى حين ربط الأخلاق بتجربة اللقاء مع وجه الآخر، معتبرا أن هذا اللقاء يفرض علينا انقطاعا في سير الزمن النفعي، ويفتح فجوة في الاستمرارية الأنانية. فالآخر لا يظهر في زمن السرعة، بل في زمن التوقف. المسؤولية تبدأ حين نتوقف.
لكن العالم المعاصر يعمل بالعكس تماما، حيث يُلغِي التوقف ويشيطن البطء ويمجّد التدفق المستمر. حتى اللغة نفسها تأثرت بهذا التحول، فصرنا نتحدث عن “قتل الوقت”، و”تضييع الزمن”، و”الاستثمار الزمني”، وكأن الزمن مادة خام، لا نسيجا وجوديا.
إن الأزمة الأخلاقية الراهنة ليست ناجمة عن غياب القيم، بل عن غياب الزمن اللازم لتفعيل القيم. فالإنسان قد يعرف ما هو الصواب، لكنه لا يجد الوقت الكافي لفعله. وقد يشعر بالتعاطف، لكنه يُستدرج بسرعة إلى موضوع آخر. وقد يعي حجم الكارثة البيئية، لكنه يُدفَع إلى استهلاك جديد.
وهنا تبرز الحاجة إلى ما يمكن تسميته “فلسفة البطء”، لا بمعنى الدعوة الرومانسية إلى الانسحاب من العالم، بل بوصفها مشروعا نقديا يروم إعادة تنظيم العلاقة بين الإنسان والزمن. البطء هنا، ليس كسلاً، بل مقاومة. ليس تأخرا، بل وعيا. ليس تعطيلا للإنتاج، بل استعادة للمعنى.
لقد نبه غونتر أندرس إلى أن قدرتنا التقنية تجاوزت قدرتنا الأخلاقية، وأننا ننتج أفعالا أكبر من قدرتنا على تخيل نتائجها. وهذا ما يجعل الزمن الأخلاقي متخلفا عن الزمن التقني. فنحن نبتكر بسرعة، لكننا لا نفكر بنفس السرعة. نغيّر العالم، لكننا لا نغيّر أنفسنا بالوتيرة ذاتها.
من هنا فإن تأسيس زمن أخلاقي بديل يقتضي إعادة الاعتبار للتأمل، وللذاكرة، وللتجربة البطيئة. يقتضي استرجاع ما سماه فالتر بنيامين “الهالة”، أي العمق الذي تفقده الأشياء حين تُستهلك بسرعة. ويقتضي أيضا مقاومة ثقافة الفورية التي تختزل الحقيقة في الخبر العاجل، والحكمة في الرأي السريع.
إن الزمن الأخلاقي هو زمن التراكم الداخلي، زمن التكوين، زمن الإنصات الطويل للأسئلة الكبرى. وهو لا يتشكل إلا حين يقبل الإنسان بأن يكون كائن انتظار، لا مجرد كائن إنجاز. وكما قال سيمون فايل: “الانتباه الخالص هو أندر وأثمن أشكال الكرم”. والانتباه يحتاج إلى زمن.
بهذا المعنى، فإن مشروع فلسفة البطء ليس دعوة إلى الهروب من الحداثة، بل محاولة لإنقاذ الإنسان داخلها. إنه سعي لإعادة التوازن بين السرعة الضرورية للحياة التقنية، والبطء الضروري للحياة الأخلاقية. لأن الحضارة التي تسرّع كل شيء، لكنها تُبطئ الضمير، إنما تسير نحو فراغ قيمي عميق.
والسؤال الذي يفرض نفسه في نهاية هذا التأسيس هو: هل ما يزال ممكنا، في عالم متسارع إلى هذا الحد، أن نستعيد زمنا إنسانيا صالحا للأخلاق؟ وهل يمكن للذات المعاصرة أن تعيد بناء علاقتها بالوقت على أساس المسؤولية لا الاستهلاك؟ أم أننا دخلنا طورا تاريخيا صار فيه الزمن نفسه معاديا للمعنى؟.
غير أن هذا الانقلاب لا يحدث اعتباطا؛ ذلك أن التسارع المعاصر ليس مجرد نتيجة عرضية للتقدم التقني، بل هو منطق كلي يغلغل في نسيج الحياة اليومية، ويعيد تنظيم العمل والعلاقات والمعرفة وحتى أشكال التديّن والتأمل. لقد بيّن هارتموت روزا أن الحداثة المتأخرة تقوم على ثلاث ديناميات متداخلة: التسارع التقني، وتسارع التغير الاجتماعي، وتسارع وتيرة الحياة. وهذه الديناميات لا تنتج فقط شعورا بالضغط الزمني، بل تخلق ذاتا “منزوعة الجذور الزمنية”، ذاتا لا تمتلك الاستقرار الكافي لبناء علاقة مستمرة مع العالم.
في ظل الرأسمالية الرقمية، لم يعد الزمن إطارا محايدا للتبادل، بل صار مادة أساسية في الاقتصاد السياسي للاهتمام. المنصات لا تبيع المنتجات فحسب، بل تستثمر في انتباه المستخدمين، وتتنافس على اقتناص ثواني وعيهم. كل إشعار هو مطالبة فورية بالحضور، وكل تمرير للشاشة هو إعادة إدخال الذات في دورة استهلاك لا تنتهي. وهكذا يتحول الإنسان إلى كائن مشتت، موزع على نوافذ متعددة، فاقد للتركيز العميق، عاجز عن الانغماس الطويل في فكرة أو علاقة أو سؤال.
وقد نبّه برنارد ستيغلر إلى أن هذا النمط من الحياة الرقمية الذي يؤدي إلى “تفقير الرغبة”، لأن الرغبة تحتاج إلى زمن للتكوّن، بينما الإشباع الفوري يفرغها من بعدها الرمزي. إننا لا نرغب بعمق، بل نستهلك بسرعة. ولا نفكر طويلا، بل نعلّق سريعا. ولا نحزن كامل الحزن، ولا نفرح كامل الفرح، لأن كل حالة وجدانية تُقطَع قبل أن تبلغ اكتمالها.
هنا تغدو الأخلاق نفسها خاضعة لمنطق التدفق. فالمواقف تُتخذ في لحظتها، والتعاطف يُمارس على هيئة “إعجاب”، والغضب يُفرّغ في تعليق، ثم يُنسى كل شيء مع الخبر التالي. لقد تحولت القضايا الكبرى إلى محتوى، والمعاناة الإنسانية إلى مادة تداولية، والالتزام الأخلاقي إلى رد فعل عابر.
وهنا تتجلى المفارقة المؤلمة: نحن نعيش في زمن تضخم فيه الخطاب الحقوقي، وتكاثرت فيه المواثيق الأخلاقية، لكن القدرة الفعلية على تحمّل المسؤولية تتآكل. والسبب في ذلك ليس في نقص الوعي، بل في اختلال الإيقاع. فالزمن الأخلاقي يتطلب بطئا بنيويا، يتطلب فسحة للتفكير في العواقب، وللاعتراف بالآخر، ولإعادة النظر في الذات. غير أن بنية العالم المعاصر تضيق بهذه الفسحة باستمرار.
لقد ربط بول ريكور بين الهوية والمسؤولية عبر مفهوم “الهوية السردية”، معتبرا أن الإنسان لا يصير ذاتا أخلاقية إلا حين يستطيع أن يروي حياته، وأن يرى أفعاله في سياق زمني ممتد. غير أن الذات المتسارعة تفقد قدرتها على السرد؛ حياتها تتحول إلى لقطات، وذكرياتها إلى أرشيف رقمي، ومستقبلها إلى سلسلة توقعات قصيرة المدى. إنها ذات بلا قصة، وبالتالي بلا عمق أخلاقي.
إن الأزمة الأخلاقية المعاصرة هي في جوهرها أزمة زمنية. إنها أزمة فقدان الاستمرارية، وانهيار الامتداد، وتآكل الصبر. فالفضائل الكلاسيكية، من قبيل الحكمة والحلم والوفاء والتواضع، كلها تفترض زمنا طويلا للتكوين. ولا يمكن اختزالها في مهارات سريعة أو كفاءات وظيفية.
وقد أدرك أرسطو منذ القديم أن الفضيلة ليست حالة آنية، بل “ملكة مكتسبة بالتعوّد”، أي ثمرة ممارسة طويلة. لكن ثقافة السرعة لا تسمح بالتعوّد، لأنها تنتقل بنا باستمرار من تجربة إلى أخرى. إنها ثقافة البدايات المتكررة دون اكتمال، والانقطاعات الدائمة دون نضج.
أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في الزمن بوصفه شرطا للأخلاق، لا مجرد مورد للإنتاج. وهنا تتقاطع الفلسفة مع الروحانية، لأن معظم التقاليد الروحية الكبرى ربطت الحكمة بالتمهل، وربطت القرب من الحقيقة بالانسحاب المؤقت من ضجيج العالم. ففي التصوف الإسلامي مثلا، يُنظر إلى “الخلوة” لا كعزلة سلبية، بل كاستعادة للإيقاع الداخلي. وفي المسيحية التأملية، يُعتبر الصمت طريقا للإنصات الإلهي. وفي البوذية، يُنظر إلى اليقظة بوصفها حضورا كاملا في اللحظة، لا استعجالا للنتائج.
غير أن فلسفة البطء التي ندعو إليها هنا ليست انسحابا صوفيا من الواقع، بل ممارسة نقدية داخل العالم. إنها محاولة لإعادة التوازن بين الفعل والتأمل والإنتاج والمعنى، وبين السرعة التقنية والبطء الإنساني. البطء بهذا المعنى، ليس نقيض الحركة، بل شرط الوعي بالحركة. إنه المسافة التي تسمح لنا بأن نسأل: لماذا نفعل ما نفعل؟ ولمن؟ وبأي ثمن؟.
وقد عبّر إدغار موران عن هذا المطلب حين دعا إلى “إصلاح الفكر” قبل إصلاح المؤسسات، معتبرا أن تعقيد العالم المعاصر يقتضي تفكيرا بطيئا، تركيبيا، قادرا على الربط بين المستويات المختلفة للواقع. فالمشكلات الكبرى من قبيل الأزمة البيئية أو تفكك الروابط الاجتماعية، لا تُحل بمنطق الاستعجال، بل تحتاج إلى زمن طويل من الفهم المشترك.
إن الزمن الأخلاقي الذي ننشده هو زمن يسمح بإعادة وصل الإنسان بالطبيعة، وبالتاريخ، وبالآخر. زمن يعترف بالحدود ويقبل الهشاشة ويعيد الاعتبار للانتظار بوصفه فعلا إيجابيا. ففي الانتظار يتكوّن المعنى، وفي التأجيل تُختبر الرغبة، وفي الصبر تتربى الإرادة.
ولعل من أهم ملامح هذا الزمن البديل استعادة مركزية المسؤولية. فالمسؤولية ليست مجرد التزام قانوني، بل علاقة زمنية بالآخر، بمعنى أن أتحمل أثر أفعالي في الحاضر والمستقبل، وأن أعي أن كل قرار هو امتداد لسلسلة طويلة من الأسباب والنتائج. وهذا ما قصده هانس يوناس حين صاغ مبدأ المسؤولية في سياق الحضارة التقنية، داعيا إلى أخلاق تستشرف العواقب البعيدة لأفعالنا، خصوصا تجاه الأجيال القادمة.
غير أن استشراف المستقبل يتطلب خيالا أخلاقيا، والخيال يحتاج إلى فراغ زمني، إلى مساحات غير مشغولة بالإلحاح اليومي. ولذلك فإن إعادة بناء الزمن الأخلاقي تمر عبر مقاومة الاستعمار الكامل للحياة من طرف منطق الأداء. وتمر عبر استعادة لحظات الصمت، وطقوس البطء، وأزمنة القراءة العميقة، والحوار غير المستعجل.
إن فلسفة البطء في أفقها العملي، تقتضي أيضا إعادة النظر في التربية وفي تنظيم العمل وفي علاقتنا بالتكنولوجيا. فالتربية التي تُلقّن ولا تُمهل تُنتج عقولا سريعة وفقيرة. والعمل الذي لا يعترف بالإرهاق الوجودي يُنتج ذواتا محترقة. والتكنولوجيا التي لا تُضبط أخلاقيا تُسرّع التفكك بدل أن تعزز التواصل.
إن الزمن لم يعد مجرد خلفية صامتة لتجربتنا الإنسانية، بل صار الفاعل الخفي الذي يعيد تشكيل معنى الذات وحدود المسؤولية وإمكان الأخلاق. لقد دخلنا مرحلة تاريخية يتقدم فيها الزمن التقني بسرعة تفوق قدرة الوعي الأخلاقي على المواكبة، فنتج عن ذلك اختلال عميق في الإيقاع الوجودي للإنسان.
هذا الاختلال لا يظهر فقط في مظاهر التوتر والقلق والتشتت، بل يتجلى أساسا في تآكل القدرة على التمهل وعلى الإصغاء، وعلى بناء علاقة مستمرة مع العالم. إن الإنسان المتسارع هو إنسان مهدد بفقدان العمق، لأن العمق يحتاج إلى زمن، والزمن صار نادرا.
ومن هنا فإن استعادة الزمن الأخلاقي ليست مسألة فردية فحسب، بل مشروع حضاري. إنها تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، والاعتراف بأن ليس كل ما هو ممكن تقنيا مرغوب أخلاقيا، وأن ليس كل ما هو سريع جدير بالاتباع. إنها دعوة إلى إعادة الاعتبار للبطء بوصفه فضيلة معاصرة، وإلى المسؤولية بوصفها جوهر الإنسانية.
فالزمن الأخلاقي هو الزمن الذي يسمح لنا بأن نكون بشرا كاملين، نفكر قبل أن نتصرف، ونشعر قبل أن نحكم، ونتذكر قبل أن ننسى، وننتظر قبل أن نستعجل. وهو زمن لا يُقاس بالساعات، بل بعمق التجربة، ولا يُستثمر بل يُعاش.
ولعل التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم هو كيف نعيش داخل عالم السرعة دون أن نصير أبناءه بالكامل، كيف نستعمل التكنولوجيا دون أن نُستعمل بها، وكيف نحافظ على بطء القلب وسط تسارع الآلات. إن مستقبل الأخلاق مرهون بقدرتنا على إعادة امتلاك الزمن، لا بوصفه موردا، بل بوصفه أفقا للمعنى.
فإما أن ننجح في تأسيس إيقاع إنساني جديد، يوازن بين الحركة والتأمل والفعل والمسؤولية، وبين الحضور الرقمي والحضور الوجودي، وإما أن نستسلم لمنطق التسارع الشامل، فنخسر تدريجيا ما يجعلنا بشرا، القدرة على التمهل وعلى الرحمة، وعلى التفكير العميق.
وفي هذا المفترق التاريخي الدقيق، يصبح البطء فعل مقاومة، والمسؤولية شكلا من أشكال الشجاعة، والزمن الأخلاقي أفقا مفتوحا لإعادة بناء إنسانية تتداعى.
***
د. حمزة مولخنيف