قضايا
علجية عيش: التراث، النهضة والأنسنة.. إشكالية حيّرت المفكرين
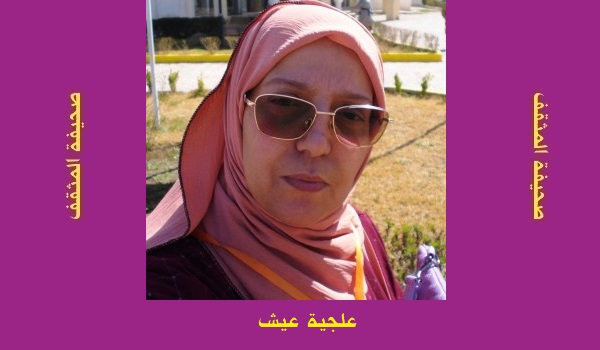
مالك بن نبي اختلف مع محمد أركون في مفهوم الإنسانية
سؤال حول اختفاء النزعة الإنسانية من الفكر الإسلامي؟
عندما نطالع كتابات مفكرين كمالك بن نبي ومحمد أركون والجابري وعلي حرب وغيرهم حول إشكالية التراث والنهضة نجد أن مالك بن نبي له رؤية دفاعية، بينما تختلف عن رؤية محمد أركون للتراث فهي رؤية نقدية لدرجة أنه يدعو إلى إحداث ثورة فكرية تذهب إلى حد البحث في الأشياء والنظرة للتراث، والتراث يعني التمسك بكل ما هو قديم أو أصيل ومنه ظهرت النزعة الأصولية التي تقف ضد الحداثة التي يرى دعاتها أن التراث ما هو إلا تقليد للماضي، ويستحيل إعادته بحكم تغير الظروف والأزمنة لأن العصر هو عصر الرقمنة، في نفس الوقت ينظر كل منهما إلى النهضة على أنها البوابة للإقلاع الحضاري، والإقلاع يعني مسح شامل للتراث، وهو الذي تحدث عنه المفكر محمد أركون في مشروعه نقد العقل الإسلامي رغبة منه في فهم الدين وخاصة الإسلام كما ذهب إلى ذلك مفكرين أخرين
فالتراث عند محمد أركون كما يقول الدكتور إسماعيل عرّاب يحدد المكوّن الأساسي لمشروعه العقل العربي الإسلامي الذي ظل سجين مناخ العقل "القروسطي " بالرغم من أهميته، وقد بيّن محمد أركون هذه المعضلة في كتابه قضايا في نقد العقل الديني، إذ يرى أن تقليد التراث لا يوصلنا إلى الهدف الرئيسي لبلوغ الحداثة ونحن بذلك نبقى في اجترار المفاهيم والمصطلحات ولا نصل إلى حلّ لمفهوم التغيير والإقلاع والانطلاق وهذه المفاهيم يمكن اختصارها في كلمة واحدة هي النهضة، فهذه المفاهيم تحتاج إلى ضبط خاصة ما تعلق بمفهوم التجديد في الدين وهذا يعني إزالة الثوابت التي علقت به، ما دفع بالبعض إلى اتهامه بالزندقة والإلحاد، وهنا وجب التفريق بين نقد العقل الإسلامي ونقد العقل الإلهي، كقوة روحية، في حين يرى الأصوليون أن التجديد محمودٌ، أمّا إن كان يقصد به الاستبدال، أي استبدال نظام إسلامي بنظام حداثي كمن يستبدل قطع غيار محلي بقطع غيار مستورد من أنظمة غربية فهذا مرفوض عندهم، فقد يكون التجديد في الوسائل، لأنها تختلف وتتغير باختلاف العصور، ولعل التجديد والنهضة يراد بهما الخروج من دائرة الجهل والتقليد، فالجزائر مثلا كما جاء في كتاب شروط النهضة لمالك بن نبي كانت حتى عام 1925 على الرغم من إسلامها تدين بالوثنية التي كانت نصيبها في الزوايا وكأنها عادت إلى الجاهلية الأولى ما قبل ظهور الإسلام، فالجهل يقول مالك بن نبي في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا بل ينصب اصناما، ولا يؤسس نهضة أو حضارة، وهذا ما دفع محمد أركون إلى نقد العقل العربي الإسلامي لاكتشاف بنيته وبأسلوب حيادي، فلا يقف مع عقيدة ضد عقيدة أخرى، فالمشروع عنده كما يقول الدكتور اسماعيل عراب تاريخي أنثروبولوجي ضمن فضاء ثقافي فلسفي، ففي كل بحثوه يطرح محمد أركون سؤال: اين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟
يُفُهَمُ من هذا السؤال أن الفكر الإسلامي القديم يريد أن يُثَبِّتَ مكانه ويفرض نفسه بواسطة الخطاب الديني، ولو أن هذا الخطاب في بعض جوانبه لم يعد يتماشى والعصر الذي نحن فيه (عصر الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي والرقمنة، حتى الحروب لم تعد بالسيف، ونحن نعيش الحرب النووية) أي ان العالم يشهد تقدما وتطورا، والإنسان يتجاوب مع هذا التطور والإزهار بشكل غريب جدا، حتى ابن البادية لم يعد يسافر على ظهر الجمل، بل يستعمل النقل الجوّي، وأصبح يستعمل التكنولوجية في إرسال الرسائل وليس عن طريق حمام الزاجل، فما يزال بعض السلفيين المتعصبين يفرضون على جيل اليوم (جيل الأيفون) منطقا، فهذا الجيل في المنظور السلفي يعيش استعمارا فكريا وله القابلية لأن ينسلخ من جلده ويرتدي جلدا جديدا حتى لو كان لا يتناسب مع مقاسه، في الواقع أن فئة من جيل اليوم تريد الانفتاح على الأخر وما قدمته التكنولوجية، بحيث يرى أن العيش في الدائرة الإسلامية رجعية وتضييق على تفكيره وتقييد لحريته، وهذا له سبب واحد هو أننا انتقلنا من العائلة الكبيرة إلى الصغيرة، ودور الأسرة في تحرّر هذه الفئة ومعظمها شباب، الذي اصبح يطالب بحرية العيش على الطريقة التي يريدها هو، وليس العائلة، لأنه متأثرا بالحياة الغربية التي تعطي الحق للشاب أو الفتاة أن يستقل عن عائلته ويسكن بمفرده قبل الزواج بمجرد أن يبلغ سن الـ: 18 سنة، فالعولمة فتحت أبوابها ونوافذها للشعوب لكي تنفتح على الحداثة وتتخلى عن حياة رجل الصحراء والرجل الدرويش واستعمال العصا في تربية الأبناء .
لماذا اختفت النزعة الإنسانية من الفكر الإسلامي؟
و المتأمل في أفكار مالك بن نبي ومحمد أركون يقف على أنه الاثنان يختلفان في مفهوم الإنسانية، فمالك بن نبي ارتكزت بحوثه ودراساته على فكرة الإنسان كشرط أساسي في بناء الحضارة، في حين لمحمد أركون له رؤية مختلفة، فهو يرى أن الحضارة تقتضي أنسنة الإنسان، فهو يرى (أي أركون) أن إحياء الأنسنة ضرورة للتحرر الفكري، وقد أشار إسماعيل عراب إلى هذه المسألة في كتابه " محمد أركون من ضرورة حتمية إلى مشروع حضاري صدر عن دار الأيام عمان الأردن، وهذا يؤكد أن محمد أركون تغلب عليه النزعة الإنسانية، أما مالك بن نبي فهو عقلانيُّ النزعة، تشير الدراسات أن النزعة الإنسانية اختفت من ساحة الفكر الإسلامي، وقد تحدث محمد أركون عن هذه النزعة في كتابه: " تحرير الوعي الإسلامي من السياقات الدوغماتية المغلقة"، إذ يرى محمد أركون أن الثقافة العربية الإسلامية كانت سبّاقة في معرفة النزعة الإنسانية عن ثقافة الغرب، لكنها وصلت إلى الغرب متأخرة، فهي عاشت الموقف الأنسي في القرن العاشر ميلادي ووصلت إليه متأخرة بستة قرون، ما دفع بأركون إعادة قراءة هذه النزعة والتفكير فيها لمعرفة سبب تأخرها وانقراضها في المجتمعات الإسلامية، يلاحظ أن أركون يسير على خطى التوحيدي الذي كان يكافح من أجل حرية الفكر والمعتقد، لكن هذه الحرية لا تنزع القداسة من المقدس أو تدنيسه.
في كتابه "الصّفحات السُّود لمدرسة التغريب والحداثة والتنوير" يهاجم الدكتور محمد عبد الشافي القوصي الحداثيين الذين يسعون لإقناع الأمة الشرقية بأنها أمّة متخلفة في تاريخها وصميم تكوينها، متخلفة في جوهرها ومن ثمّ لابد من انسلاخها تماما عن كل ما يربطها بماضيها من ناحية المظاهر السلوكية، ربما هو محق، فنحن نرى بعض من عناصر التيار الإسلامي متشددين في لباسهم، (أقول بعضهم وليس كلهم حتى لا يساء فهمي) بعضهم يتركون لحاهم تطول دون تنميق، وقطرات عصير أو لبن أو بقايا الأكل بين الشعيرات وشعرهم غير مصفف، مثل الدراويش أو أنهم في غابة، وهم بذلك يشوّهون صورة الإسلام ونبيه محمد صلّ الله عليه وسلم، ونسوا قول الله تعالى : " وأما بنعمة ربك فحدث" فيما معناه، ( إن الله جميل يحب الجمال)، ولو سألته يقول لك هذا من التراث، فما نراه من بعض المظاهر التي لا صلة لها بديننا وبسيرة نبينا (صلعم) تعبّر عن الجمود والتحجر والتعصب، ومن هذا المنطلق وليس دفاعا عن محمد أركون، نستنتج أن نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون لا يعني زحزحة النموذج أي الإسلام ونزع منه القداسة، فهو دين سماوي كبقية الأديان الأخرى (المسيحية واليهودية) وأن قراءتنا للإسلام لن تكون كافية إذا تعلق الإنسان المسلم بالتراث ويذوب فيه دون أن يتطلع إلى العالم الخارجي، ويهمل العلوم الأخرى، خاصة وأنه ولد في زمن غير الزمن الذي عاش فيه من سبقوه من الأوائل، ولا يعني هذا أن نترك التراث، لكن من الواجب مراجعته ونقد جزءًا منه نقدا بنّاءً، في الواقع أنني كلما فتحت كتابا يناقش هذه المسائل إلا وأجد نفسي وسط معركة المفاهيم والمصطلحات، فهناك مثلا من يرى أن مصطلح النقد الجديد يختلط مع مصطلح الحداثة، ومصطلح العبثية يختلط مع مصطلح العدمية واللاشيئية، كما أشار إليها محمد عبد الشافي، فهذه المفاهيم مفهومة ولا غبار عليها، فالعبثية (من وجهة نظري) تعني التلاعب بالأفكار والكلمات وتمييعها، أما العدمية واللاشيئية فهما ربما يخدمان معنى واحد هو اللا موجود أو اللاوجود، وإن كانت الحداثة الغربية عند الدكتور الشافي قصي تعني اللاوجود، وهذا يعني أنها تدعو إلى الإلحاد أو اللادينية، والسؤال هو كالتالي: ماذا عن الحداثة من المنظور الإسلامي؟ وما موقف الإسلاميين منها؟ وما موقف الحداثيين العرب؟، الجواب نقول أن الحداثة هي عمل تنويري، وقد نقف هنا مع أركون حين قال أن العمل التنويري لا يتحقق في العالم الإسلامي من دون التوسع في مجال الأنسنة ونقلها.
مالك بن نبي والتجديد
لنعد إلى مالك بن نبي ومشكلته الحضارية، فمالك بن نبي نجده في معظم كتاباته يعود إلي راي المفكرين الغربيين وذلك من باب المقارنة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، والنتيجة التي خرجة بها مالك بن نبي هي أن الغرب صنع حضارته على أنقاد الحضارة الإسلامية فيما نسميه بالاستيلاب الحضاري، أي أن الغرب سرق الفكر العربي وإنجازاته، واغتصب ارضه ليبني دولة غير شرعية ويؤسس حضارة مزيفة قامت على القمع والعنف والتجويع، مثلما نراه الأن في غزة، إن التجديد الذي دعا إليه مالك بن نبي لا يخرج عن إطار الحداثة، لكن ليست الحداثة الغربية التي فهمها البعض وهي تنكر الإنسان لأصله وكما يقال لا أصل لمن تنكر لأصله، لقد كشفت الحروب الأهلية عورة المسلمين، فلا الأنظمة أنظمة في المستوى ولا المعارضة في مستوى المعارضة، لقد بالغ خصوم الحداثة في نقدهم للحداثة بل في مواجهتها، ووصل بهم الأمر أن يقولوا أن الشِّعر الحر كفرٌ، يريدون بذلك قتل الذوق والجمال والإبداع وكل ما له علاقة بالإحساس، ما يهمنا هنا هو " الفكر"، بغض النظر عن كون صاحبه إسلامي، علماني، ملحد أو بوذي، صهيوني، لأن الفكر لا دين له ولا جنسية، والسؤال: هل يجوز لنا ان نحكم على النقاد بأنهم كفار؟ ومن له الحق في تكفير الأخر؟، فظاهرة التكفير جرّت الأمّة إلى المآسي بعدما قامت جهة بتحويل الأفراد إلى نباتات نُزعت من الأرض وهي ما تزال في طور الإنتاش قبل أن تكون لها القدرة على النمو والازدهار، هذه النباتات هم الشباب من هذا الجيل الذي وجد نفسه يتخبط بين أوساط تدعو إلى الحداثة وأخرى تطالب بالتمسك بالتراث والأصالة، حيث لا يمكنه أن يتحرك إلا بأوامر تُفْرَضُ عليه، أي أنه يكون مبرمجا من قبل جماعة أساءت الفهم للإسلام فظلت الطريق، والسؤال : هل الحداثيون زنادقة فعلا؟، كما يلقبونهم خصومهم، وهل هم دعاة للتمرد؟ أم لأنهم كذلك (في نظرهم) لأنهم كشفوا زيف بعض التراثيين (داعش) الذين أساءوا للإسلام وشوهوا صورته، حتى اصبح الغرب ينعت الإسلام بأنه دين عنف وتطرف.
نختلف هنا مع الدكتور إسماعيل عراب عندما انتقد محمد أركون بأن الأنسنة في جوهرها انتقال من عالم يسيطر فيه المقدس إلى عالم يسيطر فيه الإنسان، فمحمد أركون يرى أن المقدس الديني أقوى المقدسات، وهو ما ذهب إليه مالك نبي في دراسته المشكلة الحضارية حيث ربطها بالفكرة الدينية باعتبارها مقدسة، وفي هذا نقول أن الأنسنة هي إيجاد توافق بين المقدس واللا مقدس (وليس المدنس) ولا نقصد التوافق هنا بـ: "الندّيّة"، وإنما الجمع بين الحداثي والتراثي، كما يقول المودودي، أي كل رطب ويابس من عناصر الأمّة على رصيف واحد ويتخذ من كل العناصر الصالحة والفاسدة كتلة متضامنة تنفتح فيها روح قومية وتكون لهم سلطة مركزية وحرس قومي وجندٌ قومي وتتكون لهم دولة قومية من الأقطار التي تكون لهم فيها الأغلبية عملا بالمبدأ الجمهوري المعروف (الحكم للأغلبية)، فمالك بن نبي لا يمانع تشكيل وحدة العالم العربي لكنه ينظر إليها من حيث تخلف المجتمع، ولذا هو يرى أنه إن تتظافر الجهود وتضامن العالم العربي لحل مشكلاته يمكنه أن يحقق السيطرة ما دفعه إلى تشكيل كومنولث إسلامي.
الخلاصة
خلاصة القول ان محمد أركون دعا إلى نقد العقل الإسلامي، أي نقد الخطاب الإسلامي المبني على التناقضات (المبطن والمعلن عنه) ولم يدع إلى نقد الدين، لأن الدين ثابت، اللهم إن تعرض للتحريف (ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله)، أما بالنسبة للإسلام فهناك من أعطى للإسلام أسماء عديدة كالإسلام الأصولي والإسلام الحضاري أو الحداثي، والإسلام السياسي وما إلى ذلك، تعرض فيها الإسلام إلى التأويل، وما وقع من حروب أهلية إلا نتاج التراكمات التأويلية وظهر ما يسمى بخطاب السيف في كل الأقطار العربية أصبح الإسلام كدين سماوي بحاجة إلى أسلمة وأنسنة.
***
علجية عيش - بتصرف







