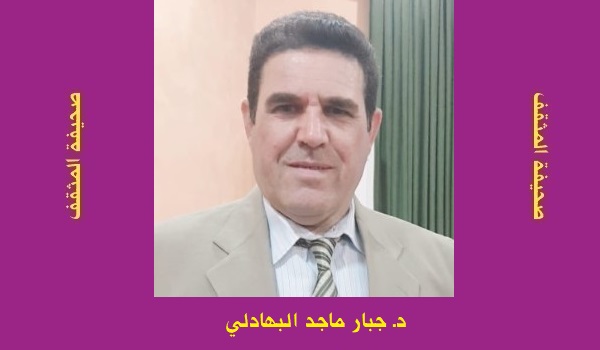قضايا
سجاد مصطفى: طواف الروح حول سرّ الإيمان المفقود
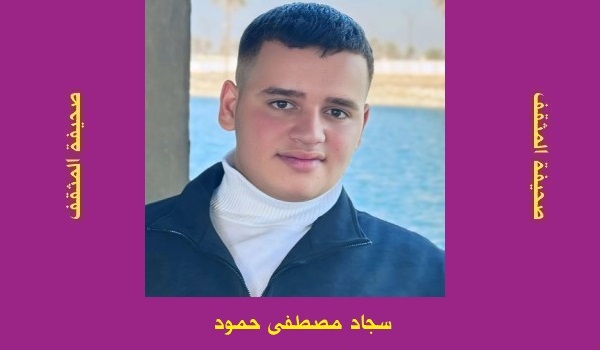
مسارات لا شعورية نحو النور الخفي
خدعة الإيمان: من المسلّمات إلى المساءلة
الإيمان ليس فعلًا حرًّا كما يُصوَّر، بل نتيجة تلقّي طويل، يجري في مستوى اللاوعي تحت تأثير البيئة التي نشأنا فيها. نحن لا نختار ما نؤمن به. نحن نُبرمج عليه، ثم نُقنع أنفسنا لاحقًا بأننا اخترناه. المشكلة ليست في الفكرة، بل في الطريقة التي تسرّبت بها إلى وعينا. الفرد لا يولد حاملًا لأي معتقد. كل ما يعتقده لاحقًا هو نتاج تراكم: أسرة، تعليم، إعلام، محيط، سلطة. إنه ينتمي قبل أن يختار، ويصدّق قبل أن يسأل، ويدافع قبل أن يفهم.
محور أوّل: الإيمان كتشكيل لاواعي
السؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرح على كل ما نؤمن به هو:هل هذه القناعة هي ثمرة تفكير واعٍ؟ أم أنها جزء من تشكيل ذهني سبق حريتنا في التفكير أصلًا؟ ثقافتنا لا تسمح للوعي بأن ينمو في بيئة نقدية، بل تُنشئه في سياق يُعيد إنتاج نفسه:
ما تعتقده الأسرة يصبح ما تؤمن به المدرسة. وما تصوغه المدرسة يصبح ما يُكرَّر على المنبر. وفي نهاية المطاف، يصبح "الإجماع" هو معيار الصحة. هكذا تتحول الثقافة إلى نظام مغلق يحرس نفسه من الداخل. كل انحراف عن هذا النظام يُوصف بالضلال، أو الشذوذ، أو الجهل. ولذلك يندر أن يسأل الناس أنفسهم: لماذا نعتقد ما نعتقده أصلًا؟ لأن السؤال ذاته صار محرّمًا.
محور ثانٍ: وهم اليقين وحقيقة التلقين
إنّ أخطر ما تصنعه الثقافة المهيمنة، أنها تمنحك شعورًا باليقين دون أن تمرّ بعملية التفكير. فتعيش الوهم مرتين:
1. بأن ما تؤمن به هو الحقيقة. 2. بأنك وصلت إليه بإرادتك. بهذا المعنى، ما نؤمن به ليس ضرورةً عقلية، بل نتيجة لاصطفاف قسري داخل معايير المجتمع. تسمّيها الجماعة "هوية"، لكنها في حقيقتها مجرد مجموعة قناعات غير مفحوصة، تم تلقينها مبكرًا.
أخطر أنواع الإيمان هو الإيمان الذي لا نعرف كيف بدأ. لأن كل قناعة لا نستطيع تتبّع أصولها، لا يمكن الوثوق بها. وأي اعتقاد لا يُحتمل زعزعته، ليس جديرًا بالبقاء. إذا لم نسأل أنفسنا: هل اخترنا هذا الإيمان؟، فسنستمر في إعادة إنتاجه جيلًا بعد جيل، ونمنحه قداسة ليست له، ثم نقمع به غيرنا، ونكبت به شكوكنا.
خاتمة أولى: لحظة المساءلة
ما نؤمن به اليوم ليس دائمًا انعكاسًا لحقيقتنا، بل كثيرًا ما يكون بقايا تشكيلٍ لم نختره. التحرر لا يبدأ بإضافة أفكار جديدة، بل بإخضاع الأفكار الموروثة للمساءلة. فالمشكلة ليست في أن نؤمن... بل في أن نؤمن دون أن نعرف: لِمَ آمنّا؟ وكيف؟ ومتى؟
محور ثالث: التفكيك كشرط أولي للفهم
الوعي الحقيقي لا يبدأ من تراكم المعلومات، بل من القدرة على تفكيك المسلّمات. ذلك أن القناعة غير المفحوصة تمثّل عبئًا معرفيًا، لا ميزة فكرية. التفكير النقدي لا يتطلب عداءً مع البيئة، بل موقفًا مستقلًا عنها. والتفكيك لا يعني العدوان، بل تحرير الفكرة من شروطها المسبقة. حين تسأل: لماذا أؤمن بهذا؟ فأنت تمارس تفكيرًا غير اعتيادي. لأن السؤال يُهدّد البُنى الراسخة، ويكشف أن كثيرًا من معتقداتك ليست حقائق، بل نتائج تَطبيع ثقافي طويل.
محور رابع: لا تُقاس القناعة باليقين
اليقين شعور... وليس حجة. أن تشعر بأنك على حق لا يعني أنك كذلك. التاريخ مليء بيقينيات قادت شعوبًا بأكملها نحو الهاوية. فلا تجعل من شعورك بالأمان دليلاً على صحّة الفكرة. فأكثر الأفكار خطورة هي تلك التي تُشعرك بالأمان المطلق، وتمنعك من أن تسأل أصلها. إنّ وجود آلاف الناس الذين يشاركونك نفس الإيمان، لا يعني شيئًا سوى أن المنظومة التي صنعتهم، هي ذاتها التي صنعتك. التكرار لا يصنع الحقيقة... بل يُخدّر بها الوعي.
محور خامس: الحريّة لا تبدأ من الخارج
لن يتحرر الإنسان، قبل أن يتحرر وعيه من شبكة المسلّمات التي زرعتها ثقافته فيه. فأنت لن تكون حرًّا، حتى لو سقطت كل السلطات من حولك، ما دمتَ خاضعًا للسلطة التي تعيش في داخلك. تلك التي جعلتك تؤمن بشيء دون أن تفكر فيه، وتدافع عنه دون أن تفهمه.
محور سادس: من الإيمان الموروث إلى الفهم المكتسب
إذا كان التفكيك هو الشرط الأولي للتحرّر، فإن إعادة بناء الذات لا تقل صعوبة عنه. الشكّ وحده لا يكفي. لا يُطلب من الإنسان أن يهدم فقط، بل أن يُعيد بناء وعيه على أساسٍ جديد، لا يقوم على الوراثة، بل على الفهم. كل فكرة تُبنى بعد التفكيك، يجب أن تمرّ باختبارين صارمين:1. هل اخترتها بحرّية؟2. هل تفهمها بعمق؟أي معتقد، قيمة، أو موقف، لا يمرّ بهذين الشرطين، يُعدّ استمرارًا للخداع الثقافي، مهما بدا مقبولًا. المسألة لا تتعلق بصواب الفكرة، بل بشرعية الطريق الذي وصلت به إليها. ليس المهم أن تصل إلى الحق، بل أن تصل إليه كحقّ، لا كإرث. الانتقال من الإيمان الموروث إلى الفهم المكتسب، يعني أن تبدأ من اللايقين المدروس لا من اليقين المحفوظ. أن تبني موقفك بعد الفحص، لا أن تردّده لأنه مألوف. وأن تختبر علاقتك بأفكارك، لا أن تنصاع لعلاقتك بمُلقنيك.
محور سابع: بناء الذات واسترداد العقل
لا تُبنى الذات الحرة عبر الإجماع، بل عبر المواجهة. لن تتطور شخصيتك المعرفية إذا بقيت تبحث عن مَن يُوافقك، بدل أن تبحث عمّا يُوقظك. كل من يعيش داخل منطقة الأمان الفكري، سيظل يدور حول نفسه، ظانًا أنه يمشي للأمام. أنت لم تُخلق لتوافق، بل لتفهم. ولا قيمة لأي إيمان، إذا لم يكن مسبوقًا بفحص، ومحمولًا على فهم، ومفتوحًا على المراجعة. الوعي لا يُقاس بكثرة المعلومات، بل بقدرتك على رفض ما لم تفكر فيه بحرية. والفهم لا يعني أن تؤمن بشيء…بل أن تعرف لماذا لا تؤمن بغيره.
خاتمة المقال: ما بعد الصدمة
إن ما تؤمن به ليس دائمًا نتاجك، بل نتاج من سبقك. ما لم تتوقف لتُعيد تقييم هذا الإيمان، ستظل تعيش داخل وعي غيرك، باسم قناعتك أنت. نقطة البداية هي الشك، ونقطة التحوّل هي التفكيك، ونقطة النضج هي الفهم الذي تصل إليه بقرارك، لا بوصاية المجتمع. لا تورِّث أبناءك أفكارك. ورِّثهم الشجاعة ليسألوا إن كانت تستحق أن تبقى.
***
الكاتب: سجاد مصطفى حمود