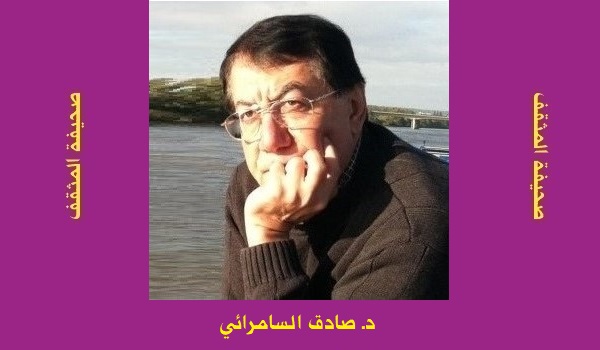قضايا
مجدي إبراهيم: خصائص الخطاب النبوى (2)

كان أبو الفتح عثمان ابن جنّي، صاحب «الخصائص»، يعتقد أنّ اللغة، بأصولها وأصواتها التي تمثلها الأبجديّة، إنما تقدّم احتمالات لا نهاية لها من الألفاظ التي ترمز إلى معاني، وأن تقلبات اللفظ الواحد تؤدي إلى معان مُتقاربة اعتماداَ على ما كان قرَّره من وجود علاقة بين اللفظ ومدلوله؛ الأمر الذى يتأكد معه أن الألفاظ تقدّم صوراً ضئيلة جداً من المعاني، وأن المعاني على كثرتها تقدِّم صوراً ضئيلة جداً للحقائق، والحقائق، كما تقدَّم، في عظمتها وجبرتها لا تدرك كل الإدراك، ولا يُحاط بها كل الإحاطة وليس يشمُّ منها أحد رائحة سوى بمقدار ما تتجلى به عليه.
وأبلغ منه وأوضح وأقدر دلالة ما يقوله «عبدالقاهر» في «دلائل الإعجاز» من أن الألفاظ لا تُعطى ما ورائها من الحقائق ولا تتجاوز مستواها، فكأنما هي محدودة بحدودها : (إنّما الألفاظ أدلة على المعاني، وليس للدليل إلا أن يُعلمك الشيء على ما يكون عليه. أمّا أن يصير الشيء بالدليل على صفة لم يكن عليها؛ فما لا يقوم في عقل ولا يتصوَّر في وهم).
ويُلاحظ في البيان النبوي خاصّة استواء الألفاظ مع المعاني مع الحقائق استواءً يتحوّل معه التعبير اللفظي إلى حقيقة ماثلة كأنك تراها وتسمعها بالحس المباشر والتجربة المشهودة.
هنالك تتحوّل الكلمات إلى حياة، وتُعاش الحياة في ظلال من المعاني المتصلة بالحقائق، فلا يتصور في الخطاب النبوي خاصّة وجود هوة وسيعة بين الحقيقة والمعنى، ولا بين اللفظ والمباشرة العمليّة.
تأمل وصيته عليه السلام من حيث قال : أكنز هذه الكلمات (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك. وأسألك شكر نعمتك، وحُسن عبادتك. وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب).
ألفاظ في كلمات غير أنها متصلة من طريق التجربة العمليّة بالحقائق من فورها، تباشرها التجربة؛ لتتحول خلاها الكلمة إلى حياة قائمة بالفعل، بل هى ألفاظ حقيقة لا تغايرها الحقيقة بل تباشرها وتمسُّها من قريب.
وممّا جاء من خطبه، صلوات الله وسلامه عليه، فيما رواه ابن جرير وابن كثير من خطب المدينة تركيزها على التقوى والتحذير من ضدها : (اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنّه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً، ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً، وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله.
قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا، وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسمّاكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله، فأكثروا من ذكر الله، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
وكانت أول خطبة خطبها النبي، صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة، جاء فيها التحذير من غضب الله والتشديد على تجنب عقابه، (فمن استطاع أن يقي وجهه من النار، ولو بشق تمرة، فليفعل، ومن لم يجد فكلمة طيبة، فإنّ بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف).
ولم يعرف العرب خطاباً أقدر على البلاغة وجمال العبارة فى إيجاز لا يخل كما جاء في الخطاب النبوى : ويظهر ذلك في الكتب والرسائل التى كانت تصدر عن النبي، عليه السلام، كما يظهر فيما جدّ من تعبيرات وأساليب جديدة كقوله عليه السلام: » الآن حمى الوطيس»، «مات حتف أنفه»، «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، «إياكم وخضراء الدّمن»؛ إلى غير ذلك ممّا رواه الثقات أنه لم يسمع من أحد قبله عليه السلام؛ الأمر الذى لا يشك أحد في أنه صلوات الله عليه، بلغ الغاية فى الفصاحة؛ لأنه نبت من قريش وهم أفصح العرب، واسترضع في بنى سعد وهم من الفصاحة بمكان؛ إلا أن ذلك لا يمنع من أن يُظاهر القرآن الوراثة والبيئة.
وليس من شك في أن للقرآن الأثر الأكبر في فصاحته عليه السلام؛ فلولاه لكانت فصاحته فى حدود بيئته، فلا نسمع منه مثل هذه المعاني الإسلامية في تلك الأساليب القرآنية ممّا لم يكن يعرفه العرب، ولم يكن يختبروه.
وعليه؛ فالخطاب النبوي خطاب حقائق، دائم الصحة وصادقها، وهو حق في حق من حق، وليس هو بخطاب لغة يتقرّر فيها الخطأ والصواب، والحق والباطل سواء، لأن اتصاله بالحقيقة يعجز اللغة ويمنعها عن الانحراف.
(وللحديث بقيّة)
***
مجدي إبراهيم