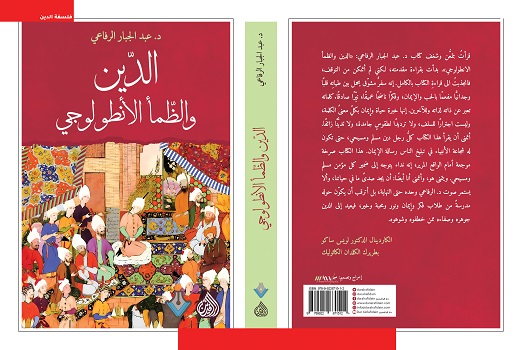قضايا
السياسةُ وفَنُّ صناعة وتسويق القطع الشطرنجيّة

السياسةُ مفهومٌ يحمل في طيّاته دلالات ومعاني متعددة، إلا أنَّ عنوانه الأبرز يدور في حدود العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فيسوس من خلاله السياسون ما يُصلح أمرَ البلاد ويدبّر شؤون العباد من خلال قوانين وقرارات تقرها سلطة تشريعية، وطرق وإجراءات تعمل عليها سلطة تنفيذية ملزمة لجميع أفراد المجتمع. فهي إذن منظومة متكاملة ومنسجمة بين جميع عناصرها، تقوم على أركانِ الفصل بين السلطات، ورفضجميع أشكال الاستبداد، وترسّخ مفهوم التداول السلمي للسلطة.
والسياسة الناجحة هي تلك التي تعمل على الاستفادة من الماضي، واستثمار فرص الحاضر، والتخطيط الاستراتيجي لمستقبل واعد.
وبناءً على هذه الحقائق، فقد تمّ تصنيف السياسيين إلى ثلاث أصناف، الأول هم أصحابُ الفكروالعقيدة، ممن يحملون القِيَم والمبادئ والمُثل ويعملون على ترسيخها في واقع المجتمع الذي يحكمونه. والصنف الثاني هُم أولئك الذين امتهنوا السياسة واحترفوها واعتاشوا على مكتسباتها، وأما الصنف الثالث، فهم الفاسدون والمفسدون، والمخادعون والسارقون، يرفعون شعارات الاصلاح بِيد، ويحملون مِعوَل التهديم بيدٍ أخرى، همّهم المناصب، ودأبهم المكاسب.
وتعتبر السلطة أعظم تجليات المنهج السياسي، حيث يعتبرها الكثيرون أنَّها مدار السياسة، والاختبارالحقيقي للسياسيين، لما تحمله من مغريات، وما تدرّ عليهم من مكاسب يسيل لها لعاب الكثيرين، فيتسابقون على الغنيمة كما تتسابق الذئاب علي الفريسة؛ لا يترددون في الكذب والخداع بل يرونه منهج الصراع.
والواقعية السياسية هي تلك التي تتخذ من السلطة هدفًا ومغرمًا، نابذة وراءها القيم المفاهيم العقائدية أو الأخلاقية، ومستعينة بمناهج سلطوي واستبدادي، تقوم على أسس مادية، واعتبارات فوقية، ومناهج شاذة تدور في فلك صناعة الأفكار والرموز وتسويقها جماهيريًّا بغية تثبيت الدولة العميقة، والتي أركانها الإعلام والقضاء والأمن والجيش ومثقفون وكتّاب وصحفيون ورجال دين، حيث يمارس الجميع أدوارهم في لعبة كسب عواطف الناس واستحصال أصواتهم.
والإعلام الاستقصائي عادة ما يكون له دور ريادي في تثبيت الحقائق وإبراز ممارسات وقواعد الحكم الرشيد، إلا إنّه إذا ما جُيِّر لخدمة مصالح حزبية او فئوية وتحوّل إلى أداة لتحريف وتزييف الحقائق فإنّه قطعًا سيكون سببًا في بناء مجتمع تسوده الفوضى، " يُقرّب فيه اَلْمَاحِلُ ويؤتمن الخائِن وَيُخَوّنُ اَلْمُؤْتَمَن".
إنَّ عملية بناء الدولة العميقة لا تستغني أبدًا عن الإعلام المؤدلج والأقلام المُسيّسة والمُوجّه، فهي دون شكّ مصنعًا لبناء الرموز الكارتونية، وتشييد المسارح التي على خشبتها ترتقي القطع الشطرنجية فيمشاهد وفصول يصفّق لها الغافل ويهتف لها المستفيد.
إنَّ استمرار الأحزاب السلطوية بانتاج الدمى السياسية والاجتماعية وتسويقها أمرٌ منوط بقدرة وبراعةتلك المُنتجات في استغفال الناس من أجل تمرير أفكار ومناهج وبرامج عبر مشاهد وفصول تراجيديةتارة وكوميدية تارة أخرى، والهدف هو كسب ثقتهم أولًا، ثُمَّ التحكم بأفكارهم وسحق إرادتهم، وبالتاليتطويعهم وإخضاعهم.
وفي الوقت الذي يراقب فيه صنّاع القرار المشهدَ من خلف الستار، ويتمعّنون في مدى انجذاب الجمهوروارتباطهم بهذا الرمز أو ذاك، فإنهم يمسكون بخيوط اللعبة ويحركون الدمى كيف ومتى يشاؤون، وحينينتهي الفصل، ويُسدل الستار، يبدأ فصل جديد، ومشهد لقصّة أخرى، وأدوار لأبطال خرافية جديدة،تحركها اصابع الريبة وتُسوّقهم على أنهم رموز وطنية وشخصيات علمية أو أكاديمية، أو رجالات ثقافيةوفكرية، والحال أنهم سخرية.
ورغم أنَّ هذه الصناعة قد شهدت رواجًا واستقرارًا خصوصًا في سوق العالم الغربي، إلا أنَّ بعضًا من المثقفين والسياسيين قد وجّهوا نقدهم اللاذع لهذا النمط من التصنيع السياسي واعتبروه منهجًا يقوم على الخداع ويعمل على حرف العملية السياسية عن وجهتها الصحيحة ويفرغها من محتواها ومضامينها الجوهرية ويحوّل رموزها إلى سلع تجارية تُباع يومًا وتُشترى في يوم آخر.
يرى العديد من الباحثين في الشأن السياسي أن مصطلح التسويق السياسي قد نظّر له بتفصيل الكاتب والسياسي ستانلي كيلي في ستينيات القرن الماضي، حتى أصبح في يومنا هذا عِلمٌ وفنٌ لا يجيده إلا من امتهن السياسة وخبرَ خفاياها، لأجل ذلك يرى الكثير من السياسيين وصنّاع القرار أن امتلاك وسائل إعلامية ضرورة من اجل الترويج لأفكارهم وبرامجهم والتسويق لرجالاتهم ، فهم يعلمون أن بقاءهم مرهون بقدرة وبراعة رموزهم المصنَّعة في اللعب على خشبة المسرح السياسة أو الثقافة أوالتعليمي، فكلها أسواق رائجة، والمشترون كُثر.
لذلك وبناءً على التجارب الواقعية يُصنّف التسويق السياسي إلى ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول هو التسويق الكامل، وهو يشمل صناعة وتسويق كيانات أو أحزاب أو تيارات بغية الزّج بها في العملية السياسية.
والوجه الثاني هو التسويق لبرامج سياسية مرتبطة بأجندات ومبادرات خارجية، وأما الوجه الثالث، وهوالأكثر استخدامًا، فهو التسويق لرموز تثبّت أركان السلطة الحاكمة، سواء كانت هذه الرموز سياسية أمثقافية أم اقتصادية أم أكاديمية أم أمنية أم دينية، وغيرها.
ففي الدول التي تحكمها أنظمة قمعية نرى أنَّ رموز الدولة العميقة فيها من السياسيين والاعلاميين وأشباه المثقفين ومتقمّصي الكفاءات العلمية وأكاديميين ورجالات أمنٍ وقضاة، وهؤلاء في العادة لايُنتخبون من قبل عامة الناس بناءً على حقيقة كفاءاتهم وقدراتهم، أو برامجهم الإصلاحية أو أفكارهم ونظرياتهم وأيديولوجياتهم، بل بصورهم وأدوارهم المسرحية التي ترسَّخت في أذهان الجماهير.
إنَّ عملية تسويق الشخصيات السياسية والاجتماعية لا تتم بمعزل عن الأحداث السياسية أو الاجتماعيةأو الأزمات الاقتصادية، أو التجمعات والمناسبات الرياضية أو الدينية؛ وهذه الأحداث إما أن تكون هيالاخرى مصنَّعة بشكل مباشر من قبل دوائر صنع القرار، أو بشكل غير مباشر، كأن يُدفع بجهة معيّنة أو تجمع جماهيري معيّن لصناعة حدث ما ليتمّ اختراقه وتغيير بوصلته بالاتجاه الذي يخدم مصالحالطبقة الحاكم.
وهكذا فإنَّ عملية تصنيع وتسويق الرموز السياسية والاجتماعية، وإن كانت تجري في بعض الأحيانب عفويّة وتلقائيّة، إلا إنّها تعتبر في كثير من دول الغرب مهنة لها قواعدها وبرامجها، وأنّها عملية يشرف عليها محترفون ومتخصصون، يُطلق عليهم خبراء الدعاية ومتخصصو الصور الذهنية، فهؤلاء عادة ما يشرفون على برامج وتحركات بعض من هذه الرموز ‘المصطنعة‘ ويهيؤون لهم الدعاية الكافية، تدعمهم بذلك الأذرع الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي، بالشكل الذي يضمن وصولهم إلى حد المقبوليةالجماهيرية.
***
بقلم: د. أكرم جلال