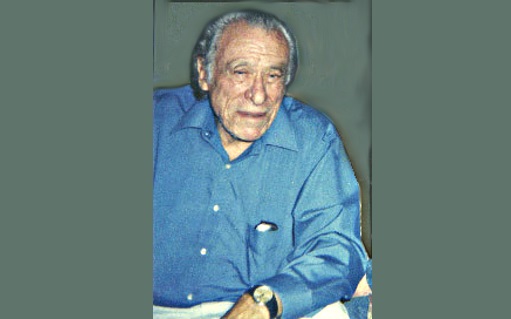نصوص أدبية
سعاد الراعي: ظلّهُ في الذاكرة

في أواسط خمسينيات الزمن الجميل، كان للسينما سحر لا يُقاوم في عيون الصبية، أولئك الفتية الذين لم تُرهقهم بعدُ هموم الحياة، لكنها كانت تعني لهم أكثر من مجرد شاشة تتحرك عليها الاحداث، كانت نافذتهم إلى عوالم لا تُحصى، ومتنفسًا رحبًا يهربون إليه بعد عناء يوم دراسي طويل أو خلال عطلة تكاد لا تسع أحلامهم الصغيرة.
مع انحدار الشمس نحو المغيب، كانوا يتقاطرون نحو ساحة "السعدي" كما لو أنهم مدفوعون بنداء خفي، يحملون كتبهم ودفاترهم، جادون في مراجعة دروسهم استعدادا للامتحان، لكن ما يختلج في صدورهم شيء آخر؛ السينما، حلم المساء، ورجاء الطفولة. يناقشون خطتهم اليومية: من سيذهب؟ كيف؟ وبأي نقود؟
ولأن جيوبهم وياقات دشاديشهم التي يخبئون فيها نقودهم خوفًا من ضياعها، كانت خاوية في الغالب، أو لا تحمل إلا الفتات، كانوا يفرغون ما لديهم من قطع معدنية على الأرض، يحصونها بأعين يملؤها الرجاء. فإن استوفت ثمن تذكرة واحدة، حينها يبدأ الطقس المعتاد/ القرعة. من سيكون سعيد الحظ الذي تُفتح له أبواب الفردوس المظلم؟ من سيجلس وحده في مقعد متآكل، يحدّق في الشاشة بانبهار، ليعود إليهم راويًا ما رأى؟ غير مكتف بالسرد، بل عليه ان يمثل، يصرخ، يبكي، يضحك، يُقلّد البطل والشرير، وكأنهم جميعًا كانوا هناك.
ولكن، إذا حضر عادل، صاحب الدهاء والعيون اللامعة، انقلبت المعادلة؛ فما من مأزق إلا وخرج منه بفكرة ماكرة، تُدخلهم جميعًا إلى السينما.
كانت السينما، بجدرانها العالية التي تعانق السماء، أشبه بقلعة حصينة يحرسها الزمن، ويصعب اقتحامها على من لا يملك الثمن. يحيطها سور مرتفع يتجاوز الثلاثة أمتار، كجدارٍ امام الفقراء بين الحلم ومرآه. غير أن القدر، كما لو أنه يهوى مداعبة الصغار، حيث زرع نخلة معمّرة بجانب السور، باسقة، يمتد جذعها كذراع أمّ حنون تحتضن مغامرة. كانوا يلقّبونها بـ „العمة"؛ تلك العجوز الطيبة التي لا تخذلهم حين يشتد الحنين إلى الشاشة الكبيرة.
عادل، الفتى الذي خُلق وفي يديه موهبة التسلق، نظر إلى أصدقائه بعينين تشعّان مكرًا وضوءًا، وقال مبتسمًا بثقة لا تعرف التردد:
"سأدخلكم جميعًا... وبتذكرة واحدة."
دخل أولًا من الباب الرئيسي، قطع الحارس تذكرته وسمح له بالعبور. وما إن خفتت الأضواء وبدأت الإعلانات، حتى غادر القاعة بذريعة شراء مشروب او شيء آخر. اعطاه البواب بطاقة خروج مؤقتة، بطاقة صغيرة، لكنها مفتاح الخطة الجريئة.
استغل عادل تبدّل البواب وزحام الداخلين، خرج حيث ينتظره أصحابه خلف السور. ناول أحدهم البطاقة، بينما هو تسلّق النخلة بخفة من اعتاد معانقتها، قفز إلى سطح الحمامات، ثم انزلق إلى داخلها، وخرج بهدوء وكأنه كان يقضي حاجته، عاد إلى القاعة وجلس عند صديقه بعض الوقت، ثم كرر الدور نفسه من جديد.
بهذه الحيلة البديعة، دخلوا واحدًا تلو الآخر، وكلٌّ منهم يختزن دهشة الطفولة في قلبه. لم يكن الفيلم وحده ما يستحق المشاهدة... بل الرحلة إليه كانت، بحد ذاتها، عرضًا لا يُنسى.
في إحدى مغامراته هذه، والتي أبهرت الصبية وعلّمتهم أن الفقر لا يقف في وجه الذكاء، خرج عادل، كعادته، يحمل بطاقة الخروج الصغيرة بين أصابعه كمن يحمل مفاتيح كنز، عازمًا على تكرار خطته في إدخال أصدقائه إلى السينما الواحد تلو الآخر. غير أن الحظ هذه المرّة لم يبتسم كما عهدوه، فقد تنبّه أحد الحراس لشيء ما. لاحظ بعين متشككة أن عدد المقاعد المشغولة في القاعة لا يتطابق مع عدد التذاكر المقطوعة، وما إن لمح عادل يغادر مجددًا بحجته المعتادة لشراء طعام، حتى أوقفه، وجرّه إلى مكتب الحرس.
في المكتب، تعالت الأصوات، توالت عليه التهديدات كالصفعات، وانهالت عليه الأسئلة كالسياط، أحدهم هدّده بالشرطة، وآخر لوّح بيده وكأنه يهمّ بضربه، لكن عادل، بعينيه الذكيتين وصدره المرفوع، على صغر سنه، لم يزده الخوف إلا صلابة. وقف أمامهم منتصبًا كفرسان الحكايات، بعينين تشعّان كبرياءً، وقال بثقة:
الواثق
"اشتريت تذكرتي وهذه بطاقة خروجي، لم أخالف قانونكم، وإن كنتم ترون غير ذلك، فهاتوا شرطتكم... سأشتكي عليكم!"
ثم رمى البطاقة في وجوههم وقال باحتقار العظماء:
"خذوا بطاقتكم، لا أريد مشاهدة فيلمكم، ولن أدخل "سينماكم" بعد اليوم
خرج بخطى ثابتة، لا يلتفت، كأنما خرج من معركة لا من السينما. لم تكن الهزيمة في نظره أن يُطرد، بل أن يَخذِل أصدقاءه، وهو الذي لطالما كان رسول أحلامهم إلى الشاشة. لقد أنجز مهمته، أدخلهم جميعًا، وخرج وحده، منتصرًا بروحه، وفخورًا بأنه جازف من أجل لحظة فرح تقاسمها معهم.
ومنذ ذلك اليوم، ظلّت صورته محفورة في ذاكرتهم، لا تمحوها الأيام ولا يغشاها النسيان. يتناقلون حكايته كلما اجتمعوا، يروونها لأبنائهم وأحفادهم بفخر وحنين لتلك الأيام الجميلة، وسط ضحكات ناعمة وإعجاب لا يخبو بذكائه، كما تُروى بطولات الأساطير الخالدة.
وهكذا ظلّ عادل حيًا في ذاكرتهم، قلبًا لا يعرف الهزيمة، وعقلًا يفتح الأبواب المغلقة.
***
سعاد الراعي