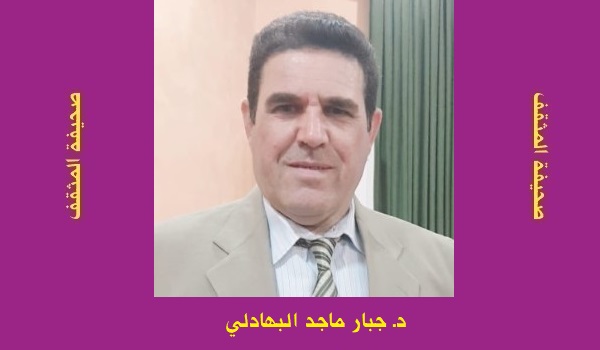تقارير وتحقيقات
الأنسنة والعلمنة وتفكيك النص الديني رؤية أركونية

(أركون الرّجل والمشروع)
(باحثة لبنانية تنتصر للفكر الأركوني: أركون زحزح التراث في مواقعه التاريخية ليخرجه من عزلته)
هي سلسلة من الأيام الفكرية دأب مركز الشهاب للبحوث والدراسات في الجزائر أن ينظمها وكان ملتقي هذه المرة مناقشة الفكر الأركوني ولأول مرة تبادر هيئة علمية أكاديمية إلى فتح نافذة لتسليط الضوء على هذه الشخصية التي لقيت إهمالا وانتقادات من أبناء بلدها، حيث شنّ عليها البعض حربًا إنه المفكر محمد أركون الذي اتهم بالإلحاد، فظر فكره مقبورا في بلده وبين قومه، لا شيئ إلا لأنه ناقش إشكالية التراث والحداثة برؤية عقلانية، وكانت ضيفة الشرف في هذا اليوم الدراسي باحثة لبنانية وهي الدكتورة نايلة أبي نادر، وعن طريق التخاطب عن بعد أنصفت مفكرا تنويريا حيث قالت وبجرأة الباحث الحُرْ الملتزم أن محمد أركون أسيئ فهمه وتم التهجم عليه ونعتوه بأنه يتجنّى على الإسلام، وقد وجب أن يُدْرَسَ فكره من زاوية محايدة بعيدا عن التعصب الفكري والديني، على أن تكون قراءة الكتابات المقدسة بشكل متماسك، في ردّها على من اتهموه بالإلحاد، تميزت هذه الندوة بالوعي الفكري، بحكم ن منظميها يمثلون " الصفوة" حيث لقيت نجاحا كبيرا وعلى كل المستويات
كان الصراع بين التراثيين والتحديثيين حول تفكيك التراث وبخاصة النص الديني، في مرحلة اتسمت بزحزحة الحدود بين الساحة الدينية والساحة الفكرية والساحة السياسية في أوروبا، فجاء اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الشهاب للبحوث والدراسات وبرعاية من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكتب عاصم الهضاب العليا، هذه المبادرة لقيت انتقادات البعض من المعادين للفكر الأركوني، وتساءل بعضهم كيف لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أو مركز الشهاب أن يتناول فكر محمد أركون اعتقادا منهم أنهما خرجا عن الخط، رغم أن كثير من المفكرين كالجابري وحسن حنفي عملوا في مرحلة معينة على تفكيك التراث باستعمال الأفكار الغربية كمشروع، فما كان على مركز الشهاب للبحوث والدراسات أن لا يترك هذه الأفكار تنام تحت أجنحة الظلام، بل كان من الضروري أن يُخرِجها إلى النور ويضعها تحت المجهر ومحاورة خصومها، بحكم أنه اعتاد على مناقشة هكذا اطروحات متبنيا لغة الحياد والموضوعية من أجل زرع ثقافة الحوار والنقد البنّاء.
الملفت للانتباه أن الملتقى الذي احتضنه مركز الشهاب للبحوث والدراسات بعاصمة الهضاب العليا (سطيف) تحت إشراف صاحبه الدكتور علي حليتيم، عرف مشاركة قوية لباحثين أكاديميين، قدموا من مختلف الجامعات، تناولوا رؤية أركون للحداثة والظاهرة القرآنية، حيث تنوعت الأفكار، بين الرّوح الاستشراقية والإبستمولوجيا الحديثة وهي ورقة قدمها الدكتور الطيب بودربالة، وتناول الد/ سرحان بن خميس سمات ومقاربات القراءة الأركونية للنص القرآني، ونقرأ عن "الأنسنة" في مشروع محمد أركون النقدي وهي ورقة قدمتها الدكتورة نايلة أبي نادر من لبنان، ثم إشكالية اللا مفكر فيه عند محمد أركون للدكتورة زبيدة الطيب من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ثم محمد أركون مفردا ومتعددا: التفكير مع أركون ضد أركون للدكتور مصطفى كيحل، ثم ورقة الدكتور علي حليتيم بعنوان تفكيكية المصطلح الأركوني بألية التحليل النفسي.
فلأول مرة يبدأ الإهتمام بالفكر الأركوني في الوسط الأكاديمي الجزائري وهذا يعود إلى محمد أركون معروف على مستوى عالمي، فهو مفكر ومؤرخ وعالم دراسات إسلامية وفيلسوف وباحث أكاديمي، وبالتالي يستحق أن تخضع أطروحاته الفكرية للنقاش والتحليل بدون تعصب فكري أو ديني، طالما إشكالية التراث والحداثة تدخل في إطار حوار الثقافات والحضارات، حيث شكلت صراعا بين الدارسين والباحثين منذ النهضة إلى الوقت الحالي، فظهرت كتب كثيرة تُنَظِّرُ في محاولة اصحابها تطبيقها على أرض الواقع، خاصة بعد هزيمة 1967م، ظهرت اتجاهات جديدة درست التراث بمنطلقات ومناهج حداثية غربية، فظهرت عدة مشاريع بأسماء أصحابها (مشروع محمد عابد الجابري، ومشروع حسن حنفي، مشروع محمد أركون وغيرهما وعُرِّفَتْ هذه المشاريع في الأوساط الفكرية بـ: "القراءات الحداثية للتراث".
أركون وجدلية اللحظة والخلود والحضور والغياب
فمن وجهة نظر الدكتور الطيب بودربالة فمحمد أركون شخصية علمية بارزة وأفكاره تدخل حول حوار الثقافات والحضارات، وأطروحاته تحيل الباحث والقارئ إلى فكرة الوسطية، لأنه ليس من السهولة تناول فكر عمّر نصف قرن وأثار إشكاليات كثيرة، خاصة وأن لكل واحد من محبيه أو معارضيه له حجته دلالته، خاصة في مرحلة سيطرت فيها اللسانيات على الساحة الفكرية والثقافية في فرنسا، كانت هناك منعطفات تفكيكية، بصرية (في مجال البصريات) وكانت مرحلة القرن العشرين حاسمة عاشها محمد أركون، وهي حسب المحاضر تمثل العصر الذهبي للفكر المتحرر وحركات التحرر في العالم، تحقق فيه ما يسمى بالنظرية الفرنسية يمثلها كبار أعلام الأدب الفرنسي كميشال فوكو (الحفريات)، ومحمد أركون كان ناقدا أيضا، بحيث يقف في نقطة معينة، يلتق فيها بتداخل التشابك المستمر بين الخيالي والعقلاني، فما يسمى بـ: "كلام الله" هو في الواقع عبارة عن نصوص دينية (من توراة وإنجيل وقرأن) وهذه النصوص أراد رجال الدين أن يحتكروها لأنفسهم ليحددوا معناها ودلالاتها، وبذلك يمنعون أتباع العلوم العقلية (أي الفلاسفة والمتكلمين) فوقعت تداخلات في الساحة الدينية والفكرية والسياسية، وكنقاد يلمس الباحثين ذلك من خلال رسالته حول الأديب طه حسين المتشبع بالفكر الإستشراقي، وكان لزاما على أركون أن يتجذر في الفكر العربي بكتابه النزعة الإنسانية المتجذرة في الفكر اليوناني والذي مكنه من الوصول إلى كرسي الأستاذية في باريس، حيث ارتكزت أطروحاته على الدراسات الاثنوغرافية، والإسلاميات والأنتروبولوجية والسوسيولوجية، ومن خلالها فكّك محمد أركون ظاهرة الإستشراق التي كانت تهدف إلى السيطرة على الشرق ممثلة في المستشرق الفرنسي جاك بيرك، وغيره من المستشرقين الذين حرصوا على دراسة الظاهرة الإسلامية، يلاحظ وحسب المحاضر ان محمد أركون في أطروحاته اعتمد على جدلية اللحظة والخلود وجدلية الحضور والغياب وإشكاليات أخرى حول الإعجاز القرآني، أراد المحاضر القول أن العقل البشري عجز عن تفكيك النص القرآني، وبالتالي من الصعوبة بمكان الوصول إلى حقائق علمية بسبب طغيان الذاتية والإيديولوجية وخاصة ما تعلق بقضية " التأويل".
أركون والظاهرة القرآنية
فمن خلال المنجز الفكري لمحمد أركون وإعادة أشكلة مفهوم "الوحي" وإن كان الوحي في المسيحية مثلا هو شيئ أخر غير الوحي في الإسلام، وكيف يمكن وضعه في الإطار المعرفي للحداثة وليس عن طريق اللغات والمصطلحات اللاهوتية التقليدية التي تحال الهيمنة علي كل طافة من الطوائف، وهي كما يقول الدكتور سرحان بن خميس من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مسائل مرتبطة بـ: اللاهوتيات مشيرا إلى بعض المفاهيم التي كان لها دور بارز في أشكلة الوحي، مثل الزحزحة والتفكيك وخلخلة النص وتجاوز المصطلحات إلى أكثر موضوعية كالظاهرة القرآنية، وأركون وهو يفكك هذه الظاهرة دعا إلى الانفتاح على المفاهيم اكثر حداثة، لأن القراءة التقليدية تؤدي إلى التأويل ولذا كانت قراءة أركون قراءة حداثية، باعتبار ان "الوحي" ظاهرة متكررة وهذا هو الفارق بين محمد أركون ومالك بن نبي، ومن هنا ينتهي أركون إلى موقف توفيقي وهو عقل ما بعد الحداثة وهي قراءة وصفت بالمتسكعة بين شخصية النبي والوحي، أراد المحاضر أن يرد على خصوم محمد أركون بأن أركون يقرأ الوحي دون تدخل النبي، أما مسالة الجمع بين الشفهي والكتابي يلاحظ أحيانا أن أركون تغلب عليه النزعة التشكيكية، فكانت قراءته للظاهرة القرآنية قراءة ابتكارية، نقدية، تفكيكية، تزامنية، تجاوزية، أسس لها كثير من المفكرين ومنهم المفكر محمد شحرور الذي تعامل مع القرآن كنص معزول وكانت دراسته الظاهرة القرآنية كرد على نكسة 67، وهي كما يقول صاحب الورقة قراءات متفتحة على كل المقاربات وهي مشروع فكري موضوعي هو العقل الإسلامي منهجها ضبط ونقل الخطاب الحداثي.
الأنسنة في مشروع أركون التنويري
أما موقف محمد أركون تجاه الأنسنة التي هي أساس الفكر التنويري باعتبارها مفهوما فلسفيا يركز على الإنسان كانت الورقة التي قدمتها الدكتورة نايلة أنطوان أبي نادر من لبنان عن طريق التخاطب الرقمي (عن بعد) بعنوان: الأنسنة في مشروع محمد أركون النقدي (التنويري)، تناولت فيها عمليات الأنسنة عند أركون وما هي العوائق اتي تحول اركون دون الدخول في التأويل، وهو أمر شغله منذ بداياته في البحث وفي التراث تحديدا، خاصة والرؤى حولها (أي الأنسنة) كانت مختلفة ومتناقضة تماما، فمنهم من يراها كنزعة علمانية متطرّفة ترى أنّ الإنسان هو مركز الكون، وأخرون كانت لهم رؤي مغايرة تمامًا، إذ ترى أنّ الله هو مركز الكون وخالقه ومدبّره، أمّا الإنسان فخليفته في الأرض، يخلفه في عمارتها، وتحقيق العدالة فيها، ومن ثمّ فالإنسان ليس هامشًا، بل هو مركز، ولكن بحدود ما استُخلِف فيه، ولذا لم يدع أركون إلي تمجيد هذا المشروع ولا إلى تهميشه وهو يتوجه إلى المجتمع المادي، فقد ذهب أركون في " الظاهرة القرآنية" إلى دراسة فكرة التوحيد عن ابن رشد والمعتزلة وفتحت مناظراته على الصراع بين العلوم العقلية والعلوم التقليدية أي العقل الفلسفي والعقل اللاهوتي أو ما يسمي بالحداثة البدائية، من وجهة نظرها هي، لا يمكن الدخول إلى الحداثة دون نقد عقلي، ومحمد أركون كان طيلة أربعين (40) عاما يعمل على تفكيك التراث، وأن يزحزحه في مواقعه التاريخية ليخرجه من عزلته، ودرس المنهج العقلاني عند المعتزلة واعتبرها مجالا واسعا، أراد أن يعيد من جديد الظاهرة الدينية وأن يسقط المصطلح الحديث على التراث.
أركون كشف عمّا وراء الإسلامات والزيف الديني
أما الدكتور زبيدة الطيب تحدثت عن الإنقلابات التي أحدثتها فلسفة ميشال فوكو، والتي أغرت محمد أركون، فحاول أن يطعم مشروعه في الفكر العربي فكان " اللا مفكر فيه" ليطبقه في العقل الإسلامي، وقد بدأه منذ نزول الوحي، أراد أركون أن يكشف عن ما وراء الإسلامات، كالإسلام الشيعي والإسلام السني والإسلام العلماني وفكر المعتزلة والصوفية، تقول الدكتورة زبيدة الطيب ليس من حق أيّ كان أن يُحاكم مفكر وفيلسوف حتي لو كان فكره يصدم القرآن، لأننا نتعامل مع الفكر لا مع الشخص، فبقراءة المفاهيم كالأنسنة، والمنهج التأويلي نقف على اللا مفكر فيه، وهذا المفهوم يراد به إبطال شيئ وهو يعبر عن اللاسامية أو اللامذهبية، وهذه المفهوم من وجهة نظرها غير متداول في التراث الإسلامي، لأنه مرتبط بالحداثة.
كيف نقرأ محمد أركون؟ وكيف نحلل شخصيته كإنسان لا كمفكر؟
ولعل وبعد هذه المداخلات وجب ان يُطرح السؤال التالي: كيف نحلل شخصية محمد أركون، كمفكر أمازيغي يختلف عن باقي المفكرين الجزائريين كمالك بن نبي رغم أن كلاهما تناول الظاهرة القرآنية ويربطهما قاسم مشترك وهو الكتابة باللغة الفرنسية، هي ورقة قدمها الدكتور علي حليتيم مدير مركز الشهاب للبحوث والدراسات قدم فيها تحليلا نفسيا لشخصية أركون، اعتمد فيها على النظرية الفرويدية في اكتشاف اللاشعور والحياة الأولى للإنسان، من خلال الألم واللذة والنبي المتمرد، أراد من خلالها ان يكرس البيئة الفكرية التي نشأ فيها أركون (الطفل) قبل ان ينتقل إلى باريس، وهو يصعد نحو الهوية والبعد القبائلي في شخصية والده ومحاولة إعادة بناء نظام رمزي مفقود، وشعوره بالا أمن الوطني والإنديجان في المدرسة، وهيمنة الآباء البيض عليهم محالة فرض عليهم اللغة الأجنبية، سفره مع ابيه إلى جعله يعيش اللاأمن الرمزي، لأنه في منطقة لا يوجد فيها أمازيغ، كلها عولم اثرت في فكر محمد أركون، خاصة علاقته بالأب لورانس الذي كانت له شبكة ادعائية للمسيحية وكانا يتبادلان الرسائل، وكيف تغيرت رؤيته للعالم بعد انتقاله إلي باريس، يقول الدكتور علي حليتيم " كل مغترب ينظر إلى نفسه في المرأة من اجل ان يكتشف ذاته، فكان اركون كلما ينظر في المرأة يرى أن ذاته مشوهة، وفي مرحلة الخيال يرى ذاتا مكتملة ذات قوة وذات مركز اجتماعي، وهي في الحقيقة الذات الغربية في صورة أركون وهنا يسعى أركون إلى التدمير الذاتي، أي تدمير القيم القديمة البالية التي همشته وعملية التطهير.
ما يمكن استنتاجه من خلال ما قدم من مداخلات أن محمد أركون وهو يعالج إشكالية العلمنة والدين (و على لسانه هو)، يوضح كيف تشكل الفضاء الإسلامي (أو المجال الإسلامي) وما يقابله في التراث اليهودي والتراث المسيحي فيما يخص حالة القرآن، إذ يلاحظ أن الخطاب الشفهي الذي نطق به محمد قد تحو{ّل فيما بعد إلى "مدونة" نصية رسمية مغلقة (أي مصحف) وقد اصبح بذلك عرضة للتأويل المنفتح باستمرار من أجل قيادة التاريخ وتوجيهه، ويدعو محمد أركون إلى الفصل بين مفهوم "كلام الله" عن "مفهوم القرآن"، فكلام الله حسبه لا ينفد ولا يمكن استنفاده، ونحن لا نعرفه بكليته، يضيف ان أنواع الوحي التي أوحيت بالتتالي إلى موسى وأنبياء التوراة ثم إلى عيسى وأخيرا إلى محمد ليست إلا أجزاء متقطعة من كلامه الكلّي وبهذا نجد القرآن يتحدث عن اللوح المحفوظ، وهنا ينبغي ان يتدخل علم اللسانيات، لأن الخطاب القرآني مدعو (خطابا) لأنه لم يكن مكتوبا في البداية وإنما كان كلاما شفهيا.
***
تقرير علجية عيش