اخترنا لكم
هاشم صالح: هل سينطلق التنوير العربي من باريس؟
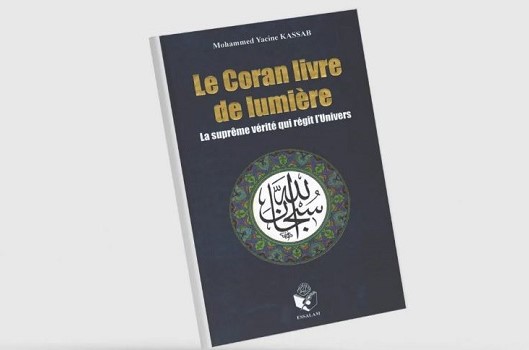
خلال شهر واحد فقط صدرت عدة مؤلفات عن القرآن الكريم والنبي العظيم
السؤال المطروح مباشرة هو التالي: هل ستنور باريس العالم العربي في القرن الحادي والعشرين مثلما نورت أوروبا وروسيا في القرن الثامن عشر؟ هل سيعود فولتير ويهزم الظلام والظلاميين مرة أخرى ولكن ضد الأصولية الإسلامية هذه المرة لا ضد الأصولية المسيحية التي أجهز عليها؟ أمر غير مستبعد على الإطلاق بل محتمل جداً. والدليل على ذلك صدور كل هذه الكتب الجديدة عن تراثنا العربي الإسلامي الكبير في عاصمة النور والأنوار. فخلال شهر واحد فقط أو شهرين صدرت عدة مؤلفات عن القرآن الكريم والنبي العظيم. نذكر من بينها كتاب الباحثة الشهيرة جاكلين شابي الذي صدر قبل أسبوعين فقط بعنوان: «قرآن الأنوار».
وهل هناك أجمل من هذا العنوان الخالد. عم يتحدث هذا الكتاب المهم؟ بالمختصر المفيد عن التفسير التاريخي والأنثربولوجي والعلمي الحديث للقرآن. وهو مختلف كلياً عن التفسير الأصولي الظلامي الذي يعمي البصر والبصيرة. يكفي. ليكف التراثيون والتقليديون عن إتحافنا بالمزيد من الثرثرات المكرورة والخرافات المجترة على شاشات التلفزيون.
ولكن المشكلة هي أن هذا التفسير التاريخي والفلسفي التنويري الجديد لكتاب الله مجهول كلياً عندنا. كل شيء يحصل كما لو أن الحقيقة ممنوعة الإقامة في العالم العربي حتى إشعار آخر. وأكبر دليل على ذلك هيمنة القوى الأصولية والظلامية على الساحة من أقصاها إلى أقصاها إلا بعض بقع الضوء هنا أو هناك. الدليل على ذلك هو أن التفاسير التقليدية العتيقة البالية لا تزال تهيمن على البيوت والشوارع والمكتبات وحتى الجامعات. ومعلوم أن هذه التفاسير التقليدية عاجزة عن إضاءة معاني النص الأعظم على عكس التفاسير الحديثة التي تقدمها لنا ليس فقط هذه المؤلفة الشهيرة، وإنما باحثون آخرون أيضاً.
تقول لنا المؤلفة ما فحواه: الكثيرون يعتقدون أنه يكفي أن نقرأ القرآن بشكل سطحي سريع لكي نعتقد أننا فهمناه. ولكن هذا وهم كبير. وذلك لأنه توجد فيه معان عميقة تستغلق على أفهامنا وعقولنا. وتالياً لا ينبغي الاكتفاء بالتفاسير السطحية التي أكل عليها الدهر وشرب. ماذا ينبغي أن نفعل لكي نفهم القرآن الكريم على حقيقته؟ عن هذا السؤال تجيب المؤلفة قائلة: ينبغي أولاً أن نفهم السياق التاريخي الكبير الذي ظهر فيه القرآن لأول مرة: أي الجزيرة العربية والقرن السابع الميلادي ومنطقة الحجاز بوجه خاص. ينبغي أن ندرسها دراسة علمية استقصائية ونتموضع في لحظتها التاريخية قبل 1447 سنة. وذلك لأن معطياتها وحيثياتها تنعكس على القرآن بشكل أو بآخر لمن يعرف كيف يقرأ بين السطور أو فيما وراء السطور. ومن ثمّ ففهم السياق التاريخي الذي أحاط بظهوره وكل الثقافات والعقائد التي كانت سائدة في عصره هو الذي يكشف لنا عن سر القرآن، عن معنى القرآن، عن فحوى القرآن. وهذا ما نص عليه القرآن ذاته عندما قال: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم، 4). القرآن عربي وقد نزل في بيئة معينة وزمن معين. وينبغي أن نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار إذا ما أردنا أن نفهمه على حقيقته. ما نحتاج إليه الآن إذن هو تفسير تاريخي محض لأحد النصوص الدينية الكبرى للبشرية.
ما نحتاج إليه هو قراءة تاريخية وفلسفية معمقة لا قراءة لاهوتية تقليدية ولا آيديولوجية ديماغوغية كما هو سائد لدى الأصوليين وجماعات الإسلام السياسي المستلبين عقلياً وفكرياً والغاطسين كلياً في غياهب العصور الوسطى وظلامياتها، كسيد قطب مثلاً. ما نحتاج إليه هو قراءة علمية تنير الأبصار بدلاً من أن تعميها.
بمعنى آخر «بحياتنا كلها لم نقرأ القرآن» أو لم نفهم القرآن على حقيقته، كما يقول لنا الباحث التونسي المعروف يوسف الصديق. وهذا يعني أن القراءة القروسطية اللاتاريخية القديمة غير القراءة العلمية والفلسفية والتاريخية الحديثة التي تنفذ إلى أعماق الأشياء. هذه بدهية. هذا تحصيل حاصل. ولكن متى سنفهم ذلك؟ متى ستفهم جماهير الأمة ذلك؟ بل متى سيفهم المثقفون العرب أنفسهم ذلك؟ هذا هو السؤال. بمعنى آخر متى سننتقل من مرحلة الطفولة العقلية إلى مرحلة النضج الفكري وسن الرشد، كما يقول لنا كبير فلاسفة الأنوار في أوروبا إيمانويل كانط في تعريفه للأنوار؟ بعد أن طبقت أوروبا المنهجية التاريخية - النقدية على الإنجيل فهمته على حقيقته وتحررت من الخرافات والأوهام. وانتقلت من مرحلة الأصولية المسيحية القروسطية إلى مرحلة المسيحية الحداثية الليبرالية. بعدئذ استنارت الشعوب المسيحية في أوروبا ولكن ليس قبل ذلك. هذه النقلة الكبرى لم تحصل عندنا حتى الآن. من هنا سر عذابنا وتخبطنا. ومن ثمّ فالسؤال المطروح هو التالي: متى سنفهم تراثنا المقدس بشكل صحيح لأول مرة في التاريخ كما فعلوا هم بدءاً من القرن الثامن عشر بالنسبة لتراثهم المسيحي؟ متى سنرتفع إلى مستوى تراثنا الديني العظيم؟ متى سنخدمه بالدراسات العلمية والفلسفية وليس بالقراءات الاستلابية الديماغوغية الغوغائية. هذا هو التحدي الأكبر المطروح علينا في السنوات المقبلة.
وإياكم ثم إياكم أن تنسوا ذلك الكتاب الموسوعي الضخم الصادر في (2186) صفحة بعنوان: «النبي محمد في مرآة المؤرخين العالميين الكبار». وهو كتاب ساهم فيه ما لا يقل عن خمسين باحثاً أكاديمياً متخصصاً في الدراسات العربية والإسلامية. وهؤلاء يعتقدون أن سيدنا محمد هو أحد أعظم الشخصيات التي أثرت على تاريخ البشرية.
وهو بالنسبة لنا خير الورى وأعظم شخص ظهر على وجه الأرض. ولكن المصيبة أو الكارثة أو البلية البلياء التي نكبنا بها مؤخراً هي أن بعض المتطرفين الضالين الذين انحرفوا عن النهج القويم لا يزالون مصرين على أن ينسبوا أنفسهم إليه زوراً وبهتاناً. لا يزالون يضربون بسيفه ويتحدثون باسمه على الرغم من أنهم شوهوا صورة الإسلام عالمياً بفظائعهم وتفجيراتهم وتكفيراتهم. لا يزالون يزعمون أنهم هم الإسلام ولا يوجد تفسير آخر للإسلام غير تفسيرهم ولا مفهوم آخر غير مفهومهم. فما حقيقة الأمر يا ترى؟ هذا ما يجلوه لنا هذا الكتاب الجماعي الموسوعي الضخم. هذا ما يحاول تسليط الأضواء عليه من كل الجهات. من هنا أهميته الكبرى.
لقد حل لنا مشكلة السر الأكبر الذي يؤرقنا بل ويؤرق كل مثقفي العالم حالياً، لأن مشكلتنا لم تعد مشكلتنا فقط، وإنما أصبحت بحجم العالم. لقد حل لنا مشكلة اللغز الأعظم، لغز الألغاز، الذي طالما حير العقول. فمن سيترجم هذا الكتاب الموسوعي الضخم الصادر قبل أسبوعين أو ثلاثة في باريس، أو قل من سيتجرأ على ترجمته؟ هذا هو السؤال. أخشى ما أخشاه أن يسبقنا جيراننا الأتراك والإيرانيون إلى ذلك. وذلك لأنه توجد حلقات تنويرية ضخمة في أنقرة وإسطنبول وطهران ذاتها. إردوغان والخامنئي ليسا كل شيء. لا تغرنكم المظاهر السطحية. وراء الأكمة ما وراءها. إني لألمح خلف الغيم طوفانا... ولكن العرب هم الأولى بقصب السبق في هذا المجال لأنهم أصل الإسلام والقرآن. النبي عربي والقرآن عربي. والجزيرة العربية هي مهبط الوحي وقدس الأقداس مع الحرمين الشريفين. أقول ذلك دون أي نزعة شوفينية بغيضة. وذلك لأن الحديث النبوي ذاته يقول لنا: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
ولكن للأسف لا تزال هذه الثورة المعرفية الكبرى التي تحصل حالياً في باريس وبقية العواصم الأوروبية محصورة في نطاق الثقافة الأكاديمية العليا لكبار بحّاثة الغرب وجامعات الغرب ولغات الغرب من فرنسية وإنجليزية وألمانية، إلخ. هذه الكشوفات عن تراث الإسلام الكبير وشخصية مؤسسه الأعظم لا تزال مجهولة أو متجاهلة من قبل اللغات الإسلامية الأساسية كالعربية والكردية والتركية والفارسية والأوردو الباكستانية، إلخ. هذه اللغات الأساسية مدعوة لاحتضان التنوير الديني والفلسفي يوماً ما. لا ينبغي أن تظل لغاتنا وشعوبنا خاضعة أبدياً للأفكار الظلامية وبرامج التعليم التكفيرية المهيمنة منذ مئات السنين. هنا يكمن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حالياً. لم يدخل العالم الإسلامي التاريخ بعد. ولن يدخله قبل أن يخوض أكبر معركة – وأخطر معركة – مع ذاته التراثية العميقة.
ولا تنسوا مشروع «القرآن الأوروبي» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد من قبل مجلس أوروبا للدراسات العليا والبحوث العلمية. هذا المشروع يطرح السؤال التالي: كيف ساهم الكتاب المقدس للإسلام في تكوين الفكر الأوروبي؟ كيف قرأه الأوروبيون وفهموه أو لم يفهموه منذ العصور الوسطى وحتى مطلع الحداثة؟ فمن الواضح أن قراءة العصور الوسطى كانت عدائية وجاهلة بحقيقة القرآن والإسلام في معظمها. ولكن الموقف تغير لاحقاً في عصر التنوير إبان القرن الثامن عشر. ففلاسفة الأنوار الكبار رأوا في القرآن الكريم احتفالاً عظيماً بالعقل والعقلانية والبصائر الأنوارية.
***
د. هاشم صالح
عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 19 نوفمبر 2025 م ـ 29 جمادي الأول 1447 هـ







