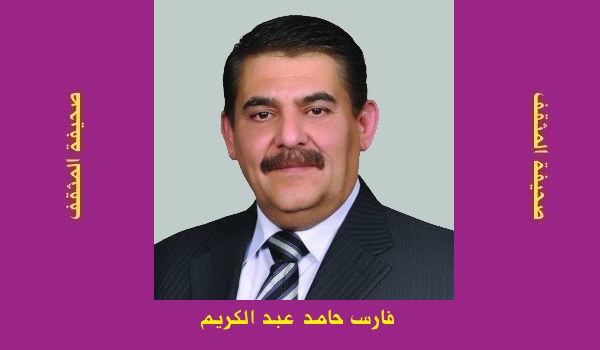أقلام فكرية
مصطفى غَلْمان: التأويل والمعرفة.. الرحلة المستمرة بين اليقين والارتياب

المعرفة لا يمكن أن تكون مجرد جمع للحقائق أو تراكم للمعلومات. إنها مسار مستمر من التساؤل والمراجعة، حيث يختبر الفكر حدود إدراكه ويواجه هشاشة اليقين. منذ باشلار الذي رأى في تاريخ العلم سجلا للأخطاء والنقد، وحتى ديكارت الذي جعل الشك شرطا للوعي، يتجلى أن كل معرفة حقيقية تقوم على قدرة العقل على مساءلة ذاته، ومراجعة أدواته ومفاهيمه. في هذا الإطار، يبرز التأويل كفضاء إبستمولوجي يتيح للمعرفة تجاوز الانغلاق على الثوابت، ويحوّل التجربة الفكرية إلى رحلة حيّة بين الذات والعالم، بين السؤال والإجابة، بين الخطأ والفهم.
إن المعرفة، في جوهرها، لا تنفصل عن نقدها. كل علم يظل معلقا في فضاء الشك حين يفقد مرآة مراجعة ذاته. وهو ما لاحظه باشلار عندما أشار إلى أن تاريخ العلم ليس سوى تاريخ أخطاء، تاريخ ملازمة النقد ومداومة المراجعة، حيث لا يتقدم الفكر إلا حين يواجه حدود فهمه ويستكشف ثغرات يقينه. ودون ضوء هذه الملازمة، يتيه العقل في متاهة المينوتور، متوهّما امتلاك الطريق، ومقفلا على سرّه الخاص، بلا مراسلة بين الحقيقة والشاهد.
فالنقد هنا لا ينفي المعرفة، بل يمنحها العمق، يحول الخطأ إلى معلم، والخطيئة إلى نقطة انطلاق. كل مراجعة للعلم، كل تأمل في زواياه المظلمة، هو صدى للحياة نفسها، حيث تصبح المعرفة فعلا حيا، يتحرك بالوعي والتأمل، متواصلا مع ذاته ومع ما هو خارجها، متجاوزا الانغلاق على الثابت، متصلا بالرحلة التي لا تنتهي نحو فهم أوسع وأشد حيادية.
في هذا الفضاء، يصبح الخطأ صديقا، والنقد وسيلة للضوء. كل إشراقة معرفية تولد من مواجهته، وكل تيه في المتاهة يُفضي إلى مسار جديد، حيث العقل يتعرف على ذاته من خلال حدود ما لا يعرفه، ويصبح البحث المستمر عن الحقيقة رحلة أبدية، ليست للامتلاك بل للمعايشة، حيث المعرفة نفسها تتجدد وتتنفس عبر مراجعتها ونقدها.
وفي أفق نظرية المعرفة، حيث تتقاطع الأسئلة المؤسسة مع قلق الفكر المعاصر، يبرز مفهوم التأويل كأحد المفاصل الحاسمة في إعادة التفكير في معنى المعرفة وحدودها وشروط إمكانها. فالتأويل لم يعد مجرّد أداة تفسيرية ملحقة بالفعل المعرفي، وإنما أضحى فضاءً إبستمولوجياً تتداخل فيه اللغة والتاريخ والذات، وتتزعزع داخله ادعاءات اليقين المستقر. ومن هذا المنظور، يتقاطع التأويل مع البراديغمات الثقافية الراهنة التي تعيد مساءلة أسس التفلسف ذاته، وتدفعه إلى مراجعة مسلّماته القديمة.
لقد ظل التصور الكلاسيكي للمعرفة مشدودا إلى ثنائية التجربة والعقل، حيث تُفهم الحقيقة باعتبارها نتيجة مطابقة بين الذهن والواقع، أو ثمرة لاستدلال منطقي قادر على اختراق الظواهر. غير أن هذا التصور سرعان ما اصطدم بحدوده التاريخية والسوسيولوجية، إذ تبيّن أن المعرفة تتشكّل داخل أنساق رمزية وسياقات ثقافية مخصوصة، وأن الفهم لا يتحقق إلا عبر وسائط لغوية وتأويلية تُحمّله آثار الزمن والموقع والذات العارفة.
وعند هذا الحد، يتخذ السؤال الإبستمولوجي طابعا أكثر راديكالية: هل في مقدور الفكر الإنساني أن يبلغ حقائق مطلقة، أم أن أقصى ما يبلغه هو أشكال نسبية من المعنى؟ فمحاولات الإحاطة بطبيعة الزمن أو الوعي تكشف عن مفارقة جوهرية. إذ كلما اقتربنا من الموضوع ازداد انفلاته، وكأن الفكر يواجه نفسه وهو يحاول أن يفكر شروطه الخاصة. فالزمن لا يدرك إلا من خلال آثاره، والوعي لا ينكشف إلا بوصفه تجربة متشظية، عصية على القبض الكلي.
في هذا المجال الرمادي، حيث تتقاطع المعرفة مع الارتياب، يستعيد الشك الفلسفي مكانته التأسيسية. فشك ديكارت لم يكن موقفاً عدميا، بل تمرينا جذريا على مساءلة البداهات، ووعيا بأن كل يقين غير ممتحَن يظل هشا. إن إعلان "أنا أشك، إذن أنا موجود" يؤسس لذات واعية بحدودها، ذات تدرك أن وجودها المعرفي يتحدد بقدرتها على مساءلة ما يبدو بديهيا
هكذا تتبدل صورة المعرفة في أفقها المعاصر، فهي لم تعد وعدا بيقين نهائي، وإنما ممارسة مفتوحة على التعدد والاختلاف. يصبح الفهم سيرورة لا تنتهي، ويغدو التأويل أفقا ضروريا لكل ادعاء بالحقيقة، حيث لا تُمتلك المعاني مرة واحدة، بل تُبنى باستمرار في حركة لا نهائية من القراءة والتأويل وإعادة الفهم.
المعرفة في جوهرها، عملية مستمرة من التوليد والتأمل، لا تستقر إلا في حركة النقد وإعادة التقييم. كل شك، وكل خطأ، يصبح أداة لاكتشاف أعماق الوعي وحدود الفكر، وحيث تتحول الحدود إلى مساحات للحرية والإبداع. فالتأويل يجعل من المعرفة ممارسة لا نهائية، ومسارا متواصلا نحو فهم أوسع وأكثر حيادية.
في النهاية، ليس المهم امتلاك الحقيقة، بل العيش في ضوئها ومراجعتها، لتظل المعرفة نفسها حية، متجددة، ومتصلة بالحياة والذات في كل لحظة من لحظات الفهم.
***
مصطفـــى غَلْمـــان