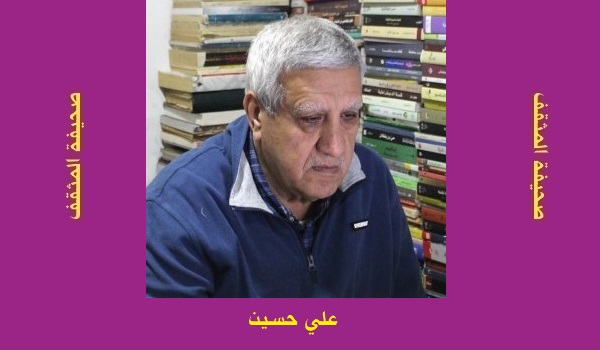أقلام فكرية
حمزة مولخنيف: حدود العقل وأفق العالم.. مساءلة معاصرة في الإمكان الكانطي

ليس العقل في الإرث الكانطي، أداةً بريئة تتقدّم بلا حدود، ولا مرآةً شفافة تعكس العالم كما هو، بل هو شرط إمكان العالم كما يظهر لنا، وحدٌّ فاصل بين ما يمكن التفكير فيه وما يستعصي على القبض المفهومي. ومن هنا فإن الحديث عن حدود العقل لا يُفهم بوصفه تقليصا لقيمته، بل باعتباره تحريرا لوظيفته من الأوهام التي علقت به عبر تاريخ طويل من الميتافيزيقا الدوغمائية. لقد كان كانط واعيا بأن أعظم أخطاء العقل لا تنبع من ضعفه، بل من ثقته المفرطة بنفسه حين يتجاوز مجال تجربته المشروعة، فيقع في تناقضاته الخاصة، ويُنتج ما سماه «أوهام العقل الخالص».
يكتب كانط في مقدمة نقد العقل المحض أن «العقل الإنساني له قدرٌ غريب، فهو يُثقل بأسئلة لا يستطيع تجاهلها، لكنه لا يستطيع أيضا الإجابة عنها». في هذه العبارة يتكثف المشروع النقدي بأكمله: العقل مُلزَم بالمساءلة، لكنه غير مخوّل بالإجابة عن كل ما يسائل فيه. إن العقل بهذا المعنى كائن حدّي، يعيش دائما عند التخوم، يفكر من داخل العالم، لكنه يطمح إلى ما يتجاوزه. وهذه الازدواجية هي مصدر عظمته ومأزقه في آن واحد.
لقد جاءت الثورة الكانطية لتقلب السؤال الفلسفي من «كيف نعرف العالم؟» إلى «كيف يكون العالم ممكنا لنا بوصفنا ذواتا عارفة؟». لم يعد العقل تابعا للأشياء، بل صارت الأشياء، كما تظهر لنا، خاضعة لشروط العقل. إن العالم، في التجربة الإنسانية، ليس معطى خاما، بل هو بناء قبلي تشارك في تشكّله الحساسية والفهم معا. الزمان والمكان ليسا خاصيتين للأشياء في ذاتها، بل هما صورتا الحس اللتان بدونهما لا يمكن لأي موضوع أن يُعطى لنا. والفهم لا يستقبل المعطيات سلبا، بل ينظمها عبر مقولاته القبلية، فيحوّل التعدد الحسي إلى تجربة ذات معنى.
غير أن هذا الانتصار المعرفي للعقل يحمل في طياته مفارقة دقيقة: فبقدر ما ينجح العقل في تأسيس عالم الظواهر، يعجز عجزا مبدئيا عن النفاذ إلى عالم الأشياء في ذاتها. وهنا يظهر الحدّ بوصفه مبدأً منهجيا، لا عيبا أنطولوجيا. فالعقل لا يُمنع من معرفة المطلق تعسفا، بل يُحجَب عنه لأن المطلق لا يُعطى في تجربة ممكنة. إن الشيء في ذاته ليس لغزا يجب حله، بل حدّا يجب الاعتراف به. وكما سيقول كانط لاحقا، فإن «العقل يرى أبعد مما يستطيع أن يمشي».
هذا التحديد الصارم لمجال العقل النظري لا يعني القضاء على الأسئلة الكبرى، بل إعادة توطينها في أفقها المشروع. فالله والحرية والخلود، لا يمكن البرهنة عليها نظريا، لكنها تظل أفكارا ضرورية بوصفها مسلمات عملية. هنا تتجلى عبقرية كانط في تفريقه بين ما يمكن معرفته وما يجب افتراضه لكي يكون للفعل الأخلاقي معنى. لقد ألغى المعرفة ليترك مجالا للإيمان، لا الإيمان اللاعقلاني، بل الإيمان العملي الذي ينبثق من مطلب الواجب. يقول كانط في نقد العقل العملي: «شيئان يملآن النفس إعجابا وإجلالا متزايدين: السماء المرصعة بالنجوم فوقي، والقانون الأخلاقي في داخلي». في هذه الجملة يلتقي حدّ العالم وحدّ العقل في تجربة مزدوجة من الدهشة والمسؤولية.
إن قراءة الإرث الكانطي في أفق معاصر تقتضي الانتباه إلى أن حدود العقل ليست جدرانا صمّاء، بل خطوط تماس بين الممكن والمستحيل، وبين القول والصمت. فالعقل حين يعترف بحدوده لا يستقيل، بل يتطهر من نزعة التسلّط الشمولي. وقد التقط فتغنشتاين هذا المعنى حين كتب في الرسالة المنطقية الفلسفية أن «حدود لغتي تعني حدود عالمي». غير أن هذا القول إذا قُرئ قراءة كانطية، لا يعني أن ما لا يُقال لا يوجد، بل أن الوجود يتجاوز دائما قدرتنا على القول. فالعالم أوسع من اللغة، والعقل أضيق من الكينونة.
لقد كانت الفلسفات اللاحقة، من الهيغلية إلى الوضعية، محاولات متفاوتة لتجاوز الحد الكانطي أو الالتفاف عليه. هيغل رأى في حدود العقل لحظة تاريخية مؤقتة، وسعى إلى رفع التناقض بين الظاهر والباطن في حركة الروح المطلقة. أما الوضعيون فقد اختزلوا العقل في وظيفته العلمية، معتبرين كل ما لا يخضع للتحقق التجريبي لغوا ميتافيزيقيا. غير أن التجربة الفكرية للقرن العشرين، بما حملته من أزمات علمية وأخلاقية، أعادت الاعتبار إلى السؤال الكانطي عن حدود العقل، لا بوصفه سؤالا مدرسيا، بل باعتباره شرطا للنجاة من العنف المعرفي والشمولي.
إن العقل الذي لا يعترف بحدوده يتحول بسهولة إلى أداة هيمنة، سواء في صورة عقل تقني يختزل الإنسان إلى مورد، أو عقل أيديولوجي يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة. وقد نبه هوركهايمر وأدورنو في جدل التنوير، إلى أن العقل حين ينفصل عن نقد ذاته ينقلب إلى أسطورة جديدة. وهذا بالضبط ما حاول كانط تفاديه: عقل ينقد نفسه بنفسه، ويضع لنفسه قانونا يمنعه من التعدي على ما لا يخصه.
في السياق المعاصر، حيث تتوسع آفاق العلم وتتداخل العوالم الافتراضية والبيولوجية والتقنية، يطرح سؤال حدود العقل نفسه بإلحاح جديد. هل ما زالت المقولات الكانطية صالحة في زمن الذكاء الاصطناعي والفيزياء الكوانتية؟ أم أن العالم قد أفلت نهائيا من قبضة العقل الإنساني؟ لعل الجواب لا يكمن في تجاوز كانط، بل في تعميق درسه: كل توسع في العالم يستدعي مساءلة جديدة لشروط الفهم، وكل ادعاء بالسيطرة المعرفية يستوجب نقدا قبليا يكشف حدوده.
إن العقل ليس سيّد العالم، بل ساكنٌ فيه، يفكر من داخله، ويصطدم دائما بأفق لا يمكن اختزاله. وحدود العقل ليست علامة نقص، بل أثر انتمائه إلى عالم لا يُستنفد. وكما كتب بول ريكور، فإن «الحدود ليست ما يُغلق الفكر، بل ما يفتح فيه إمكان التأويل». من هنا تبدأ الفلسفة لا حين ندّعي امتلاك الحقيقة، بل حين نتعلم كيف نسكن السؤال.
يمتد سؤال حدود العقل حين يُعاد التفكير فيه في أفق معاصر، من الحقل المعرفي الصرف إلى المجال الأخلاقي والسياسي والتقني، حيث لا يعود العقل مجرد بنية للفهم، بل قوة تنظّم الفعل وتوجّه التاريخ. هنا يتكشّف أن الحدّ الكانطي ليس قيدا معرفيا فحسب، بل مبدأً معياريا يحمي الإنسان من ادعاء الاكتمال. فالعقل الذي يعرف أنه محدود، هو وحده القادر على أن يكون مسؤولا. أما العقل الذي يتوهّم الإحاطة، فينتهي غالبا إلى تبرير العنف باسم الضرورة أو الاستبداد باسم العقلانية.
لقد كان كانط شديد الحساسية إزاء هذا البعد العملي للعقل. فالحرية التي لا يمكن البرهنة عليها نظريا، تصبح حجر الزاوية في كل أخلاق ممكنة. إن الإنسان بوصفه كائنا عاقلا ليس مجرد جزء من الطبيعة يخضع لحتمياتها، بل ذات قادرة على أن تشرّع لنفسها قانونها. وهذا التشريع الذاتي هو جوهر الكرامة الإنسانية. يقول كانط إن «الإنسان غاية في ذاته، لا وسيلة»، وهي عبارة لم تفقد شيئا من راهنيتها، بل لعلها اليوم أكثر إلحاحا في عالم تتزايد فيه نزعات التشييء والاختزال.
غير أن هذا التصور الأخلاقي لا ينفصل عن تصور دقيق لحدود العقل. فلو كان العقل قادرا على معرفة الخير الأسمى معرفة نظرية يقينية، لتحوّلت الأخلاق إلى علم تقني، ولغاب معنى الواجب بوصفه اختيارا حرا. إن قيمة الفعل الأخلاقي لا تنبع من نتائجه، بل من احترامه للقانون الذي يفرضه العقل على نفسه. وهنا يظهر الحدّ مرة أخرى: لا يمكن للعقل أن يضمن السعادة، لكنه يستطيع أن يطالب بالاستحقاق الأخلاقي لها. هذا التوتر بين الفضيلة والسعادة، بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، هو ما يمنح الأخلاق طابعها التراجيدي النبيل.
يمكن فهم السياسة الكانطية بوصفها امتدادا نقديا للأخلاق، لا بوصفها تقنية لإدارة السلطة. فالدولة العادلة ليست تلك التي تحقق السعادة لمواطنيها، بل التي تضمن حريتهم وفق قانون عام يمكن تعميمه. إن فكرة العقد الاجتماعي عند كانط ليست حدثا تاريخيا، بل مبدأً عقليا يُقاس به مشروعية السلطة. وكل سلطة لا يمكن تبريرها عقليا أمام كل مواطن بوصفه ذاتا عاقلة، هي سلطة فاقدة للشرعية، مهما ادعت من نوايا أو نتائج.
وقد بلغ هذا الأفق ذروته في مشروع «السلام الدائم»، حيث ربط كانط بين العقل العملي والتاريخ الكوني. فالسلام ليس حالة طبيعية، بل واجب أخلاقي يتطلب بناء مؤسسات قانونية تتجاوز منطق القوة. غير أن كانط مرة أخرى، لا يقع في utopia ساذجة؛ فهو يدرك أن الطبيعة الإنسانية محكومة بأنانية وميل إلى الصراع، لكن العقل العملي يفرض على التاريخ اتجاها معياريا، حتى وإن تحقق عبر مسارات ملتوية. إن التاريخ من هذه الزاوية، ليس تقدما حتميا، بل أفقا مفتوحا للواجب.
غير أن القرن العشرين، بما شهده من حروب شاملة ومعسكرات إبادة وتقنيات قتل صناعية، أعاد طرح السؤال: هل أخطأ كانط في ثقته بالعقل؟ أم أن ما انهار لم يكن العقل النقدي، بل العقل الأداتي الذي حذّر منه؟ هنا تتقاطع القراءة الكانطية مع نقد مدرسة فرانكفورت، التي رأت أن العقل حين يُختزل إلى أداة للسيطرة يفقد بعده التحرري. لقد كتب أدورنو أن «العقل الذي لا يفكر في ذاته يتحول إلى عقل همجي»، وهي صيغة معاصرة لتحذير كانط من تجاوز العقل لحدوده دون نقد.
في عالم اليوم، يتخذ هذا النقاش شكلا جديدا مع صعود العقل الخوارزمي والذكاء الاصطناعي. فالعقل وقد تلبّس في صورة أنظمة حسابية قادرة على التعلّم والتنبؤ، يطرح سؤالا مزدوجا: هل ما زال العقل الإنساني هو معيار الفهم؟ وأين تقع حدود المسؤولية حين تُفوّض القرارات إلى آلات؟. إن القراءة الكانطية لا تقدّم أجوبة تقنية، لكنها توفّر معيارا نقديا حاسما: كل فعل لا يمكن إرجاعه إلى ذات قادرة على التشريع الأخلاقي لا يمكن اعتباره فعلا مسؤولا. الآلة مهما بلغت من التعقيد، لا تعرف الواجب، لأنها لا تعرف الحرية.
وهنا يظهر مرة أخرى معنى الحدّ، لا بوصفه عجزا تقنيا، بل بوصفه فرقا أنطولوجيا وأخلاقيا. فالعقل الإنساني ليس مجرد قدرة على المعالجة، بل قدرة على السؤال عن المعنى. والعالم مهما اتسعت نماذجه الرياضية، يظل أوسع من كل تمثيل. إن الفيزياء الحديثة نفسها من النسبية إلى ميكانيكا الكم، كشفت أن الواقع لا يُعطى للعقل في صورة شفافة، بل عبر احتمالات وحدود قياس. وكأن العلم في أقصى تقدمه، عاد ليؤكد درس كانط: المعرفة مشروطة، والمطلق يتفلّت.
غير أن هذا لا يقود إلى نسبية مدمّرة، بل إلى تواضع إبستمولوجي خصب. فالعقل الذي يعترف بحدوده لا يتخلّى عن الحقيقة، بل يتحرر من وهم امتلاكها النهائي. وقد عبّر هابرماس عن هذا المعنى حين ميّز بين العقل الأداتي والعقل التواصلي، داعيا إلى عقلانية تقوم على الحوار لا على السيطرة. هذا الامتداد التداولي للعقل يمكن قراءته بوصفه تطويرا معاصرا للحدّ الكانطي: الحقيقة لا تُفرض، بل تُبنى في أفق قابل دائما للمراجعة.
يصبح السؤال عن حدود العالم سؤالا عن حدود المعنى. فالعالم ليس فقط مجموع الوقائع، بل أفق دلالي نسكنه ونتأوّله. وقد أدركت الهرمنيوطيقا من دلتاي إلى غادامير، أن الفهم ليس عملية تقنية، بل حدث تاريخي يتشكل في تقاطع الأفقين: أفق الذات وأفق النص أو العالم. غير أن هذا الوعي التاريخي لا ينقض كانط، بل يعمّق حدّه: فالعقل لا يعمل في فراغ، بل داخل تقاليد ولغات وتواريخ تشكّل إمكاناته وحدوده في آن.
وهنا يكتسب الصمت قيمة فلسفية. فليس كل ما لا يُقال عديم المعنى، وليس كل ما يُقال قابل للاستنفاد. لقد أدرك كانط على نحو مبكر، أن ثمة أشياء يجب التفكير فيها دون ادعاء معرفتها. وهذا ما جعل فلسفته، رغم طابعها النقدي الصارم، مفتوحة على بعد رمزي وأخلاقي عميق. فالحرية ليست موضوعا للعلم، لكنها شرط لكل علم ذي معنى. والكرامة ليست واقعة تجريبية، لكنها أساس كل قيمة.
إن حدود العقل وحدود العالم، في القراءة الكانطية المعاصرة، ليستا حدّين متقابلين، بل حدّا واحدا يُرسم عند نقطة التقاء الفكر بالوجود. فالعقل لا يقف خارج العالم ليحدّه، ولا يذوب فيه ليُلغى، بل يقيم عند تخومه، حيث السؤال ممكن واليقين مستحيل. وهذه الإقامة الحدّية هي ما يمنح الفلسفة ضرورتها الدائمة. فكلما ادّعى عصر ما أنه تجاوز كانط، عاد ليصطدم بسؤاله من جديد، لأن السؤال ليس تاريخيا، بل بنيويا.
ولعل أعظم درس يقدمه الإرث الكانطي اليوم هو أن الحدّ ليس نفيا، بل شرط إمكان. فلو كان العقل غير محدود، لما كان حرا، ولو كان العالم شفافا تماما، لما كان جديرا بالتأويل. إن الإنسان بوصفه كائنا عاقلا، محكوم بأن يفكر أكثر مما يعرف، وأن يأمل أكثر مما يبرهن. وفي هذا التوتر الخلّاق بين العقل والعالم، بين القانون والحرية، والمعرفة والإيمان العملي، تتجدد الفلسفة لا كنسق مغلق، بل كيقظة دائمة عند حافة المعنى.
وهكذا، لا ينتهي الإرث الكانطي عند رسم حدود للعقل، بل يبدأ منها. فحيث يتوقف الادعاء يبتدئ المعنى، وحيث يعترف العقل بمحدوديته، يفتح العالم على أفق المسؤولية. ليست الفلسفة في هذا المقام وعدا باليقين، بل تمرينا على السكن في السؤال دون خوف. فالعقل الذي يفكّر عند حافة العالم لا يسقط في العدم، بل يتعلّم التواضع، ويكتشف أن أعظم قوته تكمن في قدرته على ألا يدّعي السيادة على ما يتجاوزه. هناك، عند هذا الحدّ بالذات، يولد الفكر بوصفه يقظة أخلاقية، لا امتلاكا للحقيقة، بل وفاء دائما لندائها.
إذا كان انكشاف العالم مشروطا بحدود العقل، فأين يتأسس المعنى في مجال ما يُدرك ويُضبط مفهوميا، أم في ما يظلّ متعاليا على الامتلاك المعرفي؟، ثم هل يتحدّد أفق الإنسان في التوسّع اللامتناهي للمعرفة، أم في تعلّم السكون الفلسفي عند تخوم ما يمتنع عن القول والتعيين؟.
***
د. حمزة مولخنيف