أقلام فكرية
علي صغير: نظريَّة هوبز العقديَّة - الاجتماعيَّة في الأخلاق
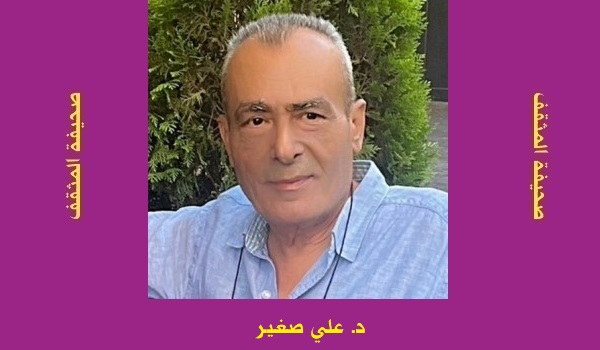
من أجْلِ الوقوف على جديد الاتِّجاهات الأساسيَّة لفلسفة العصر الحديث الأخلاقيَّة لا مَفَرَّ للباحث من التَّعرُّف إلى أبرز ما نطقت به فلسفة الأخلاق ethics السَّابقة لها في العصرين القديم والوسيط باعتبار أنَّ لا رؤية مبتكَرة إلَّا وَلَهَا سياقها الثَّقافيُّ ومقدِّماتها الفكريَّة، ولا تجديد بالقفز فوق التَّاريخ وبالقطيعة التَّامَّة مع الماضي. تتمتَّع الإطيقا القديمة، ومع كُلِّ التَّنوُّع الموسوعيِّ في محتواها والتَّغيُّرات المُهمَّة الَّتِي تعرَّضت لها على امتداد تاريخها الطَّويل، بقدر مُعَيَّن من الوحدة الدَّاخليَّة يجعلها باراديمًا paradigm أخلاقيًّا خاصًّا قُطْبُ رحاه هو الإنسان. ويمكن، على الأقَلِّ، فَرْزُ أفكار أربع تؤلِّف أساسها المشترَك والرَّاسخ: أولها هو القول بأنَّ الأخلاق عمومًا والفضائل خصوصًا هي سمة يمتاز بها الوجود الإنسانيُّ وحده؛ ثانيها- الاعتقاد الثَّابت بقدرة الإنسان الذَّاتيَّة على بلوغ كماله الأخلاقيّ وسعادته القصوى في هذا العالم الفعليِّ؛ ثالثها- القول بوحدة العقل والأخلاق، السَّعادة والفضيلة، الخير والحقيقة، وبوجود علاقة جوهريَّة عميقة بين خاصِّيَّة (مزيَّة) الإنسان وكماله وخيره الأسمى وسعادته القصوى على اعتبار أنَّ الأخلاق هي جملة فضائل الفرد والتَّطوير الأقصى لِمَلَكَاته الذَّاتيَّة وخاصِّيَّته العقليَّة الَّتِي تُمَيِّزَهُ من غيره من الكائنات؛ رابعها- القول بوحدة الإنسان والمدينة-الدَّولة. فالفرد، من وجهة نظر، الوعي القديم هو كائنٌ اجتماعيٌّ (سياسيٌّ، مدنيٌّ) يكتسب هُوِيَتَه الأخلاقيَّة بصفته، وفقط بصفته، ممثِّلًا لِبِنْيَةٍ سياسيَّة-اجتماعيَّة مُعَيَّنة. هذا فضلًا عن أنَّ الخير الأسمى واحدٌ بالنِّسبة إلى الفرد وإلى المدينة-الدَّولة على حدٍّ سواء، وصلاح كُلِّ واحد منهما شرط صلاح الآخر. فالإنسان الفاضل هو الإنسان المُتَّزِن والمنسجم مع نفسه ومع المدينة والعالم، والمدينة الفاضلة هي المدينة الَّتِي تقوم على أساس أخلاقيّ وتصبو إلى تحقيق غاية أخلاقيَّة، وتوفر لمواطنيها كُلَّ الشُّروط الضَّروريَّة لنيل سعادتهم القصوى. فالدَّولة والسِّياسة وسيلة لا غاية، والأخلاق غاية لا وسيلة. بَيْدَ أنَّ الاعتراف بقيمة التُّراث الإطيقيِّ الإغريقيِّ الثَّمينة وتأثيره الحيويّ المستمر إلى يومنا هذا في جميع المذاهب الأخلاقيَّة ينبغي ألَّا يحجب ما استبطنه من شُبهات. ولَعَلَّ إحدى أخطر هذه الشُّبهات هي شُبهة نفي الأُسُس والمعايير الموضوعيَّة العامَّة للأخلاق. فالمقاربة الَّتِي تَرِدُّ الأخلاق إلى الفضائل وترى فيها هيئةً داخليًّة للنَّفْسِ الإنسانيَّة وظاهرة شخصيَّة-ذاتيَّة، يمكن أنْ تقع بسهولة في أحضان العدميَّة الأخلاقيَّة ethical nihilism إذا ما التبس عليها الحدُّ الدَّقيق الفاصل بين النِّسبيَّة والعدميَّة. وبخلاف الإطيقا القديمة مثَّلت الإطيقا الدِّينيَّة القروسطيَّة التَّطرُّف الآخر باندفاعها بعيدًا في النَّظر إلى الأخلاق وإلزاماتها من منظور المُفَارِق والمتعالي والثَّابت والمطلق. فالتَّصَوُّر اللاهوتيُّ للأخلاق، من جهة التَّأسيس ومن جهة الاستنتاجات المعياريَّة، يتمحوَّر حول فكرة الله، وتتسيَّدَهُ رُوح المركزيَّة-الإلهيَّة، على ما يتجلَّى ذلك في أطروحاته الرَّئيسة الآتية: ا- إنَّ الله هو القُوَّة الخلَّاقة الوحيدة، ومبدأ العالم وغايته. وهو الكائن الكُلِّيُّ القدرة والعلم والخير؛ ب- إنَّ العالم بما فيه الإنسان مجرَّد موضوعٍ للتَّقييم الأخلاقيِّ، وليس مصدرًا للأخلاق؛ ج- إنَّ ما هو خير وحسن، أو شَرٌّ وقبيح هو كذلك، لأنَّ الله وفقط، لأنَّ الله يأمر به أو ينهى عنه، وليس العكس. إذ إنَّ افتراض خلاف ذلك يضعنا أمام بديلين: إمَّا تزويد مفهوم الله بمضامين ومحمولات أخلاقيَّة أو إعطاء فكرة الخير مقامًا إلهيًّا. وفي كلتا الحالتين يبدو اللهُ مُقَيَّدًا بالخير وبالقانون الأخلاقيِّ، ومُلْزَمًا بهما، ما قد يعني، بالتَّالي، وجود معايير أخلاقيَّة خارجيَّة أعلى منه ومستقلَّة عن إرادته الحُرَّة. وَكِلا البديلين، وَفْقًا لهذا التَّصَوُّر، مرفوض لانتقاصهما من الذَّات الإلهيَّة وتَعَارُضهما الفاضح مع النَّظرة إلى الله ككائن مطلق الحُرِّيَّة وخالق لِكُلِّ شيء لا نظير يساميه ولا قريب يدانيه. فالوصايا والأوامر الإلهيَّة ينبغي قبولها والالتزام بها لا لكونها حسنة وصحيحة وإنسانويَّة بذاتها، بَلْ لأنَّها إلهيَّة. فأصلها الإلهيُّ بحدِّ ذاته هو ضمانة مصداقيَّتها ونزاهتها وحُسْنها؛ د- إنَّ فصل الأخلاق عن الله والدِّين، وتجذيرها في الإنسان يفضيان، لا محالة، إلى النِّسبيَّة والذَّاتيَّة والعدميَّة الأخلاقيَّة، ويُشَكِّلان، بالتَّالي، إيذانًا صريحًا بنفي الأخلاق ونَعْيها. ويفترض هذا الموقف أنَّ معنى المفاهيم الأخيرة ومآلها الفعليّ واحد باعتبار أنَّ تربُّع الإنسان على عرش التَّشريع الأخلاقيّ لا بدَّ أنْ يؤدِّي إلى تجريد القيم والأخلاق من كُلِّ أساس ومعيار موضوعيّ وعقلانيّ وثابت وموثوق، لأنَّ ما يحلِّله أو يحرِّمه، يستحسنه أو يستقبحه إنسان ما أو جماعة ما ليس يلزم بالضَّرورة أنْ يحلِّله أو يحرِّمه إنسان أو جماعة أُخرى. فحيث يأمر كُلُّ إنسان وينهى، يحلِّل ويحرِّم ما يشاء ووقتما يشاء وكيفما يشاء طِبْقًا لمقتضيات المصلحة والهوى والانفعال يصير كُلُّ شيء خيرًا وحلالًا وكُلُّ شيء شرًّا وحرامًا، وفي الوقت عينه، لا شيء خير وحلال ولا شيء شرٌّ وحرام. لذا، فإنَّ كُلَّ ما لا يجد أساسه الأنطولوجيّ والإبستيمولوجيّ في الله لا أمان معه ولا مصداقيَّة له ولا يُعَوَّل البتَّة عليه؛ ه- إنَّ المعرفة الأخلاقيَّة الصَّحيحة مستحيلة من دون المعرفة الدِّينيَّة، ما يعني أنَّ للأخيرة أسبقيَّة منطقيَّة ومفهوميَّة على الأُولَى؛ و- إنَّ الوصايا الإلهيَّة مطلقة، أيْ إنَّها صالحة لِكُلِّ زمان ومكان ولِكُلِّ مجتمع وظرف وإنسان؛ ز- إنَّ الإنسان عاجز عجزًا مبدئيًّا عن التَّغَلُّبِ على الخطيئة الأصليَّة والخلاص من الشُّرور والرَّذائل بقواه الذَّاتيَّة الخاصَّة. فليس ذلك متاحًا له من دون تَدَخُّلِ العناية واللُّطْف الإلهيَّين؛ ح- إنَّ بلوغ الإنسان لسعادته الحقيقيَّة القصوى ليس ممكنًا إلَّا في الحياة الأخرويَّة. وعلى الرَّغْمِ من الإسهام الإيجابيِّ للإطيقا اللاهوتيَّة القروسطيَّة في إغناء مفاهيمنا وتصوُّراتنا الأخلاقيَّة بفعل إثارتها لمسائل مهمَّة تتعلَّق بالمعايير الموضوعيَّة للتَّمييز بين الخير والشَّرِّ، وبالمقام الموضوعيِّ للأخلاق، فإنَّها لم تَسْلَم هي الأُخرى من الوقوع في شُبهات شَتَّى، ومن أهَمِّها شُبْهة تجريد الأخلاق من أخصِّ صفاتها المميِّزة لها ألَّا وهي فعاليتها العمليَّة وقابليتها التَّطبيقيَّة. زِدْ على ذلك أنَّ المبدأ الَّذِي يرى في الأخلاق ظاهرةً خارج وفوق شخصيَّة، ويضفي على معاييرها وقواعدها طابَعًا مطلقًا وبُعْدًا غيبيًّا، ويضع مصادر السُّلوك الأخلاقيِّ خارج حدود الوجود الاجتماعيِّ للإنسان هو مبدأ أحاديُّ الجانب كَمَثَلِ المبدأ الَّذِي يحصرها في الهيئة النَّفْسِيَّة للشَّخصيَّة الإنسانيَّة. وبُغْيَة الخروج من تِيه هاتين الشُّبْهتين المتطرِّفتين تسعى إطيقا العصر الحديث إلى فهم الأخلاق كناموس موضوعيّ وكظاهرة ذاتيَّة-شخصيَّة معًا، وذلك عَبْرَ إعادة قراءة تلك الجوانب الَّتِي عولجت في كُلٍّ من فلسفة الأخلاق القديمة والوسيطة، على نحوٍ أحاديٍّ ومنفصل، وصَهْرها في نسقٍ نظريٍّ واحد.
ومع إطلالة العصر الحديث انعكست فكرة موضوعيَّة الأخلاق كظاهرة وكمعرفة في نظريات العقد الاجتماعيِّ الَّتِي يعود الفضل في صياغة أكثر نُسَخها أصالةً إلى الفيلسوف الإنجليزيّ توماس هوبز (1588 - 1679). لكن شَتَّانَ ما بين موضوعيَّة ترتكز على أساس ماورائيّ سماويّ وموضوعيَّة ترتكز على أساس طبيعيٍّ أرضيٍّ. وإذا كان الفكر الإطيقيّ اللاهوتيّ قد ربط، كما أوضحنا أعلاه، موضوعيَّة المعايير الأخلاقيَّة بالله وحده، ورَدَّ المعرفة الأخلاقيَّة الصَّحيحة إلى المعرفة الدِّينيَّة لا إلى المعرفة النَّظريَّة-العقليَّة، فإنَّ فلاسفة العصر الحديث عمومًا، وفرنسيس بيكون ورينيه ديكارت وغوتفريد لايبنتز خصوصًا، ينظرون إلى المسألة على نحوٍ مغاير جذريًّا. فقد عُرِف عنهم سعيهم إلى تطبيق تلك الرُّؤية الموضوعيَّة ذاتها إلى الأشياء الَّتِي ترسَّخت في العلوم الطَّبيعيَّة على ميدان الأخلاق. وفي ضوء هذه الرُّؤية تسقط مزاعم التَّأسيس الدِّينيّ للأخلاق، ويستعاض عنه بالتَّأسيس العقلانيّ-العلميّ الصَّارم. إذ إنَّ المسألة بالنِّسبة إليهم لم تَعُدْ تكمن في إدراج العالم تحت مفاهيم الخير والشَّرِّ، بَلْ في اشتقاق المفاهيم والتَّصَورات الأخلاقيَّة من العالم الواقعيِّ. لذا، لا يمكن للإطيقا، في رأيهم، أنْ تنفصل عن العلم والفلسفة النَّظريَّة. فهي نفسها تخضع للدِّراسة والبحث بواسطة المناهج العلميَّة وتعتمد على التَّأصيل الفلسفيِّ-النَّظريِّ. وفي هذا السِّياق تسترعي الإنتباه وجهة نظر ديكارت الَّذِي يُشَبِّه العلوم بشجرةٍ جذورها الميتافيزيقا (الفلسفة)، وجذعها الفيزياء، وأغصانها الطِّبّ والميكانيكا والإطيقا الصَّحيحة. وهذه الأخيرة هي رأس الحكمة ودرَّة تاجها وأطيب ثمارها بما تفترضه من معرفة كاملة بالعلوم الأُخرى(1). ومن مِثْلِ هذه النَّظرة الجديدة إلى العلوم وإلى مكانة الإطيقا بينها ينطلق هوبز. فهو يرى أنَّ في مقدور الإطيقا أنْ تكتسب الدِّقَّة والموضوعيَّة العلميَّين بقدر ما تَتَبنَّى المناهج المعتمَدة في الهندسة والفيزياء. وهذا يعني، طبعًا، أنَّ ما ينطبق على العلوم، الطَّبيعيَّة منها والصُّوريَّة، هو تمامًا ما ينطبق على المعرفة الأخلاقيَّة. وما لم تحذو الإطيقا حذو العلوم المذكورة، فإنَّها تحكم على نفسها بالمراوحة في دائرة الوعي السَّاذَج، والمجادلات العقيمة الَّتِي لا تَمُتُّ إلى الحقيقة بأيِّ صِلَةٍ. قصارى القول، إنَّ ميدان الأخلاق قابل للتَّفسير الطَّبيعيِّ والعلميِّ شأنه في ذلك شأن أيِّ مجال آخر من مجالات العالم الواقعيِّ. ومن الواضح أنَّ هوبز مؤمن بقدرة العقل الإنسانيِّ، وباستقلال عن الدِّين، على معرفة النُّظم السِّياسيَّة-الحقوقيَّة الصَّالحة لحياة البشر، وعلى تمييز الحقِّ من الباطل، الخطأ من الصَّواب، وكذلك هو المرجع الأعلى في مسائل الأخلاق. لكن ما هي الأخلاق؟
تتطابق الأخلاق عند هوبز مع المعايير ذات الأهَمِّيَّة العامَّة. فلا هي ماهيَّة ميتافيزيقيَّة ثابتة ومطلقة، ولا هي ماهيَّة طبيعيَّة، بَلْ تقوم على العقل وتؤلِّف إلى جانب الحقِّ والقانون الشَّرط الضَّروريَّ لانتقال الإنسان من الحالة الطَّبيعيَّة إلى الحالة الاجتماعيَّة، من التَّوحُّش إلى المدنيَّة. وبيان ذلك أنَّ حياة البشر، وَفْقًا لهوبز، في الحالة الطَّبيعيَّة هي امتداد لفطرتهم العدوانيَّة ومرآة تعكس حقيقة ماهيَّتهم الأنانيَّة. وبسبب هذين المَيلين المتجذِّرَين في أعماق طبيعة الإنسان ما كان للحالة الطَّبيعيَّة إلَّا أن تكون شريعة غابٍ قوامها: "الحقُّ الحصريُّ لكُلِّ واحد في امتلاك الأشياء كُلِّها"؛ و"حرب الكُلِّ ضِدُّ الكُلِّ"؛ و"الإنسان ذئب على أخيه الإنسان". ويعزو هوبز ذلك إلى الطَّبيعة الَّتِي غرست الأنانيَّة في جبلة البشر، وخلقتهم، في الوقت نفسه، متساوين في قدراتهم ومَلَكَاتهم النَّفْسِيَّة والجسمانيَّة. وهو الأمر الَّذِي يجعلهم متساوين أيضًا في غاياتهم ومطامحهم(2). لكن هذا الواحد المشترك بين جميع أفراد النَّوع الإنسانيّ هو نَفْسُهُ الَّذِي يُفَرِّق جَمْعَهُم ويُشَتِّت شَمْلَهُمْ. ومعنى ذلك أنَّ هذه الأنانيَّة المقرونة بالمساواة في المَلَكَات والغايات ستدفع، حتمًا، كُلَّ واحد منهم إلى الاستئثار الحصريِّ بِكُلِّ ما يشتهيه وتطاله يداه وتطأه أخامص قدميه، ما يؤدِّي إلى شيوع المنافسة التَّناحريَّة الحادَّة وانعدام الثِّقة في ما بينهم والاحتراب. فالغايات المحكومة برُوح الأنانيَّة الفرديَّة لا تتَّسع ولا يمكن أنْ تتَّسع للجميع. فإذا ما أراد شخصان الشَّيء الواحد عينه ولم يكن في الإمكان إلَّا أنْ ينفرد أحدهما في امتلاكه، فإنَّ النَّتيجة المحتومة المترتبة على ذلك هي استحكام رُوح العداوة بينهما. وإذا كانت الأنانيَّة الفرديَّة المتفلِّتة من كُلِّ قيد ورادع، في رأي هوبز، هي الدَّافع الرَّئيس لسلوك الأفراد ومُحَرِّك الحالة الطَّبيعيَّة وعلَّة وجودها، فإنَّ الحرب الدَّائمة والشَّاملة هي خاصِّيَّتها الجوهريَّة ومَرْجِعُهَا المحتوم. وليست أنانيَّة الطَّبيعة الإنسانيَّة هرطقة فلسفيًّة، بَلْ هي واقعة وحقيقة مُعَاشَة أكيدة، حسبما يرى هوبز. فالحياة اليوميَّة مترعة بالأنانيَّة. وأينما ولَّى الإنسان وجهه فَثَمَّ أنانيَّة تنضح بها علاقات البشر وتتنفَّسها أفعالهم كافَّةً. فنحن، على ما يقول هوبز، نتسلَّح عندما ننطلق في طريق ما، ونوصد الأبواب حين نخلد إلى النَّوم حَتَّى أنَّنا نغلق الخزائن في منازلنا، ألا تعني هذه الأفعال اعترافًا ملموسًا بالأنانيَّة الحيوانيَّة لطبيعة الإنسان؟(3). وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاعتراف بالتَّوجُّه الأنانيِّ للسُّلوك الإنسانيِّ كان بالنِّسبة إلى الفكر الأخلاقيِّ البرجوازيِّ التَّقليديِّ بمنزلة البديهة الَّتِي لا يرقى إليها أيُّ شَكٍّ. فَحَتَّى أولئك الفلاسفة الَّذِينَ أحسنوا الظَّنَّ بالإنسان وعَدُّوه كائنًا خيِّرًا ونبيلًا بالفطرة والسَّليقة نعتوا وجوده الواقعيّ بالوجود المشوب والمُلَطَّخ بِلُوثة الأنانيَّة. وبالفعل، قلَّما نجد فيلسوفًا من فلاسفة العصر الحديث، مهما كان موقفه القيميّ من الأنانيَّة، ينكر هذه الواقعة. فقد اعتقد لاروشفوكو أنَّ المصلحة الخاصَّة والأنانيَّة يتكلَّمان كُلَّ اللُّغات ويتقمَّصان أدوار جميع الشَّخصيَّات، بما فيها الشَّخصيَّة العصاميَّة والغيريَّة. فنحن لا نتقرَّب إلى النَّاس حبًّا بالخير لهم، بَلْ طمعًا بالخير الَّذِي نبتغيه لأنفسنا منهم. في حين عدَّ روسو الأنانيَّة مَسْخًا وتشويهًا لطبيعة الفرد الأصليَّة الطَّيِّبة، ونتاجًا لِتَطَوَّرِ العلوم والفنون ولظهور المِلْكِيَّة الخاصَّة واللامساواة. ورأى فيها هلفيتيوس وهولباخ أساس التَّجديد الاجتماعيِّ وقلبه النَّابض. واللافت في هذا السِّياق أنَّ كانط أيضًا لم يستطع إنكار قُوَّة حضور الدَّوافع الأنانيَّة وتأثيرها في السُّلوك الإنسانيِّ رغم مجاهرته بنقده الجذريِّ ومعاداته لكُلِّ المذاهب الأخلاقيَّة الَّتِي تؤسِّس مُثُل الإنسان وقيمه على المنفعة واللَّذَّة والمصلحة. وقد لا نبالغ إنْ قلنا إنَّ التَّعرية القاسية لأُسُس المجتمع البرجوازيِّ الأخلاقيَّة الَّتِي نجدها في مؤلَّف ماركس وإنجلز "بيان الحزب الشُّيوعيِّ" وغيره من المؤلَّفات، في كثير من جوانبها، ما هي إلَّا استئناف وتطوير لذلك الخطِّ النَّقديّ السَّليم في وصف وتقييم سلوك الأفراد البرجوازيّين الَّذِي أرسى بداياته الأُولَى توماس هوبز.
واستكمالًا للكلام على شِرْعَةِ الحالة الطَّبيعيَّة ومآلاتها يخلص هوبز إلى التَّأكيد أنَّ العمل بها لا يعيق التَّعاون المشترك والتَّكامل المتبادل فحسب، وإنَّمَا يفضي أيضًا إلى هَرْجٍ ومَرْجٍ يطيحان بِكُلِّ الحقوق وفي مقدَّمها الحقُّ في الحياة. إذ إنَّ حالةً كهذه هي حالة لا مَنَاصَ من أنْ يواجه فيها كُلُّ فرد ما صار يُعرَف في الأدبيَّات الأخلاقيَّة بمعضلة السُّجناء Prisoner's dilemma. ومغزى هذه المعضلة هو أنَّه لو فكَّر وعمل كُلُّ فرد على تحقيق خيره الخاصِّ فقط، وبأيِّ وسيلة ممكنة، غير آبه البتَّة بمصالح الآخرين، لارتدَّ ذلك عليه وعليهم وبالًا ونكالًا مُحَقَّقَين، ولحصدوا جميعًا الخسران المُبِين. وكما أنَّ الشَّرَّ المطلق مُمْتَنَع، فكذلك الأنانيَّة المطلقة مُمْتَنَعة بدورها. وكُلٌّ منهما ينفي ذاته بذاته. فالأنانيَّة نفسها وعند أقصى درجات استفحالها تنقلب من قُوَّةٍ جامحة إلى قُوَّةٍ كابحة. فليس بعد التَّناهي في الزِّيادة سوى النُّقصان، وليس بعد القِمَّة سوى الهاوية والانحدار. فالإنسان وإنْ كان يروم التَّملُّك والمجد والغلبة والجاه، إلَّا أنَّه يرغب أيضًا في العيش والبقاء ويخشى الموت والفناء. ولا يستقيم الحَلُّ والمخرَج من هذا المأزق الوجوديِّ القاتل إلَّا بالانصياع للنَّاموس الأساسيِّ للطَّبيعة، والاقتداء بالقانون الكُلِّيِّ لقاعدة السُّلوك الَّذِي اهتدى إليه العقل. ويدعو هذا النَّاموس النَّاسَ إلى السَّعي بِكُلِّ وعي وعزم وصدق في طلب السَّلام والاستقرار، وإلى التَّخلِّي من أجْلهما عن مطمع الحقِّ الأوَّليِّ في كُلِّ الأشياء. فالأخلاق بما هي ارتقاءٌ على الحيوانيَّة وتَجَاوُزٌ للحالة الطَّبيعيَّة لا تُعقل من دون ضبط للسُّلوك وخضوع للقواعد وتقييد للحُرِّيَّات وتهذيب للأهواء والشَّهوات. وهي بهذا المعنى، كما القوانين الحقوقيَّة، تؤلِّف الصِّيغة أو الشَّكل الَّذِي يتنازل الأفراد فيه بموجب عقدٍ اجتماعيٍّ وتَوَافُقٍ عقلانيٍّ عن بعض حقوقهم الأوَّليَّة بغية خلق مقدِّمات السَّلام وتوطيد أواصر الاتِّحاد الاجتماعيِّ والحفاظ عليهما. إذ إنَّه لولا الوفاق والوِئامُ في العِشْرة والعيش لَهلَك الأنامُ. وفي حال التَّوافق العامِّ على ذلك، فإنَّه ينبغي لِكُلِّ واحد أنْ يرضى ويقتنع في علاقته مع الآخرين بالقدر نفسه من الحُرِّيَّةِ الَّذِي يسمح به للآخرين في علاقتهم معه عملًا بالقاعدة الذَّهبيَّة للأخلاق: "لا تفعل بالآخر ما لا تريد منه أنْ يفعله بك"(4). وهذه القاعدة هي المعيار الَّذِي يجيز تحديد ما إذا كان الفعل موافقًا لقانون الطَّبيعة البديهي أم لا. وإذا حصل الاتِّفاق للبشر فلا بدَّ، عندئذ، من تكوين مؤسَّسَة (جهاز، هيئة) عامَّة مستقلَّة ومحايدة تسهر على حمايته وترعى تنفيذه من مُنْطَلَقٍ مفاده أنَّه لا قيمة لعقد ولا ديمومة لحقٍّ لا تعضدهما قُوَّةٌ ولا يحرسهما وازع. وهذه المؤسَّسَة العامَّة هي الدَّولة ويرمز إليها هوبز بالوحش أو التِّنِّين. وهي السُّلْطَة الَّتِي يتنازل لها الأفراد عن جزء من أطماعهم وحُرِّيَّاتهم، ويفوضونها صلاحيات فضِّ النِّزاعات في ما بينهم والدِّفاع عنهم بما لها من بأس شديد يَفُوق قُوَّةَ المتعاقدين فرادى ومجتمعين. ناهيك بكونها صاحبة الحقِّ الحصريِّ في استخدام العنف والمبادرة إلى الحرب كلَّمَا دعت الضَّرورة إلى ذلك. وهكذا، بفضل القانون الأخلاقيِّ والعقد التَّوافقيِّ ونشوء الدَّولة يتمُّ انتقال البشر من الحالة الطَّبيعيَّة إلى الحالة الاجتماعيَّة، ومن الأنانيَّة الفرديَّة المفرطة إلى الأنانيَّة العقلانيَّة المعتدلة، ومن حقِّ القُوَّةِ إلى قُوَّةِ الحقِّ. ويتَّضح مِمَّا سبق أنَّ الأخلاق عند هوبز ترتبط ارتباطًا جدليًّا بالحقِّ والدَّولة والاجتماع. فكُلُّ واحد منهم يستدعي الآخر ويحيل إليه ويؤثِّر فيه. ومع أنَّ الأخلاق، وَفْقًا لفيلسوفنا، هي أصل الدَّولة والاجتماع وشرط إمكانهما، إلَّا أنَّها من جهة وظائفها الأساسيَّة لا تُعقل خارجهما وبمعزل عنهما. فهذان النِّصابان هُمَا، تحديدًا، من يزوِّدنا بمعيار التَّمييز بين الفضيلة والرَّذيلة، بين العدل والظُّلم. وفي الحقيقة، فقد أحدثت هذه المقولة البالغة الأهَمِّيَّة قطيعةً حادًّة مع التَّقاليد السِّياسيَّة والأخلاقيَّة الدِّينيَّة القروسطيَّة. فما عادت الدَّولة والحاكم يستمدان شرعيَّتهما من قوانين الكنيسة والحقِّ الإلهيِّ، بَلْ من الحقِّ الوضعيِّ والعقد التَّوافقيِّ-الاجتماعيِّ. وما عادت مفاهيم الخير والشَّرِّ ماهيَّات كُلِّيَّة فوق إنسانيَّة، بَلْ ضرورة مُلِحَّة محايثة للاجتماع الإنسانيِّ. وعلى وجه العموم، ينظر هوبز إلى الخير والشَّرِّ بعيون أداتيَّة رافضًا القول باستقلاليَّتهما. فَمُسَوِّغ الخير إنَّمَا يكمن في ضرورته لقيام الوحدة الاجتماعيَّة وبقائها. وبالفعل، لقد كان التَّعليلُ العقديُّ-الاجتماعيُّ للأخلاق، المأخوذ في سياق التَّطَوُّر التَّاريخيِّ الملموس، الَّذِي نزع عن المفاهيم الأخلاقيَّة رداء المُطْلَقيَّة ضربًا من ضروب التَّحرُّر من الاضطهاد الرُّوحيِّ الدِّينيّ-الكَنيسيّ، من جهة، وخطوةً متقدِّمًة على درب الانعتاق من أسر الفهم الطَّبيعانيِّ للأخلاق، من جهة أُخرى.
وعلى الرَّغْمِ من اعتراض هوبز على الادِّعاءات القائلة بمطلقيَّة الأخلاق، فإنًّه يعدُّها شرطًا أوَّليًّا وعتبةً مطلقة absolute threshold لوجود المجتمع والدَّولة. وتُشَكِّلُ القوانين الأخلاقيَّة إلى جانب القوانين الحقوقيَّة بالنِّسبة إلى الأفراد الواقعيّين ورغباتهم الحيَّة اليد الخارجيَّة القاهرة والقُوَّة الموحِّدة لهم والمُهَذِّبَة لأهوائهم والكابحة لميولهم العدوانيَّة-الأنانيَّة. وتبرز الأخلاق كمجموعة من المعايير المَدْعُوَّة إلى وضع أفعال الأفراد تحت قاسم مشترَك. وينبغي التَّأكيد أنَّ الوظيفة القمعيَّة للأخلاق لا تندثر بإنجاز سيرورة الخروج من الحالة الطَّبيعيَّة. والأصل في ذلك إنَّمَا مردُّه إلى كون الأخيرة ليست مجرَّد مرحلة عابرة سادت ثُمَّ بادت من مراحل التَّاريخ الإنسانيِّ السَّحيق، بَلْ هي سِمَة جوهريَّة من سِمَات الطَّبيعة الإنسانيَّة مستمرة عَبْرَ الأجيال. ولما كانت طبيعة الإنسان، على ما يرى هوبز، لا تتغيَّر ولا تتبدَّل جوهريًّا، بَلْ تبقى أبد الآبدين طبيعةً أنانيًّة وشريرة، كان مُقَدَّرًا للأخلاق أنْ تبقى، على الدَّوام، قُوَّةً خارجيًّة مُقَيِّدة لِحُرِّيَّةِ الأفراد.
ومع أنَّ القوانين الأخلاقيَّة تملك أساسًا عقلانيًّا ويُقْرُّها العقل، إلَّا أنَّه ينبغي لها لكي تصبح فعَّالة أنْ تترسَّخ في وجدان البشر ومشاعرهم وسلوكهم أيضًا. لذا، فإنَّ البِنْيَة الحقوقيَّة مدعُوَّة عَبْرَ نظام الثَّواب والعقاب إلى تأمين مثل هذا التَّرسيخ، وترجمة القناعات الفكريَّة والأحاسيس الأخلاقيَّة إلى نهج سلوكيٍّ وخُطَّة عمل للأفراد. ذلك أنَّ "سَنَّ القانون يعني تهيئة سبب العدل وفرض الالتزام به"(5). وكذلك "ليس الثَّناء والإدانة عديمَيِ الجدوى، بَلْ إنَّهما كالثَّواب والعقاب يكوِّنان بواسطة القدوة الحسنة وقُوَّة المثال إرادة النَّاس ويوجِّهانها إمَّا إلى الخير وإمَّا إلى الشَّرِّ"(6). فالاعتراف بالمقام الأخلاقيِّ للآليَّة الحكوميَّة-الحقوقيَّة هو الوجه الآخر للسُّمو الأخلاقيِّ عند الفرد الأنانيِّ، وبالعكس. وعلى وجه الإجمال، إنَّ التَّطلُّعات المعياريَّة لهذه النَّظريَّة تصبو إلى ربط الحُرِّيَّة الفرديَّة بالضَّرورة الاجتماعيَّة، وردم الهُوَّةِ الفاصلة بين المصالح الخاصَّة والمصالح الاجتماعيَّة على قاعدة تطوير النِّظام السِّياسيِّ-الحكوميِّ، وإيجاد المبادئ والقوانين العقلانيَّة الَّتِي يمكنها أنْ تشيع التَّناغم والانسجام في عالم الأفراد الأنانيّين الفوضويّ.
بالطَّبع، يمكن للإجراءات الحقوقيَّة والآليَّات الحكوميَّة، وفي حدود معيَّنة، ضمان مراعاة المعايير الأخلاقيَّة، لكن يستحيل عليها تحويل هذه المعايير إلى حقيقة للطَّبيعة الإنسانيَّة. إذ إنَّ المقاربة الهوبزيَّة الَّتِي تحصر الأخلاق في الأفعال الظَّاهريَّة فقط، لا تلغي خصوصيَّة الأخلاق فحسب، وإنَّمَا تتناقض أيضًا مع حقائق السُّلوك الإنسانيِّ الواقعيَّة والَّتِي تشهد على أنَّ الأخلاق هي حالة حميمة تبحث عن مُسَوِّغها في صميم الوجدان الإنسانيِّ. والحال أنَّه لم يكن في وسع هوبز تجاهُل هذه الحقيقة الأخلاقيَّة الواضحة والسُّكوت عنها. لذا تراه يعترف بأهَمِّيَّة الفضائل الأخلاقيَّة، في معناها التَّقليديِّ، من مِثْلِ التَّواضع والوفاء والإنسانويَّة والرَّأفة والمودَّة وما شابه. غير أنَّ ذلك لم يعصمه البتَّة من الوقوع في حبائل التَّهافت النَّظريِّ: فكيف يُمْكِنُ تَجَاوُزُ التَّعارض الأصليِّ بين الفضائل المذكورة وطبيعة الإنسان الأنانيَّة، لا سِيَّمَا، وأنَّ التَّعويل على تبديل الأخيرة واستئصالها من جذورها هو رهان خاسر سلفًا مآله الفشل الذَّريع؟ وأنَّى يمكن الجمع والتَّوفيق بين شموليَّة المبادئ الأخلاقيَّة وطابعها الإنسانيّ العامِّ وبين الأنانيَّة الَّتِي لا هَمَّ لها سوى المصلحة الخاصَّة لهذا الفرد أو ذاك حَتَّى لو اقتضى ذلك فساد الكون بأسره؟!!! والحال أنَّه بالإضافة إلى هذه المعضلة الَّتِي تواجهها نظريَّة هوبز العقديَّة-الاجتماعيَّة ثَمَّةَ صعوبات أُخرى لا تَقِلُّ عنها خطورةً على غير مستوى وصعيد.
وللإضاءة على بعض هذه الصُّعوبات سينْصَبُّ اهتمامنا على مسألتين: الأولى تتعلَّق بمفهوم الأنانيَّة الَّذِي استحال على يد هوبز مفهومًا مركزيًّا بنى عليه صَرْحَ مذهبه في السِّياسة والاجتماع والأخلاق؛ والمسألة الثَّانية تتَّصل بمزعمه القائل بوجود حالة ما قبل اجتماعيَّة pre-social للبشر. وبما أنَّ مفهوم الأنانيَّة هو مفهوم متعدِّد الدَّلالات، ومرَّ تاريخيًّا ولم يزل يمرُّ بسلسلة من الاستثمارات الإيديولوجيَّة لخدمة مآرب فئويَّة ضَيِّقة وخبيثة، فإنَّه من المناسب إبداء خمس ملاحظات تقويميَّة. الملاحظة الأُولى- ينبغي عدم مماهاة الأنانيَّة مع حبِّ الإنسان لنفسه ونزوعه إلى تحقيق مصالحه ورغبته في تأكيد سيادته ومهر العالم من حوله بختم فرادته. فهذا ما ينبغي اعتباره شأنًا طبيعيًّا ومشروعًا وحَتَّى واجبًا. لذا كان من الضَّروريِّ التَّميِيز بين الأنانيَّة وحبِّ الذَّات. وليس هذان المفهومان مترادفين ولا هُمَا الشَّيء نفسه. فالأنانيَّة، بخلاف حبِّ الذَّات، هي تحقيق الفرد لذاته وثروته وسعادته على حساب الآخرين ومقابل تعاستهم وإفقارهم وقهرهم. فالفرد الأنانيُّ هو كائن طفيليٌّ عَيال على غيره مركزيُّ التَّوجُّه واصطفائيُّ النَّزعة ونرجسيُّ الرُّؤية يعدُّ نَفْسَهُ المبتدأ والخبر، البداية والنِّهاية، وبؤرة المعنى وغاية الْخَلْقِ. وكُلُّ ما في الوجود هو له وحده ولا شيء لغيره. فهو لا يَحِبُّ موضوعات ميوله بذاتها ولذاتها، بَلْ لذاته. وهو إذ يعشق، إنَّمَا يعشق ذاته أوَّلًا وأخيرًا. أمَّا حبُّ الذَّات أو النَّفْسِ فليس فيه ما يلزم المرء بالتَّعدِّي على حقوق الآخرين وإلحاق الأذى والضَّررِ بهم. الملاحظة الثَّانية- إنَّ مقولة الأنانيَّة الفرديَّة قد تفسِّر لنا بنجاح واجبات الإنسان تجاه نفسه، لكنَّها أعجز من أنْ تفسِّر حقوق الآخرين وواجبات الإنسان تجاههم، فضلًا عن صَمْتِهَا المُطْبِق وإخفاقها التَّامِّ في تفسير وقائع حياتيَّة من مثل حالات التَّضحية والإيثار ونكران الذَّات والممارسات الغيريَّة altruism الَّتِي لا يخلو مجتمع وعصر من نماذجها المُلْهِمَة. الملاحظة الثَّالثة- لم تقتصر تجلِّيات الأنانيَّة تاريخيًّا على صورتها الفرديَّة فقط، وإنَّمَا اتَّخذت أيضًا صورًا جماعيَّة متنوِّعة (عائليَّة، عشيريَّة-قبيليَّة، طبقيَّة وقوميَّة وإلخ). الملاحظة الرَّابعة- إنَّ الإنسان لم يوجد ولا يمكن أنْ يوجد إلَّا في حالة اجتماعيَّة. ولا حالة للإنسان سابقة ومتقدِّمة تاريخيًّا على حالته الاجتماعيَّة. وهذه حقيقة أدركها الفلاسفة الإغريق قديمًا، وأسهب ابن خلدون لاحقًا، على نحوٍ خلَّاق، في تطوير رؤيتنا لها ولأنماط العمران (الاجتماع) البشريِّ وأطواره وطبائعه. فقد كان له قَصَب السَّبْقِ في التَّفريق بين طورين متميِّزَين نوعيًّا ومتعاقبين تاريخيًّا من العمران البشريِّ: العمران البدويُّ؛ والعمران الحضريُّ. والاختلاف بين هذين الشَّكلين من الاجتماع الإنسانيِّ وما يلازم أهلهما من عادات وأخلاق وطباع ومواهب إنَّمَا هو باختلاف نحلتهم من المعاش، أيْ بجملة الأساليب والصَّنائع الَّتِي يُحَصِّلُ بها النَّاس رِزْقَهُمْ وعيشهم. وقد عنى ذلك وجود قوانين اجتماعيَّة وعوامل اقتصاديَّة وطبيعيَّة موضوعيَّة تحدِّد وعيهم وتتحكَّم بِتَغَيُّرِ أنماط حياتهم. والحقُّ أنَّ تَصَوُّرَ هوبز للحالة الطَّبيعيَّة كحقبة تاريخيَّة ما قبل اجتماعيَّة يُعَدُّ خطوةً إلى الوراء بالمقارنة ليس فقط مع ما أتحفنا به ابن خلدون، وإنَّمَا مع ما فتحه الفلاسفة الإغريق القدامى أيضًا. ولكي لا نبخس هوبز حقَّه لا بدَّ من القول إنَّ فيلسوفنا كان مصيبًا تمامًا في الشِّقِّ المتعلِّق بوصف الحالة الطَّبيعيَّة كحالة ما قبل دَوْليَّة pre-state، ولكنَّه حَادَ عن الصَّواب وخانه حدسه في الشِّقِّ الآخر المتعلِّق بوصفه لها كحالة لا ترقى إلى مرتبة الاجتماع. ويُحسب له أيضًا ربطه رُوح الأنانيَّة بالنَّزعة التَّمَلُّكِيَّة الخاصَّة، لكن يؤخذ عليه، في الوقت عينه، تَوَهُّمَه وجود الأنانيَّة الفرديَّة وهيمنتها على جميع العلاقات والدَّوافع السُّلوكيَّة للبشر في عصر الحالة الطَّبيعيَّة. ففي تلك المرحلة والحالة انتفت واقعيًّا شروط إمكان "تألُّق نجم" الأنانيَّة الفرديَّة. فقد كان على الأنانيَّة الفرديَّة بصفتها استعدادًا وقابليَّة للطَّبيعة البشريَّة أنْ تخوض معارك تصاعديَّة مريرة وطويلة قبل أنْ تتمكَّن من إحكام قبضتها على الإنسان وفرض سلطان منطقها عليه. هذا ناهيك بكون وجود الأنانيَّة نفسه مرهون في الأصل بوجود إطار اجتماعيٍّ ورابطة اجتماعيَّة ما. فمن الخطأ الاعتقاد أنَّ البدائيين يعيشون في حالة ما قبل اجتماعيَّة حدَّدتها أنانيَّتهم الشَّخصيَّة المزعومة، وأنَّ استيقاظ وعيهم الأخلاقيّ من سُبَاته العميق هو من أملى ضرورة انتقالهم إلى الحالة الاجتماعيَّة. فالعامل الحاسم (ولا نقول الوحيد) في تحديد الانتقال النَّوعيِّ من النِّظام المشاعيِّ-البدائيِّ إلى الحضارة هو مستوى تطوُّر قوى المجتمع المُنْتِجَة. فالعلاقات الاجتماعيَّة للنِّظام البدائيِّ هي علاقات قائمة على صِلَةِ الرَّحم وقرابة الدَّم حيث يتأطَّر الأفراد في جماعات (بطن، عشيرة، قبيلة) يعود أصل كُلِّ واحدة منها إلى سَلَفٍ واحد. وتؤلِّف العشيرة أساس الحياة الاجتماعيَّة كُلِّها. وتنشأ هذه البِنْيَة العشيريَّة-القبيليَّة بصورة طبيعيَّة تلقائيَّة. وهي مشروطة من البداية بحالة القوى المُنْتِجَة، وتُشَكِّلُ امتدادًا لوضع هذه القوى المتدنِّي للغاية. فقد كانت الرَّابطة العشيريَّة هي الشَّكل الوحيد الممكن للعمليَّة الإنتاجيَّة في تلك المرحلة التَّاريخيَّة القاسية من مراحل تَطَوَّرِ الاجتماع الإنسانيِّ. ففي ظِلِّ وسائل العيش الشَّحيحة، وتَخَلُّف أدوات العمل، وتدنِّي الإنتاج، وافتقار البشر إلى الخبرات العمليَّة والعلميَّة الضَّروريَّة، وعجز واحدهم عن الدِّفاع الذَّاتيِّ ودرء المخاطر الطَّبيعيَّة لم يكن أمامهم بديل آخر غير التَّنظيم الشُّيوعيِّ-البدائيِّ للحياة والعمل والتَّوزيع. وبفضل هذا التَّنظيم- الَّذِي سمح بأقوى أشكال التَّعاضد والدَّعم المتبادل بين أفراد القبيلة الواحدة- استحال ضعف الأفراد المبعثَرين قُوًّةً جماعيًّة. إذ إنَّه ما كان في الإمكان تعويض عجز الفرد إلَّا بالقُوَّةِ الموحَدة والعمل التَّعاونيّ للجماعة. ففي ذلك الزَّمن الغابر لم يكن ثَمَّةَ انفكاكٌ بين جانبَيِ الإنتاج: إنتاج الإنسان؛ وإنتاج وسائل العيش. وقد كان كُلُّ ما يؤلِّف الحياة العائليَّة والشَّخصيَّة المباشرة للأفراد هو ما يُشَكِّلُ، في الوقت عينه، حياتهم الإنتاجيَّة والاجتماعيَّة العامَّة. وبالفعل، تَطَابَقََ أنذاك فضاء الشَّأن الشَّخصيّ، مضمونًا وماصدقًا، مع فضاء الشَّأن الاجتماعيِّ العامِّ. لقد كان الفرد بفكره ومشاعره وتصرُّفاته بصمةً من بصمات العشيرة ونُسْخةً مصغَّرة عنها مطابِقة لها. وكانت سلوكياته واستجاباته مُبَرْمَجة بصورة تامَّة ومحاطة بشبكة من المعايير والنَّواهي المُفَصَّلة الَّتِي تطال مناحي الحياة كافَّةً. بَيْدَ أنَّ هذه الرُّوح الجماعيَّة الَّتِي شكَّلت عصبيَّة القبيلة ومصدر قُوَّتِها الرَّئيس اتَّسمت بطابع ضروريٍّ ومَحَلِّيٍّ داخليٍّ ضَيِّق، وذلك لاقتصارها على العلاقة بين أفراد القبيلة الواحدة وعلى من تحالَف معها من القبائل الأُخرى فقط. في حين اتَّسمت العلاقة بين القبائل الَّتِي لا وشائج قرابة ولا مواثيق وتفاهمات مستقرة بينها بالعدائيَّة والنَّفي المتبادل. ولا واحدة منها حسبت أبناء القبائل الأُخرى بشرًا ونظراء في الْخَلْقِ. فالرُّوح التَّشاركيَّة-الجماعيَّة الموجَّهة نحو الدَّاخل قابلها نفيٌ موجَّهٌ نحو الخارج تُرْجِمَ فصلًا حادًّا بين ال "نحن" وال "هُم"، بين "الأقرباء" و"الغرباء"، وتمييزًا في المعاملة أسقط عن الغرباء جميع المحرَّمات والنَّواهي المعمول بها داخل القبيلة، فَجَازَ، بالتَّالي، غَزْوُهُم وسَبْيهُم وأسْرُهُم وقَتْلُهُم وحَتَّى أكْلُهُم. الملاحظة الخامسة- ليست الأنانيَّة صفةً طبيعيًّة بقدر ما هي صفة اجتماعيَّة للفرد تُعَبِّر عن نمط سلوكيٍّ نوعيّ معيَّن من أنماط علاقته بذاته وبالآخرين. بعبارة أُخرى، ليست الأنانيَّة صفةً فرديًّة فقط، وإنَّمَا هي سِمَة المجتمع القائم على المِلْكِيَّة الخاصَّة. وأيًّا تكن النَّتائج الَّتِي تسفر عنها البُحُوث العلميَّة لطبيعة الإنسان البيولوجيَّة وخريطته الجينيَّة، فإنَّها لا تستطيع إنكار الحقيقة القائلة بأنَّ المِلْكِيَّة الخاصَّة والعلاقات الاستغلاليَّة تمنحان نشاطه كيفيًّة محدَّدة تمامًا، وأنَّ الحضارة الطَّبقيَّة تولِّد حتمًا نمطًا سلوكيًّا أنانيًّا. فجوهر المسألة، على ما يقول كارل ماركس، إنَّمَا يكمن في أنَّ المصلحة الخاصَّة هي نفسها عبارة عن مصلحة محدَّدة اجتماعيًّا ويمكن تحقيقها فقط في ظروف مُعَيَّنة يخلقها المجتمع وبمساعدة وسائل يهيئها ويوفرها المجتمع، أيْ أنَّها مرتبطة بإعادة إنتاج هذه الشُّروط والوسائل. هذه المصلحة هي مصلحة أفراد جزئيّين، لكن مضمونها وصورتها ووسائل تحقيقها معطاة من قِبَلِ الشُّروط الاجتماعيَّة المستقلَّة عن الأفراد"(7). فالأنانيَّة هي نمط من السُّلوك الموجَّه نحو إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعيَّة التَّمَلُّكِيَّة الخاصَّة يُشَكِّلُ فيه السَّعي إلى الثَّروة نواته الصَّلبة وغايته القصوى. فالأساس الشَّيئيُّ للأنانيَّة هو الثَّروة. وتتجلَّى الأنانيَّة في صورتها الخالصة كشغف بالتَّمَلُّكِ والمال والهَوَس بهما. وإلى هذا المعنى يذهب فريدريك إنجلز بقوله في ختام مؤلَّفه أصل العائلة والمِلْكِيَّة الخاصَّة والدَّولة: "لقد كان الجشع الدَّنيئ هو القُوَّة المحرِّكة للحضارة منذ يومها الأوَّل إلى يومنا هذا، الثَّروة ثُمَّ الثَّروة وثالثًا الثَّروة؛ فقد كانت ثروة هذا الفرد الجزئيّ المثير للشَّفقة هي هدفه الوحيد والحاسم لا ثروة المجتمع"(8).
إضافةً إلى كُلِّ ما تقدَّم يمكن القول إنَّه حَتَّى لو افترضنا وسلَّمنا مع هوبز أنَّنا أنانيّون عقلانيّون rational egoists، فإنَّه يبقى من الواضح أنَّ المحاججة الأنانيَّة-العقلانيَّة تبدو غير مجدية في حَلِّ "معضلة السُّجناء" في مختلف بدائلها الضَّيِّقة منها أو الواسعة. فالتَّوجُّه السُّلوكيُّ الأنانيّ-العقلانيّ وإنْ كان لا يُشَكِّل عائقًا معرفيًّا في التَّمييز بين الحسن والقبيح، الصَّحيح وغير الصَّحيح من الوجهة الأخلاقيَّة إلَّا أنَّه لا يمكن أنْ يكون متحقِّقًا عمليًّا بصورة متماسكة ودائمة وشاملة ومضمونة. فهو يبدو معدوم الفائدة ولا مكان له في المواقف الَّتِي يغلب عليها تَضارب المصالح والمنافسة التَّناحريَّة. ففي أوضاع كهذه لا شيء يضمن إمكانيَّة تَجَاهُل الإنسان للمبادئ الصَّحيحة من المنظارين الأخلاقيِّ والعقليِّ، وعدم العمل بها، خصوصًا، إذا ما تيقَّن عدم افتضاح أمْرِ مخالفته لها وانتهاك حُرْمَتِها. ولا شيء، أيضًا، يردع أو يمكن أنْ يردع الإنسان الأنانيَّ عن فعل أيِّ شيء لتحقيق أكثر ما أمكن من النَّفع لذاته ما دَامَ قادرًا على ذلك، وما دَامَ اقتناص الفرصة "الذَّهبيَّة" متاحًا له.
خلاصة القول، إنَّ الأنانيَّة هي شكلٌ حتميٌّ لتأكيد الذَّات لدى الأفراد في المجتمعات القائمة على تقديس المِلْكِيَّة الخاصَّة عمومًا، وفي المجتمعات الرَّأسماليَّة المعاصرة خصوصًا الَّتِي أوصلت النَّزعةَ الأنانيَّة إلى ذروتها وأقصى مدياتها الممكنة، وقدَّمت كُلَّ قيم الإنسان ومقدَّساته قربانًا لصنم معبود واحد وهو المال. لذا، فإنَّ التَّذمُّر الأخلاقيَّ من الأنانيَّة، على أهَمِّيَّته، يبقى قليل الجدوى كالشَّكوى من سوء الأحوال الجويَّة والتَّبَرُّمِ من الكوارث الطَّبيعيَّة ما لم يصاحبه بحث في أسبابها وطُرُقِ تجاوُزها يفضي إلى بناء نمط نوعيٍّ جديد من العلاقات الاجتماعيَّة لا يضطر الأفراد فيها لتأكيد ذواتهم إلى أنْ يكونوا أنانيّين مسبقًا، ويكون التَّطَوُّرُ الحُرُّ للفرد شرطًا لِتَطَوُّرِ الآخرين، وبالعكس.
***
د. علي صغير – لبنان
...............................
المراجع:
1- اُنْظُر: رينيه ديكارت. مبادئ الفلسفة. ترجمه وقدَّم له وعلَّق عليه الدُّكتور عثمان أمين. مكتبة النَّهضة المصريَّة. 1960. ص ص 70-71.
2- توماس هوبز: مؤلَّفات مختارة في مجلَّدين. موسكو. المجلَّد الثَّاني. 1965. ص 149. (باللُّغة الرُّوسيَّة).
3- المصدر نفسه. ص 153.
4- المصدر نفسه. ص 157.
5- المصدر نفسه. الجزء الأوَّل. ص 536.
6- المصدر نفسه. ص 539.
7- كارل ماركس وفريدريك إنجلز: المؤلَّفات الكاملة. المجلَّد 46، الجزء الأوَّل. ص 99. (باللُّغة الرُّوسيَّة).
8- كارل ماركس وفريدريك إنجلز: المؤلَّفات الكاملة. المجلَّد 21. ص 176. (باللُّغة الرُّوسيَّة).







