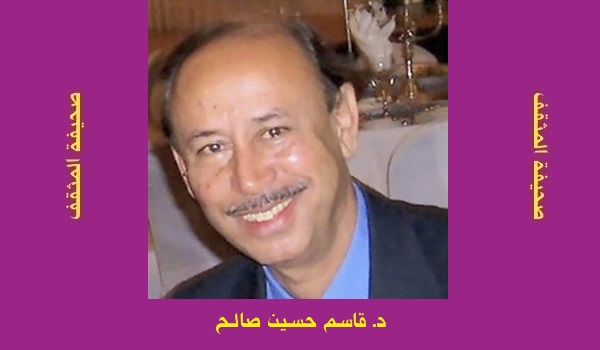أقلام فكرية
زهير الخويلدي: الفلسفة العربية الاسلامية بين علم الكلام وعلم أصول الفقه

مقاربة تأويلية
مقدمة: تُعتبر الفلسفة العربية الإسلامية إحدى أبرز الإسهامات الفكرية في تاريخ الفكر الإنساني، حيث جمعت بين التراث الديني الإسلامي والإرث الفلسفي اليوناني والعقلانية. في هذا السياق، برز علم الكلام وعلم أصول الفقه كتيارين رئيسيين شكلا إطارًا للتفكير الفلسفي في العالم الإسلامي. يركز علم الكلام على الدفاع عن العقيدة الإسلامية باستخدام العقل والمنطق، بينما يسعى علم أصول الفقه إلى وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الدينية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه في إطار الفلسفة العربية الإسلامية، مستخدمة مقاربة تأويلية تركز على تفسير النصوص وفهم السياقات التاريخية والفكرية لكلا العلمين.
1. إطار الدراسة والمنهجية
تعتمد الدراسة على مقاربة تأويلية مستمدة من مناهج التفسير الفلسفي، ولا سيما أفكار هانز-غادامر حول التأويلية (Hermeneutics)، التي تركز على فهم النصوص في سياقاتها التاريخية والثقافية. يتم تحليل النصوص الكلامية (مثل أعمال المعتزلة والأشاعرة) ونصوص أصول الفقه (مثل كتابات الشافعي والغزالي)، مع التركيز على كيفية تشكيل هذين العلمين للفلسفة العربية الإسلامية. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: علم الكلام، علم أصول الفقه، ومقارنة تأويلية بينهما
2. علم الكلام: الفلسفة العقلية في خدمة العقيدة
علم الكلام هو العلم الذي يهتم بمناقشة قضايا العقيدة الإسلامية باستخدام المنطق والعقل للدفاع عنها وتفسيرها. نشأ هذا العلم في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) كرد فعل على التحديات الفكرية التي واجهت الإسلام، مثل الجدل مع أتباع الأديان الأخرى والفرق الإسلامية المختلفة.
الأسس الفلسفية: استلهم علم الكلام من الفلسفة اليونانية، وخاصة أرسطو وأفلاطون، من خلال ترجمات النصوص الفلسفية إلى العربية. المعتزلة، على سبيل المثال، ركزوا على العقل كأداة لفهم العقيدة، مؤكدين على مبدأ العدل الإلهي وحرية الإرادة الإنسانية. في المقابل، تبنى الأشاعرة موقفًا وسطيًا يوازن بين العقل والنقل.
القضايا المركزية: تناول علم الكلام قضايا مثل وجود الله، صفاته، القدر والإرادة الحرة، وطبيعة القرآن (مخلوق أم غير مخلوق). على سبيل المثال، ناقش الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة حدود الفلسفة العقلية في تفسير العقيدة.
الأبعاد التأويلية: يعتمد علم الكلام على التأويل العقلي للنصوص الدينية، حيث يسعى إلى فهم المعاني الكامنة وراء النصوص باستخدام المنطق والجدل. على سبيل المثال، تأويل المعتزلة لصفات الله يعتمد على نفي التشبيه للحفاظ على تنزيه الله.
3. علم أصول الفقه: الفلسفة العملية لاستنباط الأحكام
علم أصول الفقه هو العلم الذي يضع القواعد المنهجية لاستنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس. نشأ هذا العلم لتلبية الحاجة إلى تنظيم الفقه الإسلامي في مواجهة التحديات الاجتماعية والقانونية في المجتمعات الإسلامية المتنوعة.
الأسس الفلسفية: يعتمد علم أصول الفقه على المنطق والتحليل اللغوي لفهم النصوص الدينية. الإمام الشافعي (ت. 204هـ/820م) وضع الأسس الأولى لهذا العلم في كتابه الرسالة، حيث حدد مصادر التشريع الأربعة (القرآن، السنة، الإجماع، القياس). كما طوّر الغزالي هذا العلم في المستصفى، مركزًا على المنهجية العقلية في التفسير.
القضايا المركزية: يركز علم أصول الفقه على قضايا مثل الدلالات اللغوية للنصوص (العام والخاص، المطلق والمقيد)، القياس، والمصالح المرسلة. يسعى هذا العلم إلى تحقيق المقاصد الشرعية (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، والمال).
الأبعاد التأويلية: يعتمد علم أصول الفقه على التأويل اللغوي والمقاصدي للنصوص. على سبيل المثال، يستخدم الأصوليون القياس لتطبيق الأحكام على مسائل جديدة، مما يتطلب تأويل النصوص في ضوء السياقات المعاصرة.
4. مقارنة تأويلية بين علم الكلام وعلم أصول الفقه
رغم اختلاف مجالاتهما، يشترك علم الكلام وعلم أصول الفقه في كونهما جزءًا من الفلسفة العربية الإسلامية، حيث يسعيان إلى فهم النصوص الدينية وتطبيقها باستخدام العقل والمنطق. يمكن إجراء المقارنة على النحو التالي:
الهدف: علم الكلام: يهدف إلى الدفاع عن العقيدة وتفسير القضايا الميتافيزيقية، مثل وجود الله وطبيعة الإرادة الإنسانية.
علم أصول الفقه: يهدف إلى تنظيم استنباط الأحكام العملية لتنظيم الحياة الاجتماعية والقانونية.
المنهج: علم الكلام: يعتمد على الجدل الفلسفي والمنطق الأرسطي لمناقشة القضايا النظرية. على سبيل المثال، استخدم المعتزلة المنطق لتأكيد حرية الإرادة.
علم أصول الفقه: يعتمد على التحليل اللغوي والمنهجي للنصوص، مع التركيز على التطبيق العملي. على سبيل المثال، يستخدم القياس لربط الأحكام بالواقع.
الإطار التأويلي: علم الكلام: يركز على التأويل العقلي للنصوص لفهم المعاني الميتافيزيقية، مثل تأويل صفات الله (اليد، العين) بمعانٍ مجازية.
علم أصول الفقه: يركز على التأويل اللغوي والمقاصدي للنصوص لاستنباط أحكام عملية، مثل تفسير الأوامر والنواهي في القرآن.
التقاطع الفلسفي: كلا العلمين يعتمد على العقل كأداة لفهم النصوص الدينية، مما يعكس طابع الفلسفة العربية الإسلامية في الجمع بين النقل والعقل.
كلاهما يسعى إلى تحقيق الانسجام بين الوحي والعقل، لكن علم الكلام يركز على الجوانب النظرية، بينما علم أصول الفقه يركز على الجوانب العملية.
يتقاطعان في استخدام التأويل كوسيلة لفهم النصوص في سياقاتها التاريخية والاجتماعية.
التحديات: علم الكلام: واجه انتقادات من التيارات التقليدية (مثل الحنابلة) التي رأت أن الاعتماد المفرط على العقل قد يؤدي إلى الانحراف عن النصوص.
علم أصول الفقه: واجه تحديات في مواكبة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مما يتطلب تأويلات جديدة للنصوص.
خاتمة
تقدم الفلسفة العربية الإسلامية، من خلال علم الكلام وعلم أصول الفقه، نموذجًا فريدًا للجمع بين العقل والنقل في سعيها لفهم النصوص الدينية وتطبيقها. بينما يركز علم الكلام على تفسير القضايا الميتافيزيقية والدفاع عن العقيدة، يركز علم أصول الفقه على تنظيم الحياة العملية من خلال استنباط الأحكام. من خلال مقاربة تأويلية، يمكن رؤية هذين العلمين كجزء من مشروع فلسفي أوسع يهدف إلى تحقيق الانسجام بين الوحي والعقل، مع مراعاة السياقات التاريخية والاجتماعية. يبقى التحدي في كيفية تطوير هذه الأطر التأويلية لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل العولمة المتوحشة والتعددية الثقافية.
***
د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي