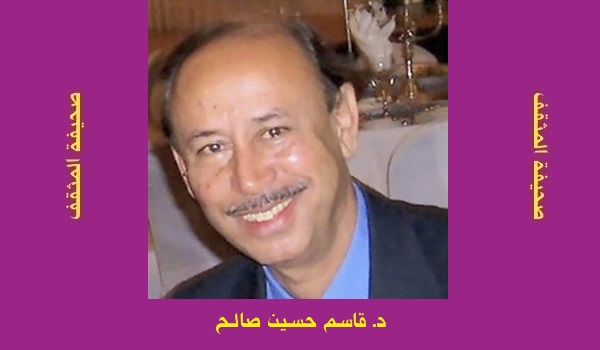أقلام فكرية
حيدر عبد السادة: ثقافة المركز والهامش.. وإشكالية التعليم
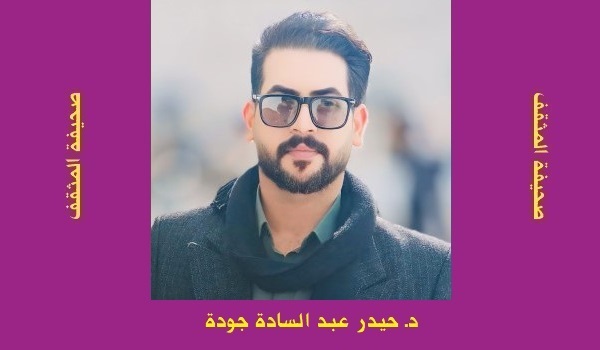
يمكن تعريف الثقافة على انها سلوك اجتماعي ومعيار موجود في المجتمعات البشرية، وتعد مفهوماً مركزياً في حقل الدراسات الانثروبولوجية... وبتعبير الدكتور (قاسم جمعة) في بحثه عن ثقافة الجمهور يقول: إن الثقافة لا تنحصر دلالتها وفق القاموس العنصري، بل هناك تعدد هوياتي وفقاً للرؤية الانثروبولوجية. من ذلك نفهم تعريف (ريموند وليم) الذي اعتبر مصطلح الثقافة من أكثر المفردات تعقيداً في اللغة الانكليزية، فهي تنطبق على عدة معان وترتبط بأكثر من ميدان، حيث ترتبط بالحضارة، وهل الحضارة من تؤسس الثقافة؟ أم أن الحضارة هي مجموعة من الثقافات؟. وبما أنها مرتبطة بالحضارة، فهي ترتبط من وجوه أخرى بالفرد والمجتمعات واحساسهم الفني ووعيهم.
ويشير المؤلف البريطاني (تيري إيغلتن) إلى مدى التعقيد والالتباس الذي يطرأ مفردة الثقافة، وينتهي إلى أربعة معانٍ رئيسية للثقافة، قد تعني تراكماً من العمل الفني والذهني، وقد تعني: الصيرورة التي يحصل بها الإرتقاء الروحاني والذهني، وقد يعنى بها، القيم والعادات والمعتقدات والممارسات الرمزية التي يوظفها الرجال والنساء في الحياة، أو هي الطريقة الكلية المعتمدة في الحياة... ويؤكد (إيغلتن) إلى أن الثقافة بالمعنى الفني والذهني للمفردة، قد تشمل على أوجه الإبتكار السائدة، في حين أن الثقافة كطريقة في الحياة هي في العموم مسألة عادات، فتصبح الثقافة في هذا السياق: هي ما فعلته أنت مراراً من قبل؛ بل وحتى ما فعله أسلافك لملايين المرات، ولكي تكون أفعالك صالحة للإنضمام في هذا السياق الثقافي يلزمها أن تكون متساوية ومتناغمة مع أفعال الأسلاف... فالثقافة في السياق الفني يمكن أن تكون حالة طليعية؛ أما كطريقة للحياة فهي في مجملها مسألة عادات وحسب؛ ولما كانت الثقافة الفنية نخبوية، فهي تختلف عن الثقافة باعتبارها صيرورة تطورية والتي قد يراها المرء موضوعة أكثر ارتباطاً بمتطلبات المساواة والعدالة البشرية.
على أن (إيغلتن) يذهب إلى إن اعتبار الثقافة الطريقة الكلية في عيش الحياة قد تكون أكثر صواباً عند تطبيقها على المجتمعات القبائلية أو ما قبل الحديثة بأكثر مما هو الحال مع المجتمعات الحديثة.
وفي الوقت الذي يشير فيه (هوركهايمر وأدورنو) في كتابهما الموسوم بـ( جدل التنوير) إلى ما يسموه بقطاع الثقافة، وُيقصَدُ بهذا المصطلح: استخدام الأفلام والإعلانات والبرامج والمجلات، كأدوات لإنتاج ثقافة شعبية. نستخدم نحن مصطلح (قطّاع الثقافة)، وهي تسمية قرينة بتسمية قطّاع الطرق، ونقصد به: تلك النخبة المسيطرة على بعض المعارف، والتي تسعى من خلالها إلى تدجين الذوات الاجتماعية تحت طوعهم وسطوتهم، وتعمل على إقصاء ونبذ كل من تجرأ على الخوض في بحار تلك المعارف، لأنها حكر على النخبة وليست متاحة للجميع. هكذا تضمن النخبة أن لا يمس أطرافها بأدنى أذى، ما دامت تحتمي بالسلطة، ودعنا نسميها بسلطة الزور.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن مصطلح النخبة قد يدل على مثقفٍ واحد أو مجموعة من المثقفين ينتمون إلى توجهات أيديولوجية محددة، فمن هو المثقف؟ وهل له أنواع؟ نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل من خلال منجزين كبيرين ورائدين في مجال الدراسات المهمومة بإشكالية المثقف، وهما انطونيو غرامشي وميشيل فوكو.
يستخدم (غرامشي) مصطلح المثقف بشكلٍ عريض، ليشير إلى كل أولئك الذين لديهم دور تنظيمي، ثقافي أو ايديولوجي في المجتمع... وهو هنا يؤمن بوجود نوعين متمايزين من المثقف، المثقف العضوي والمثقف التقليدي، ويتضح مفهوم الأخير بتعريف الأول، يعرف (غرامشي) المثقف العضوي بأنه المثقف الذي ينتمي إلى طبقته ويمنحها وعياً بمهامها، ويصوغ تصوراتها النظرية عن العالم، ويفرضه على الطبقات الأخرى من خلال الهيمنة، ويدافع عن مصالحها، ويقوم بالوظائف التنظيمية والأداتية لضمان تقسيم لعمل الاجتماعي داخل الطبقة، ومن ثم استمرارها... ومن خلال هذا التعريف تتبين النوايا الماركسية.
أما (فوكو)، فيستفيد من تفرقة غرامشي، ليؤسس ثنائية المثقف الكوني والمثقف المتخصص، على أن الكوني عند فوكو يقابل التقليدي عند غرامشي، والعضوي عند الأخير يقابل المتخصص عن فوكو، إلا أن فوكو يعزو المثقف الكوني إلى الماركسية والوجودية، فينطلق فوكو من قول: انتهاء عصر المثقف المالك للحقيقة، فيقول: لقد مرت تلك الحقبة الكبرى من الفلسفة المعاصرة، حقبة سارتر وميرلوبونتي، حيث كان على نص فلسفي، أو نص نظري ما، أن يعطيك معنى الحياة والموت، ومعنى الحياة الجنسية، ويقول لك هل الله موجود أم غير موجود، وما هي الحرية، وما ينبغي عمله في الحياة... من هنا يتضح أن المثقف الكوني عند فوكو هو المثقف النسقي، أما المتخصص فهو الذي يقطع نهائياً مع دعوى الشمولية والكونية والفلسفات النسقية، ليهتم بتقويم أدوات للعمل ومناهج للتحليل، على أنه غير مرتبط بجهاز الانتاج، بل مرتبط بجهاز المعلومات.
ويبقى التساؤل، هل هناك قابلية لتعليم الثقافة، أم أنها أمر فطري يولد مع الإنسان؟ لا شك في أن الجزم والانتصار لأحد الرأيين يكاد أن يكون ضرباً في العماية، لأنه لا يمكن أن نقرر بجعل الثقافة أمراً مكتسباً، هذا من جهة، ولا جعلها فطرية بالمطلق، وبذلك نهمش الدور التعليمي في تحصيلها من جهة أخرى. وبالتالي فالمسألتين صادقتين، ولكن صدقها بقيود، القيد الذي يترتب على الأولى يتمثل في كيفية فهم الثقافة بمعزل عن المعيار أو الأساس الفعلي لها، أما قيد المسألة الأخرى، فيتمثل بجعل الثقافة ملائمة لما هو سائد، وذلك بتأسيس نسق معياري لها.
وتبعاً للمعنيين السالفين، تكون الثقافة في المعنى الأول، شكل من أشكال التمرد على الواقع، لأن تعليمها يؤدي إلى تطورها في ذهن المتلقي أو المتعلم، وبالتالي تتشكل في ميدان الهامش، كونها غير مستقرة وغير ثابته ولا تميل إلى الرتابة أصلاً... أما بالمعنى الثاني، فتسعى الثقافة فيه إلى تشكيل صرحٍ مركزيٍ، تسعى من خلاله لوضع حجر الأساس الثابت والمستقر، لتؤلف بذلك جانباً من جوانب السلطة لدرجة الاستحالة في إمكان طعنها وخرقها، وهي بذلك تؤسس لثقافة المركز.
وتبعاً للمعنى الأخير، تظهر ثنائية العلاقة ما بين الثقافة والحضارة، أما بالنسبة للشق الأول، فتتبدى جدلية المثقف والواقع. وأنا أستخدم في الأولى كلمة (ثنائية) أما في الجانب الآخر فاستخدم كلمة (جدلية)، وأفهم من الأخيرة معنى الصراع المترتب عن الصيرورة، أما المعنى الأول، فلا أفهم منه إلا بوصفه سيرورة، تسعى وتميل إلى عملية إيصال السابق باللاحق.
ونحن لا نقطع بالحكم، سلباً أو إيجاباً، على أحد الجانبين، ولكن نحبذ ونرجح المعنى الذي يجعل الثقافة في الهامش، أي فهمها على أنها صراع ما بين المثقف (حامل شعار الثقافة) والواقع أو الأبستيم الذي يحتوي على مجموعة من الثقافات. وهنا تثار مسألة أخرى، ثقافة أم ثقافات؟. وما نريده في الإجابة عن هذا السؤال، تقنين النظام المفاهيمي للكلمة، فنرجح مناقشة الثقافة المحددة وليس الثقافات، على أن الثقافة هي إحدى تلك الثقافات، ولكن حين نبحث في الأخيرة، نجد أنفسنا في أبستيمات متعددة، بل وحضارات مختلفة ومتباينة، وبذلك يصعب الحديث عن الثقافات. على أن ذلك لا يعني أننا في صدد الحديث عن الثقافة القومية، ثقافة فرنسا أو ثقافة المانيا، بقدر ما نناقش مشكلة المثقف والثقافة بشكل واسع وضيق وبآن واحد، أقصد بالمعنى الضيق مغادرة الحديث عن الثقافات، أما الواسع فمغادرة منطقة الحديث عن القومية.
وفيما يتعلق الأمر بتشخيص تنقلات (الحقيقة) وتكييفها، فنجد أن الحقيقة حقيقة، تبعاً للمركز، وبذلك تخالف الحقيقة التي هي من وجهة نظر الهامش، وتكون الحقيقة حقيقة، تبعاً للهامش المضمر، وبذلك تختلف عن الحقيقة التي هي في المركز، وما هو سائد في هذه الثنائية، أن حقيقة المركز، بوصفها سلطة، تؤسس إلى إقصاء حقيقة الهامش، لتنفرد في الصدارة والابتعاد عن مضمار المنافسة، وفي هذا المجال تكون الحقيقة المركزية هي صاحبة المطرقة، أما الحقيقة الهامشية فعليها أن تتحمل الضربات القاسية، إذا ما أرادت أن تحتفظ لنفسها مكاناً تنافس فيه. ولكن قد يحدث نوع من التمرد بالنسبة للحقيقة التي في الهامش، وقد يكون هذا التبدل تبعاً لتبدل الأبستيم، فتنتقل الحقيقة من الهامش إلى المركز، وتؤسس بالتالي إلى إقصاء التي انتقلت من المركز إلى الهامش، وهذه علاقة جدلية لا تنتهي.
ويمكن أن نستلف هذا التفسير بالنسبة للثقافة، ونناقش بالتحديد مفهوم الصفوة أو النخبة، فهنالك صورتان للنخبة المثقفة، صورة تتوقد في أروقة السلطة، وصورة أخرى أشبه بالمعارضة، تحاول الأولى التأثير على العامة عن طريق إقناعهم بجمالية الواقع، ودفعهم نحو الاستقرار والرتابة، في حين يصر الطرف الآخر على تقديم صورة مضادة للواقع عن طريق تقديم صورة أخرى، وإن كانت مثالية، عن الواقع المرتقب، وبالتالي يسعى الفريق الأول لدفع الجماهير إلى التسليم بالثقافة السائدة والمتاحة، بينما يجيّش الفريق الآخر جماهير أخرى لدفعهم نحو المعارضة والتسقيط بنخبة المركز.
وكما هو الحال بالتبدل الذي تحدثنا عنه في مجال الحقيقة، تحدث التحولات بالنسبة لنخبة المركز والهامش، وأثناء هذا التحول، تتحول الآليات أيضاً، فبعدما حاولت النخبة المركزية دفع الجماهير للوقوف ضد نخبة الهامش، تحاول، بعد سقوطها وتراجعها من المركز إلى الهامش، أن تقنع الجماهير بسوداوية الواقع، وتدفعهم بالتالي نحو التمرد... ويجب التنبيه على أن لهذه التنقلات، سواء بالنسبة للحقيقة أو الثقافة، حالة صحية على المجتمع، فالتأسيس إلى حقيقة مطلقة أو لثقافة مطلقة، قد يؤدي بالمجتمعات إلى الاستبداد واستشراء سياسة الراعي والقطيع.
***
د. حيدر عبد السادة جودة