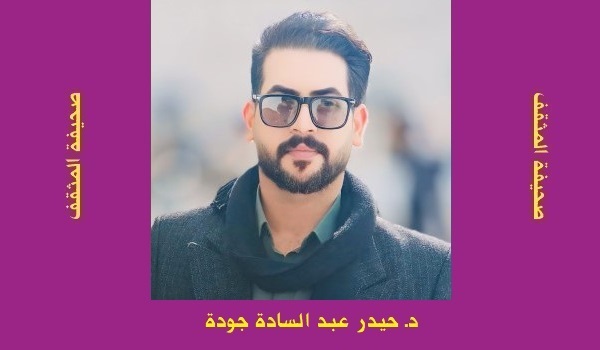أقلام فكرية
رائد عبيس: تراجع الفلسفة في عصر تداخل الاختصاصات

اكتسبت الفلسفة وتاريخها أهمية كبير تبعاً لخاصية أساسية فيها، وهي أنها توصف بـ (أم العلوم) وهذه الأمومة الجامعة بالنسبة للمعني بالبحث الفلسفي والانشغالات في تساؤلات الفلسفة، يجد نفسه أمام تنوع معرفي كبير، يشتمل على موضوعات، ومجالات مختلفة، نطلق عليها (المعرفة الموسوعية) أي التي تجمع بين علوم مختلفة، وثقافات مختلفة.
كان هذا سائد في عصر اليونان القديمة، وعصر الهيليني، والهلينستي، والعصور الوسطى المسيحية والاسلامية، وبدايات العصر الحديث تقريباً، وما ان تطورت الأبحاث المعرفية، وأخذت منحى تجريبي في كثير من موضوعاتها، لا سيما الفلك، والفيزياء، والكيمياء، والطب، وغيرها من العلوم الطبيعية التي كانت تبحث تحت عنوان الفلسفة الطبيعية. فبدأت تتطور الإنشغالات المعرفية التجريبية وتأخذ حيز من الإهتمام المعرفي والتساؤلات الفلسفية. وذلك لنتيجة الطروحات العلمية التي اعتمدت منهج تفكير تجريبي يختلف عن التفكير المثالي والعقلي الذي كانت تصطبغ به النظريات الفلسفية.
يُنسب تأريخياً هذا التحول إلى بوادر نقد المنطق الأرسطي الصوري، واعتماد المنطق التجريبي الذي يولي أهمية للاستقراء ويرفض القياس. سواء بدأ مع روجر بيكون أو فرنسيس بيكون الذي قدم لنا بحثاً في المنطق التجريبي وأسماه (الإرغانون الجديد). تعامل هذا المنطق مع الطبيعة بشكل مباشر، ومن دون الخوض في ما بعدياتها. مقتصراً مصادر المعرفة فيها على أدوات الحس.
فالمعرفة الحسية المعتمدة على المدخلات المادية للمعرفة تحليلاً وتركيباً، تعد بداية لتحول علمي واضح يقتصر التوجهات المعرفية صوت مصدر واحد من مصادر المعرفة وهو الحس وما تساعد آفاقه المعرفية من مشاهدة، وتجريب، ولمس، وشم، ونظر، في الإحاطة المعرفية بقدر ما يمنحها تطبيقها على أرض الواقع.
فالتعامل المادي مع نتائج هذه المعارف بدأ يأخذ اتجاهه التجريبي العملي مع أول تطور للآلة الحديثة التي وجهت الإهتمام للمعارف التجريبية على حساب الفلسفة العقلية، والدين، والسياسة.
هذه البدايات مع تحول الشمولية المعرفية التي كانت تتمتع بها الفلسفة، إلى نزعة تخصصية مفترضة على واقعها الجديد حينها. فبداية مغادرة الأوهام شكل نقطة بداية كبيرة للتفتيش من معرفة عقلانية واضحة لا تقبل التأويل ولا اللبس ولا الميتافيزيقا. اتسمت بصرامتها المعرفية والمنهجية التي تشخص مبحث واشكالية محددة تخوض فيها حتى تكتشف حقيقتها. فكانت كل جزئية من عالم الطبيعة محط اهتمام جزئي بما تنطوي عليه من معارف.
وهذا ما شجع ظهور نظريات جزئية وكلية في الطبيعة: مثل الجاذبية، ودوران الأرض، وكرويتها، ومركزيتها، ومركزية الشمس، والسرعة، والزمان، والمكان، والحركة، والنسبية، والحتمية، وتطور البحث في هذه المفاهيم حتى أخذت مجالاها الخاص في البحث الامربيقي. مستقلة نسبياً عن التساؤلات الما بعدية للفلسفة.
كان من نتائج تطور هذا المسار الجديد في تاريخ الفلسفة المعرفي، ظهور تيارات معرفية متماثلة في اهتماماتها، ومتباينة، مثل: الاتجاه العقلي، والاتجاه التجريبي. وهما أبرز اتجاهين فلسفيين ومنهجيين في تاريخ الفلسفة، ومنه تتفرع الاتجاهات الأخرى التي تتسم بالخصوصية المعرفية نسبياً. مثل: الاتجاه الوضعي، والاتجاه المثالي، والاتجاه التأريخي، والاتجاه العلمي، والاتجاه الآلي. والاتجاه الفيزيائي وهو أبز الاتجاهات العلمية التي أخذت من الفلسفة مفاهيم كثيرة واستعارتها وبعضها جيرتها لصالح تجاربها العلمية المبهرة في تاريخ العلم مثل النسبية والحتمية وغيرها.
في تاريخ هذه التوجهات، ظهرت تساؤلات عن مصير الفلسفة، وأهميتها، وقيمتها وجدواها إزاء طغيان النزعة العلمية التجريبية على تخصصات أخرى كانت تحت عباءة الفلسفة.
فكان الحديث عن موت الفلسفة وقلة أهميتها، كما ابتدأه ماركس وكارل، أمام الشموليات الأيديولوجية والارستقراطية التي كانت تجعل من الفلسفة نخبوية بحتة. حديث ذو أهمية كبيرة حتى داخل الجامعات والأروقة العلمية التي صنفت الفلسفة، وقسمت إلى مباحث، وتقسيمات معاصرة وفروع معرفية جديدة، مثل: فلسفة العلم، وفلسفة الدين، وفلسفة العلوم.
وهنا نشير إلى أن الفلسفة تحولت من الموسوعية النخبوية إلى التخصصية العامة. فالنتائج المترتبة من العلم أبحت متداولة مع الجميع وأن كانت بدايتها مقتصرة على الطبقة البرجوازية.
فبدأت تبعا لذلك استقلال العلوم عن الفلسفة، سواء علوم علمية أو علوم إجتماعية. وأخذت تبتعد عن وصاية الفلسفة ومناهجها نسبيا، معتقدة أنها مستقلة بمنهجها من دون الفلسفة، وهو الوهم الذي بقي يرافق التخصصات المعاصرة.
فالتخصصات العلمية أستقلت مبكراً جداً لا سيما علم الفيزياء، والكيمياء، والفلك، أما الطب فقد تأخر حتى الثلاثينيات من القرن الماضي.
فكان علمي الاجتماع وعلم النفس أنشقا مبكرا ًعن الفلسفة واستقلا في منهجيهما نسبياً، وأخذت مباحثهم العلمية تأخذ اتجاه احصائي وتجريبي .
وتوالت الاستقلالية التخصصية لكثير من المعارف والعلم، وبقيت الفلسفة معنية ومحصورة باهتمامات وتساؤلات واشكاليات محدد. لا من هي من حددت لنفسها تلك الاهتمامات، بل هذا ما ابقاه لها العلم والتكنولوجيا .
وعلى الرغم من تشعب فروع الفلسفة وتخصصاتها واهتماماتها التي نستطيع القول بها أنها قد أعنت نفسها بكل ما يتعلق بالإنسان ونشاطه، الا أن الإنسان هو من أختار لنفسه الابتعاد عنها، وأخذ يتكل على العلم التطبيقي، معتقداً أن القدرة المالية هي الحل الوحيد لجميع مشاكله، وبالتأكيد هذا الاعتقاد واهم لأن الإنسان لا يتقوم بما يملك من قدرات مالية وآلية بل يما يملك من إرادة وحرية ومعرفة في إدارة هذه الطاقة. ونزعم ان ما تتبناه الفلسفة هي تلك القدرة المعنوية التي تشجن بها الإنسان، بدوافع الأمل، والسعادة، والأمان، والاستقرار، والأخلاق، والعدالة، والحق. وكل ما تقدم هو مسعى بشري عام يتكامل بإرادة الخير.
فالإنسان المعاصر اليوم، أمامه المئات من التخصصات المعرفية والعلمية البحتة في كل ميدان ومجالات الحياة والعلم وهل يجد الفلسفة في كل منها ؟
هذا الأمر نسبي جدا؛ لأن الغالب على النشاط البشري هو العفوية، والتقليدية، ومن ثم المعرفية، وكل تطور له يمثل وجهة صوب مجال معين قد ينفرد به فرداً، أو مجتمعاً، أو أمة، أو حضارة. لذلك نجد مثلاً الحضارة الغربية هي المتفوقة علمياً لأنها سبقته بالتفوق المعرفي. وما زال يترافق التطور المعرفي منهجياً مع التطور العلمي صناعياً. وهناك شعوب متراجعه في تفكيرها، يُقابله تراجع في النزعة التخصصية.
وكلما تطور العلم وتعمقت أدواته في البحث عن الأسرار الطبيعية واكتشاف الجديد منها، كلما ثبت عملياً بأن تلك الإمكانيات لا يوفرها العقل المتفلسف؛ لأن عقل إينشتاين لا يتكرر دوماً. وهنا إشارة إلى أهمية العقل الأداتي في توجيه منفعة التخصصات على حساب الفلسفة وقيمتها بين تلك التخصصات.
***
د. رائد عبيس