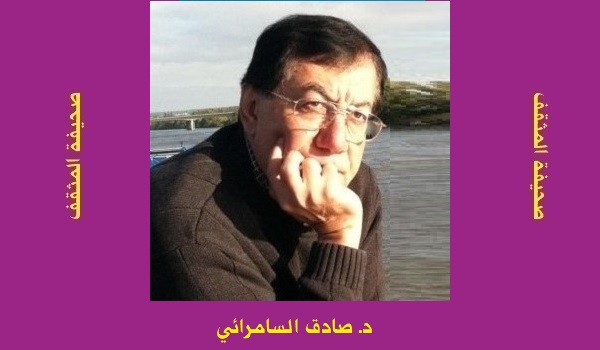أقلام ثقافية
خطاب نوبل للكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاى الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2025م

ترجمة: د. محمد عبد الحليم غنيم
سيداتي وسادتي الكرام!
بمناسبة حصولي على جائزة نوبل في الأدب لعام ٢٠٢٥، كنت أرغب في البداية أن أشارككم أفكاري عن الأمل، لكن بما أن الأمل قد نفد مني تمامًا الآن، لذا فسأتحدث عن الملائكة.
1
أتمشى ذهابًا وإيابًا، وأنا أفكر في الملائكة، وما زلت أتمشى الآن، لا تصدقوا أعينكم، يبدو أنني أقف وأتحدث في ميكروفون، لكن لا، في الواقع، أنا الآن أدور في حلقة، من زاوية إلى أخرى، ثم أعود إلى حيث بدأت، وهكذا، أدور وأدور، نعم، عن الملائكة أتحدّث، أولئك الذين يمكنني أن أبوح لكم منذ الآن بأنّهم ملائكة من نوعٍ جديد، ملائكة لم يعد لهم أجنحة،ولهذا السبب، على سبيل المثال، لم نعد بحاجة إلى التفكير في كيفية عمل خياطهم السماوي، وما نوع المعرفة الخفية التي تملأ ورشته هناك في الأعالي عندما يلبسهم، وعما إذا كان هذان الجناحان يبرزان من الخلف، بل وكيف ينتشر هذان الجناحان الضخمان بثقل فوق الرداء، وكيف تبرز أجنحتهم من تلك الأردية غير الجسدية، تلك الأردية الحلوة والمتموجة، التي تغطي أجنحتهم أيضًا، وعلى العكس إن لم تبرز، كيف يغطي هذا الرداء السماوي أجسادهم مع أجنحتهم، مسكين بوتيتشيلي، مسكين ليوناردو، مسكين مايكل أنجلو، بل ومسكين يا جيوتو وفرا أنجيليكو!، لكن لا يهم الآن، لقد تلاشى السؤال مع ملائكة الزمن الماضي، الملائكة الذين أتحدث عنهم هم الجدد، هذا واضح الآن، عندما أبدأ المشي جيئة وذهابا في غرفتي، والتي لا ترون منها الآن سوى أنني أقف أمام ميكروفون، وأعلن بصفتي حائزًا على جائزة نوبل أنني أردت الحديث عن الأمل، ولكني لن أستطيع ذلك الآن، لذا سأتحدث عن الملائكة بدلاً من ذلك، سأبدأ من تلك النقطة، من هنا أنطلق، لقد كان هذا بالفعل موجودًا في ذهني بخطوط عريضة قبل أن أبدأ المشي متخذًا وضعية المفكر المتأمل في مكتبي، وهو ليس كبيرًا، فقط أربعة أمتار في أربعة أمتار في غرفة برجية،والتي يجب أن نستبعد منها أيضًا المساحة التي يشغلها الدرج الصاعد والنازل إلى الطابق الأرضي بالطبع، لا تفكروا في برج عاجي رومانسي، فقد بُنيت غرفة البرج هذه على الزاوية اليمنى من مبنى خشبي من طابق واحد، مصنوع من أرخص ألواح خشب التنوب النرويجي، ويرتفع فوق المباني الأخرى، لأن قطعة أرضي تنحدر، لأنها تقع على قمة تل، أعني قطعة الأرض بأكملها، وهي تنحدر، في الواقع، بشدة نحو وادٍ. ونتيجة لذلك، إذا أردتُ توسيع غرف الطابق الأرضي التي تحتاج إلى إضافة، وأردت بسبب الكتب التي كانت تحاول تغطية كل شيء، ثم بعد فترة من الوقت كان من المحتم أن ترتفع الغرفة التي تم بناؤها كملحق مثل البرج، وتثقل كاهل الغرفة السفلية، بسبب الانحدار، حسنًا، هنا أود فقط أن أتحدث عن الملائكة، وليس عن الأمل، وليس عن القدماء، ملائكة الزمن الماضي ذوي الأجنحة - فكروا في أشهرهم، والعدد الهائل من اللوحات التي تصور البشارة من العصور الوسطى وعصر النهضة - يجلبون رسالة، رسالة مفادها أن المولود سيولد - هؤلاء كانوا ملائكة الزمن الماضي، هؤلاء الرسل السماويون يصلون دائمًا بهذه الرسالة أو رسالة أخرى، ووفقًا لـ علم الملائكة، يسلمونها إلى المرسل إليه غالبًا شفهيًا، أو في بعض الأحيان - كما في الرسوم التوضيحية من القرنين التاسع والعاشر - يقرأونها مباشرة من شريط جمل متموج، باختصار، تكتسب الكلمة أهمية قصوى في هذا المشهد بالفعل، ولكن حتى في مهام الملائكة الأخرى، فإنهم يسلمون، أو بالأحرى، كانوا يسلمون ما يرسله الأعلى إلى المختار بكلمة مغلفة بالنور أو بالهمس في الأذن، وبهذا المعنى - بغض النظر عن تصويرهم الآن - لم يعد بالإمكان تمييزهم كثيرًا، أو بالأحرى لم يكن بالإمكان تمييزهم كثيرًا عن رسالتهم، لدرجة أنه يجب علينا في الواقع أن نقول إن الملائكة القدماء، ملائكة الماضي هم فى حد ذاتهم رسائل، أنهم هم الرسالة نفسها، التي تأتي دائمًا من الذي لا اعتراض عليه، فهو الذي يرسلهم، يرسل ملائكته إلينا، نحن الذين الذين نكابد في التراب، نحن الذين نتجوّل محكومين بمصائر لا يمكن التنبؤ بها / يا لتلك الأيام الجميلة!/، باختصار، الملاك القديم: رسالة من شخص إلى شخص آخر، رسالة تحمل خبرًا له طابع التعليمات أو التقرير، لكنني لا أنوي إثارة هذه المسألة هنا، وأنا أقف أمامكم، بينما أنا، كما تعلمون، أتمشى في الغرفة البرجية التي، كما تعلمون، مبنية فقط من خشب التنوب النرويجي الرخيص، ويكاد يكون من المستحيل تدفئتها، وهي برج فقط بسبب الانحدار الشديد للأرض، حسنًا، حتى في هذه الحالة لا أتناول الملائكة القدماء،ملائكة الزمن الماضي، حتى لو كانت صورتنا الذهنية عنهم - بفضل عباقرة العصور الوسطى وعصر الحداثة المبكرة، من جيوتو إلى جيوتو - حتى لو كان هؤلاء الملائكة القدماء، بأوصافهم المناسبة من سحرٍ وسموٍّ وحميمية، حتى لو كان بإمكانهم أن يلمسوا أرواحنا في أي وقت،، حتى الآن، وحتى لو كانوا قادرين على لمس أرواحنا العاجزة عن الإيمان،، لأنهم بالتأكيد كانت الوحيدين، على مر القرون، بسبب ظهورهم النادر، سمحوا لنا باستنتاج وجود السماء، وبذلك يمكننا أيضًا استنتاج الاتجاه الذي خلق فينا بنية الكون كاتجاه، لأنه حيث يوجد اتجاه توجد مسافة، أي توجد مساحة، وحيث يوجد اتجاه توجد أيضًا مسافة بين نقطتين، أي يوجد زمن، وهناك، وفقًا لذلك، منذ قرون - أوه! ولآلاف السنين! - العالم الذي اعتقدنا أنه مخلوق، حيث وفرت اللقاءات معهم، أي مع الملائكة القدامى،ملائكة الماضي طريقة للإحساس الحاسم بالأعلى وبالأسفل كشيءٍ أصيلٍ وحقيقي، ولذا لو أردتُ التحدث إليكم عن الملائكة القدماء، ملائكة الماضي لكنتُ أتمشى جيئة وذهابا في دوائر من زاويةٍ ما، ثم أعود إلى نفس، ولكن لا، لم يعد لملائكة الزمن الماضي وجود، فقط ليس هناك سوى الملائة الجدد، وأنا لا أتمشى في دائرة من زاوية إلى نفس الزاوية وأنا أقف هنا أمام انتباهكم، لأنه، كما ذكرت ربما، لدينا ملائكة جدد، وقد فقدوا أجنحتهم ولم يعد لديهم حتى تلك الأردية المتموجة الحلوة، إنهم يمشون بيننا بملابس الشارع العادية، لا نعرف كم عددهم، ولكن وفقًا لبعض الإيحاءات الغامضة، فإن عددهم لا يتغير، ومثل ملائكة الماضي، يظهر هؤلاء الجدد بشكل غريب هنا وهناك، يظهرون أمامنا في نفس المواقف في حياتنا تمامًا كما فعلت ملائكة الماضى، وفي الواقع من السهل التعرف عليهم إذا أرادوا ذلك، إذا لم يكونوا يخفون ما يحملونه في داخلهم، فالأمر سهل لأنه كما لو كانوا يدخلون إلى وجودنا بإيقاع مختلف، ونظم مختلف، ولحن مختلف عن الذي نسير عليه، نحن نكد ونتجول في الغبار هنا في الأسفل، علاوة على ذلك، لم نعد متأكدين من أن هؤلاء الجدد يأتون إلينا من مكان ما في(الأعلى)، لأنه لا يبدو أن هناك أي أعلى على الإطلاق، بعد الآن، كما لو أن ذلك أيضاً- مع ملائكة الزمن الماضي- قد تخلى عن مكانه للمكان الأبدي، فى مكان ما حيث الآن فقط الهياكل المجنونة لإيلون ماسك في هذا العالم تنظم المكان والزمان، ومن هذا قد يتضح أنه بينما لا تزالون تنظرون وتستمعون إلى رجل عجوز هنا يتحدث بلغته المجهولة بمناسبة الإعلان عن استلام جائزة نوبل، والذي هو بالطبع، وبشكل ثابت، وفي نفس الغرفة البرجية غير القابلة للتدفئة تمامًا، بين ألواح خشب التنوب النرويجي الرخيص، يذهب دائرة بعد دائرة، باختصار أنا، أو بالأحرى "الشيء" الذي أنا عليه الآن، يسرّع خطواته، وكأنه يريد التعبير عن أن أفكاره حول هؤلاء الملائكة الجدد تتطلب مقياسًا مختلفًا وسرعة مختلفة من الشخص الذي يفكر فيهم، وبالفعل، مع تسريع خطواتي، أصل على الفور إلى استنتاج مفاده أن هؤلاء الملائكة الجدد ليس لديهم أجنحة فحسب، بل ليس لديهم رسالة أيضًا، لا شيء، إنهم موجودون فقط بيننا، بملابس الشارع العادية، غير قابلين للتعرف، إذا أرادوا ذلك، ثم، إذا أرادوا خلاف ذلك، فإنهم يختاروننا، ويخطون إلينا، وعندئذٍ تسقط الغشاوة عن أعيننا في لحظة، وينجلي الصدأ عن قلوبنا، أي أن اللقاء يتم، ونحن مذهولون: يا إلهي، ملاك، وهم يقفون أمامنا، ولكن فقط ... لا يقدمون لنا أي شيء، لا توجد جمل متموجة حولهم، لا يوجد نور يهمسون به في آذاننا، لأنهم لا ينطقون بكلمة واحدة، وكأنهم أصيبوا بالخرس، إنهم يقفون فقط وينظرون إلينا، يبحثون عن نظراتنا، وفي هذا البحث هناك توسل لنا بأن ننظر في أعينهم، وأن نسلمهم نحن رسالة، لكن للأسف ليس لدينا شيء، لأن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله ردًا على النظرة المتوسلة هو ما كان جوابًا في الماضي، عندما كان هناك سؤال، ولكن الآن لا يوجد سؤال ولا جواب، فما نوع هذا اللقاء؟ ما هذا المشهد السماوي /الأرضي؟ إنهم يقفون أمامنا، ينظرون، ونحن أيضًا نقف وننظر، وإذا كانوا هم يفهمون شيئًا من كل هذا، فنحن بالتأكيد لا نفهم ما يحدث، الأبكمُ مع الأصمّ، والأصمُّ مع الأبكم، كيف يمكن أن ينشأ من هذا أيّ تحاور، أيّ فهم، فضلًا عن الحضور الإلهي؟ عندئذٍ سيخطر ببال كلّ إنسان وحيدٍ، مُتعَبٍ، مُكتئبٍ وحسّاس- كما يحدث الآن تمامًا، إن سمحتم لي أن أُدرِج نفسي بينكم- سيخطر لي أنا، الذي يبدو أنّني أقف هنا أمامكم متحدثًا في الميكروفون، ولكني في الواقع هناك في الغرفة البرجية، كما تعلمون، جدران من ألواح خشب التنوب النرويجي الرخيص، وعزل حراري سيئ، أن هؤلاء الملائكة الجدد في صمتهم اللانهائي ربما لم يعودوا ملائكة على الإطلاق، بل قرابين، قرابين بالمعنى الأصلي والمقدس للكلمة، أُخرج سريعًا سماعتي الطبية، لأنها دائمًا معي، حتى الآن، هنا، بينما أتحدث من تلك الغرفة البرجية، أذرع المكان ذهابًا وإيابًا، وأضع القرص والجرس برفق شديد على صدوركم جميعًا، وأسمع على الفور صوت القدر، أسمع أقداركم، ومع هذا أخطو إلى ذلك القدر، أشعر بمثل هذا القدر ينبض، والذي يُغير هذه اللحظة على الفور، ولكن بشكل رئيسي اللحظة التالية التي كانت ستقف أمامي، لأن اللحظة التي بدت مرجحة أن تلي ليست هي اللحظة التي تليها، بل تأتي لحظة مختلفة تمامًا، لحظة الصدمة والانهيار تضربني، لأنّ سماعتي الطبية تلتقط القصة المروّعة لهؤلاء الملائكة الجدد الواقفين أمامي: إنهم قرابين، قرابين، لا من أجلنا، بل بسببنا، من أجل كلّ واحد منا، وبسبب كلّ واحد منا، ملائكة بلا أجنحة وملائكة بلا رسالة، وهم يدركون طوال الوقت أنّ هناك حربًا، حربًا ولا شيء سوى الحرب، حرب في الطبيعة، وحرب في المجتمع، وهذه الحرب تُشنّ لا بالأسلحة وحدها، ولا بالتعذيب وحده، ولا بالدمار وحده؛ فهذا، طبعًا، أحد طرفَي الميزان. لكن هذه الحرب تجري على عكس الميزان أيضًا، لأن كلمة سيئة واحدة تكفي، كلمة سيئة واحدة تُلقى على أحد هؤلاء الملائكة الجدد، فعل واحد جائر، أو طائش، أو غير لائق يكفي، جرح واحد للجسد والروح، لأنهم عندما ولدوا لم يكونوا معدّين لهذا، إنهم عاجزون عن الدفاع في مواجهة هذا، عاجزون عن الدفاع ضد السحق، عاجزون عن الدفاع ضد الدناءة، في مواجهة القسوة الساخرة من براءتهم وعفتهم، عمل واحد فقط يكفي، بل إن كلمة سيئة واحدة تكفي لجرحهم إلى الأبد - وهو ما لا أستطيع علاجه حتى بعشرة آلاف كلمة، حيث لا علاج له.
2
آه، كفى حديثاً عن الملائكة!
فلنتحدث بدلاً من ذلك عن كرامة البشر.
أيها الكائن البشري، أيها المخلوق المذهل، من تكون؟
لقد اخترعت العجلة، واخترعت النار، واكتشفت أن التعاون هو فرصتك الوحيدة، واخترعت أكل الجيف لتكون سيد العالم الذي تحكمه، اكتسبت قدرًا مذهلاً من الذكاء، ودماغك ضخم، كثير التلافيف ومعقد لدرجة أنك اكتسبت قوة - محدودة إلى حد ما - على العالم الذي تسميه العالم، توصلت إلى رؤى تبين لاحقًا أنها غير صحيحة، لكنها ساعدتك على المضي قدمًا في تطورك، لقد عزز تقدمك الذي بدا قفزة ونمّى نوعك على الأرض، تجمعت في قطعان، وبنيت مجتمعات، وأنشأت حضارات، وكنت قادرًا على تلك المعجزة المتمثلة في عدم الانقراض، رغم أن الفرصة كانت متاحة لك، لكنك وقفت على قدمين مرة أخرى، ثم كـالإنسان الماهر (Homo Habilis)، صنعت أداة من الحجر وتمكنت من استخدامها، ثم كـالإنسان المنتصب (Erectus)، اخترعت النار، وبسبب تلك التفصيلة الصغيرة المتمثلة في أن الحنجرة والحنك الرخو لا يلتقيان لديك، على عكس الشمبانزي، أصبح من الممكن - بالتوازي مع صقل مركز الكلام في الدماغ - أن تنشئ الكلام، جلست مع رب السماوات، وإذا كان لنا أن نصدق الفصول الصامتة من العهد القديم، فقد جلست معه، وأعطيت اسمًا لكل ما أظهره من الأشياء المخلوقة، ثم لاحقًا اخترعت الكتابة، ولكن في هذا الوقت كنت بالفعل قادرًا على التفكير الفلسفي، ربطت الأحداث أولاً، ثم فصلتها عن معتقدك الديني، واعتمدت على تجربتك لتخلق الزمن، بنيت عربة وسفينة، وسافرت في المجهول على الأرض، ونهبت كل ما يمكن نهبه، واكتشفت ما يمكن أن يعنيه تركيز قوتك وسلطتك، قمت بمسح الكواكب التي كان يُعتقد أنه لا يمكن الوصول إليها، ولم تعد تعتبر الشمس إلهًا والنجوم محددة للمصير، اخترعت، أو بالأحرى، وصفت الجنسانية، ودور المرأة والرجل، ثم بعد فوات الأوان، وإن لم يكن بعد فوات الأوان أبدًا، اخترعت لهما الحب، اخترعت الشعور، والتعاطف، واخترعت طرقًا هرمية مختلفة لاكتساب المعرفة، وفي النهاية حلقت في الهواء، متجاوزًا الطيور، ثم سافرت إلى القمر، واتخذت خطواتك الأولى هناك، اخترعت أسلحة يمكنها تفجير الأرض، ومرات عديدة متتالية، أنشأت علومًا على مستويات مرنة لدرجة أن الغد يسبق دائمًا ويخجل ما يمكن تصوره اليوم، وخلقت أيضًا فنًا من رسومات الكهوف إلى العشاء الأخير لليوناردو، من سحر الإيقاع السحري والأسود إلى يوهان سيباستيان باخ، وأخيرًا، فجأة على مقياس تاريخي، بدأت لا تؤمن بأي شيء بعد الآن، بمساعدة أدواتك التي خلقتها بنفسك وتدمر الخيال، لم يتبق لديك سوى ذاكرة قصيرة المدى، وهكذا، تركت الحيازة النبيلة والمشتركة للمعرفة والجميل والخير الأخلاقي، وأنت الآن مستعدٌ للانتقال إلى الأراضي المنبسطة، حيث ستغرق ساقاك، لا تتحرك، هل ستذهب إلى المريخ؟ بل الأفضل القول: لا تتحرك، لأن هذا الوحل سيبتلعك، سيسحبك إلى المستنقع، لكنها كانت جميلة، رحلتك في التطور تأخذ بالأنفاس، لكن للأسف: لا يمكن تكرارها.
3
آه، دعنا من الكرامة الإنسانية.
سأتحدث عن التمرد بدلاً من ذلك.
لقد حاولت التطرق إلى هذا الموضوع مرة واحدة في كتابي "العالم يمضي قُدمًا"، لكني لست راضيًا عن ذلك، سأحاول مرة أخرى.
في فترة ما بعد الظهيرة الرطبة والمشبعة بالبخار في أوائل التسعينيات، كنت أنتظر قطارًا في برلين، في الطابق السفلي لإحدى محطات مترو الأنفاق (U-Bahn). كانت الأرصفة، كما هو الحال في جميع أنظمة مترو الأنفاق، مصممة بحيث تم تركيب مرآة كبيرة مزودة بأضواء تحكم عند نقطة البداية في اتجاه السفر، على بعد أمتار قليلة فقط من المكان الذي يواصل فيه القطار مساره في نفق مرة أخرى، جزئيًا لمساعدة السائق على رؤية طول القطار بالكامل، وجزئيًا للإشارة إلى النقطة التي يجب أن يتوقف عندها مقدمة القطار بدقة بالسنتيمتر، مؤقتًا، للسماح بالصعود والنزول.
كانت المرآة مخصصة بالطبع للسائق، وكانت الإشارة الحمراء للأضواء تشير إلى المستوى العمودي على القضبان الذي يجب أن يوقف السائق القطار عنده لضمان الصعود والنزول بأمان، ثم تتحول هذه الأضواء إلى اللون الأخضر بعد اكتمال الصعود والنزول، ويمكن لمترو الأنفاق أن يستمر في النفق - وفي حالتي - نحو روهليبن لتجنب الحوادث، وترتيب القواعد بشكل عام، بالإضافة إلى وضع لافتة تحذيرية، تم أيضًا طلاء خط أصفر سميك وواضح على الرصيف بين عمود حامل المصباح ومدخل النفق، وكان هذا الخط الأصفر يهدف إلى الإشارة إلى أنه حتى لو امتد الرصيف نفسه بضعة أمتار أخرى، وهو ما كان صحيحًا، فلا يجوز للراكب تجاوز هذا الخط الأصفر على الإطلاق. وهكذا، تشكلت - كما هو الحال في جميع المحطات - منطقة محظورة تمامًا بين الخط الأصفر ومدخل النفق، لا يجوز لأي إنسان، أي راكب، الدخول إليها تحت أي ظرف من الظروف.
كنت أنتظر القطار ليأتي من اتجاه (كروزبرج )، وفجأة لاحظت أن شخصًا ما كان في هذه المنطقة المحظورة هذه المرة. كان متشردًا، وكان ظهره محنيًا، من الألم، وقد أدار وجهه قليلاً نحونا في مبديا هذا الألم، كشخص يتوقع التعاطف، كان يحاول التبول في الممر المبني للقضبان.
بدا واضحاً أن عملية التبول تسبب له معاناة كبيرة، وكان بالكاد يتخلص من البول قطرة قطرة. بحلول الوقت الذي استوعبت فيه تمامًا ما كان يحدث هناك، كان الناس من حولي قد لاحظوا أيضًا ما هو هذا الحدث غير المسبوق الذي يعكّر صفو فترة ما بعد الظهيرة بالنسبة لنا. كان الرأي فوريًا وعامًا، ومتفق عليه بشكل يكاد يكون ملموسًا، بأن هذا فضيحة، ويجب إنهاء الفضيحة على الفور، ويجب يغادر المتشرد، ويجب إعادة تفعيل الخط الأصفر. لم تكن هناك مشكلة لو تمكن المتشرد من إنهاء حاجته، والتسلل عائدًا إلينا، ثم الصعود على الدرج إلى المستوى العلوي، لكن المتشرد لم ينهها، ومن المفترض أنه لم يتمكن من ذلك، وما جعل الحدث أقرب إلى المشكلة هو أن شرطيًا ظهر فجأة على الرصيف المقابل، ومناديًا من هناك، وكان في الواقع يقف تقريبًا مقابل المتشرد، أمر المخالف للقانون بحزم بالتوقف عما يفعله فورًا.
لقد تم تصميم هذه المحطات - مرة أخرى، من أجل السلامة - بحيث يتم فصل القطارات القادمة والمغادرة إلى محطة معينة من اتجاهين متعاكسين عن بعضها البعض، أي أن مجموعتي القضبان وُضعتا في حفرة بعمق متر تقريبًا وعرضها حوالي عشرة أمتار، لذلك إذا غير الراكب رأيه وأراد الانتقال من الرصيف المخصص للقطارات المتجهة في اتجاه واحد فقط إلى الرصيف المتجه في الاتجاه الآخر، فإن عليه القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى الدرج الذي يفتح في نهاية رصيفه، والصعود إلى المستوى العلوي، ثم السير عبر الممر فوق القضبان إلى هذا الجانب، والنزول على الدرج، وهكذا يصل إلى القطار المتجه في الاتجاه الذي رغب فيه فجأة، ولكن بالطبع لم يكن بإمكانه ببساطة أن يقفز في حفرة السكة ويقطع تلك الأمتار العشرة متجاوزًا هذه القضبان، لا، هذا، إذا كان من الممكن تصعيد الحظر، كان ممنوعًا بشكل أكبر، وبالطبع كان يشكل خطرًا على الحياة، وأنا أشرح هذه الحقيقة الواضحة بمثل هذه التفاصيل لأنه كان على الشرطي المذكور والذي كان غاضبًا بشكل واضح - محافظًا على كرامته إلى حد ما، ولكنه يستخدم سلطته وحسن تقديره - أن يسلك نفس المسار بالضبط، أي كان عليه أن يبدأ السير نحو الدرج الصاعد على ذلك الرصيف المقابل، ومن ثم كان عليه أن يصعد الدرج إلى المستوى العلوي هناك، ثم يسرع عبر الممر إلى هذا الجانب، وأخيرًا ينزل إلينا.
كان هذا هو الوضع الحاكم، لذلك أُجبر الشرطي أيضاً على ذلك، لأنه من لحظة ملاحظة الأمر، رغم أنه صاح عدة مرات بصوته الجهوري، لم يأبه المتشرد، بل احتفظ برأسه موجهاً إلينا في نفس الاتجاه، ونظر إلينا بنظرة تعكس استمرار معاناته، بينما استمر في تقطير البول على القضبان، وهذا: انتهاك غير مسبوق حقاً للقاعدة، والنظام، والقانون، والحس السليم، أي أنه لم يأبه للأمر، أو بتعبير الشرطي المفترض: تظاهر بأنه أصم، وهذا آلم الشرطي بشكل خاص.
لا شك أنّ المتشرّد كان واعياً بأنّ الشرطي، بفضل ميزته المؤثّرة الأخرى، سيكون أسرع منه، وأنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يُتمّ الفعل المحظور في الوقت المناسب وفقاً لإرادته وإرادة الطبيعة. لذلك، عندما أدرك أنّ الشرطي انطلق مسرعا، وأخذ يركض على الرصيف المقابل ليبلغ المخرج المرتفع البعيد، ويصعد إلى المستوى الأعلى، ويعبر فوق القضبان، ثم يهبط إلى جهتنا ليمسك به متلبساً، توقّف بصعوبة، وهو يئنّ ويتنهّد، عمّا كان يفعله، وبدأ يفرّ باتجاهنا ليصل بأسرع ما يمكن إلى أقرب سلّم صاعد ويختفي بطريقة ما.
لقد كان سباقاً مروعاً. صمت الجمهور على رصيفنا، لأنه عندما تحرك المتشرد، أصبح واضحاً على الفور أن هذا الهروب لن ينجح هنا، لأن هذا المتشرد العجوز بدأ جسده كله يرتجف، وبدا أن ساقيه ودماغه الذي يتحكم في ساقيه يعودا يعملان بشكل سليم، وهكذا، بينما كان يراقب الشرطي وهو يسارع نحو مخرج الصعود هناك على الجانب الآخر - متراً بعد متر! - لم يكن هو، هنا على جانبنا، قادراً على قطع سوى سنتيمترات وسنتيمترات بجهد رهيب وأذرع متأرجحة، بينما كان الشرطي أيضاً، وهو أيضاً، ينظر إلى الأمتار العشرة التي فصلتهما عن بعضهما البعض. كانت هذه الأمتار العشرة تمثل للشرطي عذاباً قاسياً لحاجز عقابي غير مستحق، وبالنسبة له، على جانبنا، كانت هذه الأمتار العشرة تعني التأجيل، وهو تأجيل يحمل في طياته الأمل الساذج بأنه سيفلت من المساءلة الواضحة.
من وجهة نظر الشرطي، كان هو يمثل القانون، والخير الذي أقره الجميع وبالتالي أصبح إلزاميًا، في مواجهة المخالف للقواعد الذي أدانه الجميع والرافض للمنطق، بمعنى آخر، كان يقف في وجه الشر. نعم، كان يمثل الخير الواجب، لكن في تلك اللحظة كان عاجزًا. أما في داخلي، بينما كنت أشاهد بتواضع هذا السباق اللا إنساني بين الأمتار والسنتيمترات، حدث أن انتباهي أصبح حادًا، وهذا الانتباه أوقف اللحظة. أوقفها عند اللحظة التي لاحظ فيها كل منهما الآخر: الشرطي الطيب لاحظ أن المتشرد الشرير يتبول في المنطقة المحظورة، والمتشرد الشرير لاحظ، لسوء حظه، أن شرطيًا طيبًا رأى كل هذا. لم يكن بينهما سوى عشرة أمتار، أمسك الشرطي بعصاه المطاطية، وقبل أن يندفع، تردد. أوه، كانت قوة لا نهائية لكنها محبوسة في تلك الحركة، عضلاته مشدودة مستعدة للقفز، لأنه خطر بباله للحظة: ماذا لو قفز ببساطة فوق تلك العشرة أمتار، بينما في حماية العشرة أمتار على الجانب الآخر، كان ذلك الكائن الهش شديد التعاسة يتخبط ويرتجف. هنا توقّف انتباهي، وهكذا ظلّ حتى اليوم، كلّما استحضرت تلك الصورة: حين انطلق الشرطي غاضباً، يلوّح بعصاه المطاطية، متجهاً نحو المتشرّد؛ أي حين اندفع الخير الواجب نحو الشرّ الذي عاد للظهور متخفّياً في هيئة المتشرّد، بل ليس نحو الشرّ فحسب، بل نحو الشرّ المحض، نحو الشرّ المقصود بوعيٍ كامل. وهكذا، في هذا المشهد المتجمّد، ما زلتُ إلى اليوم أرى أنّ الشرطي، في الجانب المقابل، يقطع أمتاراً وأمتاراً بخطوات متسارعة ثم راكضة، بينما المذنب، في جانبنا، لا يقطع سوى سنتيمترات وسنتيمترات، وهو يئنّ ويرتجف، ضعيفاً، ومشلولاً تقريباً من الألم، إذ مَن يدري كم تبقّى من قطرات في هذا الجسد. نعم، أرى أن الخير في هذا السباق لن يتمكن أبدًا من الإمساك بهذا الشر بسبب تلك الأمتار العشرة فقط، لأن هذه الأمتار العشرة لا يمكن تجاوزها، وحتى لو قبض هذا الشرطي على هذا المتشرد في نفس اللحظة التي يقتحم فيها القطار المحطة، فإن تلك الأمتار العشرة في عيني أبدية ولا تُقهَر، ذلك أنّ انتباهي لا يدرك إلا حقيقة واحدة: أن الخير لن يصل أبدًا إلى الشر المتخبط، لأنه لا يوجد أي أمل بين الخير والشر.
صحبني القطار باتجاه روهليبن، ولم أستطع إخراج ذلك الارتعاش والتخبط من رأسي، وفجأة، كالبرق، طرأت على ذهني تساؤلات: متى سيثور هذا المتشرد وجميع المنبوذين الآخرين - وأي نوع من الثورة والتمرد سيكون؟ ربما دمويًا، ربما قاسيًا، ربما رهيبًا، عندما يقتل أحدهم الآخرين. ثم هززت رأسي، لأني أقول: لا، التمرد الذي أفكر فيه سيكون مختلفًا، لأنه يتعلق بالأمر برمته.
سيداتي وسادتي، كل تمرد هو تمردٌ شامل، والآن، وأنا أقف هنا أمامكم، وأتباطأ خطواتي في غرفة البرج تلك في منزلي، تعود بي ذكريات رحلة قطار الأنفاق من برلين إلى روهلبن. محطةٌ مضاءةٌ تلو الأخرى، لا أنزل منها، وما زلت منذ ذلك الحين أتنقل بهذا المترو في الأنفاق، لأنه لا توجد محطة يمكنني النزول عندها، فقط أتابع المحطات وهي تمرّ أمامي، وأشعر أنني فكرتُ مليًا وقلتُ كل ما في خاطري عن التمرد،، والكرامة الإنسانية، والملائكة، ونعم، ربما عن كل شيء – حتى عن الأمل.
(تمت)
***
...................
* تنشر ورقيا فى جريدة أخبار الأدب المصرية فى العدد الجديد بتاريخ 14 /12/2025