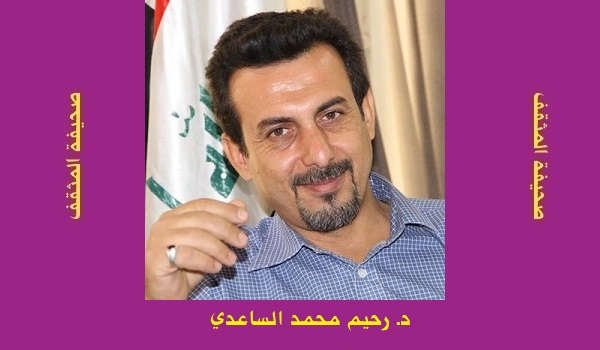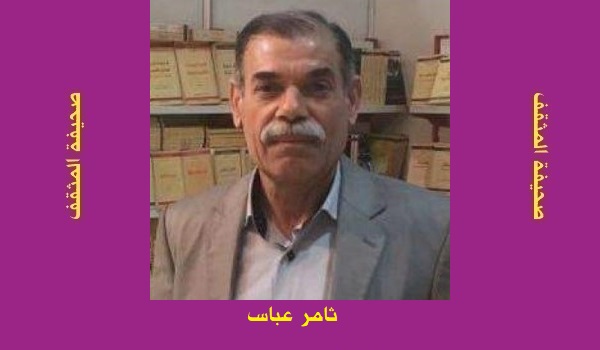تجديد وتنوير
جعفر نجم نصر: عقدة الخواجة.. الإسلام الليبرالي والاستعارات الممكنة

إن هذا الإسلام حمل تسميات متعددة، في البدء أطلق عليه بـ(الإسلام التغريبي) وهي تسمية تغمز من قناة كل القائلين به، وتشكك في إسلاميتهم الى حدٍ كبير، ومرة أطلق عليه تسمية بـ(الإسلام الحداثوي) ويراد به (الإسلام التقدمي) وهي تسمية قبالة (الإسلام الرجعي) الذي يمثله بعض الإسلاميين وهي بطبيعة الحال تسمية موجعة ومتكلفة للغاية، ولكن الاسم الجامع الذي اتفق عليه كتاب غربيون ومسلمون عرب، والذي سنعتمده هنا هو (الإسلام الليبرالي) الذي يبدو ظاهرياً أنهُ أكثر حيادية وعقلانية وأقل عدائية.
والأمر الجوهري الذي ينبغي لفت النظر إليه هنا أن الإسلام الليبرالي ما هو الإ قراءة حداثية للإسلام؛ ظهرت بعد التحدي الغربي ومشاريعه الثقافية المتعددة، وبعد فشل مشروع النهضة في العالم الإسلامي، واعتمد التأويل في قراءة (النصوص المقدسة) لأجل الانطلاق نحو فضاء (الحرية الفردية) أو (الحرية الدينية) من دون وصاية سدنة (الإسلام الفقهي) بحسب دعواه، ومرتكزه الرئيس استعارة أدوات ومفهومات ومنظورات التجديد الديني من الغرب لأجل إحداث التغييرات التي يعتقد بضرورة وجودها في العالم الإسلامي.
قبل التعريف بماهية الإسلام الليبرالي، الذي نفترض ويفترض الكثير من الباحثين والمفكرين وجوده في العالم الإسلامي عبر جملة مشاريع فكرية وشخصيات (حداثوية) ينبغي التوقف في البدء عند محطة أساسية، إلا وهي مسألة تطور الحركة الإسلامية، وانتقالها من طور آخر أمام التحدي الغربي، وكيف استطاعت صياغة خطاب إسلامي ليبرالي جديد.
إذ يشير الباحث تشارلز كورزمان Charles Kurzman الى التحولات والتطورات الفكرية التي شهدها العالم الإسلايم ضمن سياقات خطابات الحركات والمشاريع الإسلامية الجديدة، إذ يقول: ويُعد التشبع بالفكر الحداثي أهم ما يميز الحركة الإسلامية في العصر الحديث عن سابقاتها من حركات الإصلاح الإسلامية والتي لم تعرّف قيمها بالحديثة، وعن منافسيها مثل التقليدين الرافضين للقيم الحديثة. وأخيراً فقد ميز الفكر الحداثي الحركة عن اثنتين من الحركات التالية لها، واللتين اتخذتا مواقع الإسلام الحداثي في منتصف القرن العشرين، فمن ناحية نجد العلمانيين الذين انتقصوا من أهمية الإسلام في العالم الحديث، مفضلين عليه مبادئ أخرى مثل: القومية، أو الاشتراكية، أو غيرها من الأيديولوجيات؛ ومن الناحية الأخرى نجد الإحيائيين الدينيين الذين تبنوا القيم الحديثة مثل: المساواة الاجتماعية، والقانون الوضعي، وحق التعليم للجميع، لكنهم قللوا من قدر حداثتها مفضلين عليها مبادئ أخرى مثل: الأصالة، والأحكام الألهية. وكما تؤكد إحدى الدراسات، فإن تاريخ انحسار الإسلام الحداثي يرجع الى عام 1940م تقريباً، ...، وفي أواخر القرن العشرين انتعشت مرة أخرى أساليب الخطاب التي تتجمع بين الإسلام والحداثة، في توجه منبثق عن حركة الإسلام الحداثي الذي أطلق عليه بـ (الإسلام الليبرالي) والذي سعى لاستعارة مكانة الحداثين الأوائل وإنجازاتهم.
أن ما يحاول أن يقوله كورزمان أن العالم الإسلامي على الرغم من بزوغ معالم تحديث الإسلام فيه على عدة مستويات جراء حدوث جملة تغيرات عالمية، إلا أن هذا التيار خف مدة وضعف، ومن ثم استولى على الساحة اتجاهات متطرفة بين الاستغراق بالغربنة التامة (الأيديولوجيات الغربية)، وبين الإفراط في حماية الإسلام عبر حركات أصولية؛ ولكن وعلى الرغم من قوة هذه الاتجاهات وامتلاكها جمهور ودعم سياسي واسع، إلا أن عودة الإسلام الحداثي، والذي طاب له أن يسميه بـ (الإسلام الليبرالي)، حاول العمل على تطوير الإرث التحديثي للإسلام من جهة.
والعمل من جهة أخرى على إعادة بناء تأطيرات مفاهيمية ونظرية ومنهجية لأجل تحرير الفكر الإسلامي من ربقة النزعة الماضوية وطرز التفكير التقليدية المهمينة عليهن وعلى المؤسسات الدينية (مؤسسة الفقاهة)، التي مازالت تعيد إنتاج ذات المقولات الماضوية، من دون أن تعبئ أو تعير أهمية لاختلاف الزمان والمكان، وأحوال الإنسان المسلم أبان عصر النبوة أو عصر الفقهاء المؤسسين الأوائل. والذين انتجوا خطابات وفتاوى، مازالت تمارس التسيد في المشهدية الاجتماعية والثقافية الراهنة وعلى عدة أصعدة على الرغم من أننا نعيش (عصر السيولة) الذي تحدث عنه عالم الاجتماع المعروف زيجمونت بومان.
ويقول كورزمان في عمل سابق كان محرره كذلك، وكان عنوانه ومدار دراساته تحديداً حول (الإسلام الليبرالي) (Liberal Islam)، والذي أورد فيه الكثير من النصوص من أغلب بلدان العالم الإسلامي؛ وعلى الرغم من اطلاقه اسم (الإسلام الليبرالي) على هذه النصوص التي اختارها لمجموعة من الباحثين والمفكرين في هذا المجال، لكنه وضع محاذير عند استخدام مصطلح (الليبرالية) وللأسباب الآتية:
أولاً: الكتاب المذكورون في هذا المرجع لا يصنفون أنفسهم على أنهم ليبراليون بالضرورة (وهذا يعني أنه بإمكان الآخرين أن يضعوهم في هذا الفضاء).
ثانياً: يحمل مصطلح (الليبرالية) دلالات سلبية في بعض بقاع العالم الإسلامي، حيث يقنرن بالسيطرة الأجنبية والرأسمالية المطلقة، والتغني بالحقوق على نحو زائف، حتى معاداة الإسلام (إذن هي تسمية تثير الامتعاض والرفض عند بعض المسلمين عموماً وعند الكثير من الإسلاميين تحديداً).
ثالثاً: يجب أن تتعامل مع مفهوم (التيار الليبرالي في الإسلام على أنه وسيلة إرشاد وليس أصلاً ثابتاً لا سبيل الى تغييره).
ثم يذهب بعد ذلك الى التأكيد على خصوصية معنى الليبرالية لدى الباحثين والمفكرين المسلمين بوصفهم ليسوا نسخاً كاربونية عن (الليبرالية الغربية) إذ يقول: فمن الشائع لدى مُحللي التيار الليبرالي في الإسلام أن يقارنوا بينه وبين الليبرالية الغربية، وفقاً لمعايير الليبرالية الغربية، ومقارنة على هذه الشاكلة تلقى انتقادات،... ولكن بقدر تركيز دراسة التيار الليبرالي في الإسلام على البُعد الإسلامي الذي ينطوي عليه، أرى أنها تستطيع النجاة من مثل هذه الانتقادات. فالتشابه بين التيار الليبرالي في الإسلام والليبرالية الغربية لا يوحي بأن الليبراليين المسلمين ما هم إلا مجموعة من المبتذلين السخفاء الذين يتبعون سياسة التقليد الأعمى للتفكير الغربي، حيث إن كثيراً من أعمالهم ومؤلفاتهم تنبعُ من تفسيرات القران، ومن حياة الرسول، ومن حياة المسلمين الأوائل، إضافة الى أن هذه الأعمال والمؤلفات يظهر فيها التأثر الواضح بأشكال الجدل الإسلامي التقليدي.
تأسيساً على ما تقدم، نذهب للقول إن خصوصية مصطلح (الإسلام الليبرالي) تشترط تعاملاً خاصاً وحذراً، حتى لا يكون مطابقة أو مماثلة كلية مع توجهات (المركزية الغربية)، ونظرتها الخاصة بـ (الإسلام)، ولكن هل نجح الباحثون والمفكرون المسلمون الذين ينتمون الى هذا الحقل الجديد أن يكونوا بعيدين عن تلك المركزية ولاستعارات المستمرة منها ؟ وهل نجحوا في التخلص من تلك العقدة الفكرية (تقدم الغرب الساحر وضرورة تقليده والاحتذاء به)، تلك العقدة التي نصطلح عليها بـ (عقدة الخواجة)؟.
إن مجموع اشتغالات الإسلام الليبرالي عبر ممثليه من باحثين ومفكرين، إنما تدور في إنجاز خطاب إسلامي جديد حول مجموعة من القضايا والاشكالات الراهنة في العالم الاسلامي أمثال موضوعات (الحرية الفردية، التعددية الدينية وقبول الآخر، حدود الأخلاق، تحديث الشريعة والدولة المدنية، ... الخ) ان هذه الموضوعات تسعى لإحداث تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية، بل واقتصادية كذلك، فالإسلام الليبرالي يمثل توجهاً فكرياً لمواجهة (الإسلام السياسي) من جهة و(الإًسلام الفقهي) من جهة أخرى عبر دعواه تقديم فضاء – معرفي – تداولي جديد.
أنهُ يمثل إسلام تقدمي بحسب قول أحد الباحثين، الذي وجد أنهُ اصطلاحاً بديلاً عن (الإسلام الليبرالي) الذي به حمولات سلبية، ولكن الجوهر والاشتغال هو واحد بالنسبة له إذ يقول: والمهم أن الإسلام (التقدمي) ليس أيديولوجية جاهزة، أو عقيدة معيارية شائعة، أو حركة أو مجموعة من المبادئ، ... ، وليس مذهباً فكرياً، لأنه أكثر من مجرد نظرية منهجية لتفسير الشريعة، والعقيدة، والأخلاق، والسياسية الإسلامية. إن نظرة المسلمين التقدميين الى العالم مؤسسة على أكثر من مجرد: هوية، ونصوص، وممارسات، وتاريخ.
فهو يسعى لإعادة قراءة الشريعة الإسلامية قراءة عصرية، متلائمة والمتغيرات والتحولات التي حصلت في العالم الإسلامي، ومركزاً في الوقت عينه على موضوعات عدة: المواطنة، حقوق الإنسان، إعادة صياغة القانون المدني بما يتلائم ومجريات العصر.
ولقد تحدث الكاتب المعروف وائل حلاق وتحت عنوان سياقات الحداثة واشتراطاتها التي فرضت تحدياً كبيراً لإعادة تكييف الشريعة، مما أنتج مجموعة من من المعالجات التي تصب تحت مظلة (الدين الليبرالي)، والذي صاغ منهجاً ليبرالياً خاصاً تبناه البعض، يقول عنهم: يشتمل النقد الموجة للمنهج الليبرالي (المحّرر) على فهمهم للوحي نصاً وسياقاً ولا تستند العلاقة بين النص المنزل والمجتمع المعاصر الى تفسير حرفي، بل الى تفسير روح النص والمقصد العام وراء لغة النصوص الخاصة. (ولذلك سمينا ذلك المنهج بالليبرالي)، ولا تستند كذلك الى مبادئ منفعية مثل الحاجة والضرورة، المبادئ التي يراها المتحررون ضيقة وغير إسلامية. ومع أن مصلحين قلائل اعتمدوا المنهج التحرري فإن المنهجية التي اعتمدها كل فهم تختلف عن الأخرى اختلافاً كبيراً. ويمكن القول أن قاسماً مشتركاً يجمع بينهم، سلبي أكثر مما هو إيجابي، أي إصرارهم على أن التفسير الحرفي التقليدي ليس وفيا للدين ولا يمكن أن يكيف الشريعة على الأوضاع المتبدلة دوماً
إن هذه الإطروحات نجد صداها في اشتغالات باحثين ومفكرين كثر، ربما كان أبرزهم المفكر التونسي الراحل محمد الطالبي (1921-2017) الذي حدد بوضوح معالم (الليبرالية الدينية) عبر تعريفها، منطلقاً في البدء من فكرة جوهرية، راهنية وهي اللوائح القانونية العالمية الجديدة، قائلاً: في وقتنا الحالي يجب الإقرار بأن الليبرالية الدينية هي شيء متأصل في جذور حياتنا اليومية، فمنذُ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1945 وصار هذا المفهوم (الليبرالية الدينية) احد المفاهيم الجوهرية في القانون الدولي. ومن الناحية الأخرى، نحن نعيش في عالم تعددي، ومن المرجح أن سيستمر في ذلك على نحو متزايد.
وبنظره فإن الحقيقة الليبرالية الدينية، هي في الأساس الحق في أن يقرر المرء لنفسه، من دون أن نوع من أنواع الضغط عليه أو تخويفه أو ترهيبه، وهي الحق بأن تؤمن أو لا تؤمن، وكذلك الحق في أن يقرر المرء مصيره بوعي كامل منه. وبالطبع، الحق في أن يتخلص المرء من الأساطير الموجودة في العصور المظلمة، ناهيك عن أنها الحق في أن يعتقد المرء الدين بإرادته، وأن يقيم الشعائر وينطق الشهادتين بحرية تامة.
وفي السياق نفسه وجدَ المفكر الإيراني مهدي بازركان (1907 – 1995) في التأويل العصري للقرآن، أن الليبرالية اللتي يبحث عنها موجودة في القرآن ذاته من دون آثارها (الجانبية، السلبية) وهو يسعى للبحث عن الحرية الدينية وكيف تقترن بالتجربة الذاتية / الفردية، وهذا يعني أنه يقدم فهماً جديداً للدين يتلائم وجملة التغيرات المتدفقة في العالم وعلى عدة مستويات ومن دون وصاية لأحد الى أحد.
ولهذا فهو يقول: وإذا كان الدين أمراً داخلياً ويرتبط بملكات الإنسان الباطنية، ويشار في ذلك الى الكشف والشهود، فإنه لا يكون حينئذٍ مساويا لمجموعة من الأحكام والأوامر الظاهرية، ولهذا السبب، فإن بازركان ينتقد معادلة: أن الدين هو عبارة عن مجموعة الأحكام الفقهية. وهو يرى أن الأمة الإسلامية شهدت خمسة تطورات بعد رحيل الرسول (ص) لم تكن متناغمة مع جوهر الدين والتدّين. وكانت هذه التطورات عبارة عن: ظهور وتمايز فئتين في الأمة وهما: فئة الأشراف والكبار، وفئة الزهاد والعباد، وظهور طبقة رجال الدين، وتساوي الفقه والدين، وانتشار المنهج الفكري الصوفي والعرفاني، وتقابل وتعارض قطبين في الأمة وهو ما وقع في العصر الحاضر بين الاتجاه الديني ورواد الحداثة.
من الواضح إن بازرركان يعد الإسلام الفقهي مسؤولاً عن حالة الجمود والسكون في تجربة الإسلام من جهة، وتجارب الأفراد الدينيين من جهة أخرى، وأن الذي يُسهم في إحداث الحراك الروحي هو الإسلام الصوفي بوصفه يقدم تجربة الفرد بوصفها المعيار الأقوم للتدين، ولكونه ينطلق نحو أفق أرحب في ممارسة الحريات الدينية.
استنتج بازركان من قراءته للإٍسلام أنه درس لاينحاز الى عرق أو لون أو شعب، لذلك أتى إسلامه على درجة عالية من اللياقة والتهذيب، فهو لا يُقصي أحداً، ولا حتى أولئك الذين اتخذوا مواقف عدائية قد تكون آنية في مرحلة من المراحل ضد الدين والعلماء . فمن وجهة نظره، لا الرأسمالي، ولا المراة السافرة خرجا عن الإسلام. فالدين عنده أوسع وأرحب من أن يضيقه أحد، فالتضييق ناتج عن عقول ضيقة والسبب كون العلاقة بين الانسان وربه لا تتحمل وجود وسيط، فمثل هذا الوسيط، وهو دون شك ليس معصوماً، سيحيله في لحظة غير متوقعة الى جلاد.
ولهذا فقد رفض ضمناً وجود دولة دينية، ومنطلقاً من القرآن كذلك، لأن آياته بحسب رأيه لم تكن تعنى بهيئة وشكل الحكم، بل عنت أكثر بالأخلاق. اذ كان بازركان دائماً في أيام الشاه، وبعد الثورة الإسلامية، يجد في القرآن ما يساعده على طرح وجهة نظره في أن الأخلاق، والدعوة إليها أهم من وظيفة الحكم؛ حيث وجد أن القرآن يحتوي على (184) صفحة عن الأخلاق، بينما لا تحتوي بنود الشريعة على أكثر من (14) صفحة. ومن ثم أن قيام سلطة باسم الإسلام يديرها علماء الدين، قد نهض على النزر القليل من القرآن، فيما تجاهل القاعدة الأوسع، والأهم فيما يدعو إليه كتاب الله الا وهو التركيز على البعد الاخلاقي بالدرجة الاولى.
***
ا. د. جعفر نجم نصر