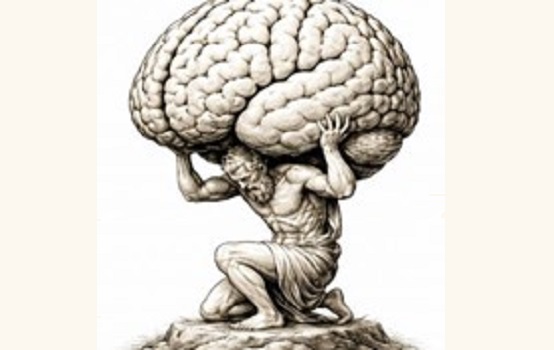دراسات وبحوث
مجدي ابراهيم: القرآن واللغة

القرآن يَمَسُّ الحقيقة الجوهرية للإنسان المؤمن مسّاً مباشراً، ينفذ إلى أسرار النفس البشرية نفاذاً بيناً، يُعوّل عليه في كل شئ، ولا يُعوّل على سواه. والتجربة مع القرآن تقرّر الآتي:
لو تخيلنا في الإنسان وجود دائرتين:
الأولى: دائرة الحياة الدنيا بكل ما فيها، دائرة الوجود الحَسّي المحدود، الوجود الإنساني بكل ما فيه من طعام وشراب ومأوى، ومن تربية وتعليم وتزكية وترقية ونجاح وفشل وأوهام وخزعبلات وأمراض وآفات ومطامع ومصالح وسوءات. باختصار: كل ما في حياة الإنسان من أوهام وحقائق.
يُلاحظ أن هذه الدائرة الأولى هى الطاغية، تستغرق جميع أنشطة الإنسان الفاعلة، وهى لا محالة تنحرف به بعيداً عن حقيقته الأصليّة، الجوهرية، والمطلوب هو اكتشاف هذه الحقيقة الأصليّة.
والدائرة الثانية: دائرة الوجود الروحي المطلق، الوجود الإنساني الأرقى، المفتوح لا المغلق، دائرة القرآن على التحقيق، الدائرتان موجودتان في الإنسان المسلم، إذا طغت الأولى على الثانية ضاقت حياته بما رحُبَتْ، وأصبح عرضة للفناء والضياع والتمزق والأطماع والأوهام والأمراض والبلادة الذهنية والعقلية والروحيّة، وغابت عنه حقيقته الأصليّة فلم يستطع اكتشافها في ذاته.
والقرآن باعتباره علماً وفهماً وحكماً وذكراً هو الأقدر على اكتشاف الحقيقة الأصلية في الإنسان، وهو الفاعل دوماً بترقية الوجود الحسي إلى الوجود الروحي، فبالدائرة الثانية، دائرة القرآن، تضيق الدائرة الأولى؛ لأن العلم يُغذي الفهم، والفهم يقوي الحكم، والذكر هو الأفعل دائماً في نشاطها وحيوتها وارتقاء مطالبها إلى أن تسيطر بالكلية على أنشطة الإنسان الفاعلة المؤثرة.
لا تتأتى هذه السيطرة بين عشية وضحاها .. كلا بل الأمر يحتاج إلى دُربّة وعادة ومران مع الدوام وقلة الفتور، وبخاصّة (الذكر) لأنه الوسيلة الوحيدة لضرب الوهم في مقتل، ولإزالة المخاوف، ولتعلق القلب الذاكر برجاءات المذكور وهو الله تعالى.
وشيئاً فشيئاً مع محاولات النجاح والإخفاق، ومع تكرار المحاولات، والاستعانة الدائمة بالله، يضيق الوجود المحدود وتضيق الدائرة الحسيّة، ويتّسع الأفق القرآني وتتسع الدائرة الروحيّة. والأصل فيها الذكر وتغذية الروح العاقل بالعلم والفهم والحكم بدايات الحركة الروحيّة، ثم يكون الذكر بالكلية العماد الأصيل فيها؛ ليتم اكتشاف حقيقة الإنسان الأصيلة.
تلك كانت معطيات ضرورية لفاعلية القرآن (مع التجربة) في النفس الإنسانية، لكنها معطيات قليلة النفع بالنسبة للجاحد المنكر، بعيدة عن اهتماماته ومتعلقاته؛ مع أنها أقرب ما تكون لكل متجرّد يعمل على الصفاء وحُسن التلقي ويتعامل مع القرآن على الفطرة المستقيمة.
وفي إطار صراع الأديان لا تكاملها ووحدتها، كانت وربما لازالت هنالك دعوات صهيونية على الساحة الثقافية تقرّر أنه بغير القضاء على القرآن الكريم لا يتسنى القضاء على الإسلام، ويوم أن يُقضى على القرآن عن طريق إدراجه في قائمة المحفوظات، وأرشفته في زوايا التاريخ، وإهماله ونسيانه، يكون القضاء على الإسلام شيئاً ميسوراً.
لكن الكيفية التي يتمُّ بها القضاء عليه في زعمهم هى اللغة؛ فلغة القرآن لغة عربية فصيحة مُبينة وقديمة – هكذا تجيءُ حجتهم – لا تساير حاجات العصر ولا تتمشى مع مطالب الحياة اليومية لعصر عسير عليه أن يتعامل بلغة ينطق بها كتاب المسلمين المقدس.
وإذا كانت الدعوات الصهيونية تهجم على اللغة العربية باعتبار قداستها المنظور إليها في ميدان الدين، فإنّ جميع الكتب المُقدّسة لا يفترض فيها الصراع إلا من حيث هذه القداسة للغة؛ كونها دينية. فما يُقال عن القرآن فيما لو صحّ على اعتبار أن اللغة الدينية لا تساير عصور العلم فيجب هجرها واستبدلها؛ فحريٌّ أن ينطبق هذا على سائر الكتب المقدّسة في اليهودية والمسيحية سواء.
ومن الغريب أن اللغة لدى اليهود لم تكن باللغة التي تخرج عن الأفق الديني الذي تدور فيه؛ فكانت توفيقاً وإلهاماً من حيث إنهم نظروا إلى اللغة العبريّة في إطار قداستها مع أن قواعد لغتهم لم تقنن إلا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي من قبل يهود إسبانيا.
ومن المؤكد كما يشير المؤرخون أن قواعدهم النحوية مصبوغة بصبغة نحويّة عربية، وأن أهم الأعمال التي قدّمت لم تظهر إلا بعد اختلاطهم بالعرب، واتصال ثقافتهم بالأمم المجاورة، وخوفهم من اندثار لغتهم لانصراف الناس عنها وتعلمهم اللغة العربية. ولم تشأ الدراسات اللغوية اليهودية المستقبليّة فيما بعد أن تنشط خارج الدين، نشأت من خلاله مرتبطة به في كل مراحل نموها وتطورها خدمة للكتاب المقدس، وفي إطاره، ثم استقلت تباعاً رويداً رويداً.
ولقد كان “سعيد الفيومي” عالماً لغوياً يهوديّاً أنتج أعمالاً نحوية، ومعجميّة على غرار المعاجم العربية ممّا جعل “روبينز” يشير في “موجز تاريخ اللغة” إلى أن أصل المعرفة اللغوية العبرية لتفسير الأدب الديني للعبرانيين بما في ذلك كتب العهد القديم، يرتد إلى الدرس اللغوي العربي فضلاً عن أن تطور المعرفة اللغوية عند اليهود في القرون الوسطى يرجع في الأصل إلى التأثير المباشر باللغة العربية.
وليس يُخفى تأثير اليهود بالدرس اللغوي العربي؛ إذ لا يزال التفكير اليهودي إلى يومنا هذا يعتمد في تطور لغته العبريّة معجمياً على المعجم العربي. وقد ذكر بعضهم أن اللغويين اليهود لجأوا إلى حيلة لإقناع شعبهم بما يفعلون، مضمونها أن لغوييهم يدعون أن هذه الكلمات المأخوذة من المعجم العربي أصلها يهودي وقد أخذها العرب منهم، فليس هناك من غضاضة فيما لو تمّ استرجاعها، جرياً على نهج القاعدة: تلك كانت بضاعتنا رُدَّت إلينا.
واقعياً؛ لم تكن هذه الدعوات على مَرِّ الزمن تخلو من آثار ملموسة تنعكس على المجتمعات بالإيجاب أو بالسلب بمقدار تحققها وتطبيقها واستقبال الناس لها أو صدّهم وعزفهم عنها؛ وشيئاً فشيئاً نرى تحقيق هذه الدعوات المزعومة بين أبناء العربية من جرّاء إهمال لغة القرآن؛ وأسرار هذه اللغة في استقامة التفكير عندهم، فلولا هذه اللغة العربية المُبينة ما عرفنا شيئاً قط عن جملة العقائد: العقيدة الإلهية، وعقيدة النبوة، وعقيدة الإنسان في الألوهية، ولولا اللغة القرآنية ما وضحت أمامنا معالم الحقوق يؤديها الإنسان المسلم؛ فيكلفه القرآن بتأديتها ثم تنبثق عنها واجبات مفروضة بمقدار الحقوق التي له أو عليه. لولا اللغة القرآنية ما ظهرت أمام العقول أسرار العبادات والمعاملات؛ فمثل هذه الأسرار لا تتجلى بلغة أخرى غير اللغة التي نطق بها البيان الإلهي.
فلهذه اللغة القرآنية أسرارها ممّا يبيّنها القرآن في لغته الفصيحة وأسلوبه المتفرِّد ورمزيته الدالة، فلو كانت لغته لا تتناسب مع حاجات العصر لامتنع وجود الحقوق العامة للإنسانية بل والحقوق والوجبات الإنسانية الخاصّة ووجود المعارف المتعلقة بها، وهى بلا شك معارف تدل عليها لغته. وإنما لغة القرآن أكثر رقياً وتهذيباً فيما لو أنها مَسّت قلوباً مستعدة، فهزت ضمير الإنسان: جوفه وباطنه، وتغلغلت في أعماق طواياه، وأنه كلما رأى منها مثل هذا التغلغل الباطني أو مثل هذا التماس الداخلي؛ رأى من ثمّ حياته الحقة في ظلال القيم العلوية تترقى بارتقاء هذه البواعث الوجودية الضابطة لحركة النوازع السائرة:
لغة أقل ما يُقال في حقها من رقي إنها دليل حياة صالحة للبقاء، بل أقل ما فيها من رقيّ أنها مصدر لخلود الحياة؛ إذْ الدلالة فيها تربط الدنيا بمسائل المصير بمقدار ما تربط الفاني بالباقي، والمحدود بالذي لا حدود فيه، وتصل جهود الأرض بقيم السماء. وإنه؛ كلما نظر القارئ لهذه اللغة بعين الإيمان بخصوصيتها – ولا أقول قداستها – إلى حقائق الحياة، وجد هنالك لغة القرآن خيرَ معين له على الاستبصار في هذه الحياة واستكشاف ما خفىَ منها من وجوه وظلال، في حين تتبدَّى أمام غيره ممَّن لم ينظر مثل نظرته، حقائقها غير واضحة ولا مجلوة؛ لتكون مثالاً صارخاً للتخبط البادي في الظلمة والاضطراب.
وممّا يكشف له هذه الحقائق أن ينظر إلى مقررات اللغة ومقوماتها، تلك التي تضمّنت أسرار الحقائق جميعاً في لفظ يهدي ومعنى يرشد ويبين، ينظر إليها بعين الإيمان لا بعين الجحود والنكران، وأنه كلما داوم النظر لحدّ التعلق بعين الإيمان؛ استطاع أن يتكشف بفضلها أسرار الحقائق الحياتية؛ لأن الإيمان إذ ذاك يستحضره ويربيه؛ فيصقله ويقوّمه ويهديه، ثم يطلعه من بعدُ على الحقائق الجوانيّة الباطنة باللغة التي هى فيه؛ شريطة أن تكون العين الناظرة عين “إيمان” مجرّدة عن التعطيل، كاشفة للسّر الكامن وراء حجب الألفاظ والعبارات، مستجلية للرمز خلف الصور اللغوية، تتبدّى فيها الحقائق وتتكشف في أصل عنصرها الرفيع: الاستجابة للحياة القويمة من دعوة الله ورسوله.
وربمّا كان أقربُ الأدلة على تأثير الدين في اللغة من الزاوية اللفظية والدلالية هو الصيغة الجديدة التي أعطاها الدين (الإسلامي) في القرآن لكلمات مثل: الصراط، الميزان، الحساب، الآخرة، الزكاة، الحج، فتلك مفردات اصطلاحية وجدت في القرآن وحُمِّلت بمعان ودلالات جديدة لم تكن معروفة بالقدر الكافي قبل مجيء الإسلام. وعليه؛ فللدين من ثمَّ معطى لغوي يحفظ اللغة ويحافظ عليها من حيث إنها وسيلة اتصال بالله من خلال القرآن الذي يُتلى والأدعية التي يُتَعبَّدُ بها.
من زاوية أخرى؛ يُلاحظ أن لغة الدين نفسها تفرض على فئات المجتمعات المختلفة ذاتها؛ فالتعابير الدينية لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات؛ كالقسم والسلام والتحية والحوقلة والتهليل والترحُّم على الأموات واستحضار الله في مناسبات شتى إلى آخر هذه التعبيرات التي لا تعدم منها مجتمعات الأديان. ولا يخفى ما للغة من تأثير بالإيجاب في نشر الدين؛ فكما يؤثر الدين في اللغة ويطورها ويضيف إليها دلالات جديدة، كذلك تؤثر اللغة في الدين وتساعد على فهمه بالصحيح المقبول، وبخاصّة حين تكون اللغة هى لغة الدين التي نزل بها كتابه المقدّس.
وأبعدُ من ذلك: أن تؤثر اللغة في صحيح الدين فيما لو استقامت، وإذا هى انحرفت، انحرفت معها لا محالة مقاصده الحيوية على الجملة، وفهمت الدلالات الدينية على غير وجهها الصحيح. ولم يكن بعيداً عن الصواب أن تشترط الدراسات الحديثة لتجديد الخطاب الديني، لزوم تجديد القوالب اللغويّة التي تتضمّنه، لأن اللغة أقرب الموارد لفهم الصحيح من الخطأ، ولمزايلة الفاسد المعطوب من المستقيم الذي لا عطب فيه.
إنمّا اللغة وسيلة اتصال وتفاهم ليس إلا؛ فتجديد قوالبها ليس تجديداً للحقيقة الدينية في ذاتها بمقدار ما هو تجديد للفهم وترقية للوسيلة في رحاب هذه الحقيقة، ضمنها وفي محتواها المعرفي، لا خارجها أو خارج حقائقها الاعتقادية. إنه إذا كانت اللغة وسيلة اتصال وتفاهم ليس إلا؛ فتجديد قوالبها – كما تقدّم – ليس تجديداً للحقيقة الدينية في ذاتها بمقدار ما هو تجديد للفهم وترقية للوسيلة في رحاب هذه الحقيقة، ضمنها وفي محتواها المعرفي، لا خارجها أو خارج حقائقها الاعتقادية. وعليه، فليس شرطاً أن يكون القالب هو نفسه القالب، ولا أن يجيء التركيب هو نفسه التركيب لأن للفهم في إطار هذا كله وسائله التعبيريّة. واختلاف التعبير خاضع لاختلاف الفهم لا محالة. وكشف المخبؤ من تحت أستار اللغة صنعة الماهر لا تفارق عطاياه، فكما لا يلام الفنان إذا هو استخدم في عمله الفني كل الوسائل المتاحة له، كذلك لا يلام الفيلسوف اذا هو استخدم النقد اللغوي التحليلي في معطاياته النظريّة.
وربّما كان من أسوأ علامات الانحراف بالدين عن مقاصده الحيويّة وارتقاءاته الشعورية ونفعه الأبدي للإنسان، هو غياب العلاقات الفاعلة بينه وبين اللغة، واهتزاز وشائجها دلالةً وفهماً وحركة ومسيرة، وانفصال الروابط الجامعة بين فهم اللغة وبين المقاصد الدينية.
ولم تنشأ قوائم التطرف ولا حوادث العنف والإرهاب ولا الحروب الدينية البلهاء باسم الدين أو تحت مظلته إلا لنشوئها أولاً في اللغة والفكر؛ فالتطرف فيما لو لاحظته إنمّا هو في البداية تطرف لغوي، أحدث عوائق معرفية سبقت الفهم، وتقدّمت منذ البداية طمس الدلالة، وأبرزت هُوَّة سحيقة بين الخطاب الأيديولوجي والممارسة الفعليّة، أو بين الاعتقاد النظري والمباشرة العمليّة، لكأنما حدثت فواصل بين مقتضيات الشعور الديني والحركة في إطاره. وبإمكان اللغة فيما لو قننت وحُسب لها حساب المعقول أن تكون أقدر لإزالة هذه الفجوات الكارثية، وأسلم للفهم وأصح للمعرفة وأبقى للدلالة النافعة. مرة ثانية؛ ليس يخفى ما للغة من تأثير بالإيجاب أو بالسلب في فهم الدين ونشره.
ومن أجل ذلك؛ وجبت الدعوة (أمراً) إلى سبيل الله أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تكون بالتطرف والفظاظة أبداً، وبخاصّة حين تكون اللغة هى لغة الدين الذي نزل بها كتابه المقدس. وليس يخفى أيضاً ما في هذه الإشارة من لفتة توحي بدلالة ظاهرة؛ فقد نجد الترجمة للقرآن مثلاً تفقده روحه؛ لأن لغته مع الترجمة تتلاشى تماماً ويستبدل بها لغة أخرى؛ تكاد تفقد بريقها وعطائها الباطن، ولا تكاد تجد لا للإيقاع ولا للموسيقى مع الترجمة أثراً، ناهيك عمّا ينشأ عن اللغة من سوء فهم قد يتسبَّب من المؤكد في عوائق معرفية؛ الأمر الذي يدلُّ بالمباشرة على أن العربية لغة القرآن خاصّة ذاتية له، وأنّ لغة القرآن في إطار تلك الخصوصية الذاتية هى العربية، وأن استظهار الإبانة لا تتاح على الحقيقة بغيرها: لسانٌ عربي مبين.
***
من أين لنا بمعرفة خير ما يصلح للمجتمعات الإنسانية ممّا يفسدها إذا لم نكن على علم باللغة التي جاء بها النفع والصلاح؛ فإذا هى مُوجِّهة الإنسانية قاطبة إلى خير ما ينفع، زاجرة لها ناهية عمّا يضر ويفسد؟ وليس من شك في أن الأمر والنهي الإلهيين إنما هما في الأصل لغة قائمة، مجرد نصوص من كلمات جامدة تتحول مع الممارسة في أجواف القارئين إلى حقائق وحياة؛ فاللغة هنا رموز وإشارات لا قيمة لها بغير الفاعلية التطبيقية. وتلك هى بالحقيقة لغة القرآن في بساطتها وخلوّها من التعقيد الخاوي والتكلف الممقوت. ونحن لا نعلم في لغة من اللغات مدى عنايتها بالسلوك والتهذيب وإثراء الجانب الأخلاقي على الجملة فضلاً عن التفصيل كما عنيت لغة القرآن بضوابط الحركة والسلوك: انتقال الفكرة فيها إلى دائرة العمل المشروع؛ فإذا لم يتح للمتلقي أن يعمل بما وَصَل إليه من فكر في هاته الأداة المبينة، أو في اللغة التي عرفها؛ فعرف من أسرارها الشيء الكثير أو القليل على قدر استعداده؛ إذا لم يتح له في ميدان العمل أن يعمل بما عرف من فكر مؤدَّى بلغة مُبينة، كان ما عَرَفَه أنقص ممّا جهله على المستوى التطبيقي؛ لأن السلوك هنا هو بمثابة اكتمال دائرة لا تكتمل الحركة إلا به، فحركة في الذهن يصحبها عمل، وعمل نتاج حركة ذهنية، وكلما أحكم وضبط، أحكمت مراحل التوجيه وضبطت لكي تؤدي الغرض الساري منها قصداً؛ فدائرة الأخلاق ناقصة إنْ لم تكن اللغة فيها فكرة عملية قابلة للممارسة التطبيقية، وكل كمال على هذا النحو ناقص ما لم يكن الفكر فيه لغة مًوحية بالعمل مُوجبة لإرادة التنفيذ.
فما كنَّا لنستطيع أن نعرف مجمل الخصائص العقائديّة والأخلاقية، ولا سائر العبادات والآداب الإسلامية، ونحن بمعزل عن لغة القرآن. وما كنا لندرك شيئاً عن هذه اللغة، ونحن بمعزل أيضاً عن العمل بفكرتها التأسيسية، تؤديها على أكمل ما تكون تأدية الأفكار وتوصيلها إلى المؤيدين والمنكرين سواء.
ولو لم تكن اللغة في أدائها موصّلاً جيداً لما فيها من أفكار وتعاليم وايحاءات، ما كان يقرّها منكر قبل مؤيد، وما صارت قط موضع لغط كبير أو ضئيل من قبيل نفر يجيدون اللغط حتى على الثوابت الرواسخ، ولا ينفرون من إجادة اللغظ فيريدون أن يجعلوه قاعدة التجديد المبتكر والتحديث من بعد التحديث من بعد التحديث إلى غير انتهاء في مثل هذه “التحديثية” الغريبة والمنفرة، بدعوى مسايرة العصر وحداثته الفجة الكسحاء، وهو عصر كم اللغط المنفر والدردشة الفارغة فيه، أعمُّ وأشمل من كم الصدق والعمل النافع والاستقامة الخالصة.
وليس أغرب من أن تجئ هذه الدعوات على ألسنة وأقلام لأناس يمتلكون في الغالب الإحساس باللغة, ورهافة الذوق, والقدرة على التعبير, والتوظيف بكلمات ذات مساقات أصيلة، ومع ذلك يريدون أن يتقدّموا ولشعوبهم أن تكون مستنفرة تجاه اللغة على حساب التأخر والخسارة، وأن يرتفعوا على فريضة الإهمال, غاية ما هنالك أنهم يضربون اتجاه فكري باتجاه آخر حتى إذا ما أهملوا هذا أخذوا بذاك، وفرضوه على أنفسهم وعلى غيرهم، فإذا الإنسان معه يسير كما الأكتع بغير استقامة، إذ لم يكن عقلاً كله ولا علماً كله بل له من العلم والعقل جوانب تمتلئ بها مناطق ولا تزال فيه مناطق لا يملأها العلم التجريبي ولا العقل المحدود، جوانب أخرى وجودية تحتاج إلى امتلاء. وما كان التقدّم ومسايرة العصر أبداً ضرباً من خسارة القيم الروحيّة التي شكلت حضارات وقوّمت أمثلة نادرة في التاريخ الثقافي الإسلامي وغير الإسلامي على حدٍ سواء.
وما كان الارتفاع قط مطلوباً من جرّاء فريضة الإهمال لمقوم الهُويّة النشطة والفعال في حياة الفرد أو في حياة المجموع، أعني هوية العقيدة والأخلاق.
وعندي أن أخصّ ما يكون مكنون فيها هو اللغة المُعبرة عن وجود الإنسان الحق، الإنسان الإنسان لا الإنسان الحيوان، ولو شئت لقلت الإنسان الكامل. هذه اللغة، ولا ريب، أسهل مأخذاً وأبلغ قناة إنْ في ألفاظها وإنْ في معانيها أو في مساقاتها من كثير من اللغات العصرية تلك التي لا تعرف لها مؤدّى ولا مرفأ أميناً ترسو عليه.
نعم! هي لغة، ولكنها تجري على ألسنةٍ المحجوبين، وتعوج بهم بمقدار ما ينسدل عليهم حجاب الغفلة والاعوجاج، هي اللغة المفككة عن الضوابط والأحكام، المنحلة عن الأصول التي تربطها بالقيم الداخلية وأخلاق الكمال في مطمح كل إنسان شريف.
هذه اللغة من تلك الجهة تمثل عائقاً معرفيّاً كما يمثل الاعتماد فيها على العلم أو العقل هذا العائق الذي يسير فيه المرء بمقتضاه كما لو كان أكتعاً يشعر بالنقص والاعوجاج، لأنه ملأ جانباً في وجوده على حساب جانب آخر، حتى أن الفراغ المتروك يطالبه دائماً بتغذية وجوده فيه، الأمر الذي تحدث معه هزة باطنة هى المقصودة عندنا بالعوائق المعرفيّة.
وكما تكون اللغة من تلك الجهة مدعاة للعوائق المعرفية، تكون سبباً لإزالتها فيما صدق صاحبها في استخدامها، واستعمال أنشتطها في تغذية وجوده الروحي؛ فالتجرد والصفاء من علامات حسن الاستخدام للغة وإزالة العوائق المعرفية، وهما من علامات الترقي المعرفي ومن موجباته كذلك. فليس علماً على التحقيق ما كان صادراً عن حكاية أقوال الغير؛ ولتلحظ أن أقوال الغير هذه، إنْ هى إلا مجرد لغة؛ لأن أقوال الغير ليست إلا أحوالهم، فالذي يحكي عنها هو لا محالة يصف حال صاحبه وقت أن صدر عنه هذا القول أو ذاك، والأحوال تتبدل ولا تستنسخ كما تستنسخ الآلات آلاف آلاف النسخ المكررة فيما تريد استنساخه؛ فأحوال هذا ليست كأحوال ذاك، وأقوال هذا لا يمكن تبعاً لذلك أن تكون هى نفسها أقوال ذاك. فليس علماً ما كان صادراً عن حكاية أقوال الغير؛ إذ العلم بداية المعراج المعرفي، ما فوقه أسمى منه وأرقى.
أما العلم في ذاته، فليس أسمى منه في الحياة، ولكنه مع ذلك ليس هو كل ما في الحياة، لأن في الحياة ما هو أعلى من العلم وأسمى، إذ من شرط العلم النافع أن يقود إلى المعرفة، وأن يؤدي إليها بالتحقيق لا بالاستشراف. ومن شرط المعرفة أن تقود إلى شهود الفضل الإلهي ومعاينته كما يُعاين المحسوس؛ وليس هناك أفرح للقلب ولا أدعى للرحمة من ذلك الشهود على التحقيق:”قل بفضل الله وبرحمته؛ فبذلك فليفْرحوا هو خيرٌ ممَّا يجمعون”. وعليه؛ يصبح العلم الذي لا يؤدي بدوره إلى مثل هذا الشهود، شهود الفضل الإلهي، ليس بنافع ولا هو أهل لآن ترقى معه حياة صاحبه إلى منازل المحققين.
إنه ليمثل عائقاً معرفيّاً في ذاته، كما تمثل اللغة فيه نوعاً من التحجير والتضييق لتصبح هى الأخرى نفسها عائقاً معرفياً يؤخر ولا يقدّم، يحصر المرء في منطقة محدودة بحدود الأفق الذي يتحرك فيه العلم المحدود والعقل المحدود. وفي المقابل لاحظ اللغة في الآية الكريمة ولاحظ المعراج الدلالي فيها، فإنّ فضل الله مدعاة للفرح، وأن فضل الله هذا مقرون بالرحمة، وهما معاً أفرح ما يفرح قلب السائر مع الشهود، فليس من فرح أسمى ولا أعلى من الفرح بفضل الله وبرحمته. فاللغة هنا معراج، تجربة، والمعراج باللغة ليس لفظاً يكرر ولكنه حقيقة واقعة وحياة تعاش مع أن اللغة في عين هذا الشهود لا أثر لها على الإطلاق.
اللغة هنا ليست عائقاً معرفيّاً بل نقلة إلى ما بعد المعرفة، إلى الحقيقة مباشرة. أجواء الآية بفضل رهافة الإحساس باللغة فيها، تقضى بمثل هذا العروج إلى منازل الشهود حيث لا لغة هنالك ولا واصف ولا موصوف.
***
تموت اللغة حتماً بمقدار ما يموت فينا “الوجود الروحي” الشاعر بنبض المعنى داخل هذه الأجوفة الآدمية قرائح كانت أو قلوباً، ويعزُّ علينا البيان كيف نمضي به إلى طريق سواء، إنْ في عالم الإبداع وإنْ في دنيا الخلق والتجديد والابتكار. لك أن تذهب إلى المحافل والمنتديات الثقافية إن شئت فماذا عساك تلاحظ؟ ما إن تتردد على المسامع كلمة غريبة لها وقع نابي حتى يحفظها الناس بالمشافهة، فتلوكها الألسنة لدرجة أن تعدمها قيمتها إنْ وجِدَتْ لها قيمة بين الكلمات، فترى الأشداق تتغنى بها دون أن تدرك العقول لها معنى وكأنها مفتاح الدخول إلى عالم الثقافة ودنيا المثقفين. كلمات جوفاء بغير معنى ولا مدلول؛ لا تدل إنْ دلت إلا على الفراغ العقلي والبلادة الذهنية والعقم المعرفي، ونصيبها من فقر الشعور والإحساس أضعف بكثير من حظها من الفراغ العقلي وبلادة الذهن وعقم التفكير .. تلك هى بحق لغة الكتاتيب!
عالم اللغة: ألفاظه ومعانيها أشبه بكتّاب كبير، ترى الشيوخ فيه – فضلاً عن الشباب – لا هم من المعمَّمين ولا من المطربشين، ولكنهم من حُفاة الرؤوس العارية عن معنى فقه المعنى فكرة أو كلمة، يُردّدون كلمات اخترعوها من عنايتهم لا يستقيم لها ضابط يحكمها من واقع الحياة الفكرية والثقافية ولا من فقه اللغة العربية في أصولها الأصيلة، وإنما هي مخترعة اختراعاً من واقع يعانونه ومن دنيا يعايشونها: من عادم السيارات وبلاعات المجاري الطافحة بالقاذورات، ومن زخم الزحام العنيف في الشوارع والطرقات، ومن أبخرة الفول والبصل والطعميّة المحروقة في الزيت المسموم، تغيم على العقول فتغيبها عن الوعي، فإذا هى فاقدة مفقودة معدمة الصلاحية، ومن واقع كله فقر ومرارة ينعكس بالسلب على المثقفين والمبدعين فلا يجعلهم يحسنون أقل ما يجب إحسانه من استخدام الكلمات للتعبير عمّا تضيق به صدورهم من لواعج ومنغصات، وما تزخر به أجوافهم المضطربة من تلوث فكري وثقافي فضلاً عن التلوث البيئي، يستمدون منه ألفاظهم اللغوية، وحياتهم في هذه البيئة أو تلك الطافحة بغريب القول والفعل وغريب التصرّف والعمل.
ومع ذلك؛ فهم معذرون؛ لأنهم نشأوا وتربوا في عالم مقدار التلوث فيه أكبر من مقدار الصفاء والنقاء، وهم معذورون مرة ثانية؛ لأن وسائلهم إلى تغيير هذا العالم أضعف بكثير من وسائلهم إلى مسايرته والبقاء فيه كما هو عليه. فلا تغيير؛ لأن إرادة التغيير لديهم فكرة نظرية، مجرد كلام في كلام، وليست هي بالسلوك المفضي إلى عمل إيجابي. ولا تغيير لأن إرادة التغيير يجب أن تنبعث من تحت، من هذا الواقع، من القاعدة، من الأعمال، أعني من داخل النفس البشرية، من التربية الروحيّة والفكرية، من ذلك التحول المباشر في أطوار الإدراك، وانقلاب أنماط الاستقرار النفسي الرابض على الدّعة والسلبية والاستكانة.
وعمّا قريب ستجد كلمات ما أنزل الله بها من سلطان هى السائدة والمسيطرة بقوتها وغلبتها على أذهان الناس عامتهم ومثقفيهم؛ فإذا سألت من أين جاءت؟ فلن تجد جواباً أشفى ولا أصوب من ذلك الجواب الذي يطلعك على هذا الواقع المستعر: من عادم السيارات، وبلاعات المجاري، وأبخرة التلوث، وسعر الناس في دنياهم من أجل معاشهم ومتاعهم. كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وأسماء كان الناس سَمّوها هم وآباؤهم، لا ترى لها أصلاً من ثقافتنا الروحيّة أو وجودنا الأخلاقي الذي ينبغي أن يتقدّم فيُوجب على كل من يؤمن بقيمه العليا وأعرافه الصائبة أن يغيّر به واقعاً طفح وطفر كما لو كان هذا الواقع الطافر الطافح هو الأصل وسائر القيم والأعراف بمثابة الفروع اللاحقة عليه؛ تكاد تقصف من أصولها إنْ وجدت لها في دنيانا أصول.
هذه الحياة المعكوسة المضطربة تفرض علينا ألا ننساق وراء ذلك الهبوط المُذل للإنسان، وهو في جوهره من الكرماء، إذا عرف حقاً فضيلة أن يتقدّم عنده وجوده الروحي، فيجعل له الأولويّة على سائر الحيوات الأخرى، تعترك سبيله عن يمين وشمال صباح مساء، وهو لا يتقدّم لديه هذا الوجود الروحاني إلا بمفتاح التفكير، ومفتاح تفكير هذا الوجود خاصّة هو اللغة القرآنية الكاملة.
ولم تكن صدفة عارضة أن يتشرط العلماء أن يكون ذوق اللغة العربية مصدراً من مصادر تفسير القرآن، حتى ولو كان هذا التفسير هو التفسير بالرأي. ومعلومٌ أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: قسم جائز ممدوح لا غضاضة فيه. وقسم حرام مذموم. وحيث يكون التفسير بالرأي من القسم الأول؛ فلا بدّ من أن يتفق مع ما جاء في المصادر الأساسية للتفسير، ولا يخرج عنها من حيث التأصيل وهي: القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما صحَّ من أقوال الصحابة، واللغة العربية، والتفسير بالمقتضى من كلام العرب، والمقتضب من قوة الشرع. فاللغة العربية: صحتها وتذوقها والعلم بها وتأويلها وحُسن تخريجها، ركنٌ لا غنى عنه في التفسير بوجه من الوجوه. وكل تفسير يخرج عن تلك الحدود عرضة للقدح المذموم كما أنه يندرج تحت طائلة الحرام قطعاً كما شرط العلماء (برهان الزركشي: جـ2، ص 180 وما بعدها).
وقد نقل السيوطي عن ابن تيمية (ت 728هـ) من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف (تلك الشروط) كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله”. على أن هذه الفتوى المُقرّرة من ابن تيمية، إذا قصد من ورائها توقف فهم القرآن عند حدود ما ذكره، فليست ملزمة، ومناقشتها في ضوء المعارف الحديثة وتطور الأزمنة، تبطلها، غير أن هذا مجال واسع بين أخذٍ وردٍ ليس هذا موضعه الآن.
وبما أن اللغة العربية هى الحركة المفصلية للذهن بين ما هو مستقر في الباطن الخفي وما هو خارج ظاهري، فليس من شك في أن الإحاطة بها ومعرفة أسرارها وتذوق دلالاتها والارتقاء بها إنما هو مصدر من مصادر التفسير بالرأي على ديدن الذوق الوجداني واتساع الأفق العقلي؛ إذْ من الواجب أن يكون للتفسير مستند لغوي، وألا يتعارض مع ما يفهم من ألفاظ اللغة العربية وقواعدها حتى تقرّر أنه يجب على المُفسر الاحتراز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام العرب، ويكون المتبادر خلافها، فكيف يسوغ الاستدلال بغير اللغة العربية كالفرنسية والإنجليزية والعبرية مثلاً على تفسير القرآن؟ فإنّ هذه المسألة لا تفتقر إلى دليل وحسب؛ بل هناك دليل من القرآن ينفيها وينكرها، وهو قوله عز وجل:”ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمي وعربي”؛ فالله سبحانه أنكر نزول القرآن بلغتين بل هو أثبت في آيات أخرى:”قرآناً عربياً غير ذي عوج”.
ولغة القرآن لا شك أسلس لغة يستقيم بها لسان أستقام على صفات الكمال أو ما يقرب إليها من قول وعمل؛ فإنّ اللفظة القرآنية تخاطب الضمير وتثوِّر الوجدان؛ لتثوِّر في جوف القارئ ثورات التغيير.
ما من قارئ يقرأ القرآن على هذه الصفة: صفة الثقافة الثورية فيه، إلا ويهتز ويطرب من داخلة بقشعريرة دافعة لإرادة التغيير من الداخل؛ لأن اللفظة تنقله من حيث يدرك لها معنى مفتوحاً ذا آفاق روحيّة عليا، إذ تشيع في باطنه وتسري في كيانه أشعة التحول من عالم إلى عالم، وسريان الانقلاب من حالة إلى حالة؛ ونظراً لأنها لفظة مفتوحة العوالم غير مقيدة ولا محصورة بأهداب الأرض وطينة المادة الصماء، فلا ريب في أن تفرض عليه لوازم التغيير تجيء من باطنه لتحرك فيه ما أعتاد على السكون والخمول. ويكفي من تعلقه بالحسِّ وتوهمه الحقيقة على أطلاله، وتشبثه بالمحسوس من ركون وتعامل وحياة وحركة، يكفي من هذا كله ركوناً ما بعده ركون واستلاباً لحقيقته الأصلية. فلولا أن رأى في تلك اللغة فضيلة اليقظة الداخلية، ما استيقظ ولا أستفاق، وعسى أن تكون في يقظته فضائل الترفع عن أوهاق المادة ليعي حركة الروح في أعمق أعماق وجدانه وفي أخلج خلجات التفكير في دنياه وأخراه.
ومَرَدُّ الأمر في تلك اليقظة الواعية أن ينظر في اللغة التي يتعامل معها فكره وضميره: أهى لغة حواس قريبة المنال أم هى لغة ترفع عنده ملكات الإدراك لما هو أرقى وأسمى من مدراك الحواس القريبة وأعلى وأبعد من المآلات الدنيوية الأرضية؟ إنْ وجد اللغة دالة على قرابة المحسوس يقع بين يديه وتحت رجليه، فهى إذ ذاك من جنس ما يريد، ومن جنس ما تدل عليه تتضع بوضاعة المحسوس الذي يقع عليه عنده على نفس الدلالة التي تقربه منه وتبعده عن سواه. وإن هو وجدها لغة أعلى وأبعد ممّا يناله محسوس ولا منظور، كانت دليلاً مباشراً على أن الخطاب الإلهي يتضمّن لغة علوية، وأن هذه اللغة لا تصلح على الإطلاق لمخاطبة الخنازير الآدمية؛ لأنها لغة من جنس ذلك المقام العلوى، تناسبه، ترتفع ما ارتفع هذا المقام عند صاحبه، وتسمو حينما تسمو المطالب الروحيّة في ذات المتلقي، وعلى هذا القياس تكون اللغة القرآنية سامية بمقدار ما تسمو في الإنسان مدركاته الروحانية.
غير أن هذا السمو الروحي هو بلا شك خاصّة ذاتية في لغة القرآن، من معطياتها، ومن أفاقها الرحبة المتسعة: ولك أن تتعمّق بالتأمل قوله تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ الذَّي أَتَينَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنهَا فَأَتْبَعَه الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ. وَلَو شِئنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، وَلَكِنُّهُ أَخْلَدَ إلىَ الأرضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الكَلبِ إنْ تَحْمِل عَلَيِه يَلْهَثْ أوْ تَترُكهُ يَلهَث، ذلِكَ مَثلُ القَومِ الذَّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ”.
من ذلك الحيوان الأعجم الذي لا يرقى برقى هذه اللغة كلما قرأ وتدبَّر ووعى ثم صعد بروحه في معارج الكمال؟ من ثم من؟ إلا أن يكون خنزيراً ينسل من بعده الخنازير.
***
بقلم: د. مجدي إبراهيم