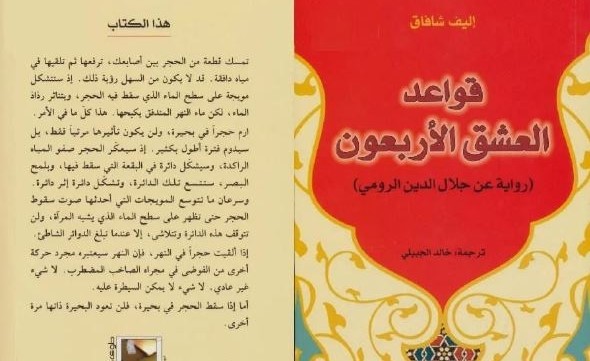قراءات نقدية
ليث الصندوق: ألمفقود والموجود من المهيمنة الفردوسية في قصائد الشاعر عبود الجابري

أضواء على أدب أل facebook
قبل الدخول في المتن النصي المتوفر بين يدي للشاعر عبود الجابري لا بدّ من الإقرار بأنه لسبب لا علاقة لي ولا للشاعر به، لم أقع على أيّ من مجاميعه الشعرية. ومع ذلك قلت مهوّناً لا بأس فالمجاميع الشعرية المنفردة مضللة، إنها لا تقدم صورة أمينة ومتكاملة لأي شاعر، بل أقصى ما تقدمه هو ملامح للأساس التصوري الذي بُنيت عليه منفردة والذي يختلف بالتأكيد من مجموعة إلى أخرى. فكل مجموعة تستقل بأفقها التصوري، وبصوتها الإيقاعي الخاص، وبرؤاها وبملامحها المغايرة عن أخواتها، وكل تلك العناصر قد تمثل الشاعر، ولكن ليس في كلّه، بل في جزئه المنطوي بين دفتي كتاب منفرد.
أما إذا كانت الرؤى والأبنية متماثلة في كل مجاميع شاعر ما، فهذا يعني ببساطة أنه يستنسخ نفسه، ويُعيد تكرار سوابقه في لواحقه. ولذلك وجدت في عدم اطلاعي على عبود الجابري في مجاميع منفردة ميزة، كما أني وجدت أن لجوء الشاعر لعرض بضاعته في موقع التواصل الاجتماعي ال facebook هو أسلم لي في البحث عن صورته الشعرية الأوسع والأشمل، وهي في الوقت ذاته محاولة من الشاعر لتقديم رؤى شعرية غير مجتزأة، بل مفتوحة على احتمالات تجزئة مستقبلية في مجاميع منفردة أكون باطلاعي عليها في مهدها على موقع التواصل الألكتروني ذاك قد تجاوزت إشكاليات تجزئتها في مجاميع منفردة. كما أنها في مهدها ذاك مفتوحة على مفاجآت شائقة، ومعيار التشويق فيها أن مرجعيات وأبنية ورؤى بعضها تُفارق مفارقة تامة الأخرى، وهي بمجموعها يمكن أن تُشكّل الأعمال الكاملة المفترضة للشاعر مستقبلاً.
هذا التعدد والتجدد والشمول في قصائد ال facebook يمنحنا حق الإقرار بأن الشاعر يخلع جلده ويجدده مع كل محاولة لينطلق من الصفر شاعراً جديداً. ومع ذلك فأن تلك الولادات المفارقة والمتجددة لم تفلح في محو أثر قار لمهيمنة بؤرية ذات طابع دلالي تتبدّى في أكثر من نسق ما بين قصيدة وأخرى، بل وحتى ضمن القصيدة الواحدة.
والآن، فضمن المرحلة الأخيرة لتطور البحث الشكلاني، أي مرحلة (إدماج الصوت بالمعنى) أقرّ جاكوبسون بأن مفهوم (المهيمنة) كان مفهوماً مثمراً، وقد عرفها بكونه (عنصراً بؤرياً للأثر الأدبي، أنها تحكم، وتحدد، وتغير العناصر الأخرى، كما أنها تضمن تلاحم البنية) (1) وهي (عنصر لساني نوعي يهيمن على الأثر في مجموعه، ويعمل بشكل قسري، لا راد له، ممارساً بصورة مباشرة تأثيره على العناصر الأخرى) (2) أنها العنصر الإجباري في الأثر الأدبي وفي سياق زمني محدد، وفي حدود ذائقة جماعية معينة، كحضور أو غياب عدد المقاطع في الشعر المقطعي، أو القافية أو النبر.
وقد وسّع جاكوبسون مفهومه للمهيمنة بتوسيعه لمفهوم الوظيفة الجمالية، إذ لا يمكن للأثر الإنشائي (أن يُحصر في الوظيفة الجمالية، بل هو يتوفر إضافة إلى ذلك على وظائف أخرى، وفعلاً فبنيات أثر إنشائي ترتبط في الغالب ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة وبخلق اجتماعي معين) (3). أن ربط جاكوبسون للمهيمنة بمرحلة الصوت والمعنى وتوسيعه لوظائف الأثر الإنشائي خارج الحيثيات الجمالية يشجعنا أن نسحب مفهوم المهيمنة خارج إطاره القسري للنوع أو الجنس الأدبي ليشمل الإحالات الدلالية النوعية المائزة في الأثر الشعري لشاعر ما، وبالتالي ستكون ضمن القاموس الشعري لكل شاعر مهيمنته الدلالية الخاصة به.
ووفق هذه الإمكانية بوسعنا تشخيص المهيمنة الدلالية التي تشغل الحيز البؤري الأوسع في قصائد الشاعر عبود الجابري، وتلك المهيمنة هي الفردوس المفقود، أو الوطن في صورته الأوسع، مع احتمالات تضييقها حسب متطلبات سيرورته التخييلية ليتحوّل إلى بيت، بل وإلى ما دونه فضاءً وتشكلاً، فلتلك المهيمنة مجالها الدلالي المتسع، وتقلباتها الرمزية التي بموجبها يتلاعب الشاعر بسيمياء المكان، ويشكلها كيفما شاء. فالوطن والبيت والمنفى والضياع والتشرد والغربة مع ظلالها و تنويعاتها هي نماذج علاماتية من المجال السيميائي للشاعر وإن تبادلت دلالاتها بأخرى مقاربة لها في المعنيين البعيد والقريب. ومع هذا الحضور، والحضور المغيّب تتجدد المهيمنة، ويفرض تجددها على النصوص ألا تكرر نفسها من جهة، مع إبقاء خيط دقيق يربطها ببعضها من جهة أخرى.
أما الستراتيجية التي يتبعها الشاعر في تلبية متطلبات مهيمنته، وإقناع المتلقي بجدوى مظاهرها المتقلبة والمتباينة، فمن المفارقة أن تكون ستراتيجية تغييب، فهو لا يقدمها كما يُتوقع منه على وفق المعينات المرجعية الموروثة للدلالات المألوفة وتواتراتها في الأدبيات المتداولة والمستهلكة، بل كما تفترضه خطاطة تستعين بتقنيات المفاجأة والصدمة اللتين تأتيان بالنقيض من المترادف والقرين، وبالغريب من النمطي والمعتاد، وبالبعيد من القريب وبالعكس. وتحت قشرة هذا المزيج ينمو المعنى مفارقاً الأصل الذي نشأ منه ليصدم المتلقي الذي يبدأ بالبحث عن العوامل التي دفعت لتلك المفارقات الصادمة.
ليكن مدخلنا للبحث عن مفاتيح تلك المهيمنة قصيدة (همهمة) حيث تتشكّل من مفصلين، ألمفصل الأول مخصص لاعترافات أنا المتكلم، أما المفصل الثاني فمخصص لتشريعاته، وما بين المفصلين، أو ما بين الإعترافات والتشريعات ثمة رابط خفي تختزله العنونة (همهمة) عبر انتمائها إلى جذرها اللغوي (الهم) وما يتفرّع عنه من معان لعل الأدنى منها إلى مضمون النص أنها (بحسب الفيروزآبادي) (4) أنها (تردد الزئير في الصدر من الهم) وليس ببعديد عن ذلك الأدنى (وبحسب الفيروزآبادي أيضاً) (5) أنها (ألكلام الخفي). وربما جمع الشاعر المعنيين في توليفة نصيّة شاء لها أن تكون ذات منحيين متضادين، فهي من جهة ساخنة صخّابة كونها تمتح من صدر موّار بالهموم، وهي من جهة أخرى هادئة خفيضة النبرة كونها موصومة ب (الكلام الخفي) لكن رابط العنونة ليس وحده ما يجمع المستويين، بل أن رابطاً آخرَ أقوى هو لُبّ المفصل الثاني أي (التشريع)، فالاعترافات، أي المفصل الأول تأتي أو يأتي معها مفصلها في أثر التضارب ما بين اعتراف المتكلم / المذنب بعدم مسؤوليته عن التشريعات من جهة أولى (سأعترف بأني لم أشرّع)، وما بين اعترافه الصريح في المفصل الثاني بكونه المسؤول عن التشريع، بل هو مشرّع بارع (أعترف بأني مشرّع بارع للخوف مما لا يُخيف) أو (أنا مشرّع خجول لكراهيتي للأوطان).
وعلى هذين المنحيين المعجميين المتضادين (ألصاخب والخفي) تتوالى هموم الشاعر متراصة ضمن المفصلين المذكورين، واللذين يمكن تطويق أبعاد ملامحهما العامة كالتالي:
ألمفصل الأول:
وهو مفصل الإعترافات، وضمنه يعرض الشاعر بين يدي قارئه ثلاثة اعترافات، بيد أنه قبل الخوض في تفصيلاتها يقرّ ابتداءً بالذنب (كما ينبغي لمذنب). وبالتالي فهو يقطع الطريق على كل احتمال بالبراءة، كما أنه يقرن هذا الإعتراف المسبق بالمتطلبات التي ينبغي عليه أداءها باعتباره مذنباً، وتلك المتطلبات هي اعترافاته الثلاثة.
لكن قبل الدخول في تفاصيل تلك الإعترافات ينبغي التساؤل: أمام أية محكمة يقف هذا المتهم، ومن هم قضاته، لاسيما أنّ النص موجّه من المتكلم إلى نفسه، دون أن تكون هناك أية إشارة صريحة إلى مخاطب ما. بيد أن المفصل الثاني يُختتم بإشارة مموهة إلى مخاطبين اثنين معنيين بأزمة الشاعر الروحية من دون أن يتوجه إليهما الخطاب مباشرة هما (الله والوطن) وسنأتي إلى ذلك في حينه.
أما الإعترافات الثلاثة التي شكلت البنية الدلالية للمفصل الأول فهي:
1 – (سأعترف بأني لم أشرّع قانون الأبواب)
2 – (... ولأني لا أملك بيتاً)
3 – (سأعترف كذلك بكراهيتي للنوافذ)
كل اعتراف من الثلاثة مدعوم بتفاصيل من مجاله الدلالي، فاعترافه الأول ألزمه بالبراءة من كل لوازم الأبواب (ألنحاس والحديد والخشب) وفضّ علاقته ب (بالأقفال والمفاتيح). أما الإعتراف الثاني فقد جاء بصيغة ضمنية وخالية من فعل الإعتراف إذ تمّ تمييع دلالته المكثفة في المسوّغ الجُرمي الذي اضطره للاعتراف وهو عدم امتلاكه بيتاً (... ولأني لا أملك بيتاً). أما حرف العطف (الواو) السابقة لهذا التسويغ فهي التي أدرجته ضمن التسلسل الثاني لقائمة الاعترافات الثلاثية. والجريمة التي تمخض عنها هذا التسويغ تمضي بدورها ضمن ثلاثة مسارات:
ألمسار الأول:
تدفع إليه سذاجة بالتفكير بالبيت المفتقد، أو بمجاله الدلالي، أو بكل ما يحيل إليه البناء بمظهره العام، أو بكل ما يمكن أن يكون ملاذاً أو حمىً:
(ولأني لا أملك بيتاً
فإن من السذاجة أن أتعب نفسي
في التفكير بالأسوار وارتفاعاتها)
ألمسار الثاني:
يمضي باتجاه التغاضي، أو عدم العناية بالتفاصيل الدقيقة للمجالات الدلالية للبيوت ممثلة بمواد بنائها: (فلا يهمني إن كانت من حجر أو من زجاج).
ألمسار الثالث:
فتعبر عنه حالة عدم الاهتمام بساكني البيوت، وضمن هذا المسار جاء الذكر على ساكنين اثنين محتملين هما (ألطيور وعابري السبيل) وعلى طريقتي التعاطي (المأوى والمتكأ) اللتين تتوافقان مع طبيعة كل منهما:
(لا يهمني إن كانت مأوى للطيور
أو متكأً لعابري السبيل)
في الإعتراف الأخير / الثالث (سأعترف كذلك بكراهيتي للنوافذ) يضع المجال الدلالي للنوافذ جانباً بعد أن استنفذ طاقة هذه الآلية في الإعترافين السابقين، واكتفى بتبيين سبب كرهه للنوافذ باعتبارها عيناً مخصوصة للتلصص. ويبدو أن سبب الكره هنا لا ينصب بالدرجة الأولى على النوافذ بالرغم من أنها لا تسلم منه، بل ينصب الكره أساساً على فعل التلصص إلى حدّ أنه يكره التلصص حتى على من يطرق بابه، ومن دون شكّ أن فعل الطرق هنا يأتي تكنية لفعل التلصص، بينما الباب هو تكنية عن الذات، فكأنه أراد القول أنه يكره أن يتلصص حتى على من يتلصصون عليه.
ألمفصل الثاني:
مع الإعتراف الأخير يُختتم المفصل الأول ويبدأ المفصل الثاني، ولكن هذا الإختتام، وتلك البداية غير منفصلين عن بعضهما كما سبق التبيين، لآن اعترافات المفصل الأول استُفتحت بإقرار الشاعر عدم مسؤوليته عن تشريع قانون الأبواب، وما تمخّض عنه من الإعترافات الثلاثة السابقات هي تفرعات متباينة عنه، بينما المفصل الثاني هو تجلية لطبيعة تلك التشريعات والتي يمكن ردّ دوافعها بالإجمال إلى الإعتراف الثاني من المفصل الأول، أي (... ولأني لا أملك بيتاً)، فنمطا التشريعات الإثنان اللذان تمخض عنهما المفصل الثاني يدوران في فلك الحرمان من البيت، وقد تتسع دلالة البيت استعارياً لتشمل الوطن. وهذا هو محور المهيمنة الدلالية التي ستنيخ ظلالها على أغلب قصائد الشاعر.
أما طبيعة تشريعات هذا المفصل فمقرونة بضمير المتكلم عن عمد إصراراً منه على الإعتراف بمسؤوليته الشخصية عن:
1 – (ألخوف مما لا يُخيف) ولا يكتفي الشاعر بإصراره على تشريع هذا النمط من الخوف، بل يقرنه ببراعته في تشريعه (أنا مشرّع بارع للخوف مما لا يُخيف) مع تفريعه لأنماط الخوف الذي لا يُخبف التي تضم (التشرّد والرياح الباردة والحنين لمعطف دافيء والجلوس على الرصيف أو على مقعد مهجور):
(أنا مشرّع بارع للخوف مما لا يُخيف
ألتشرّد مثلاً
ومصاحبة رياح باردة
ألحنين مثلاً آخر
لمعطف يقيك ثرثرة البرد في ضلوعك
والجلوس حيثما تكلّ قدماك
على رصيف أو على مقعد مهجور
وذلك أقصى ما يُمكنكَ
أن تهديه لنفسك من الترف
ومن الواضح أن تلك التفرعات التي وصمها الشاعر ساخراً بأنها (لا تُخيف) هي الدافع الأساس للخوف، لأنها ببساطة بدائل البيت كما هي في واقع الضائع والمشرّد حتى ليصبح تأمين بعض تلك المتطلبات البسيطة هدية ونوعاً من الترف:
(... أقصى ما يمكنك
أن تهديه لنفسك من الترف)
2 – وعلى الضد من إصرار الشاعر على الإعتراف بمسؤوليته الشخصية على التشريع (ببراعة مما لا يُخيف) تراجع بضع خطوات إلى الوراء لتتحول براعته إلى خجل حين يتعلق الأمر بكراهيته للأوطان (أنا مشرّع خجول لكراهية الأوطان). وإذا كنا نتفهم دوافع الكراهية لدى من فقد البيت، يبقى السؤال لماذا الخجل؟ ولماذا كراهية الأوطان؟
وإمعاناً في تعقيد الإجابة على السؤالين يقرن الخجل من كراهية الأوطان بردود أفعال تتوافق معه (أي مع الخجل) في النعومة واللين: (شتائم ناعمة / ألنظر بعين دامعة / تحريك اليدين بهمهمة) وبضم تلك الردود إلى بعضها، وتوجيهها الوجهة التي خطها لها الشاعر، مع ربطها بدعائم دلالية من المفصل الأول ربما نكون اقتربنا من الإجابة عن السؤال الثاني، فليس من المنطقي أن يأتي الشاعر بردود أفعال مناقضة ل (الكراهية والشتائم والنظر إلى السماء وتحريك اليدين) عندما تكون الأوطان هي المسؤولة عن تشريد أبنائها، أو بالأحرى مسؤولة عن المظلمة التي ألمح إليها في المفصل الأول عبر (... لأني لا أملك بيتاً) والتي سينتهي إليها المفصل الثاني بوضوح:
(أنا مشرّع خجول لكراهية الأوطان
بشتائم ناعمة ربما
والنظر بعين دامعة إلى السماء
وتحريك اليدين بهمهمة
لن يفهمها إلا الله
وأبناؤه الذين لا بيوت لهم
ولا أوطان)
إن هاجس البيت والوطن هو المهيمنة الدلالية التي ينفتح لها قاموس الشاعر بصور ومفردات المنفى والتشرّد والضياع والغربة ثم يضفي على هذا المزيج الصوري والبياني ما يزيحه عن دلالاته المعيارية وعن سياقاته النمطية ليطلقه رموزاً تستقبل أكثر من معنى ومن تأويل. ففي قصيدة (قبل أن يجنّ الفتى) تبرز ظاهرة التذكر قرينة لظاهرة النسيان، فالفتى يتذكر لينسى استعداداً لاستقبال المنفى الذي يعني محو الذات، لذلك يستقبله بحزن:
(وكعادته، يغرق في التذكر طويلاً
ليمحو الأسماء والأمكنة
ويمضي إلى منفاه حزيناً)
ومع ذلك تفشل محاولته في (التذكر / النسيان) لأن وحدتي هذه الثنائية الضدية تتبادلان موقعيهما، وعندئذ يتحوّل النسيان إلى تذكر، ومع هذا الإنقلاب المفاجيء يمضي الفتى إلى منفاه حزيناً من أجل أن:
(يعيد قراءة صور المدن القديمة
تلك المدن
التي تشتعل في رماد المكاتيب)
وكما تذكّر الفتى لينسى، ثمّ نسيَ لتذكّر، يكرر الشاعر ثنائية أخرى ذات صلة بمهيمنته، وما يتفرع عنها من دلالات ورموز. وفي ثنائيته هذه التي التي نسلها من قصيدته (دير الآباء اليسوعيين) يسير لا ليصل، بل ليضيع، ممثلاً ضياعه بحجر يركله طفل:
(ها أنذا أسير في الشارع ذاته
أنحدر في مشيتي
كما لوكنت حجراً صغيراً
يركله طفل عابث)
أما الإفتتاحية فقد مضت إلى الطرف الأقصى من دلالات البيت، ولكنه هذه المرة البيت النقيض للساكن النقيض، إنه الظل الذي تأوي إليه الشمس، أو تستند إليه، ولا فرق مجازياً ما بين الإيواء والاستناد فكلاهما يحيلان إلى الراحة والاطمئنان، ولكنّ الغريب في هذه الإفتتاحية الغرائبية أنّ الشاعر هو الموكل بالبحث عن ظل تستند إليه الشمس، وليست الشمس هي المعنية بإيجاده لنفسها، وإن الشاعر يحلف بعجزه عن إيجاد هذا المسند وكأن هناك من يُلزمه على هذا البحث:
(وأيم الله أني لا أجد ظلاّ
تستند إليه الشمس
عندما تكفّ عن هذيانها المضيء)
في قصيدة (في الحب أكثر مما ينبغي) يكون السؤال عن البيت، أو عن طريق البيت، هو ذاته السؤال عن الذات، وعندما يضيع الطريق إلى الأول، يفقد المرأ طريقه إلى الثاني، إنها حالة تداخل في الإتجاهات، أو حالة تماهي يصبح فيها الإثنان واحداً، وبذلك تدخل الذات ضمن مجازات قاموس المهيمنة، فالجملة الإبتدائية بعد أداة الشرط غير الجازمة (لو) أو ما يسمى ب (حرف امتناع لامتناع) ونعني جملة (ولو كنت أعرف أين أنا) أحالت إلى نمطين من الضياع، نمطين متماهيين في بعضهما، أو ناجمين عن بعضهما، الأول هو الضياع في المكان، ويحيل إليه إسم الإستفهام (أين)، والثاني ضياع الذات، ويحيل إليه ضمير المتكلم (أنا):
(أعرف أنك ستسألني السؤال ذاته
أين أنت؟
ولو كنت أعرف أين أنا
لأرشدت قدمي إلى طريق البيت)
ومن الطبيعي أن تُركز كل احتمالات البحث عن هذه المهيمنة في حدود المكان، ولكن ليس المكان الفيزياوي بأبعاده الثلاثة، ومرتسماته الجغرافية، إذ متى كانت الحلول الواقعية، والمظاهر الطبيعية من خواص الشعر؟ إنها ضديدته، لأنها ستحوله عندئذ إلى مقولات منطقية وإلى محمولات مغلقة، ولذلك يركز الشاعر بحثه عن عناصر مهيمنته في اللامكان. وفي اللامكان لا يبحث عن البيت، لأنه سيحمل البيت والمرأة المخاطبة معاً على ظهره، وهذا هو حاله في قصيدته (في الحب أكثر مما ينبغي) حيث يتجسد الضياع في ثلاثة مواقع: أولها في الفعل (أدور) الذي يحيل إلى عدم الإستقرار، وثانيهما في مفردة (البحث) المفارقة لمفردة (العثور)، وثالثهما في اللامكان:
(أنتِ في البيت
بينما أحمل البيت على ظهري
وأدور بكما
بحثاً عن زقاق ليّن
لنتحدّث عن الحب في اللامكان)
والضلالة عند الجابري لا تختزن دلالة يقينية مناقضة لدلالة الإيمان، بل تأتي دوماً بمعنى الضياع، والضياع لا يهدد استقرار المرء فحسب، بل يمتدّ أثره حتى إلى الحجر. وإن كان الإستقرار في الوطن هو نهاية لسردية الضياع بالنسبة للمرء الضال، فأن الرأس هو المستقر لسردية الضياع بالنسبة للحجر الضال. أما زجاج الآخرين فهو قرين المنفى. ثمّ يتبدّى فعل الإعتراض (أي اعتراض طريق الحجر المتوجه إلى زجاج الآخرين) كمحاولة لإيقاف تكرار تجربة المنفى، حتى لو نجم عن تلك المحاولة شجّ الرأس. وهكذا تتميّع المسافة ما بين عناصر المجاز المتباعدة، وتصبح إحدى ممكنات التأويل كما يلي:
- الحجر الضال = المرء الضائع
- ألرأس = الوطن أو المُستقر
- زجاج الآخرين = المنفى
(تعرّف جيداً
على الحجر الضال
إعترض طريقه برأسك
حينما يكون متجهاً إلى زجاج الآخرين)
***
ليث الصندوق
...........................
(1) نظرية المنهج الشكلي – نصوص الشكلانيين الروس – ترجمة ابراهيم الخطيب – الشركة المغربية للناشرين المتحدين ومؤسسة الأبحاث العربية – بيروت – الطبعة الأولة 1982 – ص/ 81
(2) نفسه – ص/81
(3) نفسه – ص/83
(4) ألقاموس المحيط – محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزابادي – تحقيق د. يحيى مراد مؤسسة المختار – ص /1119
(5) نفسه – ص/1119
...........................
نماذج من قصائد الشاعر عبود الجابري
(همهمة)
كما ينبغي لمذنبٍ
سأعترفُ بأنّي لم أشرّعْ قانونَ الأبواب
وأبرأُ صادقاً إلى النحاس، والحديدِ، والخشبِ
من علاقتي بالأقفالِ والمفاتيح
ولأنّني لا أملكُ بيتاً
فإنَّ من السذاجةِ أنْ أتعبَ نفسي
في التفكيرِ بالأسوارِ وارتفاعِها
فلا يُهمُّني إنْ كانتْ من حجرٍ أو من زجاج
لا يُهمّني إنْ كانتْ مأوىً للطيور
أو مُتكّأً لعابري السبيل
سأعترفُ كذلكَ بكراهيّتي للنوافذِ
فليسَ بوسعي أن أتلصّصَ من خلالها
على من يطرقُ بابي
أنا مشرّعٌ بارعٌ للخوفِ ممّا لا يخيف
- التشرّدُ مثلاً
ومصاحبةُ رياحٍ باردةٍ
- الحنينُ مثلاً آخر
لمعطفٍ يقيكَ ثرثرةَ البردِ في ضلوعك
والجلوسُ حيثما تكلُّ قدماك
على رصيفٍ أو على مقعدٍ مهجور
وذلك أقصى ما يُمكنكَ
أنْ تهديه لنفسكَ من الترَفِ
أنا مشرّعٌ خجولٌ لكراهيّة الأوطان
بشتائمَ ناعمةٍ ربّما
والنظرِ بعين دامعةٍ إلى السماء
وتحريكِ اليدين بهمهمةٍ
لن يفهمها إلّا الله
وأبناؤه الذين لا بيوتَ لهم
ولا أوطان
**
(قبلَ أنْ يُجَنَّ الفتى)
كعادتِهِ
يمرُّ دونَ أن يلقي التحيّةَ
خشيةَ ألاّ يرُدَّ عليهِ أحدٌ
مُطرِقاً يعبرُ أبوابَ البيوت
كما لو انّها أضرحةٌ
وكعادته، يغرق في التذكّر طويلاً
ليمحو الأسماءَ والأمكنة
ويمضي إلى منفاهُ حزيناً
يعيدُ قراءةَ صورِ المدنِ القديمةِ
تلك المدن
الَّتي تشتعلُ في رمادِ المكاتيب
*
هوَ كأسٌ تفيضُ بماينقصُ منها
يحلمُ أن يكتبَ قصيدة
عن الأزرارِ العالقةِ في أصابعِهِ
فيصيبُهُ خجلُ القمصانِ
حين تلاعبُها الريح
لذلك يفتحُ فمَهُ عند كلِّ منعطفٍ
ويتذرَّعُ بنسيانِ العناوينِ
عندما يضيع
*
صارَ شبيهاً لها
تلكَ التي تنازلتْ للطينِ
عما ينقصُهُ من ملامحِها
ذلكَ مايجعلهُ كاملاً في مراياها
ويقلقُ صفحةَ الماء
حين ينظر إلى وجهِه، في البئر العتيقة
*
هذه الكأسُ ليستْ لي
مادامتْ فارغةً
وهي بالتأكيد ليستْ لكِ
لذلك لن نكترثَ
حين يطوِّحُ بها سكرانٌ
أو يُسقطُها طفلٌ عن الطاولة
فلمْ نكنْ ننظرُ إليها بلهفة ٍ
حين تيبَّستْ شفاهنا
كأسٌ شاردة
من قنّينةِ نبيذٍ فارغةٍ
ربَّما من نهرٍ حوّلَ الأعداءُ مجراهُ
إلى بِرْكةٍ أناخوا قربَها جمالَهم
وأشاروا إلى جواميسهم، لتسبحَ قربَ شريعتِه
وهي على أيَّةِ حال ليستْ لأَحَدٍ
فلماذا يعدُّها البعضُ من أثاثِ ليلتنا
حينَ يبصرون ملامحَ القناعةِ على وجهينا،
مادام قلبها لا يتَّسعُ
لتغدوَ مقبرةً زجاجية فارهةً
عندما نفكِّرُ بالموت؟
*
ينفخُ في الرمادِ طويلاً
لعلَّ جمرةً مَيّتةً
تعترفُ بخطاياها فَتشتعلُ
يهتفُ:
- ياربّ، وينسى ما يريد
ينسى أنْ يكونَ مهذَّباً وذليلاً
حينَ يجاهرُ بالمعصيةِ
وينتصرُ لغصنٍ هاربٍ من اخوتِهِ
هو ذاتهُ الغصنُ الّذي أخبرَهُ
أنَّ الحفيفَ سيقودهُ حتماً، إلى الشجرة
*
كلُّ شيءٍ
يأخذهُ إلى المعنى الناقصِ
وهو يضحكُ كالأبلهِ
فرِحاً بالهمّةِ التي تتنزَّلُ عليه
بينما ينظّفُ أثرَ العابرين في حياتهِ
كما لو انَّ أحداً وهبَهُ مسدّساً محشوّاً
ليطلقَ النارَ على الرغيفِ المثلومِ
في بقايا المائدةِ
والرجلِ الذي أخطأ العنوانَ
فطرقَ البابَ كي يسألَهُ عنهُ
والمرأة التي نامتْ بعيداً
دونَ أنْ تخبرهُ
على أيَّةِ جهةٍ وضعتْ جَنبها
*
قبلَ أن يجنَّ
دخَّن سيجارتينِ وماتْ
- ألمْ تقلْ إنَّه جنَّ
بعد سيجارتين من الوقت؟
- بلى، قلتُ ذلك لأنّي لم أعثرْ عليه
قربَ رصيفٍ كان يؤمُّهُ عاقلاً
فتَّشتُ عنهُ قلوبَ النساء
جيوبَ الفلاسفة
وخرائبَ البلادِ
وحين تعبتُ من التجوالِ
قلتُ لهُ: ابقَ حيثُ أنت
ريثما أعودُ غداً
أو بعدَ غد
سيكونُ معي من الوقتِ سيجارتان
وجنونٌ غزير
أهيلُه على خطواتِ من يبحثونَ عنك
قبلَ أنْ تموت
***
(دير الآباء اليسوعيين)
(مقطع من القصيدة)
وأيمُ الله إنّي لا أجدُ ظلّاً
تستندُ إليه الشمسُ
عندما تكفُّ عن هذيانها المضيء
لا أجدُ في نصفِ الكأس
ما يصلحُ للوصف عندما أشربهُ
ها أنذا أسير في الشارعِ ذاته
أنحدرُ في مشيتي
كما لو كنتُ حجراً صغيراً
يركلهُ طفلٌ عابث
أمرُّ كلَّ صباحٍ على (ديرِ الآباء اليسوعيين)
البابُ مغلقٌ
والآباءُ اليسوعيّون لمْ يَصِلوا بعدُ
ربّما وصَلوا، ودخلوا الدير
كضوءٍ يهبطُ من الأعلى
ربّما يكون يومُهم بلا مواعيد
لقدّاسٍ أو معموديَّةٍ عاجلة
لطفلٍ يتهجّى صرخته الأولى
أقِفُ طويلاً عند الباب
سبّورةً ثكلى
يؤانسها طباشيرٌ يقتصدُ باللون
سبّورةً خضراء
لكنّها لا تتقمّصُ دورَ العشبِ
في مغازلةِ الطباشيرِ
ليسَ سوى غبارٍ
يهوي من ممحاةِ عمرها
فتمضي بهِ مكنسةُ القشِّ
إلى بابِ الريح
مغلقٌ بابُ الديرِ
(ديرِ الآباء اليسوعيين)
لامعةٌ اقفالهُ
مفاتيحهُ معلّقةٌ على غصنِ شجرة
أذكر أنّها كانت ليمونة
أو مما لا أعرفُ من الشَجر
عالياً كانَ سورُ الدير
وطويلاً جدّاً
يتراءى إليَّ أنَّه لن ينتهي
أتطاولُ فلا أرى رؤوساً تتحرَّك
وأنحني فلا أبصرُ أقداماً تثير غباراً
كيفَ إذنْ دخلَ هؤلاء القوم
ومتى يخرجون
كيف عمّروا هذا السور
وما الَّذي جعَلَهُم يُلصقونَ بجدرانهِ
أطباقاً مليئةً بالرمل
أطباقاً خزفية
يُبَّدلون ترابَها يوميّاً
ليطفئ المريدون سجائرَهم
قبل أن يدخلوا
أيُ تبجيلٍ تحظى بهِ سجائرُهم
عندما لايدوسون عليها
لتنطفئ؟
*
تعرّف جيّداً
على الحجرِ الضالّ
اعترضْ طريقَهُ برأسِكَ
حينما يكونُ متَّجهاً إلى زجاجِ الآخرين
وحاولْ أنْ تصدرَ صوتاً
شبيهاً بصوتِ الهشيم
لتلفتَ انتباهَ العابرين
وتُفرحَ مَعشرَ الاحجارِ النائمة
في قلوبِ الجدران
انتظرْهُ في المقهى
عندما يواعدُكَ بلِقاءٍ عاجلٍ
واطلبْ لهُ ما يشاءُ من الشراب
أسعفْ وحشَتَهُ بسيجارةٍ
وكنْ نارَهُ التي تُشْعلُها
كنْ فَمَهُ وأصابعَهُ
دَعْهُ يدخّنْ
وشاركهُ البكاء المرَّ
على خيبتهِ
عندما يسقط في النهر
و يعکّرُ سكون الماء
أو عندما يُحاولُ أن يؤنسنَ
أوجاعهُ
كلاكُما حجَرانِ في هذا العالم
حجَرانِ ثقيلانِ
تعافكُما أيدي الأطفال الناعمَة
في المشاجرات
ولن يفكّر بِكُما أحدُ
في النَيلِ من الثمارِ العالية
أشبهَ بضيفٍ طارئ
يزورُنا النهار
مُتعَباً يطرقُ الباب
عندما يقتربُ من بيوتِ أعمارنا
و يدخلُ بيدينِ فارغتين
حتّى أنّه لمْ يسألْ
إن كانت بنا حاجةٌ
لشيءٍ من دكاكينِ الجهةِ
الأخرى للأرض
***
(في الحبِّ أكثر مما ينبغي)
كما يبدو من الأثرِ على وجهِ التراب
فإنَّ من عبَروا قَبْلَنا
لمْ يفكّروا أنْ يدوروا حولَ أنفُسهِمْ
لمْ يحاولوا أنْ يحفروا بئراً
ولمْ يفكّروا حتّى بطريقةٍ بدائيَّةٍ
أنْ يغسلوا اقدامَهمْ من أثرِ الطريق
*
علينا أنْ نكونَ أوفياءَ برَرةً
ونحرّكَ أقدامَنا في مواضعِ الجلوس
وحينَ يداهمُنا التراب
علينا أنْ نصنعَ منهُ عواصفَ
مهنةٌ عظيمةٌ
أنْ نفعلَ ذلكَ لنحجبَ الرؤية
عمّن يريدُ بِنا العَمى
*
أنتِ في البيت
بينما أحملُ البيتَ على ظهري
وأدورُ بِكما
بحثاً عن زقاقٍ ليّنٍ
لنتحدّثَ عن فكرة الحبِّ في اللّامكان
*
أوَ لمْ يكنْ بوسعِنا اختيارُ لُغةٍ أخرى
لغةٍ أكثر يباساً
من هذهِ اللُّغةِ الّتي تغرقُ مفرداتُها
في بحرٍ من الدموع؟
*
لا تحدّثيني عن الوقت
لا تُحدِّثيني عن الليلِ والنهار
سنعرفُ ذلكَ من الظلام
ما دُمْنا نحملُ قلوباً بلا ساعات
*
أعرفك من طريقتك في التحيّة
أعرفُ أنّكِ غاضبةٌ عندما تقولينَ لي: شكراً
بدلاً من أتعبتُكَ ياحبيبي
وأعرفُ أنّكِ متعبةٌ
عندما تختبئين في دمعةٍ شاسعة
أعرفُ ما لا تريدين قوله
من صمتِك في العناق
*
لماذا لمْ تُخبريني
أنَّ الله قد زارنا في غيابي
وأنّه قد أنزلَ علينا مائدةً من السماء
وإلاّ فما هو تفسيرك
لهذا النوم الّذي يغطُّ فيه الصغار
كما لو انّهمْ أكَلوا للتوّ؟
*
لم نعدْ نسمع الأغاني منذ زمن بعيد
جميعُها تتحدّثُ عَنْكِ وعنّي
لم نعدْ نسمعها ياحبيبتي
لأنّها قديمةٌ
تشبه بصورةٍ أو بأخرى
عتب الجياعِ على الرغيف
*
أعرفُ أنّكِ ستسألينني السؤال ذاته:
أينَ أنت؟
ولو كنتُ أعرفُ أين أنا
لارشدتُ قدميَّ إلى طريق البيتْ
*
لديّ الكثيرُ من الأصدقاء
طبيبٌ تعذّبُه سيّارته العاطلة
وحلّاقٌ يشكو رداءة الشفرات في السوق
بقّالٌ يقطعُ من دفترِ الديون
كلَّ يومٍ ورقةً ليشتري دفتراً جديداً
لديَّ من الأصدقاءِ من لا أعرفُ أسماءَهم
أعتذرْ منكِ،،
كنتُ أريدُ الحديثَ عن القطِّ الحنون
وهوَ يشمُّ أصابع قدميَّ
ليعرفَ إن كنتُ عائداً إلى البيتِ مشياً
***
كذبتُ عليكَ
عندما أخبرتكَ أنّني أتعافى
كنتُ أعني أنّ الجرحَ
صار قنطرةً يعبرُ النملُ عليها
صوبَ ضفّةٍ أخرى
من الوجع
وأنّني أسكنتُ فيهِ كثيراً
من الأكاذيب
أهونُها ضحكةٌ ملساء
وأصعبُها ما أردّده في الأدعيةِ
عن كشفِ الضُرّ
وإطلاق النار على الكروب
تعال إذن
خذْ عمري، واحجزْ لهُ مقعداً
في المدرسة
خذْ مفاصلَ البابِ إلى الطبيب
ليكفَّ عن النحيب
خذْ ظهر الخزانةِ
إلى المعالجِ الطبيعي
كي تعاودَ الوقوفَ بلا ألمٍ
خذ نار بيتي
وتصدّقْ بها الآن
على ذوي القلوب الباردة
خذني إلى سجنٍ ضيّقٍ
تظنُّ أنٌه أفضل
من هذه الحديقةِ القاسية
خذ رقعةً من جلدي
لترفو بها الشقّ الأبديّ
في سترةِ روحي
ولا تنسَ أن تزورنا كلّ ليلةٍ
لتعرفَ،
متى نشدُّ الرحالَ إليك
قلْ لي بربّك:
كيفَ سأجمعُ كلّ هذه الأكاذيب
وأرميها على بابك
في دمعةِ صدقٍ واحدة؟
كيفَ لي أن أفعلَ ذلك
وانت تبيتُ كلً ليلةٍ
في منحدرٍ ثلجيٍّ
وتلقي بنيرانك علينا
فيكبر فينا العناد
ولا ننضجُ؟
قل لي بشرفكَ:
أينَ أمضي
و كيفَ لي أن أعرفَكْ
أو تعرفَني
عندما نلتقي؟
*
لن تجدَ حجَراً في هذا العالم
تَحتكُّ بهِ كيْ تُضيء
أو أنْ تصدرَ مِنكَ على الأقلّ
شرارةٌ يتيمةٌ
***
في زمنِ سرّاق النارِ
ستغدو عودَ ثقابٍ منسيّاً في العلبة
أولئكَ الّذينَ ينتظرونكَ
قُلْ لهم:
إنّك تنتظرُ كذلك.
هيَ أُحجيةٌ لاتحلُّ إلّا بمعجزةٍ
أو رحيلٍ إلى حياةٍ نائيةٍ
أبْعدَ ممّا أنتَ فيه
وأقربَ إلى حوار الرياح
مع جناحِ صقرٍ عجوز
يحلّقُ قربَ السماءِ السابعة.
(رُسُل الظلام)
ثمَّة من يأتي ليلاً
ويغطّيكَ بلحافٍ قديم
وهو أمرٌ بليغٌ في متنِ الحبِّ
لأنّهُ يمنحكَ الشجاعةَ
كي تمدَّ ساقيكَ حين تنامْ
*
ثمَّةَ من يأتي ليلاً ويسلبُكَ ما تتغطّى بهِ
حتّى لو كانَ لحافا قديماً
وهو أمرٌ موجعٌ في متنِ الكراهيةِ
لأنّه يجعلُك شبيهاً بجنينٍ حزين
فتحضنُ رأسكَ بين ساقيكَ
حين تنام
*
هناكَ من لا ينتظرُ الليل
ويعرفُ أَنَّكَ بلا غطاء
لكنَّه يتردَّدُ على نومكَ بين حُلمٍ وآخر
ليعرف فحسبْ
إن كنتَ تحضنُ رأسكَ
بين ساقيْك
*
ماذا لو كنتَ بلا رأسٍ أصلاً؟
ماذا لو كنتَ بلا ساقين؟
كيفَ لكَ أن تحتفي بهم
أولئك الساهرين الذين يراقبون ليلَك
كما لو انّهمْ عسسٌ
يسعون أن يحتفظوا بصورة
لغفوتكَ الأخيرة؟
*
ماذا لو كنتَ تنامُ
واضعاً رأسكَ في حُضنِ أُمّكَّ؟
تُرى هل يُغيِّرونَ وُجهَتَهُم
بزعمِ أَنَّك طفلٌ
لا يمكنه أن يمضي وحيداً
إلى الغابة؟
***
(نقطة حبر)
بهذهِ الخطوطِ المتعرّجةِ الّتي تغزو جبينَك
والخطِّ المستقيمِ الذي ينامُ قلِقاً
بينَ حاجبيكَ المعقودين
بالغضونِ الّتي تتقاطعُ في وجهك
ترمُقها بأسىً
طيّاتٌ تتشاجرُ في عُنقِكْ
كم تشبهُ خارطةَ الرملِ
عندما يحفرُ العالمُ خنادقَ في وجهك
ليُخفي جيوشهَ الخاسرة
ويرسمَ على ما تبقّى منكَ
خطّةً مُحكمةً، لحروبهِ القادمة
*
ليسَ للطّائرِ الغريبِ
سوى جناحيهِ، وأسلاكِ الكهرباء
ليسَ لهُ سوى عُشٍّ
يجمعُ ماتناثرَ في زواياه
من حروفٍ مهملةٍ
تكتبُ حنينَهُ إلى القشِّ
وترسمُ صوتَ البردِ
في وجعِ النوافذ
*
أنا تائهٌ
وأنتَ تعجنُ الهواءَ بأصابعِك
لتدُلَّني بالإشارة
لماذا لم تؤدّبْ يدَكَ
في حضرةِ من يلوذُ بك
كي يستنطقَ ماتُخفي
من العلاماتِ الواضحة؟
رُبَّما كنتَ تقصدُ الأعلى والأسفل
وهي ليستْ جهات
بأيّ حالٍ من الأحوال
فأنا لنْ أصلَ السماء
عندما أقفزُ
مثلما لايهمّني أن يترفقّوا بي
عندما يضعونَني في حفرة
*
كنتُ آخرَ من وصلَ
وأوّلَ من أطلقَ ساقيهِ للريح
لمْ أبحثْ عن كرسيٍّ كي يُجالسَني
في وحشةِ الواقفين
ولم أتوقَّفْ دقيقةً واحدةً
لقراءةِ سورةِ الفاتحة
كانَ الحاضرون يموتونَ، واحداً تلوَ الآخر
لكنّهمْ لا يسقطونَ عن الكراسي
حتّى عندما تهزُّ أكتافَهُم
من بابِ التلطُّفِ
الواقفون اصيبتْ اقدامُهمْ بالخدَر
وثمّة من غلَبَه نومٌ عميقٌ
فنسيَ أنْ يصحو
نسيَ أن يقطعَ تذكرةً
قبلَ صفيرِ القطارِ المسافر
إلى السماءْ
*
لشدَّ ما جرحتُ يدي
عندما أشرتُ إلى ما خفيَ منّي
وبدلاً من الصمتِ
صرتُ أغنّي بصوتٍ أعلى
ظننتُ أنّهم كانوا يهزّون رؤوسهم طرباً
أولئكَ الذينَ أغمضوا عيونهم
كي لا يسمعوني
وعندما أخبرتهم أنّي لا أملك مظلّة
فإنّ ذلك لا يعني تماماً
أنّها تمطرُ في الحديقة
قدمي جريحةٌ
ومنذ زمنٍ لا أذكره
أقطعُ الدروب سيراً نحو الله
لأخبرَهُ فحسبْ، أنَّ قدَمي توجعني
أحملُ كلّ صباحٍ
ما زِنّتُهُ وطنٌ ثقيلٌ
لأكتشفَ أنّ ظهري يؤلمني كذلك
وعندما أحلمُ بالنومِ
أحاولُ مخادعةَ التعب
لأغفو في الوثيرِ من تلالِ القشِّ
وأرنو من بعيدٍ إلى البيدَرِ
أيَّتُها الأسباب
ما زلتُ أشعرُ بالانكسارِ
كلّما وقفتُ على بابكِ صامتاً
راجياً أنْ تكوني شفيعي عند الأسئلة
*
ليسَ من الحكمةِ
أن تطلبَ من الشجرةِ
أن تأتي بأبنائها
ليكنسوا الورقَ المتطايرَ
عن الأرصفة
الشجرُ -أسوةً بالأوطان-
ينجبُ أولاداً
كي يهاجروا بعيداً عنه
ويملأوا رصيفَ العالم
بالورقِ اليابس
*
ليسَ شرطاً أن تنتظر
لتعرفَ متى يَصِلونْ
- أولئكَ الذين تحبّهم –
ربّما يأتون بغتةً ودونما انتظار
تماماً مثل الذين تكرهُهم
وتكدُّ لتنساهم
ستحملُهم اليكَ رياحُ الفجر
كما أغنيةٌ
تتناهى إلى سمعِكَ من بعيد
كما غيمةٌ متعبةٌ
تفتشُ عن وسادةٍ آمنة
في فنجانِك
***