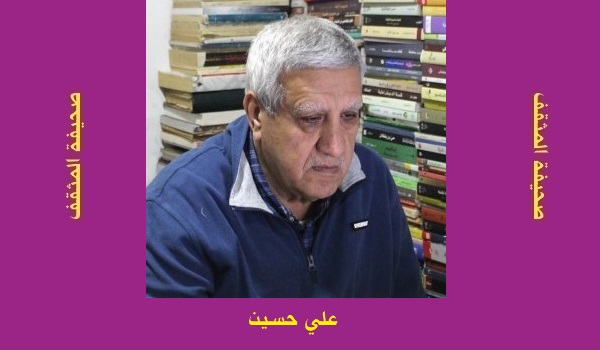قضايا
عبد السلام فاروق: روح بلاد الرافدين بين الاستشراق والاستلاب!

أي أقدار مرة هذه التي تحملنا علي استعارة ذواتنا من متاحف الغرباء؟ وأية مهانة معرفية تجعلنا نقتفي أثر هويتنا في مرايا الآخرين؟!
إنها أقدار عجيبة غريبة.. أن نجد ذواتنا مطمورة تحت ركام ذاكرة الآخرين؟! وأن نستعيد هويتنا الحضارية من خلال عيون الغرباء!
المستشرق الفرنسي "لويس ماسينيون" يعود إلينا من الماضي، محملاً برسالة استشراقية مزدوجة الوجه، تعكس تلك الازدواجية العميقة التي طبعت كيانه: بين انجذاب روحي صوفي إلى التراث الإسلامي، وولاء كولونيالي استعماري لا يتزعزع لبلاده.
يعود في هذا السفر المعرفي "مهمة في بلاد الرافدين"، الذي نقله إلى العربية بمنهجية دقيقة المترجم نزار هليل، نجدنا إزاء ظاهرة فكرية تستحق التأمل العميق: إنه المستشرق الذي يبحث عنا، ويغوص في أعماقنا، أكثر مما نبحث نحن عن أنفسنا! إنها مفارقة وجودية تطرح سؤالاً جوهرياً يخترق الأعماق: لماذا نستعير ذاكرتنا الجماعية من سجلات الآخر ومحفوظاته؟
لقد كان ماسينيون - بحق - عالماً موسوعياً نادر المثال، جمع بين عمق المؤرخ المدقق ودهشة الرحالة المغامر وحساسية الصوفي المتأمل. لكنه مع ذلك، ظل أسيراً لإشكالية الاستشراق الجوهرية، وهي النظرة الاستعلائية التي تتعامل مع تراثنا الحضاري وكأنه موضوع للدراسة والتحليل، لا كـ "ذات" حية تنبض بالحكمة والتاريخ والإرث الإنساني العميق.
يذهب البعض إلى أن هذا الكتاب يكشف عن المهمة العلمية والثقافية التي قام بها ماسينيون في العراق. أما أنا فأقول: إن كل مستشرق يحمل في حقائبه مهمتين متمايزتين، واحدة ظاهرة للعيان، وأخرى خفية في اللاشعور الجمعي للغرب. فالمهمة الظاهرة هي البحث والتنقيب والجمع، أما المهمة الخفية فهي إعادة تشكيل صورة الشرق وفق رؤية غربية، حتى عندما تبدو هذه الرؤية متعاطفة ومحبة!
الخرائط التي تحدث عنها ماسينيون، والنقوش التي فك طلاسمها، والسطور التي حللها وفسرها، كلها تحمل في طياتها إشكالية التمثيل الثقافي. فالشرق الذي يرسمه هذا المستشرق، حتى في أصدق لحظاته وأكثرها تعاطفاً، هو شرق متخيل، معاد تركيبه في مختبر العقل الأوروبي ومنظوره الحضاري.
وهنا أصل إلى لب الإشكال الخطير العميق، لماذا نقبل نحن العرب أن تكون ذاكرتنا منسية مدفونة في رمال التاريخ، حتى يأتي من ينقب ويفتش عنها ويكتشفها؟ لماذا نرضى بأن نكون مجرد موضوعاً للدراسة والتحليل، لا فاعلين أصليين في إنتاج المعرفة بأنفسنا ولأنفسنا؟ وترجمة مثل هذه الأعمال، على أهميتها المعرفية البالغة، تظل خطوة في اتجاه واحد. فالأهم من ذلك كله أن ننتج نحن قراءتنا الخاصة لتراثنا، أن نكتب تاريخنا بأيدينا وأقلامنا، أن نستعيد الذاكرة الحضارية من أقبية الاستشراق وأروقة المتاحف الغربية.
العراق العظيم، بلاد الرافدين، مهد الحضارة والإبداع الإنساني، يستحق أكثر من أن يكون مجرد "موضوعاً" لمهمة علمية أجنبية. إنه ذات حاضرة، تنبض تحت الرماد، تنتظر من أبنائها أن ينهضوا ويقرأوا تراثهم قراءةً وجودية أصيلة، لا استهلاكية مستوردة.
لقد قدم لويس ماسينيون عملاً أكاديمياً رصيناً، بلا أدنى شك. لكن الحقيقة التي لا بد أن نعيها تمام الوعي والإدراك، أن كل قراءة للتراث هي في النهاية إعادة إنتاج له. والخطر كل الخطر أن نستمر في استهلاك صورة أنفسنا كما ينتجها ويرسمها غيرنا. فإلى متى نظل نستعير هويتنا من عيون الآخرين؟ وإلى متى تبقى ذاكرتنا رهينة مهمات المستشرقين، وإن كانت مغلفة بإعجابهم وحبهم الظاهري لتراثنا؟
بالتأكيد إن طريقنا إلى الذات الحقيقية يبدأ عندما نكف عن كوننا هوامش على نصوص الآخرين، عندما نتحول من موضوع للدراسة إلى فاعلين في المعرفة والإبداع. وإذا أردنا أن نعمق النظر، فلنسأل: أي عراق كان يبحث عنه ماسينيون؟ وأي عراق نبحث عنه نحن اليوم؟
كان ماسينيون - في حقيقته العميقة - يبحث عن العراق الصوفي الذي يتوافق مع رؤيته الخاصة للتراث الإسلامي. العراق الحامل لسر الغربة والانتماء، العراق الذي يتجاوز الجغرافيا إلى الميتافيزيقا. لكن هذه الرؤية، على جمالها الأخاذ، تظل قاصرة عن إدراك كينونة العراق الحضارية الشاملة المتكاملة.
فالمستشرقون الكبار مثل ماسينيون، غالباً ما يأتون إلى تراثنا محملين بإشكالياتهم وقضاياهم الغربية الخاصة. فهم يدرسون ويبحثون تراثنا من خلال مرايا فلسفتهم، ويحملون أسئلة قد لا تكون أسئلتنا. وإن بدت إجاباتهم عميقة، فإنها تظل إجابات عن أسئلتهم هم، لا عن أسئلتنا نحن! والأخطر من ذلك، أننا نتلقى هذه الإجابات وكأنها حقائق مطلقة، فنصبح تلامذة في مدرسة الغرب نتعلم عن أنفسنا! أليس هذا ضرباً من الاستلاب المعرفي والثقافي؟
وفي هذا السياق، يذهب البعض إلى أن الترجمة جسر مهم وضروي بين الحضارات. أما أنا فأقول: نعم، لكن بشرط أن لا نبقى واقفين على الجسر! لأن الترجمة يجب أن تكون محفزاً للإبداع الذاتي، لا بديلاً عنه. كم من مترجم نقل إلينا كنوز الغرب، فأنسانا كنوزنا نحن!
بالتالي فإن تحقيق المترجم نزار هليل لهذا العمل - وهو جهد مشكور دون أدنى ريب - يظل خطوة في طريق طويل. فالمطلوب ليس مجرد نقل النصوص، بل تفكيكها وإعادة تركيبها في وعينا الجمعي. وبلاد الرافدين، بكل طبقاتها الحضارية المتعاقبة، تشبه نهراً جارياً يحمل في تياراته أسرار الأمس وأحلام الغد. لكننا للأسف نقف على شاطئ النهر ننتظر من يأتينا بعبارة لنجتازه!
لقد آن الأوان أن نصنع سفننا المعرفية الخاصة، أن نغوص في أعماق هذا النهر بأنفسنا، أن نستعيد ثقتنا بقدرتنا على فهم تراثنا دون وساطة.
ولا أريد أن أظلم ماسينيون، فهو دون شك من المستشرقين القلائل الذين حاولوا فهم روح الحضارة الإسلامية من داخلها. لكن تظل هناك هوة شاسعة بين الفهم من الخارج، والإحساس من الداخل. الفرق بين دراستنا لتراثنا ودراسة المستشرقين له، كالفرق بين من يدرس المحبة بكتب العلم، ومن يعيشها بكل كيانه ووجوده!
فليكن هذا الكتاب مناسبة لنهضة معرفية جديدة، لا نكرر فيها أخطاء الماضي. لنقرأ المستشرقين، ولكن بعين ناقدة. لنأخذ منهم ما يفيد، ولكن لننسج على منوالهم رؤيتنا الخاصة. إن ذاكرة العراق المدفونة لن يستخرجها إلا أبناء العراق أنفسهم، بحفرهم المعرفي الصادق، وبعزمهم الأكيد على استعادة هويتهم من براثن النسيان والاستلاب.
العراق ليس مجرد أرض، العراق فكرة متجددة. وبلاد الرافدين ليست آثاراً وتراثا، هي روح حية تنتظر من يوقظها من سباتها العميق.
***
د. عبد السلام فاروق