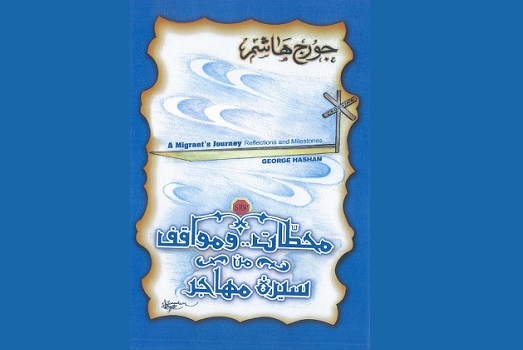قضايا
عبد الله الفيفي: حتى نُحَقِّق حُلم (أدهم)!

(قراءة في بِنية العقليَّة الاتِّباعيَّة)
حدَّثنا (ذو القُروح)، في المساق الماضي قائلًا:
- يوشك الكهنوتيُّون الجدد من الإخوة المسلمين أن يشترطوا على الإنسان أن لا يُسلِم إلَّا إن كان على شاكلتهم، أو إذا أسلم، أن يدبَّ على دربهم فقط، لا يحقُّ له لا أن يفكِّر، ولا أن يكون له رأي، أو صوت، أو موقف، ما لم يباركوه هم بدمغتهم الخاصَّة، في سلسلة ذرعها ألف سنة، خَلَفًا عن سَلَف، وسَلَفًا عن سَلَف!
- وهذا منتهَى التخلُّف والجهل، وتقديس الماضي.
- هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو استغلال الدِّين من أجل تشكيل كيانات سُلطويَّة هائلة، تريد أن تستأثر بالفهم وبالرأي وبالتفسير، وتحجر على من ليس تحت عباءتها البالية أن يتعامل مع النصِّ مباشرة.
- هم يزعمون أنهم على الجادَّة.
- كلَّا، ليس هذا من الدِّين اليسير، الذي نزل على (محمَّد بن عبدالله) في شيء، بل هو من الدِّين المؤسَّساتي، الذي ابتدعته الحوزات، وانتجته الجوامع، والمدارس، والأزاهر، ولاسيما منذ عصور الانحطاط، وتربيب الأولياء والصالحين والأحبار، بنماذجهم كافَّة.
- إذا كان الإسلام قد جاء بمبدأ «لا إكراه في الدِّين»، فمن باب أولى أنه قائل بأن «لا إكراه في الرأي»!
- صحيح، لكن هذا لا يعني، في المقابل، أن يهرف امرؤٌ بما لا يعرف، ويتعالَم، وأدوات الفهم والتلقِّي والتعبير أصفارٌ في رأسه، أو أن يهرطق على الناس لمآرب في نفسه، لا علاقة لها حتى بصريح النصِّ وصحيح اللُّغة! ذلك محض تدجيل، وإنْ جاء صاحبه تحت عمامة، وداخل قفطان، أو كان من نسل الرسول. فليست العمامة والقفطان ولا النَّسَب الشريف بمؤهِّلات عقليَّة، فضلًا عن أن تكون مؤهِّلات علميَّة.
- هل من نموذج؟
- صاحبك الذي ألمحتَ إليه في المساق الماضي هو النموذج. فهل اجتزاء (القبَّانجي)، واختزاله، وتبسيطه للآيات، كي يستشهد بها على نظريَّته التي ينادي بها حول القراءة الوجدانيَّة، هل ذلك كلُّه يتماشى مع أمانة البحث ونزاهة الطرح؟!
- هو يرى ذلك، ولا إكراه في الرأي!
- كلَّا، هذا ليس برأي! بل هو يستغفل المتلقِّي ظانًّا، كما يبدو، أنه لا يعرف «القرآن»، ولن يقرأه، ولن يكشف السقطات القبَّانجيَّة، وجهله أو تجاهله، بل عبثه بالنصوص؟
- عمَّ تتحدَّث، يا ذا القُروح؟
- راجع حديثنا في المساق السابق. لترى أنه، ولأسبابه المشار إليها مجتمعة، لمَّا تساءل: كيف يُقال في «القرآن»: «فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَخُذُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»؟ فأين ذهبت «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»؟ لمَّا فعل ذلك، فإنَّه لا يقرأ ما في الآيات من إشارات إلى أنَّ ما ورد هو في حقِّ المنافقين، الذين يتولَّون الكافرين، وهم أهل قتال، وعداءٍ للإسلام، وتأليبٍ على أهله، ما يمنعهم عن ذلك إلَّا أن تَحْصَر صُدُورُهُمْ عن القتال، أي تضيق عنه لسببٍ أو لآخر؛ فهؤلاء مستثنون، وإلَّا فهم مقاتلة، «وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ».
- وهذا الحُكم المتعلِّق بالخيانة في الولاء يشمل الناس جميعًا، حتى أقارب الإنسان، ولا تَسامُح فيه ولا محاباة لأحد.
- نعم، حتى آل الرسول نفسه، وليس لاستهداف فئةٍ أو طائفة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ، إِنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ. وَمَنْ يَتَوَلَّـهُمْ مِنكُمْ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ: إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، وَإِخْوَانُكُمْ، وَأَزْوَاجُكُمْ، وَعَشِيرَتُكُمْ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ، وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ.» (سُورة التوبة). كما أنَّ صاحبك لا يقرأ ختام تلك الآيات التي يستشهد بها: «فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ،وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.»
- لأن هذا سينقض افتراءه السابق!
- أجل. وكذا لا يقارن الآية بالآية الأخرى- وبعض «القرآن» يفسِّر بعضًا-: «فَإِنْ حَاجُّوكَ، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِـلَّهِ، وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ: أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، فَقَدِ اهْتَدَوا، وإِن تَوَلَّوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلَاغُ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ.» وهي من (سُورة آل عمران)، وهي سُورة مدنيَّة؛ لكيلا يَكُرَّ علينا أحدٌ نظريَّةَ (القرآن المكِّي) و(القرآن المدني)، كما هو منهاج أولاء الذين جعلوا «القرآن» عِضِيْن!
- ألا ترى أنَّ الآية تتحدَّث عن ضربٍ من الخيانة الوطنيَّة؟
- بلى، يمكنك أن تقول. إضافةً إلى التآمر، و«تَوَلِّي» أعداء المسلمين، وهذا معنى «تَوَلَّوا»، لا بمعنى فَرُّوا منكم فقط. والآية بكاملها، وفي سياقها، واضحة المعنى. وتؤكِّدها الآية الأخرى: «وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِن قَبْلُ، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَهَاجَرُوا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا، مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ. وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.» وبتلك الصورة الساذجة أراد الرجل، لا تشويه «القرآن» فحسب، بل كذلك تشويه الأخلاق الإسلاميَّة والنبويَّة، وتكريه الناس في الإسلام، زاعمًا أن الآية تنصُّ على أنَّ أحد المشركين إذا لم يؤمن- ولم يهاجر أيضًا- وتولَّى في سبيله، فالآية تأمر باستلحاقه وقتله! ثمَّ تعال، لنقارن هذه القراءة بقراءة أخرى. ليست لرجل دِين، بل ليست لمَرْضِيٍّ لدَى رجال الدِّين. وهي قراءةٌ لها قيمتها النفسيَّة والاجتماعيَّة والإنسانيَّة؛ لأنَّ صاحبها ثاقب التبصُّر في هذه الدهاليز من الصراع البَشَريِّ ومقتضياته في الحياة. وهو لا يكتب ما يكتب لسرد السِّيرة النبويَّة، أو للتبشير بصِدق النبيِّ وعدالة دعوته. ولقد تعرَّض بما كتبَ للتكفير، بل لمحاولة الاغتيال.
- من تعني؟
- أعني (نجيب محفوظ). فعلى الرغم ممَّا تناول به قضيَّة النُّبوَّة من تبسيط، يصل أحيانًا إلى درجة الإسفاف في تصوير الشخوص- ممَّا لا يليق في نظر من ينظرون إلى تلك الشخوص الرموز بإجلال عظيم، وأبرز تلك الشخوص شخصيَّة (قاسم)، التي عبَّر بها عن شخصيَّة الرسول- فلقد كان منصفًا إلى حدٍّ كبير في النظر إلى هذه القضيَّة، في مستويَيها التاريخي والإنساني. وهو في هذا السياق يقول على لسان (قاسم): «لن نُطَهِّر حارتنا من الفُتُوَّة إلَّا بالقُوَّة، ولن نُحقِّق شروط الوَقف إلَّا بالقُوَّة، ولن يَسود العدل والرحمة والسلام إلَّا بالقُوَّة ، وستكون قُوَّتنا أوَّل قُوَّة عادلة غير باغية.» كما يقول على لسان (قاسم)، بعد الهِجرة: «سنرفع النبابيت كما رفعها (جَبَل)، ولكن في سبيل الرحمة التي نادى بها (رفاعة)، ثمَّ نستغل الوقف لخير الجميع؛ حتى نُحَقِّق حُلم (أدهم). هذه هي مهمَّتنا، لا الفُتُوَّة.»(1) في إشارة بـ«جَبَل» إلى (موسى)، وبـ«رفاعة» إلى (عيسى)، وبـ«أدهم» إلى (آدم)، عليهم السلام. هذا، إذن، هو تصوُّر (نجيب محفوظ) لمجريات الأحداث، ولضرورة مواجهة القُوَّة والبَغْي بالقُوَّة والرَّدْع، وأنَّ هذا هو ديدن التجربة الإنسانيَّة في واقع الحياة. وهي رؤيةٌ تفسيريَّةٌ لما حدث، من غير متَّهمٍ بانحيازٍ أو حماس. تُرينا الفارق بين خطابٍ يحاول تفسير التاريخ بواقعيَّة إنسانيَّة مجرَّدة وخطابٍ يسعَى سعيه للمغالطة لقلب كلِّ إيجابٍ إلى سلب، لأغراض في نفسه.
- لنعُد، يا صديقي، إلى حسم تلك الفِرية الزاعمة أن الآيات المتعلِّقة بالحُرِّيَّة الدِّينيَّة إنَّما كانت مَكِّيَّة لا مَدَنيَّة، كما يدندن هؤلاء.
- لنفعل ذلك، متنزِّلين بهذا عند قياسهم الأخطل، الذاهب إلى أنَّ القتال كان ينبغي أن يُصدَع به من أوَّل يوم، وإلَّا فإنَّ (محمَّدًا) كان يَلْبَس لكلِّ أوانٍ لَبُوسه، منتهين إلى أنَّ مبدأ الحُرِّيَّة الدِّينيَّة ليس بمبدإٍ إسلاميٍّ، بل الإسلام دِين الغزو والسيف والدَّم والهَدْم، لا يحفل باختيارات الناس، ولا باستقلال إراداتهم، ولا بحُرِّيَّاتهم، بل يمضي في إجبارهم على اعتناقه اعتسافًا، حسب دعاوَى هؤلاء وأسلافهم. إلَّا أنَّه قبل بيان ما يناقض تلك الدعاوَى المتهافتة، لا بُدَّ من الإشارة إلى مبدأ الحُريَّة في الإسلام. فالحقُّ الذي لا يجهله مطَّلع على الإسلام- إنْ كان نقيًّا من التعصُّب أو الغرض- أنَّ فِرية الجَبْريَّة الدِّينيَّة يصادمها المبدأ الإسلاميُّ حول ارتباط الدِّين أساسًا بالحُرِّيَّة؛ ذلك أنَّ من مناطات التكليف للمسلم الحُرِّيَّة، فكيف لا يكون ذلك أساسًا للدخول في هذا الدِّين ابتداءً؟! لكن دع التفصيل في هذا إلى المساق المقبل، إن شاء الله.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
.....................
(1) محفوظ، نجيب، (1986)، أولاد حارتنا، (بيروت: دار الآداب)، 388.