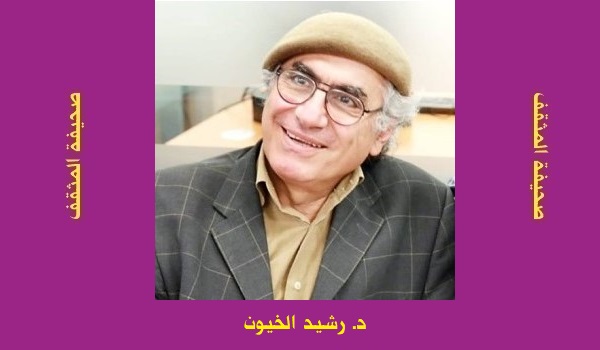آراء
إبراهيم برسي: الإخوان المسلمون.. ما بعد الربيع العربي

من لحظة التمكين إلى هاوية الانكسار (2011 – الآن)
خمس وقفات على أطلال الإسلام السياسي (4)
***
في الجزء الثالث، تابعنا كيف ولدت القاعدة من رحم الإسلام السياسي، وكيف لعب السودان دورًا في احتضانها. واليوم نصل إلى مرحلة ما بعد ٢٠١١: لحظة الربيع العربي، حين بدا أن الإخوان على وشك السيطرة، قبل أن يسقطوا في هاوية الانكسار.
حين انفجرت ثورات ٢٠١١ في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، بدا المشهد وكأنه لحظة تاريخية نادرة: الجماهير تهدم جدران الخوف، الأنظمة التي بدت أبدية تتساقط في أسابيع، والساحات تمتلئ بشعارات الحرية والعدالة. لكن وسط هذا الزخم، كان الإسلام السياسي – وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين – يتهيأ ليقطف الثمار. لم يكن حضوره وليد اللحظة؛ كان نتيجة تراكم عقود من التنظيم السري، السيطرة على النقابات والجامعات، ونسج شبكات اجتماعية وخيرية عميقة. وحين فُتحت صناديق الاقتراع لأول مرة، ظهر الإخوان كأكبر قوة منظمة.
في تونس، صعدت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، معلنة تبنيها خطابًا “ديمقراطيًا” و”توافقيًا”، لكن جذورها الإخوانية ظلت واضحة: رؤية شمولية تُدخل الدين في كل مفاصل الحياة. في مصر، فاز الإخوان بالرئاسة عبر محمد مرسي في يونيو ٢٠١٢، في لحظة وُصفت بأنها “التمكين الأكبر” منذ تأسيس الجماعة عام ١٩٢٨. بدا وكأن الحلم الذي راود البنّا وقطب قد تحقق أخيرًا: الجماعة على رأس الدولة، قادرة على صياغة الدستور والسياسة والخارجية.
لكن هذا الصعود السريع كشف عن هشاشته بنفس السرعة التي صعد بها. فالإخوان لم يملكوا مشروع دولة، بل مشروع سلطة. لم يستطيعوا إدارة التنوع، ولا استيعاب القوى المدنية والعسكرية. اصطدموا بالجيش، وأقصوا خصومهم، فبدأت الجماهير التي منحتهم أصواتها تنقلب عليهم. ومع ٣/٧/٢٠١٣، أُطيح بمرسي في انقلاب عسكري مدعوم من الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع.
لحظة الانكسار هذه لم تكن مجرد هزيمة سياسية، بل لحظة عُري كامل: الجماعة التي ادّعت تمثيل الأمة وجدت نفسها منبوذة من قطاعات واسعة من الشعب، ومطاردة من الدولة.
في مصر ما بعد ٢٠١٣، عاد العنف كخيار. شهدت البلاد سلسلة تفجيرات وعمليات مسلحة نُسبت إلى جماعات إسلامية بعضها خرج من رحم الإخوان. في رابعة العدوية، سقط المئات في مجزرة بشعة، تركت ندبة في الذاكرة الوطنية. لكن بدلًا من أن تتحول إلى مراجعة نقدية، تحولت في خطاب الجماعة إلى “كربلاء جديدة”، تُغذي خطاب المظلومية وتبرر الانغلاق والعنف. وسرعان ما تفتّتت الجماعة داخليًا إلى أجنحة متصارعة: جناح إصلاحي يطالب بالمراجعة، وجناح متشدد يرى أن السلاح هو الرد الوحيد. هذه الانقسامات أضعفت بنيتها، لكنها لم تمنعها من محاولة إعادة التمركز عبر الإعلام الرقمي والمنصات الخارجية.
في سوريا، كان المشهد أكثر دموية. اندلاع الثورة ضد بشار الأسد ٢٠١١ فتح الباب لتدخل جماعات إسلامية مسلحة، بينها جبهة النصرة (فرع القاعدة في الشام). ورغم أن الإخوان السوريين حاولوا التمايز، إلا أن الواقع أظهر تداخلاً كبيرًا: نفس الخطاب، نفس البنية، نفس الحلم بإقامة دولة إسلامية. ومع صعود “داعش” ٢٠١٣–٢٠١٤، بدا أن كل الخطوط الفاصلة قد انهارت. داعش – رغم عدائها المعلن للإخوان – جسدت أقصى ما يمكن أن تصل إليه الأيديولوجيا التكفيرية التي مهد لها قطب: دولة الخلافة كيوتوبيا دموية، تُدار بالذبح والتكفير والاغتصاب.
في ليبيا واليمن، لعب الإسلاميون أدوارًا ملتبسة: مرة في الحكم، مرة في المعارضة، ومرة في الميليشيات المسلحة. في كل الحالات، ظلّ المشهد متشابهًا: غياب مشروع وطني، حضور خطاب ديني مُسيس، وانزلاق نحو العنف. وفي السودان، وبعد سقوط البشير ٢٠١٩، بدا أن المشروع الإخواني قد وصل إلى نهايته. لكن الواقع كشف أن شبكاته العميقة لا تزال تتحرك في الظل، عبر الميليشيات، الاقتصاد الموازي، والأذرع الإعلامية.
التجربة التونسية بعد ٢٠١٤ كشفت مأزقًا إضافيًا. فحركة النهضة التي قدمت نفسها كقوة توافقية، تراجعت عن خطابها المدني بسرعة كلما اقتربت من السلطة. دستور ٢٠١٤ بدا ثمرة توافق، لكنه سرعان ما تحوّل إلى ساحة صراع بين النهضة وخصومها. وعندما جاء قيس سعيد إلى الرئاسة عام ٢٠١٩، استثمر حالة الغضب الشعبي ضد فساد الطبقة السياسية، وكان جزء كبير منه موجّهًا ضد النهضة. تجميد البرلمان في ٢٥/٧/٢٠٢١ بدا وكأنه إعلان شعبي بانتهاء أسطورة الإسلام السياسي في تونس، الدولة التي اعتبرها كثيرون نموذجًا للانتقال الديمقراطي. وهكذا، تحوّل “التمكين” إلى عبء، وأصبح وجود النهضة في الحكم رمزًا للفشل بدلًا من الأمل.
أما في المغرب، فقد واجه حزب العدالة والتنمية – وهو الامتداد المحلي للإخوان – تجربة مختلفة لكنها تحمل دلالات مشابهة. فبعد سنوات في السلطة، سقط سقوطًا مدويًا في انتخابات ٢٠٢١، حين خسر مقاعده البرلمانية بشكل شبه كامل. الرسالة كانت واضحة: الناخب المغربي لم يعد يثق بالشعارات الدينية إذا لم تقترن ببرامج اقتصادية واجتماعية فعالة. في موريتانيا والجزائر أيضًا، ظل الإسلام السياسي يتأرجح بين المشاركة السياسية والانغلاق الأيديولوجي، لكنه لم ينجح في تقديم نموذج مختلف أو جذاب.
التنظيم الدولي للإخوان حاول أن يعوض هذه الخسائر بالتمركز في أوروبا. ففي لندن وإسطنبول والدوحة، أسس مكاتبه ومؤسساته الإعلامية، وحاول أن يقدم نفسه كصوت “المسلمين المضطهدين”. لكن أوروبا لم تعد تنظر إليهم كما في السابق. بعد هجمات باريس وبروكسل ٢٠١٥–٢٠١٦، صارت السلطات أكثر تشددًا في التعامل مع الجمعيات الإخوانية. تقارير برلمانية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ربطت بينهم وبين نشر الفكر المتشدد حتى إن لم يحمل شكل العنف المباشر. ومع أن بعض العواصم استمرت في استقبالهم بحجة حرية التنظيم، إلا أن الشكوك تراكمت، وبدأت الملاحقات القانونية تطال أنشطتهم المالية والدعوية.
تركيا وقطر بدورهما لعبتا دورًا محوريًا. فقد تحولت إسطنبول بعد ٢٠١٣ إلى مركز إعلامي للإخوان، حيث انطلقت قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية تخاطب العالم العربي بخطاب المظلومية. ووفرت الدوحة مظلة مالية وإعلامية، مستخدمة أدواتها الناعمة لتسويق الجماعة كضحية للأنظمة القمعية. لكن هذا الدعم لم يغير حقيقة أن الإسلام السياسي فقد جاذبيته أمام جماهير عاشت تجربة مباشرة مع حكمه، واكتشفت خواء شعاراته.
العالم بدوره أعاد النظر في الإخوان. مصر والسعودية والإمارات أعلنتهم تنظيمًا إرهابيًا. الولايات المتحدة وأوروبا انقسمت: بعض الأصوات رأت فيهم حائط صد ضد التطرف، فيما اعتبر آخرون أن تمييزهم عن القاعدة وداعش ليس إلا مسألة تكتيكية. وقد وصف باحثون غربيون جماعة الإخوان بأنها “المظلة الأوسع التي خرجت منها معظم التنظيمات الجهادية”. أما المفكرة المصرية نيرفانا محمود، فقالت بوضوح إنهم “ليسوا حزبًا محافظًا بل جماعة تسيء إلى الإسلام”.
التحليل النفسي في هذه المرحلة يكشف ما يمكن تسميته “عقدة المظلومية المزمنة”. فالجماعة تفسر كل هزيمة باعتبارها امتحانًا إلهيًا، وكل إقصاء كدليل على صدق رسالتها. هذا التفكير يُعيد إنتاج العنف: بدلًا من مراجعة الذات، يتحول الإحباط إلى تبرير للاغتيال والتفجير. الفرد الإخواني يعيش داخل سردية مغلقة: نحن المظلومون/هم الظالمون، نحن المؤمنون/هم الكافرون. وهذه الثنائية، كما يقول علماء النفس السياسي، هي الوقود الأول لكل عنف أيديولوجي.
لكن الأهم أن ثورات ٢٠١١ أظهرت تناقضًا صارخًا: الجماهير خرجت تطالب بالحرية والعدالة والدولة المدنية، بينما الإخوان حاولوا إعادة إنتاج الدولة الدينية. هذا التناقض هو ما أسقطهم سريعًا. فالمجتمع العربي – رغم ضعفه – لم يعد قابلًا للانصياع الكامل لشعارات “الإسلام هو الحل”. الناس جربت، واكتشفت أن وراء هذا الشعار فراغًا، وأن وراء التنظيم استبدادًا مقنّعًا.
اليوم، بعد أكثر من عقد على الربيع العربي، تقف الجماعة في مأزق تاريخي: مطاردة في مصر، محاصرة في الخليج، منقسمة في السودان، مُتهمة في أوروبا، ومحرجة أمام شباب عربي اكتشف أن الدولة الدينية ليست حلمًا بل كابوسًا. ومع ذلك، لا يزال التنظيم العالمي موجودًا: في لندن وإسطنبول والدوحة، مكاتب ومؤتمرات، محاولات لإعادة التموضع، استثمار في الإعلام الرقمي. لكن هالة القداسة سقطت، وبات السؤال الأعمق: هل يمكن لجماعة قامت على السرية والعنف أن تتحول إلى حزب سياسي طبيعي؟
المفكرون الاشتراكيون يرون العكس. صادق جلال العظم كان يقول إن “كل مشروع يرفض النقد وينغلق على النصوص محكوم بالانتحار”. والطيب تيزيني أضاف أن “الإسلام السياسي يسجن الأمة في ماضٍ متخيَّل ليُخفي عجزه عن الحاضر”. هذه الأقوال لا تزال صالحة اليوم: الجماعة التي لم تُنتج سوى الاغتيال والمظلومية، لم تقدم بديلًا فكريًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.
من زاوية فلسفية، يمكن القول إن مرحلة ما بعد ٢٠١١ عرّت الإسلام السياسي أكثر من أي وقت مضى. في مصر، كشف عن عجزه عن إدارة الدولة. في تونس، كشف عن فشله في إقناع المجتمع بأنه قوة مدنية. في سوريا وليبيا واليمن، كشف عن قابليته للتحول إلى ميليشيات. في السودان، كشف عن بنيته العنيفة العميقة. وفي فلسطين، كشف عن مأزق الجمع بين المقاومة والسلطة. وهكذا، من لحظة التمكين إلى هاوية الانكسار، اتضح أن الإسلام السياسي ليس مشروع خلاص، بل مشروع أزمة دائمة.
الأسبوع المقبل نصل إلى الجزء الخامس والأخير: نقد ما بعد السرد، قراءة في البنية العميقة في مشروع الإخوان، حيث نحاول أن نفكك البنية الفكرية والنفسية للجماعة، ونطرح أسئلة المستقبل.
***
إبراهيم برسي