بأقلامهم (حول منجزه)
سعاد الراعي: الحقيقة.. مشروعٌ نقديٌّ متجدد لا يُختزل في النص

قراءة تأملية تحليلية في كتاب "النص وسؤال الحقيقة" للمفكر الأستاذ ماجد الغرباوي
ابتداء: ما إن أتممت قراءتي لمقدمة كتاب "النص وسؤال الحقيقة" للمفكر الأستاذ ماجد الغرباوي، حتى وجدتني أمام مرايا الذاكرة، تُعيد إليّ مشاهد غائرة من سنوات مضت، حيث وقفتُ غير مرة على تخوم الأسئلة الصعبة، وأنا أمارس شرف مهنة التعليم. كانت كلمات المقدمة كالمفاتيح الخفية، فتحت أبوابًا منسية في الوجدان، واستحضرت في ذهني مواقف قاسية وتجارب مؤلمة، لطالما حملتها بين جنبات القلب كتجاعيد صامتة لا تُروى، لكنها ظلّت شاهدة على صراع خفيٍّ بين قدسية الرسالة ومحنة الرأي، بين توق المعرفة وحدود التلقي.
لقد وجدت في هذا الكتاب ما يتجاوز حدود القراءة العابرة إلى مقامات التجربة الوجدانية والفكرية، حيث تتحول الصفحات إلى فضاء متقد بالأسئلة، وحيث النص لا يُقدَّم بوصفه معطًى نهائيًا، بل باعتباره كيانًا ديناميكيًا، يتنفس عبر التأويل، ويتشكّل من خلال جدل الحقيقة والمعنى.
وما زاد من عمق تفاعلي مع هذا العمل، أنني كنت قد وثّقت بعضًا من تلك التجارب التعليمية في قصة نشرتها في صحيفة المثقف بتاريخ الأول من أيار 2020، وكان أن تكرّم الأستاذ الغرباوي، مشكورًا، بإهدائي نسخة من كتابه الذي وجدته يفتح أفقًا جديدًا لفهم النص، لا كحُرمة مغلقة، بل كمجال حيّ للتحليل والمساءلة، حيث لا تكتمل الحقيقة، بل تتجدد عبر السؤال، وتنضج بالمراجعة، وتتسع كلما اقتربنا من جذر المعنى وتعدد التأويل.
في كتاب "النص وسؤال الحقيقة" للمفكر ماجد الغرباوي
تنبثق "الكلمة الأولى" من رحم الحاجة الفكرية الملحّة إلى إعادة النظر في مرجعيات الفكر الديني، لتكون بمنزلة المدخل التأملي والصرخة الأولية التي يطلقها الكاتب في وجه التراث المغلق، والإجابات الجاهزة، واليقينيات المهترئة. إنها نص تأسيسي، لا يكتفي بالتمهيد لموضوع الكتاب، بل يضع القارئ أمام مرآة الذات المتورطة في خيوط المعنى الموروث، ليبدأ رحلة نزع الأقنعة عن النصوص وسؤال حقيقتها.
يختار الكاتب ماجد الغرباوي أن يبدأ بلغة عالية النبرة، موشّاة بشحنات وجدانية وعقلانية متداخلة، فيقول:
"لا أحد فوق النقد.. لا مقدس إلا الحقيقة."
بهذا التصريح القاطع، يفتتح الكاتب خطابه في وجه الثوابت. فاللغة هنا ليست وصفًا، بل مقاومة. البلاغة تتجلّى في التكثيف، وفي التوازي الإيقاعي بين "لا أحد" و "لا مقدس"، حيث تتكسّر السلطات ويُعاد تشكيل المشهد الذهني.
المقدمة لا تكتفي بتقديم أطروحة الكتاب فقط، بل هدم البنى الذهنية التي اعتادت استهلاك النصوص دون مساءلتها. الغرباوي لا يخاطب القارئ العابر، بل يستدعي القارئ المفكّر، المتأهب لخلخلة التصورات الساكنة، ويعلن أن النص ليس نهاية المعنى بل بدايته؛ والنقد ليس عداء، بل استنطاق، ومساءلة جذور المعنى.
وفي حديثه عن النص كحقيقة متحولة، يعمد الكاتب إلى توظيف لغة تجمع بين الصرامة الفكرية والانسياب البياني، حيث يصف العلاقة بين النص والحقيقة بأنها علاقة تأويل لا تقرير. فاللغة عنده ليست وسيلة تواصل فقط، بل أداة تفكيك، وهذا ما يتجلى في قوله:
"لا نص يكتمل إلا بتأويل، ولا تأويل بريء من مؤولاته."
هنا تتداخل الفلسفة بالتأمل الديني، وفي مساءلة كل نص عن سلطته الخفية، وسياقه المنتج، والمرجع الذي يتكئ عليه. ويتلاقى هذا أيضًا مع نزعة نصر حامد أبو زيد في نزع القداسة عن النصوص التاريخية لصالح مقاربتها كبنى دلالية خاضعة لسياقاتها.
الرسائل الضمنية هنا عديدة ومركبة:
أولها، أن النصوص ليست معصومة، بل متورطة في التاريخ والسلطة.
وثانيها، أن القارئ هو منتج المعنى، وأن العلاقة بين النص والقارئ علاقة شد وجذب، لا تبعية وامتثال.
وثالثها، أن تحرير الدين من سلطة النصوص المغلقة يبدأ بتحرير الوعي من عبودية القراءة التقليدية.
تعكس المقدمة براعة الكاتب في فن التضمين والتكرار، حيث يعيد تدوير المفاهيم الكبرى (النص، الحقيقة، التأويل، السلطة) ضمن سياقات متعددة، لتتوالد دلالاتها لا في مضمونها فقط، بل في موسيقى خطابها. هذا الأسلوب يؤسس لحالة من الترنيم الفكري الذي يرسّخ المفاهيم في الذهن دون مباشرة أو إملاء.
ان أهمية هكذا نص في الفكر الديني التنويري تكمن في كونه مفتاحًا لوعي جديد لا يتعامل مع النصوص كأصنام ذهنية، بل ككائنات حيّة، قابلة للتأويل، بل للتمرد أحيانًا. والغرباوي، هنا، يكتب من عمق معاناة فكرية مع نصوص صارت تُستخدم أداة للسيطرة لا للتحرير، للسكون لا للانطلاق.
وفي زمان تتكالب فيه الأصوليات وتتغوّل فيه الخطابات السلفية، تبرز أهمية هذا النوع من الكتابات في إيقاظ العقل الجمعي من سباته الطويل، وتحريره من وطأة القُداسة المُصنّعة. فـ"كلمة أولى" ليست تمهيدًا تقنيًا، بل وثيقة تمرد، ومقدمة فكرية تنويرية تدعو القارئ إلى المشاركة لا التلقي، وإلى النقد لا الخضوع.
إنها افتتاحية لا تقف عند أبواب الكتاب، بل تفتح أبواب الذهن وتحرّض على المراجعة والتجاوز.
الفصل الأول: المفهوم والدلالات
بالنظر في الفصل الأول ـ المفهوم والدلالات ـ من الكتاب، نجد أنفسنا أمام نصّ نقدي تحليلي متين البنية، ثري المفاهيم، يشكّل أحد الأعمدة الأساسية في مشروع الغرباوي الفكري الهادف إلى تفكيك مرجعيات التفكير الديني ونزع هالة القداسة عن النصوص المتوارثة. هذا الفصل لا يُعدّ فقط مدخلًا لموضوع النص والخطاب، بل يمثّل بوابة لفهمٍ جديد قائم على الوعي، والتأمل، والمراجعة العقلانية للمفاهيم المغلّفة بالقداسة.
يبدأ الغرباوي بتحرير مفهوم "النص"، لا بوصفه مجرد وعاء لغوي، بل ككائن دلالي يحمل شبكة علاقات بين اللغة والسياق والمتلقي. يقول: "ما تعددت دلالاته بتعدد قراءاته وتأويلاته المحتملة"، مشيرًا بذلك إلى أن المعنى ليس ساكنًا في النص بل يتشكل بفعل القراءة.
يتوسل الكاتب في تحليله بأسلوب رصين، يجمع بين السلاسة والتكثيف البلاغي، ويستند إلى أدوات النقد المعرفي والمنهجي. يوضح أن "قداسة النص سلطة مصطنعة كرّستها القراءات الأحادية والتقاليد التأويلية المغلقة"، في إشارة صريحة إلى البُعد السلطوي الذي يتغذى من وهم القداسة
في هذا السياق، يكشف الغرباوي عن وعي نقديّ متقدّ، يعري فيه أُطر القداسة المسقطة على النصوص، ويبرز كيف أن النص لا يُولد مكتمل المعنى، بل يُعاد تشكيله بفعل القارئ: "النص لا يكتمل إلا بفعل القراءة، وهو قابل دوماً لإعادة التفسير والتأويل بحسب السياق"
هذا الموقف يتجاوز نقد التفسير التقليدي إلى إعادة توجيه البوصلة المعرفية نحو قراءة تعددية، حيث تصبح إعادة إنتاج المعنى "حقًا إنسانيًا مشروعًا، لا امتيازًا للمؤسسات الدينية". بل يذهب إلى تأكيد أن النص ليس بريئًا، بل محكوم بسياقات إنتاجه وتلقيه، وأن سلطته ليست ذاتية، بل مصطنعة.
ومن بين الرسائل الضمنية المهمة:
* أن سلطة النص هي سلطة تراكمية تأسست عبر التكرار والمرجعية.
* أن فهم النص ليس امتيازًا خاصًا بل ممارسة فكرية متاحة.
الغرباوي هنا لا يعيد قراءة النص فحسب، بل يعيد إنتاج شروط تلقيه، ويفتح الباب أمام تأويلات إنسانية أقرب إلى مقاصد الدين في التحرر لا التقييد. يقول: "القراءة الجديدة تبدأ من تفكيك البُنى العميقة للنص وتأمل خلفياته التاريخية والمعرفية
في زمن طغت فيه الخطابات السطحية والمقولات الجاهزة، يأتي هذا الفصل كمصباح معرفي، يضيء عتمة الخطاب الديني التقليدي، ويمنح القارئ أدوات للمساءلة الحرة. إنه دعوة لأن نقرأ، لا لنؤمن وحسب، بل لنفهم ونُسائل. وكما قال الغرباوي: "ليس ثمة أخطر من فهم مكرّس يعيد إنتاج الاستبداد باسم الدين، دون أن يطرح أسئلته الجوهرية".
الفصل الثاني: النص وحرية النقد
يشكّل هذا الفصل ركيزة معرفية ومنهجية في تفكيك العلاقة بين النص الديني وسلطة النقد. إنه ليس اجتهادًا في القراءة وحسب، بل مشروع تنويري يسعى إلى زحزحة المسلمات وتحطيم جدران القداسة التي حالت دون ممارسة العقل لحريته.
منذ البداية، يُعلن الغرباوي انحيازه للإنسان بوصفه مركز الفهم والتأويل، فيقول: "الإنسان هو مركز الفهم، ولا معنى لتفسير يتجاهل وجوده وتاريخه ووعيه"
يرى أن حرية النقد ليست ترفًا بل ضرورة: "ليس النقد ترفاً فكرياً، بل ضرورة لاستعادة العقل من سطوة القداسة، وتمكينه من ممارسة فهمٍ واعٍ للنص"
. كما يرسّخ فكرة أن "قداسة النص لا تُلغي بشريّة الفهم"، وهو ما يعني أن سلطة الفهم ليست مطلقة بل تاريخية ومشروطة.
في معالجة ثنائية "النص / القارئ"، يوضح أن المعنى لا يُستخرج من النص فقط، بل يُولد في تفاعل جدلي بين النص وسياق القراءة. لذا يؤكد: "النص يبقى نصاً، لكنّ فهمه يظل رهين الإنسان وتاريخه وسياقاته المختلفة"
كما يحذر من خطر احتكار المعنى، فيقول: "لا يوجد فهمٌ نهائيّ للنص، لأن القراءة نفسها هي عملية تأويل متجددة مشروطة بالسياق"
يعتبر هذا الفصل إنتاج قطيعة معرفية مع التقليد، من أجل بناء خطاب ديني جديد يعيد الاعتبار للعقل ويفتح المجال أمام وعي نقدي يرفض الخضوع الأعمى. ويؤكد: "التحرر من سلطة التراث لا يكون إلا بوعي نقدي يعيد للعقل مكانته في فهم النص وتأويله".
إنه فصلٌ يُعيد الاعتبار للنقد بوصفه أداة تحرر، لا خصمًا للدين، ويفتح أفقًا لفهم الدين كمنظومة إنسانية قابلة للنقاش. وحين ترتفع الأصوات التكفيرية وتقمع الحريات باسم الدين، تصبح هذه الكتابات بمثابة مقاومة فكرية، وشعلة تُنير عتمة الاستبداد الرمزي والروحي.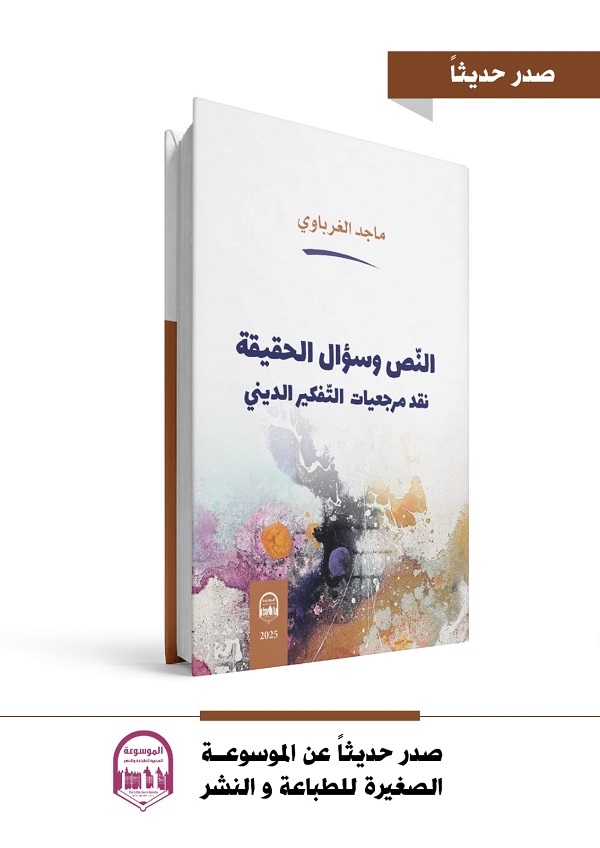
الفصل الثالث: النص وخطابات النفي
في رحاب الفكر النقدي والاشتغال المعرفي العميق، يقف القارئ أمام الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء تحت عنوان "النص وخطابات النفي"، وكأنه أمام مرآة كاشفة تنقض الغشاوة عن مسلّمات رسختها التقاليد الدينية، وتسلّط الضوء على زيف التقديس المطلق للنصوص، حين تُوظَّف في إطار سلطوي يُقصي ويُخوِّن ويُجهّز على المختلف.
يشير الغرباوي صراحة إلى أن "خطابات النفي تُكرّس نوعاً من القطيعة بين الذات والآخر، وتُنتج وعياً متعالياً يُقصي كل مختلف"، وهو ما يكشفه بقوة في تحليله للمنظومة الفقهية التي احتكرت المعنى وجعلت من النصوص أدوات إدانة وإقصاء
يتناول الكاتب ظاهرة خطابات النفي داخل الفكر الديني بوصفها آليات لفرض الهيمنة، من خلال مفاهيم مثل "الفرقة الناجية" و"الضلالة" و"البدعة" و"حد الردة"، ويكشف أن "النفي لا يقتصر على الإقصاء الرمزي، بل يشرعن الإبادة المعنوية، عندما يتم توصيف الآخر بـ 'البدعة' أو 'الضلالة'"
ويُظهر بجلاء كيف تم تطويع النص لخدمة الرؤية الأحادية، وتحويل التأويل إلى أداة استبعاد: "أُعيد إنتاج مقولة 'الفرقة الناجية' لتكون أداة تفوق ديني تبرر إقصاء المختلف وتشريع العنف باسمه".
بلغة بلاغية وأسلوب فلسفي، يكتب الغرباوي نصه بوصفه فعل مقاومة معرفية لا تكتفي برصد ظواهر الخطاب الإقصائي، بل تسعى لتفكيك بنيته، وإعادة الاعتبار إلى إمكانات التأويل التحرري. "النقد فعل مقاومة عندما يستهدف البُنى المغلقة التي تصادر المعنى باسم المقدّس"، هكذا يُعلن موقعه الصريح في وجه المقولات الجاهزة.
ويشير كذلك إلى أن تفكيك بنية خطاب النفي هو بداية ضرورية لتحرير الدين من قبضة التوظيف السياسي والمذهبي، إذ يكتب: "القداسة لا تعني العصمة، وكل خطاب يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة باسم النص يستحق التفكيك والمساءلة".
أما الرسائل العميقة التي تترشح من هذا الفصل، فمن أبرزها:
* أن النصوص ليست مطلقة بل مشروطة بسياقاتها.
* أن التقديس حين يتحول إلى تكميم للفهم يصبح خصمًا للدين لا خادمًا له.
* أن حق الإنسان في التأويل لا يُنتزع باسم الوحدة أو الجماعة أو الفرقة.
ويطرح تساؤلاً وجوديًا ذكيًا: هل نملك النص أم هو يملكنا؟ هل نؤوّل النص أم نُؤوَّل به؟ ليردف قائلاً: "الخطير في النصوص ليس مضمونها، بل كيف تُفهم وتُوظّف. فالنصوص بريئة، لكن التفسير هو الذي يقتل"
الفصل الرابع: الحقيقة والنص
في زمنٍ تتكالب فيه الظنون على يقين النص، يبرز الفصل الرابع من الكتاب "الحقيقة والنص" كصرخة فكرية ضد التلقين، ومحاولة جريئة لتحرير الحقيقة من أسر الحرف. يبين فيه الغرباوي أن "ليس النص سلطة بذاته، بل بما يُحمّل به من دلالات ومقاصد تسوّغ فرض الحقيقة وتكميم الفهم".
يذهب الكاتب إلى أن الحقيقة ليست مُعطىً بل بناءٌ تأويلي يتشكّل ضمن علاقة القارئ بالنص، متأثرًا بثقافته وموقعه المعرفي. يقول: "كلّ تأويل هو إفراز لموقع القارئ ضمن بنية السلطة المعرفية، وليس معزولًا عن خلفياته الأيديولوجية".
يعمد الغرباوي إلى نقد التراث التفسيري الذي أحال النصوص إلى أنظمة مغلقة، ويؤكد أن "المسلمات التراثية ليست معايير نهائية للفهم، بل مقولات تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل نقدي"، داعيًا إلى تفكيكها بوصفها أدوات سلطة لا أدوات فهم.
في هذا الفصل، اللغة ليست محايدة، بل وسيط مشحون، وهو يوضح أن: "اللغة تُمارس دورًا تأسيسيًا في صياغة المعنى، لكنها ليست محايدة، بل مشروطة بثقافة التأويل وقيمه.
وتتبدّى الرسائل الضمنية في جملة من الأفكار الجوهرية:
ـ أن المعرفة الدينية ليست بريئة، بل مؤدلجة.
ـ أن التقديس للتفاسير هو نتاج سلطة لا نص.
ـ أن مشروع التنوير يبدأ من مساءلة المفاهيم لا تكرار الشعارات.
يكتب الغرباوي أخيرًا، مؤكدًا دور الناقد: "لا حياد في المعرفة الدينية، لأن خلفها دائمًا نوايا سلطوية، حتى عندما تدّعي الموضوعية".
هذا الفصل لا يقدم تأملًا نظريًا مجردًا، بل يشارك في معركة الوعي، ويسعى إلى تفكيك احتكار الحقيقة وفتح أفق جديد لفهم النصوص ضمن سياقها وتاريخها ومسؤوليتها الإنسانية.
الفصل الخامس: المهيمن الرمزي
في قلب الكتاب، يقف الفصل الخامس الموسوم بـ „المهيمن الرمزي" كعتبة فكرية كثيفة، تنبض بقلق معرفي وسعي تأويلي لتفكيك بنية الخطاب الديني وهيمنة رموزه على الذهن الجمعي. بأسلوب أدبي يتماهى مع جرس الفلسفة وحرارة السؤال، يقتحم ماجد الغرباوي منطقة شائكة، تتراءى فيها السلطة بلبوس المقدس، حيث "السلطة الرمزية تستمد فاعليتها من قداستها، التي تفرض التسليم والانقياد، فتغدو مصدراً للشرعية دون الحاجة إلى تبرير عقلاني".
في هذا الفضاء المتشابك، لا يعود الرمز مجرد إشارة لغوية، بل يصبح أداة هيمنة ثقافية. فالغرباوي يرى أن "المهيمن الرمزي فعلية إيديولوجية، ذات طابع مركب، تتجسد عبر سلسلة من الرموز والمفاهيم والمعتقدات، وتكتسب طابعها القدسي من خلال ربطها بالمطلق أو بما هو ميتافيزيقي، فتغدو ذات سلطة فوقية، تفرض قداستها على وعي الفرد والمجتمع". هنا، يتحول النص من خطاب إلى سلطة، ومن معنى إلى توجيه سلوكي وفكري.
يكتب الغرباوي بلغة لا تُشبه مداد السرد المعتاد، بل يغوص في عمق النصوص بوصفها منظومات رمزية تستوطن الوعي وتعيد تشكيله من حيث لا يشعر. وهو إذ يتناول "المهيمن الرمزي"، لا يراه حالة طارئة أو عارضة، بل بنية منتظمة من الهيمنة المعرفية، تتغلغل في التاريخ والفقه والاجتماع الديني، وتُكرّس حضورها بوصفها "حقائق" غير قابلة للمساءلة. لذلك، يحذّر من خطورته قائلاً: "تكمن خطورة المهيمن الرمزي في تحصينه ضد النقد، حيث يُقدّم كحقيقة مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويُعامل ككلام مقدّس، رغم بشريته وأيديولوجيته".
ويبلغ التشخيص ذروته حين يتتبع الغرباوي أثر الرموز العليا، كالإمام المعصوم أو المجتهد، بوصفهم وسطاء للقداسة وممثلين عن "النصّ الآخر" غير القابل للتفكيك، إذ يؤكد أن "عندما يتحول الرمز الديني –كالمجتهد أو الإمام المعصوم– إلى ناطق أو وكيل حصري عن الحقيقة، يصبح مرجعية نهائية، ويكتسب سلطة رمزية تتجاوز العقل والتاريخ".
في ضوء هذا كله، يتجلى الغرض الجوهري من كتابة هذا الفصل: كسر الطوق المضروب حول النص الديني، ونقله من دائرة القداسة المغلقة إلى فضاء النقد والتاريخ والتعددية المعرفية. يقول الغرباوي بوضوح: "نقد المهيمن الرمزي هو خطوة أولى لتحرير النص من قبضة الإيديولوجيا، وإعادته إلى فضاء التداول البشري، حيث يمكن مساءلته وفهمه ضمن سياقه الزمني والثقافي"
الرسائل الضمنية التي يحملها هذا الفصل تتعدد، لكنها تلتقي عند هدف واحد: تفكيك "المقدّس المصنّع" واستعادة حق العقل في التفسير. يريد الكاتب أن ينقلنا من عبودية الرمز إلى حرية الفهم، من سطوة "النص-الإله" إلى مسؤولية "القارئ-الإنسان". إن الرمز الديني، حين يتحول إلى أداة هيمنة، يصير خطرًا لا على الدين فحسب، بل على وجود الإنسان بوصفه كائنًا مفكرًا.
ولعل أجمل ما في هذا الفصل أنه لا يكتفي بالنقد، بل يفتح نوافذ الخلاص؛ فهو يؤمن أن التحرر من "المهيمن الرمزي" لا يعني الانفلات من الدين، بل تحرير الدين من أغلال التأويل السلطوي. وهو بذلك يساهم في مشروع إنساني كبير، يعيد للدين بعده الأخلاقي ويُنقذه من كونه "خطاب سيطرة".
في زمن تتكاثر فيه الأصوات الشعبوية، وتتصاعد فيه نداءات الغلو، تأتي مثل هذه الدراسات الجادة كصوت العقل في صحراء الصراخ. إن أهمية هذا الفصل، بل الكتاب كله، تتجلى في سعيه الدؤوب لنشر الوعي، لا بوصفه ترفًا ثقافيًا، بل شرطًا وجوديًا لإنسان جديد، حر، عاقل، ومسؤول.
الفصل السادس: بين الفكر الطقوسي ووعي الذات – قراءة في فلسفة الطقوس
في هذا الفصل الفريد، يعمد المفكر التنويري ماجد الغرباوي إلى اقتفاء أثر الطقوس الدينية لا بوصفها شعائر عابرة أو موروثات محفوظة، بل بوصفها نظامًا دقيقًا من الدلالات والمضمرات، يتجاوز حدود الشكل الظاهري ليغور في عمق البنية المعرفية للعقيدة والمجتمع. الفصل السادس من "النص وسؤال الحقيقة" هو بيان فلسفي، معرفي، وتحليلي يواجه الطقوس الدينية ليس بنية النفي، بل بنية التفكيك، سعياً إلى تحرير الإيمان من سلطة الطقس، وتحرير الطقس من قيد القداسة المتكلسة.
الغاية من الفصل هي مساءلة الطقوس باعتبارها أداةً للضبط الاجتماعي والترويض النفسي، لا مجرد تمظهر تعبّدي. يرى الغرباوي أن الطقوس لا تُنتج بالضرورة إيمانًا عميقًا، بل قد تُستثمر – بل تُخترع – لتكريس مركزية السلطة، سواء كانت سلطة الفقيه أو المرجع أو الجماعة. لذا، فهو يسعى إلى فرز البُعد الروحي الأصيل عن الأطر الشكلية التي تمتص الوعي، وتُحيله إلى مكرورٍ لا يفكر، بل يكرر.
الكاتب يتتبع مفاصل الخضوع الطقوسي بوصفها نمطًا من الاستلاب الموجه، يُبقي الفرد داخل دوائر مغلقة من التأويل المسدود، والارتباط العاطفي المشحون بالخوف والرجاء، دون أن يُتاح له تأمل جوهر العلاقة بينه وبين المقدّس. فالطقوس، كما يحللها، تُنتج "إلهًا" مُقنّنًا، مسجونًا في تكرارات حركية، تُراد لها أن تُصبح "هوية" لا "وسيلة"، و"غاية" لا "سبيلًا".
الرسالة الضمنية هنا هي دعوة لتحرير الإيمان من الوسائط الثقيلة: إلى وعيٍ متجاوز، يتلمّس الله في معناه لا في جسده الرمزي. الغرباوي يُعيد الاعتبار إلى العقل التأويلي المتحرر، ويدعو إلى أنسنة العلاقة مع الدين، لا تأليه العلاقة مع الطقس.
من الناحية الأسلوبية، يغترف الكاتب من معين الفلسفة النقدية الحديثة، وهو متأثر بخطاب التفكيك كما عند دريدا، ومنهجية الشك المعرفي كما عند فويرباخ وماركس، في قراءته للطقوس كتمظهر اجتماعي – سياسي، لا كمجرد واجب تعبّدي. غير أن تأثيره الأبرز يبدو في عمق تأثره بمحمد أركون، في خلخلة المفاهيم المستقرة وهدم ما يسميه "الأنساق الدوغمائية المغلقة". أما لغته فهي مزيج من الوضوح الإجرائي والتحليل التأويلي، لا يخلو من طابع أدبي حين يتناول الطقوس بوصفها "لغة جسد جماعي"، و"ترجمة خوف وجودي".
من حيث البلاغة، ينهل النص من طاقة التكرار الدلالي، والإيقاع الفكري الحجاجي، ليُرسّخ رؤية مناهضة للاعتقاد الساذج بأن الدين طقس، وأن الطقس جوهر. فالعلاقة التي يبتنيها مع القارئ هي علاقة تفاعل وجدلي، لا تلقين أو ترهيب. يُفتح الباب أمام التساؤل: "هل نؤدي الطقوس لنُعبر عن الإيمان، أم أننا نُنتج الإيمان بالطقوس؟".
هذا الفصل يحوي أهمية بالغة في حقل الدراسات الدينية الحديثة، لكونه يُزيح النقاب عن مؤسسة الطقوس بوصفها منظومة رمزية قابلة للتأويل والنقد، لا موضوعًا فوق النقد. كما أنه يُنبه إلى خطورة تحويلها إلى أدوات تطويع وتبرير لسلطة دينية – سياسية، تَمنع المجتمعات من الارتقاء نحو إيمان حر، وفكر مسؤول.
في زمن تتفكك فيه الحدود بين الدين والتديّن، بين الإيمان والعادة، تأتي هذه الرؤية لتؤسس لوعي نقدي، يكون الطقس فيه معبرًا روحيًا لا سجنًا عقليًا. وهنا تتجلى أهمية هذا الطرح في وقتنا الراهن، إذ لا خلاص من التشدد والجمود إلا بالعودة إلى جوهر الدين، لا إلى شكله؛ إلى معناه المتعالي، لا إلى تمثلاته التاريخية المقيدة.
إن الفصل السادس من هذا الكتاب ليس مجرد دراسة لظاهرة دينية، بل هو بيان تحرري، يوقظ الوعي من سباته الطقوسي، ويدعو إلى علاقة صوفية مع الدين، عبر نفي القداسة عن الوسائط الشكلية، وإعادة توجيه العقل إلى سؤال الحقيقة: أين الله من كل هذا التكرار؟
الفصل السابع: أدلجة الخطباء
في الفصل السابع المعنون بـ«أدلجة الخطباء» من كتاب "النص وسؤال الحقيقة" للمفكر ماجد الغرباوي، تمتد الصفحات لتشكّل قراءة جريئة ومعمقة في واحدة من أعقد إشكاليات الخطاب الديني المعاصر: تحوّل المنبر من وسيلة لتبليغ الدين إلى أداة أيديولوجية، لا تكتفي بإيصال المفاهيم بل تصنعها، وتخدم سلطة ما، سواء أكانت سياسية، مذهبية، أو ثقافية.
إن هذا الفصل لا يُقرأ بوصفه دراسة في أداء الخطباء فحسب، بل بوصفه محاولة لتفكيك منظومة خطابية تهيمن على الوعي الجمعي في الفضاء الديني. يفتتح الغرباوي تحليله بتساؤل مفصلي: كيف انتقل الخطيب من ناقل إلى مؤدلِج، ومن واعظ إلى صانع وعي مأزوم، مغلق، يعيد إنتاج نفسه بمنطق التكرار لا بمنطق التجديد؟ وهو لا يكتفي بطرح السؤال، بل يتوغّل في الطبقات العميقة للنصوص والممارسات التي تصنع هذا الخطاب.
يؤكد الغرباوي أن "الخطيب المؤدلَج لا ينقل الحقيقة، بل يُنتجها وفق مقتضيات موقعه المرجعي والسياسي"، وهو ما يؤدي إلى ما يسميه بـ"تدجين الوعي"، حين يُصبح المتلقي مشاركًا غير واعٍ في تزوير وعيه، متلقّيًا الخطاب المؤدلج بوصفه تجليًا للحقيقة المطلقة.
الكاتب في هذا الفصل لا يُهاجم الأشخاص بل البنية، ويكشف أن "المؤسسة المنبرية باتت، في كثير من الأحيان، جهازًا أيديولوجيًا يبرر، يُطوِّع، ويؤدلج باسم النص والدين". فالخطيب الذي يُقدَّم كنموذج ديني، ما هو في الغالب إلا مفسّر مذهبي، يُعيد إنتاج رؤية مذهبية ضيقة باسم الشريعة، وهو بذلك يُحوّل المنبر إلى أداة سلطة، لا وسيلة وعي.
ويكتب الغرباوي بلغة نقدية تأملية، ممزوجة بنَفَس أدبي وفلسفي، تجعل هذا الفصل أقرب إلى النص المقاوم. يقول: "لا يمكن لتحرير العقل أن يتم من دون تحرير الخطاب من أُسسه الأيديولوجية، ولا بدّ من زلزلة المؤسسة المنبرية لكسر طابو القداسة الذي يحيط بها"
أهمية هذا الفصل تنبع من جرأته في طرح الأسئلة التي لطالما اعتُبرت خارج المألوف: ما دور المنبر؟ هل هو مساحة وعي أم جهاز أيديولوجي؟ وهل يمكن أن يكون أداة تحرر لا تقييد؟ في هذه الأسئلة يكمن جوهر النقد، وفيها تتجلّى الرسالة العميقة: أن كل سلطة غير مفككة، حتى ولو لبست ثوب القداسة، هي سلطة قمعية بالضرورة.
الكاتب لا يكتفي بالتشخيص، بل يُقدّم رؤية للخروج: وعي نقدي يمارس التأمل بدل التلقّي، ويخترق ظاهر الخطاب إلى بنيته المضمرة. وهنا تتكثف أهمية هذا الطرح في زمن تتكاثر فيه الأصوات الشعبوية ويُستغل فيه الدين لتكريس الجهل، فيتحول الفصل إلى صرخة فكرية، ومطلب وجودي بتحرير الإنسان من عبودية النصوص المؤدلجة.
"الخطيب لا يُفترض أن يكون ناطقًا باسم المقدّس، بل محاورًا له"، بهذه العبارة يختتم الغرباوي تقريبًا ملامح مشروعه في هذا الفصل: استعادة الإنسان في مواجهة النص، واستعادة الوعي في وجه التلقين.
إن هذا النوع من الكتابات لا يسعى إلى الهدم، بل إلى التأسيس: تأسيس وعي جديد بالخطاب الديني، وفتح نافذة نحو أفق عقلاني، لا يلغي الإيمان، بل يسمو به، ويجعله اختيارًا حرًا لا فرضًا قسريًا.
الفصل الثامن: الفتوى وسلطة الفقيه
في هذا الفصل العميق من كتابه، يغور المفكر ماجد الغرباوي في دهاليز العلاقة الملتبسة بين النص الديني وفتاوى الفقهاء، سابرًا أغوار التأويل وأدلجة الخطاب، كاشفًا عن تشوهات تراكمية لحقت بالخطاب الديني جراء سلطة الفتوى، وسطوة المرجعية، وتغوّل العقل الأيديولوجي على العقل التأويلي الحر.
يشكّل هذا الفصل مقاربة نقدية جريئة وعميقة لمفهوم "الفتوى" وآليات إنتاجها، في سياقاتها السياسية والفقهية. لا يكتفي الغرباوي بتشخيص الأزمة، بل ينفذ إلى الجذر: إلى تواطؤ الفقه مع السلطة، حيث تصبح الفتوى أداة لضبط السلوك الجمعي، لا لفهم النص. ويطرح تساؤلات حارقة: هل الفتوى كاشفة عن حكم الله، أم منتَج ثقافي مشروط بالسياق؟ وهل يجوز لمفاهيم الأمس أن تُسقط على واقع اليوم؟
يعيد الغرباوي الاعتبار للنص بوصفه كينونة حية، لا جامدة، ويكشف عن زيف الادّعاء بأن الفتوى تجسيد لحكم الله، في حين أنها اجتهاد تاريخي نابع من واقع خاص. ينتقد مركزية الفقيه بوصفه المفسر الأوحد، ويقترح إعادة توزيع سلطة التأويل، مؤكداً أن "أنسنة النص" هي السبيل لفك الاشتباك بين المقدس والبشري.
يكتب: "الفتوى تعبير عن وعي فقيه مشروط بزمانه، لا تجلٍّ لحقيقة مطلقة"، وهذه الرسالة تعكس موقفًا نقديًا من الخطاب الفقهي الذي احتكر حق الفهم والإفتاء.
أسلوب الغرباوي في هذا الفصل مشحون بطاقة لغوية، تجمع بين البيان والبرهان، وتستلهم تقنيات التفكيك الفلسفي. تتجلى تأثيرات أركون ونصر أبو زيد في الطرح، كما يحضر نَفَس ميشيل فوكو في تعرية البنى التحتية للخطاب الفقهي، خاصة حين يشير إلى أن السلطة تتجلى عبر الفتوى، لا عبر النص مباشرة.
في عالم إسلامي غارق في استقطابات أيديولوجية، يُعد هذا الفصل صيحة عقلانية تدعو إلى الانتقال من "سلطة الفتوى" إلى "سلطة العقل". الفتوى، كما يكشف الغرباوي، ليست خطابًا معرفيًا فقط، بل أداة لضبط اجتماعي وتكريس للتراتبية الرمزية، وللعنف الرمزي باسم الدين.
يقول: "نقد الفتوى ليس مساسًا بالمقدس، بل تحرير له من قبضة المؤسّسة"، مؤكداً أن تحرير النص هو الخطوة الأولى نحو تحرير الإنسان.
يمثل هذا الفصل محطة فارقة في مشروع الغرباوي الفكري، الذي يسعى إلى "عقلنة النص"، و"تفكيك السلطة"، و"تحرير الإنسان". إنه خطاب ينشد قراءة جديدة للدين، لا تخاف النقد، بل تراه أداة للنهضة.
بلغة جزلة، وأسئلة مؤرّقة، يمضي بنا الغرباوي في مشروعه، ناثرًا بذور الوعي في أرض طال سباتها، مؤمنًا أن لا خلاص دون نقد، ولا نقد دون حرية.
الفصل التاسع: النص وميثولوجيا التراث
في الفصل التاسع من كتاب "النص وسؤال الحقيقة"، والمعنون بـ"النص وميثولوجيا التراث"، تتجلى قدرة الغرباوي على الغوص في أعماق الفكر التقليدي لتفكيك آلياته ونزع القداسة عن الموروث العقائدي الذي نُسج حوله خطاب أسطوري مغلق، أقرب إلى المثيولوجيا منه إلى منهج نقدي عقلاني.
يدور هذا الفصل حول نقد "التأليه الرمزي" للنصوص، حيث يبيّن الكاتب أن التفاعل مع التراث تم بعيدًا عن العقل، وأسرَ خيال الجماعة بأساطير تحوّلت إلى ثوابت مقدسة. لقد أُعيد إنتاج هذا التراث بوصفه معيارًا للحقيقة، لا بوصفه نتاجًا تاريخيًا.
الغرض من الفصل هو زعزعة تلك الأساطير وطرح رؤية معرفية ترى أن النصوص ليست معصومة عن التأويلات البشرية المشروطة بالواقع. يكتب الغرباوي: "ما نراه تراثًا مقدسًا هو، في جوهره، تعبير عن صراعات بشرية صيغت ضمن أطر سلطوية".
اهم رسائل الفصل الضمنية:
ـ قداسة النص لا تعني تعطيل العقل.
ـ الماضي ليس مرجعًا مطلقًا.
ـ التراث قابل للنقد لأنه منتَج بشري.
بلاغيًا، يتداخل الفكر الفلسفي مع النقد التاريخي، وتتشابك اللغة العقلانية مع الإيقاع الأدبي. الكاتب لا يكتفي بتفكيك المثيولوجيا، بل يشحن النص بطاقة رمزية توقظ الوعي، وتحفز القارئ على التحرر من الخطاب التلقيني.
في ظل تصاعد الخطابات الدينية المتطرفة، تبرز أهمية هذا الفصل بوصفه نموذجًا للاهوت نقدي، يُعلي من شأن العقل، ويعيد الاعتبار للإنسان كمفسر فاعل.
إنه فصل لا يُقرأ فقط، بل يُمارس كموقف فكري، ودعوة إلى ثورة عقلية تبدأ من تحرير النص وتنتهي بتحرير الإنسان من عبودية الماضي. كما قال الغرباوي: "لا خلاص إلا بالعقل... ولا عقل في ظل الأسطورة".
الفصل العاشر: النص وشرعية السلطة
في هذا الفصل، يتوغّل ماجد الغرباوي في أعمق مواضع التوتر بين النص الديني وتأسيس السلطة، مشهرًا مشرط النقد في وجه البنية التراثية التي طالما استندت إلى قداسة النص لتبرير أشكال من الهيمنة السياسية والدينية. فليس الحديث هنا عن "نص" في معناه البريء، بل عن نص تحوّل إلى سلطة رمزية متعالية، تمت أسطرته وتثبيته في خدمة السلطة الزمنية.
يكتب الغرباوي، في تحليل يكاد يكون جراحيًا:
"النصوص ليست هي من أسّست السلطة، بل طرائق قراءتها وتأويلها، ومن يقف خلف هذا التأويل".
يطرح المؤلف تساؤلات جوهرية تفكك العلاقة بين النص والمؤوّل والسلطة:
ـ من يملك حق التأويل؟
ـ كيف تتحول القراءة إلى أداة للقهر باسم الحقيقة؟
ـ وأين موقع الإنسان من هذا الصراع الثلاثي بين النص، والسلطة، والعقل؟
تتمركز أطروحته حول تفكيك مقولة "الحاكمية"، التي يعتبرها تمظهرًا لاحتكار التأويل واحتكار تمثيل الإرادة الإلهية في آن. وهي في جوهرها ـ كما يبرهن ـ تعبير عن تسييس النص، لا عن روح النص الأصيلة.
إن الغرض من هذا الفصل لا يتوقف عند حدود النقد النظري بل يتجاوزه إلى بلورة مشروع تحرري. مشروع يعيد الاعتبار للعقل والضمير الإنساني، في مواجهة سلطة المؤسّسة الدينية التي كثيرًا ما نصّبت ذاتها وصية على السماء، عبر تأويل نصوصها. يكتب:
"السلطة لا تستمد شرعيتها من ذات النص، بل من آليات توظيفه وإخضاعه لرؤية المؤوِّل".
ومن الرسائل الضمنية المضمَّنة في ثنايا الفصل، أن:
"النص كما يُقرأ، لا كما هو؛ والتأويل سلطة، ومن يهيمن على التأويل يهيمن على الإنسان".
وهذا ما يجعل هذا الفصل ليس بحثًا أكاديميًا فحسب، بل مرافعة عقلانية ضد الاستبداد المقنَّع بالدين. مرافعة تنحاز للحرية الفكرية، وترفض اختزال النصوص في قراءات سلطوية تعسفية.
الفصل الحادي عشر: النص ومراوغات المفهوم
في فصل "النص ومراوغات المفهوم" ينتقل الغرباوي من تحليل بنية السلطة إلى تشريح أداة السلطة: المفهوم. هنا، لا يُطرح المفهوم كأداة لغوية أو إصطلاحية فحسب، بل كبنية سلطوية قابلة للتوظيف والتلاعب.
يفتتح الفصل بملاحظة صادمة:
"ليس كل مفهوم ديني بريء من التوظيف السياسي أو الأيديولوجي".
يشير إلى أن المفاهيم ليست جاهزة في النصوص، بل تُنتج ضمن سياقات محددة، وغالبًا ما تكون مشروطة بمصالح سلطوية. إنها كائنات دلالية مراوغة، تتسلل عبر الفهم، وتُشكّل الإدراك الديني والاجتماعي. يكتب:
"المفهوم يُختزل ثم يُوظف، ويُعزل عن حواضنه ليكون طيعًا في يد السلطة".
الغرباوي لا يكتفي بتفكيك المفاهيم، بل يسائل الآليات التي جعلتها مقدسة ومحصنة ضد النقد، كاشفًا عن أزمة القراءة في الفكر الديني التراثي، التي تعتمد على "القراءة التقديسية" مقابل ما يسميه بـ"القراءة النقدية التاريخية".
في إحدى مقاطعه الفلسفية العميقة، يقول:
"لا توجد قراءة محايدة، فكل قراءة هي إعادة إنتاج للنص ضمن أفق معرفي معين، يحمل داخله سلطة التأويل وسلطة المُفسِّر".
هذا القول يقلب أطروحات التقليد رأسًا على عقب، إذ يُبرز فعل القراءة لا كعملية سلبية، بل كممارسة سلطوية أو تحررية بحسب نية القارئ وأفقه.
ومن هنا، فإن القيمة الفعلية لهذا الفصل تكمن في كونه ليس نقدًا للمفاهيم فحسب، بل نقدًا للبنية الذهنية التي تنتجها وتعيد إنتاجها. وهي بنية تميل إلى الثبات والتقديس وتخشى التحول والتاريخ.
الفصل ـ كما هو شأن الكتاب كله ـ يمثل التزامًا معرفيًا وأخلاقيًا نحو إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والنص، بين الفهم والتسلّط، بين المعرفة والهيمنة. إنه يقول للقارئ بوضوح:
حرّر نفسك من سطوة المفهوم، تحرر من سطوة النص المؤدلج، وافتح أفق المعنى لما فيه خير الإنسان لا قهره.
النص وخطاب المعارضة: قراءة فلسفية في الفصل الثاني عشر
في الفصل الثاني عشر من الكتاب، نقف أمام معالجة فلسفية تحليلية جريئة لمفهوم "النص وخطاب المعارضة"، حيث لا يتردد الكاتب في اقتحام المناطق المحظورة فكريًا، مفككًا علاقة النص بالسلطة والمعارضة من منظور يتجاوز التلقين التراثي، نحو مساءلة معرفية متجذّرة في سؤال الحقيقة.
يبدأ الغرباوي من سؤالٍ محوري:
"هل أن النصوص الدينية كانت مرجعية مقاومة أم وسيلة لإعادة إنتاج الخطاب السلطوي؟"
ثم يجيب بنَفَس ناقد:
"قد تستعين المعارضة السياسية بنصوص دينية لتبرير موقفها، لكنها في حقيقة الأمر تساهم في تكريس البنية الرمزية التي تقوم عليها شرعية السلطة."
هنا تنكشف الحيل البلاغية التي استعملتها بعض حركات المعارضة عبر تأويل النصوص بما يخدم مشروعها السياسي، متوشحة بـ"الشرعية الإلهية" أو "التمثيل النبوي".
يُظهر الكاتب أن العلاقة بين النص والمعارضة ليست بالضرورة علاقة تحرر، بل قد تكون علاقة إعادة إنتاج للسلطة، لكن من موقع مختلف. يقول الغرباوي:
"ليست كل معارضة بالضرورة تنويرية، كما أن التمرد لا يعني التحرر... فغالبًا ما يعيد المتمرد إنتاج بنية القمع."
كما يعرض نماذج تاريخية حاسمة – مثل خطابات الزبير وابن الزبير، وأهل الكوفة، والخوارج – ليؤكد أن هذه الجماعات لم تُنتج خطابًا بديلًا فعليًا، بل اعتمدت النصوص نفسها التي شرعنت السلطة، مكتفية بتغيير زاوية الرؤية وسياق التوظيف.
من هنا، ينبثق التحليل نحو كشف التواطؤ الضمني بين النص والتأويل، حيث يُصبح النص أداةً أيديولوجية يُعاد تشكيلها بحسب موقع المتحدث:
"إن النصوص صالحة لأن تكون مصدر شرعية لأكثر من طرف، ما لم نضع آليات دقيقة في تأويلها."
أما بلاغة هذا الفصل، فتتجلى في لغته الفخمة، وأسلوبه الذي ينوس بين التوتر المعرفي والتكثيف الرمزي، إذ تنبني الفقرات على جدلية السؤال والشك، لا على التقريرية الجاهزة، ما يُضفي على النص بعدًا فلسفيًا تأمليًا عميقًا.
ولعلّ الرسالة الضمنية الأهم في هذا الفصل، كما يمكن استنتاجها من سياق الطرح، هي دعوة إلى تحرير العقل العربي من ثنائية السلطة والمعارضة كمطلقين. إذ كلا الطرفين – بحسب الغرباوي – يمكن أن يتلبّسا بلبوس النص لتبرير غاياتهما، لكن ما يميز الموقف النقدي الحقيقي هو مساءلة الطرفين، لا التماهي مع أحدهما باسم "النص" أو "الحق".
الفصل الثالث عشر: التنظير والمعارضة
يمضي الفصل الثالث عشر في تتبع الجدل المعرفي العميق بين "التنظير والمعارضة"، حيث يفكك الكاتب البنية المعرفية للخطابات المعارضة. يؤكد أن هذه الخطابات لم تكن دومًا "ردات فعل"، بل كانت غالبًا مشاريع معرفية تحمل منظوماتها التأويلية الخاصة، وإن اتخذت شكل المعارضة السياسية.
يقول الغرباوي:
"إن المعارضة الدينية لم تكن هامشًا على السلطة، بل كانت في كثير من الأحيان صراعًا على تأويل الحقيقة."
ويُبرز بذلك خطورة تحويل النص إلى أداة في الصراع لا في التنوير.
الفصل الرابع عشر: اتجاهات الغلو
أما الفصل الرابع عشر، فيُعد من أكثر الفصول جرأة، إذ يعالج الغرباوي ظاهرة الغلو بوصفها فعلًا تأويليًا مُغرضًا:
"الغلو هو غربة العقل في موطن التقديس."
وفي هذا التشخيص الكثيف، يتضح أن الغلو ليس إفراطًا في الحب أو الاعتقاد فحسب، بل خللٌ في آليات التفكير والتأويل.
يفكك الكاتب أربع آليات أساسية في بنية الغلو:
1. التأويل المتعسف.
2. تضخم الرموز وتقديس الأشخاص.
3. التوظيف السياسي للمقدس.
4. التحصين ضد النقد والمعارضة.
ويخلص إلى أن الغلو ألغى "مساءلة الرمز" وحوّل الدين إلى أداة أيديولوجية صلبة، تجرّم الشك وتقدّس الانقياد
قراءة ثقافية لفصول 15 و16 من كتاب "النص وسؤال الحقيقة"
في فصوله المتأخرة، وتحديدًا في الفصلين الخامس عشر والسادس عشر من كتابه "النص وسؤال الحقيقة"، يُقدّم المفكر التنويري ماجد الغرباوي أقوى ما يمكن أن يُقال في نقد البُنى التراثية التي أسست لعقائد الغلو والقداسة المطلقة، خصوصًا في الفكر الشيعي.
الغلو والولاية التكوينية: مركزية الإمام أم تهميش للعقل؟
يتناول الغرباوي مفهوم "الغلو" بوصفه انحرافًا تأويليًا تأسّس على ثقافة التقديس غير المشروط. وهو هنا لا يكتفي بالتوصيف، بل ينفذ إلى الجذر، إلى العقيدة القائلة بـ"الولاية التكوينية" للأئمة، والتي تُنسب إليهم قدرات كونية خارقة.
يُسائل الغرباوي الأساس النصي والمعرفي لهذه المعتقدات، فيُظهر أنها ليست نتيجة نصوص قطعية، بل روايات انتقائية جاءت في سياقات سلطوية. إنها مقولات لم تُبنَ على يقين معرفي، بل على إيمان مؤسّس على الاصطفاء والمعجزة، لا على الكفاءة والعقل.
الغلو، كما يراه، ليس عقيدة معزولة، بل آلية لشرعنة سلطة دينية مطلقة، تجعل من الإمام ظلًا لله، وتحوّل طاعته إلى عبادة، وتنزع من العقل حقه في مساءلة المقدّس.
الولاية والغيب السياسي: السلطة باسم المطلق
في هذا الإطار، تتكشف العلاقة العميقة بين الغلو والسلطة. فالغلو لا ينفصل عن السلطة، بل يُستخدم لتكريسها، لإنتاج طاعة عمياء. هو عملية إعادة تشكيل للوعي الديني ضمن قوالب غيبية تستند إلى معجزات لا إلى منطق.
ما يفعله الغرباوي هنا هو ما يمكن تسميته بـ"الجراحة الفكرية"؛ إذ يفتح الجرح التأويلي المزمن في التراث ليكشف كيف حوّل التقديس غير المشروط النصوص إلى أدوات استلاب.
الرواية تحت المجهر: من القداسة إلى النقد
في الفصل السادس عشر والاخير، ينتقل الغرباوي إلى موضوع حساس آخر: "معرفة الروايات". هنا يضرب في صميم مرجعية الرواية في الخطاب الإسلامي، لا ليلغيها، بل ليعيد موضعتها ضمن العقل.
يشدد على أن الرواية لا تُقرأ في فراغ، بل ضمن سياقات إنتاجها. ويُبيّن أن كثيرًا من الروايات نُقلت وتم توظيفها لا لخدمة الحقيقة، بل لخدمة السلطة العقائدية.
"الرواية يمكن أن تتحوّل إلى أداة فاعلة لتكريس سلطة الفقيه، أو لترويج ثقافة الاستسلام والرضوخ، عندما تُحمَّل بمضامين تُعزز التبعية وتُجهض روح النقد والمراجعة."
هذا الاقتباس يكشف عن وظيفة الرواية داخل المنظومة الدينية؛ فهي ليست محايدة، بل حُملت بحمولات سلطوية، وجعلت من بعض المرويات أداة ترويج للاستبداد باسم الإيمان.
مساءلة الرواية: من السند إلى المعقولية
الغرباوي يُقدّم معيارًا مزدوجًا في فحص الرواية: لا يكفي أن تكون صحيحة السند، بل لا بد أن تكون معقولة المتن، منسجمة مع قيم الدين الكبرى.
"يجب مساءلة الرواية، والغوص في دوافعها، ومراجعة أسانيدها، والكشف عن علاقتها بسياقها التاريخي."
بهذا، يُعيد الاعتبار للعقل، ليس كأداة خارجية بل كمعيار تأويلي.
الرواية والوعي الجمعي
"لقد ساهمت الرواية في تشكيل العقل الجمعي، وكان لها أثر حاسم في تثبيت مفاهيم، بعضها لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، لكنها رُوّجت بوصفها تمثّلات حقيقية للنبوة."
إنها دعوة لتحرير الإنسان من سلطة الرواية غير المحققة، ومن سطوة المرويات التي تحوّلت إلى حدودٍ للعقل لا أدواتٍ له.
في هذين الفصلين، يطرح ماجد الغرباوي مشروعًا متكاملاً لنقد الغلو الديني والرواية التقليدية، لا بهدف الهدم، بل بهدف التحرير. إنها دعوة لتأسيس وعي جديد، يستند إلى العقل لا إلى الغيب، وإلى التساؤل لا إلى التسليم.
في زمن تتكاثر فيه مظاهر التدين الشكلي والخطابات الطائفية، يمثل هذا الطرح رافعة فكرية نحتاج إليها، لا بوصفه تحليلًا نقديًا فحسب، بل كخارطة طريق لعقل ديني جديد: عقل لا يخاف من النص، بل يُحاوره.
***
سعاد الراعي