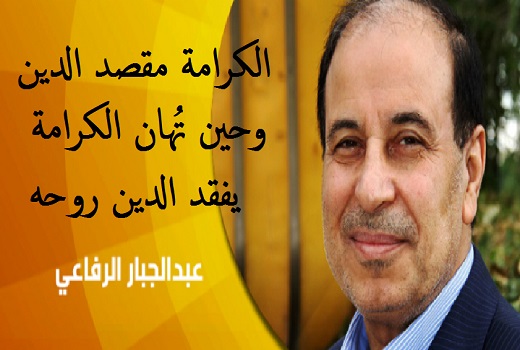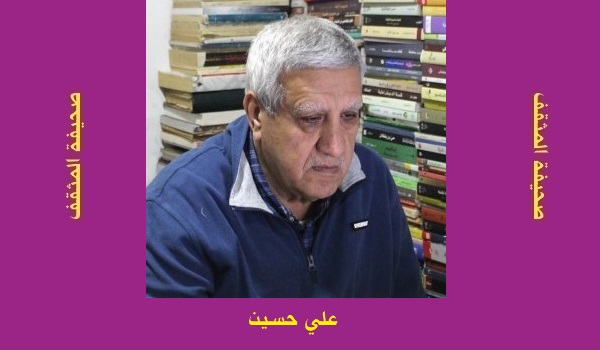أقلام فكرية
غالب المسعودي: القبلية البنيوية والبدائية السياسية

تأطير الإشكالية الفلسفية
تُعدّ العلاقة بين "بدائية السياسة" و"القبلية البنيوية" إشكالية فلسفية عميقة، إذ تمس جوهر التفاعل بين الحتمية الاجتماعية والسلطة ومركزية الذات في سياق النظم السياسية المعاصرة.
يهدف هذا المقال إلى تحليل الاشتباك النظري بين "البدائية السياسية" - كأيديولوجيا حكم معرفية - و"القبلية البنيوية" - كنموذج تحليلي للنظم الاجتماعية اللا-دولتيه. يتضمن التحليل استعراضًا للنماذج الكلاسيكية وتأطير الإشكالية الفلسفية المتعلقة بتأثير البنى على حرية الذات في تشكيل الواقع السياسي.
البنية والوظيفة
تجد هذه الإشكالية جذورها في المنهج البنيوي الذي ظهر في العلوم الإنسانية. يؤكد هذا المنهج وجود بُنى عميقة وثابتة تشترك فيها جميع الثقافات، مُرسِّخةً مبدأ تكافؤ الممارسات الثقافية عبر المجتمعات. كانت للعلوم السياسية حصتها من هذا المنهج، مما أدى إلى نشأة ما يُعرف بـ البنيوية السياسية، التي تركز على البعد الاجتماعي المشترك للسياسة الدولية.
تهتم الأنثروبولوجيا السياسية بدراسة بُنى النظم السياسية عبر النظر إليها كجزء لا يتجزأ من أسس البنية الاجتماعية، وتتبُّع أشكال تطورها التاريخي. يؤكد المنهج البنيوي في هذا السياق على استبدال الدراسة التكوينية أو الوظائفية بتحليل البنى المجردة والنماذج البنيوية. هنا، يُنظر إلى السياسة من زاوية العلاقات "الشكلية" التي تُحلّل علاقات السلطة القائمة فعليًا بين الأفراد والجماعات.
يتمثل جوهر المنظور البنيوي في فرضية الحتمية، التي تنظر إلى الإنسان على أنه محكوم بالبيئة والظروف والطبقة أو الطائفة/القبيلة التي وُلِد فيها. هذا التصور ينفي الحرية المطلقة التي يتصوّرها بعض الفلاسفة. في هذا الإطار، تُعتبر البنى السياسية أنظمة مجردة تُعبّر عن المبادئ الأساسية التي توحد العناصر المكونة للمجتمعات السياسية الواقعية.
القبيلة مقابل القبلية
يواجه التحليل تحديًا منهجيًا يتمثل في الخلط المتكرر بين دلالات مصطلحي "القبيلة" و"القبلية". إن الفشل في الفصل بين هذين المفهومين يحول دون تقديم تحليل سياسي دقيق للظواهر الاجتماعية.
القبيلة: البنية الاجتماعية (الساكنة)
تُعرف القبيلة بأنها المؤسسة الاجتماعية الأولية المسؤولة عن تنظيم حياة الجماعات البدائية، وتأمين الأمن الغذائي، والدفاع عن المجال الجغرافي. هذا ينطبق بشكل خاص على الحقب التاريخية التي لم تكن الدولة قد تحولت فيها من فكرة مجردة إلى واقع ملموس. هي بنية اجتماعية أساسية تعمل كإطار للحماية والأمن الجماعي.
القبلية: النزعة والوظيفة السياسية (المتحركة)
أما القبلية فهي نزعة تعصّبية ذات طابع سيكولوجي وسياسي، تسعى للقفز خارج إطارها الاجتماعي-الأنثروبولوجي الضيق لتباشر تعزيز مكانتها في المؤسسات السيادية للمجتمع، بما فيها الدولة. تتم هذه العملية عبر تسيس المصالح الاقتصادية والقيمية للقبيلة، ومنحها حقوقًا سياسية تتشابه مع حقوق الكيانات المدنية التي تخضع لسلطة وقوانين الدولة المركزية.
يشير التحليل البنيوي إلى وجود ظاهرة "التخادم البنيوي" و"التناغم المؤسسي" بين القبيلة (البنية الأولية الساعية للحماية) والقبلية (النزعة العصبية الساعية لفرض الإرادة). في ظل المصالح والظروف القاسية (كغياب الموارد أو النزق البيئي)، قد تستعين القبيلة كجماعة اجتماعية بنوازع القبلية كعصبية لتعزيز مصالحها. وهذا يؤكد أن النزعة القبلية ليست مجرد بقايا بدائية، بل هي تسيس وظيفي للبنية الأولية يتم تفعيله عند ضعف مؤسسات الدولة الحديثة.
إن هذا الفصل المنهجي ضروري، فالنزعة القبلية، كونها قوة سياسية مخترقة، تمثل التفعيل الوظيفي للبنية الأولية (القبيلة) في مواجهة تحديات الدولة الحديثة. وهذا يوضح لماذا يمكن للقبلية أن تلعب دورًا في تعزيز التماسك في أوقات الأزمات، بدلًا من كونها مجرد مصدر للانقسام.
البنيوية والحتمية
تُشكّل الإشكالية الفلسفية الأولى للبنيوية في تبنّيها المطلق لمبدأ الحتمية، الذي يحدّ من دور الذات الفاعلة. يؤكد البنيويون، وعلى رأسهم كلود ليفي-شتراوس، أن البنى العميقة للعقل البشري موحدة وأن العقل "المتوحش" له نفس هياكل العقل "المتحضر"، مما يجعل جميع الثقافات قابلة للمقارنة ومتكافئة.
في حين أن هذا الموقف، الذي يرى أن الأساطير القبلية تمثل مهارة عقلية لا تقل احترامًا عن أعمال نيوتن، هو عمل تحرري ضد التراتبية الحضارية التي سادت في الغرب. إلا أن الثمن الفلسفي لذلك هو تقييد حرية الفرد ضمن حدود البنى الثابتة. بالنسبة للبنيوية، الفرد هو نتاج للبنية الاجتماعية والاقتصادية والقبلية التي يعيش فيها، ما يجعله غير حر بالقدر الذي يتخيله المفكرون الوجوديون. وبالتالي، تفتتح البنيوية بابًا للنقد الوجودي وما بعد البنيوي الذي سيركز لاحقًا على الفعل الثوري والحرية والذاتية الفاعلة.
العصبية كآلية للتكاتف الاجتماعي
تُعدّ نظرية العصبية محاولة رائدة لدراسة الرابطة والتكاتف الاجتماعيين. لقد وسّع ابن خلدون مفهوم "النسب" من معناه البيولوجي الضيق لكي يشمل الحلف والولاء، مستحدثًا تعبير "نسب الولاء". بالنسبة لابن خلدون، تكمن قوة العصبية في وجود "ثمرات النسب"، أي جريان أحكام الجماعة وأحوالها على الفرد، مؤكدًا أن الالتحام بالقوم هو المعنى الحقيقي للعصبية، بغض النظر عن النسب الأولي الذي قد يتناسى بطول الزمن.
تُفسِّر العصبية، دينية كانت أم قبلية، ديناميكية دورات الحكومات؛ فهي القوة الدافعة التي توحّد القبائل والقوى الغازية وتشدّها، مما يُمكّنها من الغلبة على الدولة القائمة التي تكون قد ترهلت وضعفت. تمر الدولة الجديدة بعدها بفترة قوة وازدهار، لتواجه في نهاية المطاف نفس مصير سابقتها، في جدلية مستمرة بين البادية والحاضرة.
تحدي القبلية البنيوية للدولة الحديثة
تتجسد الإشكالية البنيوية في الراهن السياسي في التعارض الحاد بين بنية القبلية ومفهوم المواطنة في الدولة الحديثة. تقوم الديمقراطية الحديثة على المواطنة أي الفرد الذي يرتبط بالدولة عبر رابطة قانونية ومعنوية، وحيث تكون السيادة ملكًا لجميع المواطنين. أما القبيلة، فتقوم على الانتماء العائلي الذي لا يمكن للفرد أن يغيره بإرادته، خلافًا لخياراته السياسية أو الفكرية.
تسعى القبلية السياسية لإعطاء البنية القبلية وزنًا سياسيًا ضمن الدولة الحديثة، وغالبًا ما تتخذ شكل اختراق للمؤسسات السيادية. هذا التسيس للبنية القبلية يعرقل مفهوم المواطنة الشاملة القائمة على الإقليم والرابطة القانونية.
مع ذلك، تظهر ديناميكية معاصرة للقبلية البنيوية في سياق الدول الفاشلة أو الهشة. فالتحليل يشير إلى أن القبيلة، في سياقات الأزمة الشاملة، تتحول إلى عامل تماسك اجتماعي وتوفير لشبكات الدعم، وليست بالضرورة مصدرًا للانقسام كما تصفها الخطابات الدعائية. هذا التحول الوظيفي يمثل استعادة البنية الأولية لسلطتها، مدفوعة بفشل الدولة المركزية في توفير الحماية والأمن، وهما الوظيفة الأساسية التي كانت تقوم بها القبيلة تاريخيًا.
تحول بدائية السياسة إلى ظاهرة داخلية
في تطور فلسفي هام، لم يعد مفهوم "بدائية السياسة" مقتصرًا على تصنيف المجتمعات اللا-دولتيه الخارجية، بل أصبح يُستخدم لنقد الظواهر البنيوية الداخلية للديمقراطيات الغربية نفسها.
عندما تفشل الدولة الليبرالية المركزية في تحقيق وظائفها الأساسية (الأمن والحماية)، فإن البنية القبلية الأولية تستعيد وظيفتها السياسية، ليس كبقايا الماضي، بل كآلية بنيوية حاضرة لمواجهة الأزمة. وهذا يؤكد أن الأنظمة القبلية، إذا تم تجريدها من التصنيف الأيديولوجي السلبي، يمكن أن تكون متوافقة مع مفاهيم الحكم القائمة على التفاوض والمشاركة. إن التحرر السياسي الكامل يتطلب أولًا التحرر من البنية المعرفية الأيديولوجية التي تصنّف الذات ضمن إطار "بدائية السياسة" و"القبلية البنيوية"، التي تمثل عودة "البدائية" إلى المركز.
***
غالب المسعودي
.......................
المراجع المستخدَمة في التقرير
en.wikipedia.org - Structural anthropology - Wikipedia
في البنيوية - مركز خُطوة للتوثيق والدراسات
elearn.univ-tlemcen.dz - اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
uomustansiriyah.edu.iq - مناهج الانثروبولوجيا السياسية واتجاهاتها
المحاضرة الثالثة
alfililaw.com - الدين والقبيلة في مواجهة الديمقراطية - د
محمد الفيلي أستاذ القانون العام
cmi.no - The contemporary nature of tribalism.
Anthropological insights on the libyan case
anthropology.iresearchnet.com - Segmentary Lineage
Systems - Anthropology
as.nyu.edu - 'PRIMITIVISM', ANTHROPOLOGY, AND THE
CATEGORY OF
researchgate.net - Liberalism and Its Other: The
Politics of Primitivism in Colonial and Postcolonial Indian Law
udaychandra.com - Liberalism and Its Other: The
Politics of Primitivism in Colonial and Postcolonial Indian Law
thenewatlantis.com - Anthropology as Atonement - The
New Atlantis
en.wikipedia.org - Claude Lévi-Strauss - Wikipedia
copolicy.uobaghdad.edu.iq –
اطروحة في كلية العلوم السياسية تناقش البنيوية
وما بعد البنيوية في الفكر السياسي الفرنسي المعاصر
fiveable.me - Segmentary Lineage System - (Intro to
Anthropology)
economics.ubc.ca - Segmentary Lineage Organization and
Conflict in Sub-Saharan Africa
infinitemiledetroit.com - Primitivism in 20th Century
Art: Affinity of the Tribal and the Arrogant
sihr.fr - محنة العقلانية في الفكر السياسي العربي المعاصر
muslimsc.net - نظرية العصبية عند ابن خلدون وتأسيس الدول
رابطة علماء المسلمين
dohainstitute.org - Tribalism, Regionalism, and the
Stalled Building of the Modern State in Libya
scholarship.law.wm.edu - Tribalism and Democracy -
W&M Law School Scholarship Repository
un.uobasrah.edu.iq