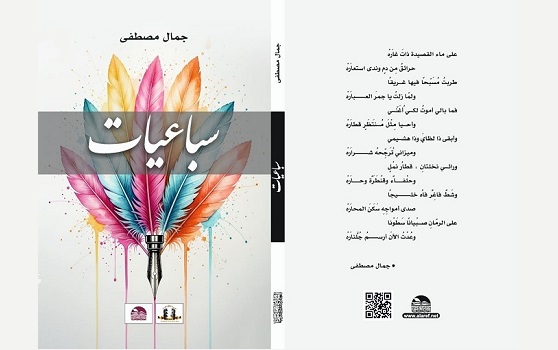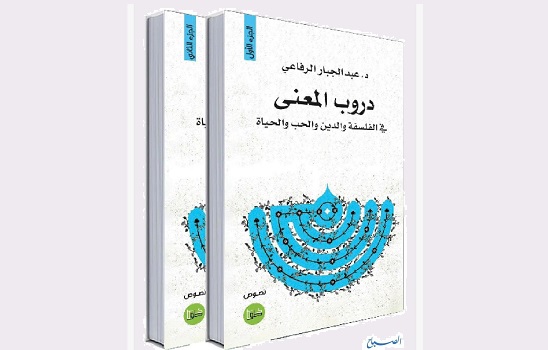أقلام فكرية
زهير الخويلدي: فلسفة الإدراك البشري بين الذاتية والموضوعية

من التمايز المصطلحي إلى التكامل المعرفي
مقدمة: يُمثل الإدراك البشري (Perception) أحد الموضوعات الأساسية في الفلسفة، حيث يتناول العملية التي يترجم بها العقل البشري المعطيات الحسية إلى معرفة. يتمحور النقاش الفلسفي حول الإدراك حول سؤال أساسي: هل الإدراك عملية موضوعية تعكس الواقع كما هو، أم أنه ذاتي يتشكل وفقًا لتجارب الفرد وتصوراته؟ هذا المقال يهدف إلى استعراض التمايز المصطلحي بين الذاتية والموضوعية في سياق الإدراك، ثم استكشاف إمكانية التكامل المعرفي بينهما، مع الاستناد إلى التراث الفلسفي وآراء فلاسفة مثل ديكارت، كانط، وهوسرل، إلى جانب الإسهامات الحديثة في فلسفة العقل وعلم الإدراك.
التمايز المصطلحي: الذاتية والموضوعية
يُعرف الإدراك في الفلسفة بأنه العملية التي يتم من خلالها تفسير البيانات الحسية لفهم العالم الخارجي. يتمحور التمايز بين الذاتية والموضوعية حول مصدر المعرفة وطبيعتها:
الذاتية (Subjectivité): تشير إلى الإدراك كتجربة فردية تتأثر بالعوامل الشخصية مثل الخلفية الثقافية، العواطف، التجارب السابقة، والتحيزات المعرفية. في هذا السياق، يُنظر إلى الإدراك كعملية داخلية تعكس حالة الذات أكثر من الواقع الخارجي. على سبيل المثال، يرى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في كتابه التأملات في الفلسفة الأولى (1641) أن المعرفة الحسية قد تكون خادعة، وأن اليقين الحقيقي يكمن في الذات الواعية ("أنا أفكر، إذًا أنا موجود").
الموضوعية (Objectivité): تفترض أن الإدراك يمكن أن يعكس الواقع كما هو، مستقلًا عن الذات الفردية. هذا الموقف تجسد في الفلسفة الواقعية، التي تؤكد أن هناك عالمًا خارجيًا موجودًا بغض النظر عن إدراكنا له. على سبيل المثال، يرى جون لوك في مقال في الفهم البشري (1689) أن الأفكار تنقسم إلى صفات أولية (موضوعية مثل الحجم والشكل) وصفات ثانوية (ذاتية مثل اللون والطعم).
التمايز بين الذاتية والموضوعية يطرح إشكالية فلسفية عميقة:
هل يمكن للإدراك أن يكون موضوعيًا بالكامل، أم أن الذاتية جزء لا يتجزأ منه؟ هذا السؤال قاد إلى انقسامات فلسفية بين التيارات المثالية (Idéalisme)، التي ترى أن الواقع يعتمد على الذهن (كما عند بيركلي)، والتيارات الواقعية (Réalisme)، التي تؤكد وجود عالم مستقل.
الإدراك عند الفلاسفة: من ديكارت إلى كانط
رينيه ديكارت (1596-1650): أسس ديكارت للشك المنهجي، معتبرًا أن الحواس قد تكون خادعة، كما في مثال الشمع الذي يتغير شكله عند الذوبان، لكنه يظل شمعًا في جوهره. اقترح ديكارت أن العقل هو مصدر المعرفة الحقيقية، مما يعزز الطابع الذاتي للإدراك.
إيمانويل كانط (1724-1804): قدم كانط في كتابه نقد العقل الخالص (1781) رؤية ثورية تربط بين الذاتية والموضوعية. يرى كانط أن الإدراك يتشكل من خلال هياكل معرفية مسبقة في العقل (مثل الزمان والمكان)، والتي تُنظم المعطيات الحسية. وفقًا لكانط، لا ندرك "الشيء في ذاته" (Noumène)، بل الظاهرة (Phénomène) كما يتشكل في وعينا. هذا النهج يُظهر تفاعلًا بين الذاتية (هياكل العقل) والموضوعية (المعطيات الخارجية).
إدموند هوسرل (1859-1938): في الفينومينولوجيا، دعا هوسرل إلى "تعليق الحكم" (Epoché) لدراسة الإدراك كما يظهر للوعي، متجاوزًا الافتراضات حول الواقع الخارجي. يرى هوسرل أن الإدراك عملية ذاتية في جوهرها، لكنها تتيح فهمًا مشتركًا للواقع عبر التجربة الواعية.
التكامل المعرفي: جسر بين الذاتية والموضوعية
في الفلسفة الحديثة وعلم الإدراك، ظهرت محاولات لتجاوز الثنائية بين الذاتية والموضوعية من خلال التكامل المعرفي. يمكن تلخيص هذا النهج في النقاط التالية:
الفينومينولوجيا والتجربة المشتركة: يقترح هوسرل ومن تبعه (مثل موريس ميرلو-بونتي) أن الإدراك، رغم ذاتيته، يعتمد على تجربة مشتركة بين البشر. على سبيل المثال، إدراك اللون الأحمر قد يختلف في تفاصيله بين الأفراد، لكنه يتيح التواصل بفضل السياقات الثقافية واللغوية المشتركة.
علم الإدراك (Science cognitive ): تُظهر الدراسات الحديثة أن الإدراك يتأثر بتفاعل معقد بين العمليات العصبية والمعطيات الخارجية. على سبيل المثال، نظرية "الإدراك التوقعي" تقترح أن العقل يبني نماذج تنبؤية بناءً على المعطيات الحسية والتجارب السابقة، مما يجمع بين الذاتية (النماذج الداخلية) والموضوعية (المدخلات الحسية).
التشابكية: هذا النهج، الذي طوره فرانسيسكو فاريلا وآخرون، يرى أن الإدراك ليس مجرد استقبال للمعطيات، بل عملية ديناميكية تنشأ من التفاعل بين الكائن الحي وبيئته. هذا التفاعل يتيح التكامل بين الذاتية (تجربة الفرد) والموضوعية (البيئة الخارجية).
التحديات والنقاشات المعاصرة
رغم محاولات التكامل، لا تزال هناك تحديات:
الوهم الإدراكي: تُظهر الظواهر مثل الأوهام البصرية أن الإدراك قد يكون خادعًا، مما يعزز الطابع الذاتي. على سبيل المثال، تجربة "فستان الألوان" (2015) أثارت نقاشًا عالميًا حول اختلاف إدراك الألوان بين الأفراد.
التحيزات المعرفية: تؤثر التحيزات مثل تأثير التأكيد على الإدراك، مما يجعل الموضوعية الكاملة أمرًا صعب المنال.
الذكاء الاصطناعي: مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت فلسفة الإدراك تواجه أسئلة جديدة: هل يمكن للآلات أن تدرك بطريقة موضوعية، أم أن إدراكها يعتمد على برمجة ذاتية؟
خاتمة
فلسفة الإدراك البشري تكشف عن توتر دائم بين الذاتية والموضوعية، لكنها تُظهر أيضًا إمكانية التكامل المعرفي. من ديكارت الذي ركز على الذات الواعية، إلى كانط الذي جمع بين هياكل العقل والواقع الخارجي، إلى الإسهامات الحديثة في الفينومينولوجيا وعلم الإدراك، يتضح أن الإدراك عملية مركبة تجمع بين التجربة الفردية والبيئة الخارجية. التكامل المعرفي، كما يظهر في التشابكية ونظريات الإدراك التوقعي، يقدم أملًا في فهم أعمق لهذه العملية. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، مما يجعل الإدراك موضوعًا حيويًا للنقاش الفلسفي والعلمي في القرن الحادي والعشرين. فكيف جعلت فلسفة الذهن من الادراك تجربة أساسية للكائن الحي؟.
***
د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي