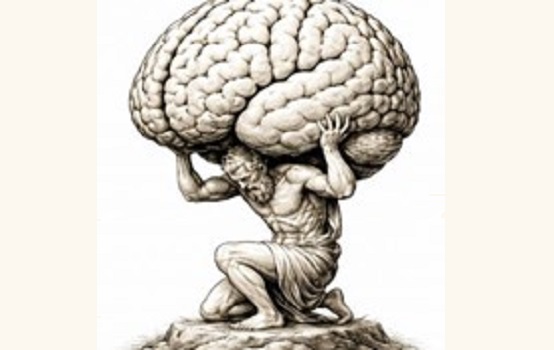قضايا
عدي عدنان البلداوي: فصل الدين عن الدولة.. أم فصل الثقافة عن سياسة الدولة؟

تشغل مسألة بناء وتنظيم المجتمع إهتمام العقل الإنساني الثقافي، وتصل الى درجة من الصعوبة تجعلها من أصعب مشكلات عصر التقنية اليوم، فمعطيات الواقع تفيد بأن التغييرات الإقتصادية والتطور التقني والتحولات الإجتماعية والميول الشخصية تتحرك بشكل أسرع من قدرة الثقافة على اللحاق بها. وتكمن مضار ذلك في أن تلك التغييرات قد تتمكن من التدخل في إعادة هيكلة البناء الإجتماعي بما يسمح بإدراج ثقافات جديدة تحددها التغييرات المتسارعة المحكومة بالسوق الإستهلاكية، وبالمشاريع السياسية العالمية، ومشاريع الاقتصاد الصناعي التقني، لذا أخذت بعض السلوكيات الغريبة والطارئة على المجتمع تنتشر بين الناس بسرعة اكبر اذا ما قورنت بسرعة انتشار فكرة هادفة، أو نظرة موضوعية.
عندما أتاحت وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت في ظل المتغيرات العالمية، حرية التعبير دون ضوابط ثقافية وأطر أخلاقية ومسارات أدبية للنشر، دخلت شركات استثمارية تقنية على خط الحرية الرقمية فوظفت المال لتنمية تلك الحريات، مما حمل كثيرين على النزول بمحتويات سلبية تنوعت ما بين تافهة وهابطة وفاشلة، ومحتويات إيجابية تنوعت ما بين نافعة وقيّمة وناجعة. وأعطت حق تقييمها لجمهور المتلقين عبر إعجاباتهم وكثرة مشاركاتهم وعديد مشاهداتهم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، فكانت أعداد المتابعين معياراً لتزكية المحتوى حتى وان كان ذلك المحتوى بعيداً عن الضوابط الثقافية المتعارف عليها فكرياً ولغوياً وانسانياً وأدبياً وإجتماعياً. بسبب ذلك استطاع بعض منشئي المحتويات الرقمية فرض حضورهم على المشهد الإعلامي ثم الثقافي في المجتمع بقوة جمهورهم الداعم والمشجع والمتابع. وسواء أكان ذلك الجمهورعلى قدر كافي من الوعي بما يقوم به من مسؤولية في التقييم أم لا، فإن النتيجة صارت لصالح كبسة زر يقوم بها هذا المستخدم وذلك المتابع، دون الأخذ بنظر الإعتبار ما إذا كانت تلك الكبسة قد تمت بتأثير إنفعال عاطفي أو مرحلي أو تفاعل موضوعي. المهم ما يسجله عدّاد الشاشة الرقمية، لذلك لم يعد بوسع الثقافة ان تتطور، بل هي في اعتقادي قد تأكل بعضها في السنوات القادمة وتتحول من مشروع رسالي الى نشاط جمالي يضفي على صاحبه بعض اللمسات الإجتماعية والتمظهر الحضاري.
أزمة الثقافة في عالمنا العربي في عصر التقنية المتطورة ومشاريع الذكاء الإصطناعي أكثر تعقيداً مما كانت عليه ثقافة الدول الصناعية في القرن التاسع عشر وهي تواجه صعوبة في التوفيق بين الجانب المادي المتمثل بالعلم المجرد والجانب الروحي المتمثل بالإبداع الثقافي. واذا كانت الثقافة قد احتاجت الى نصف قرن لكي تميل بالمجتمع الغربي الى الواقع المادي بعدما استطاع العلم ان يوفر اجوبة مقنعة لكثير من اسئلة الناس خصوصاً الشباب منهم فيما يتعلق بشؤون حياتهم التي كانت الكنيسة قد فرضت قوالب جامدة إزاءها خصوصاً ما تعلق منها بشؤون المرأة وغيرها. فإن ثقافة مجتمعنا العربي اليوم تواجه أزمة عميقة تتمثل في ان المجتمعات العربية لم تصنع تطورها العلمي والتقني، ولم تشهد مرحلة انتقالية تسمح لها بترتيب الأولويات، فضلاً عن إن البعد الديني عند العربي يتمدد على خارطة حياته الشخصية والإجتماعية والثقافية والنفسية.
بالاضافة الى ان النظام السياسي العربي فشل في مختلف الظروف تقريباً في توفير أجواء آمنة لظهور ثقافة قادرة على فهم التغيير الذي يمر به المجتمع والمتعلق بالتغيير الحاصل في النظام العالمي، لذا لم يتمكن المثقف لوحده من اللحاق بركب التطور المتسارع للتقنية ولم تتمكن انظمة الحكم المسؤولة عن بلدان العالم العربي من توفير مستلزمات ذلك اللحاق، كما لا ننسى ان للعادات والتقاليد والأعراف العشائرية حضور أقوى من حضور الثقافة بمعناها المتمدن، ومن شأن هذا ان يقيد الثقافة كرسالة تنمية في المجتمع، فقد نجد كثيراً من المتعلمين والمثقفين وهم بمارسون انماطاً سلوكية لا تختلف كثيراً عن تلك التي يمارسها من هم أقل نصيباً منهم في التعليم والمعرفة والثقافة والمكانة الإجتماعية، وقد نجد أستاذاً أكاديمياً وطبيباً ومهندساً ومعلماً في صف واحد مع الآخرين أمام سلطة العرف العشائري.
إذا كان المجتمع الغربي قد تجاوز النقد الهدّام الذي أودى في القرن التاسع عشر بحياة كثير من العلماء والمجددين مثل غاليلو، فإن العالم العربي لا يزال الى يومنا هذا ونحن في القرن الحادي والعشرين، لم يتجاوز مرحلة النقد الهدّام وقد نجد مصداق ذلك فيما تواجهه بعض شخصيات المفكرين والكتّاب والمثقفين من نقد لاذع وتسقيط خطير ونيل يطال الكرامة ويهدد الحياة.
يعاني المجتمع العربي عموماً وخلال فترة غير قصيرة من عمره من انه لم يفسح له المجال للتمكن من الأدوات التي تلائم طبيعته وفلسفته للحياة، تجعله أو تساعده على تحويل تعلقه بالماضي الى تجربة حياتية يستثمرها في حاضره لكي لا يغدو الحاضر نسخة جامدة عن الماضي، والأغرب من كل هذا ان في مجتمع اليوم من يعمل على تمكين الماضي من الحاضر اذا توفرت لديه القوة اللازمة لذلك، فمنهم من يرى في الزمن الماضي ما هو اجمل من الحاضر على الرغم من الفارق الكبير بين أدوات الماضي البسيط وأدوات الحاضر المتطور. ذلك لأن مخرجات عصر التطور التقني لم تتمكن من الدخول الى حياة الناس في العالم العربي دخولاً يبعث على الطمأنينة وراحة البال، بل على العكس فقد كان الموقف مضاداً، خصوصاً بعد أن وظفت السلطة السياسية هيمنتها على القرار توظيفاً أضرّ بسلامة البناء الإجتماعي عندما أعطت للحرية الشخصية مساحة أكبر من طبيعة الشخصية العربية والمجتمع العربي، فقد صار العربي المسلم من حيث يرضى ولا يرضى، ومن حيث يدري ولا يدري، يرى صوراً ومقاطع فديو ويقرأ أفكاراً غريبة بعيدة عن احتياجات واقعه، ينشرها أشخاص لا يعرف شيئاً عن حقيقة ثقافتهم وسلامتها، يستخدمون حق النشر وحرية النشر عبر تطبيقات الكترونية توفرها شركات إنتاج رقمية غربية تجارية هدفها كثرة عدد المتابعين والمشاركين ومستخدمي مواقعها الإفتراضية.
اختلف الناس في تعاطيهم مع التغيير الحاصل في عصر التقنية بين الشرق والغرب من حيث ان التعريف العملي للحكومة في كثير من بلدان الغرب هو السلطة بينما هو التسلط في كثير من بلدان العالم العربي، وهذا الإختلاف في التعريفين عوّق جهود نهضة المجتمعات العربية المسلمة وتسبب في حرمان ثقافتها من التطور، فمما لا شك فيه ان الثقافة تتقاطع مع كل ما هو لا إنساني أو مع كل ما يعرض الإنسان للإستهلاك وللإستثمار والتسليع، أو للإستحمار كما قال المفكر الإيراني علي شريعتي. فالعربي وان كان مستهلكاً لمنتجات الغرب، فبوسعه ان يستخدم تلك التقنية لتطوير ثقافته فيما لو تنازلت الحكومة في بلاده عن مفهوم التسلط لصالح مفهوم السلطة، وقد نجد ذلك واضحاً حين مارست السلطة السياسية نشاطات ثقافية في العالم العربي من خلال وزارة الثقافة أو من خلال أي نشاط ثقافي تقوم به دوائرها ومؤسساتها المتنوعة. لقد فشلت ثقافة السلطة السياسية في تمكين المجتمع ثقافياً واقتصرت أدوارها وأنشطتها على مهرجانات ومؤتمرات وندوات ونشرات وصحف ومجلات خاضعة بشكل كبير لروتين وأجندات سياسة السلطة الحاكمة، فقد صار وزير الثقافة ناطقأ باسم الحكومة، وصار الشاعر مستشاراً ثقافياً للرئيس، وصار الأستاذ الجامعي لساناً حزبياً أكاديمياً. يضاف الى ذلك ان المجتمع العربي عموماً مرّ بفترة اضطراب سببتها أحداث الربيع العربي ثم موجة الإرهاب، الأمر الذي صرف إهتمام ثقافة المجتمع الى البعد الأمني حفاظاً على البعد الحياتي لوجود الناس، وتهددت ثقافة الجيل الجديد من الشباب بعد اجتياز تلك المحن، فهي اليوم ثقافة قلقة متوترة متمردة، استطاعت باضطرابها أن تتجاوز نوعاً ما على سلطات دينية وعشائرية وأسرية باستخدامها تقنيات عصر التطور الرقمي في التعريف والتعبير عن ذلك التجاوز، فصرنا نسمع عن تطاول على رموز دينية وثقافية واجتماعية بمساعي يقوم بها اشخاص ينتمون أو يدّعون انتماءهم الى الوسط الثقافي والاجتماعي، وقد نجد في مواقع التواصل الإجتماعي كثيراً من الفديوهات التي يظهر فيها أشخاص وهم ينالون من هذا المفكر وذلك الكاتب تحت عنوان حرية التعبير وحرية الرأي وحرية النشر وحرية التفكير وحرية النقد.
مشكلة الثقافة في عالمنا العربي متعلقة بثلاث سلطات: دينية، وحكومية، وعشائرية، وقد انقسم الوسط الثقافي الى قسمين: قسم يريد إحداث تغيير أو تحديث في سلطة الدين بما يتوافق مع قوة التطور العلمي وتوسعه في مناخ سياسي يتناغم مع تسلط الحاكمين. وقسم آخر يريد تحريك التطور العلمي والنظام السياسي في إطار سلطة الدين، وبينما لا تزال هذه المشكلة قائمة أخذت مشاكل الناس الشخصية والإجتماعية تكثر وتكبر، وأخذ الضغط النفسي يزداد على المواطن العربي المسلم، فهو في طبيعته يريد ان يصل الى حالة اتزان في جوانب شخصيته الروحية والمادية والسلوكية والنفسية والاخلاقية ويبحث في بيئته عن كل ما يمكنه من ذلك.
في داخل الوسط الثقافي تظهر مشكلة الثقافة في نوعين من التفكير، نوع خاضع لإرادة سلطة الحكومة، ينظر بعين الإعتبار الى الوظيفة الثقافية كنشاط إبداعي فردي لا يتعدى حدود الشكر والإشادة، والتكريم و.. ونوع آخر مضاد، يرى في الثقافة مشروع مجتمع ينبغي له أن يتجاوز كل حدود منع تمكينه ثقافياً. الثقافة الرسمية التي ترعاها السلطة السياسية تؤدي ادواراً داعمة لجهود أعضاء رسميين في مؤسساتها، فهي تطبع كتبهم وتنمحهم الألقاب والأوسمة والهدايا والتكريمات وتنشر مقالاتهم في صحفها الرسمية وتعقد لهم المهرجانات والمؤتمرات وتنظم لهم الندوات واللقاءات، لكننا لا نرى كل ذلك إنجازاً ثقافياً بالبعد الأعمق الذي يمتع الثقافة بحق معالجة الواقع وانقاذه من التراجع.
لا شك ان هذا الكلام سيكون موضع انتقاد المثقف الرسمي، لأنه يرى ان الثقافة فيما تقوم به هي موضع تطور وازدهار مثلما وصف بعضهم العصر العباسي بالعصر الذهبي مقارنة له بعصور خلت لم تشهد فيه الثقافة ما شهدته من اهتمام سياسي بلغ في عهد هارون الرشيد تأسيس بيت الحكمة الذي تقول المصادر عنه ان مكتبته ضمت قرابة 300 الف كتاب. كل ذلك كان الى جانب الإعتقالات والإغتيالات وركود الثقافة الحرة في المجتمع فقد كانت الثقافة ثقافة الحكومة التي رأت في ثقافة الإمام موسى بن جعفر ما يضرها فألقت به في مطامير السجون ثم قتله فيما بعد.
الحكومة العربية اليوم لا ترى في نفسها عائقاً أمام الثقافة، فهي تشيد بالثقافة والمثقف وتدعم نشر الكتاب وتحث على البحث والتعلم وتحفز على التطور. لكن أي نوع من العقل أرادت هذه الحكومات صناعته في المجتمع العربي ؟ انه العقل المادي الروتيني الذي يقرأ الكتاب ويشكر الحاكم ويشيد بحكمته ورعايته للثقافة، وفي احسن حالاته ينتقد الحكومة دون ان يكون لنقده اذناً واعية في أروقة السلطة، والمشهد العراقي حافل بكثير من الكتابات النقدية البناءة والأفكار المتطورة على مدى عشرين عاماً من بداية القرن الحالي، لكنها لم تستطع ان تغير شيئاً في الواقع الذي يتراجع اكثر واكثر في الوقت الذي تشهد فيه انشطة المؤسسة الثقافية الرسمية عقد مهرجانات وافتتاح معارض ومكتبات وإلقاء محاضرات وإقامة مسابقات و... هذا هو العقل الذي تريد السلطة الحاكمة صناعته في مؤسساتها الثقافية الرسمية. انه عقل حر في حدود القيود التي تضعها مصلحة الحكومة في التسلط. هكذا عقل لا يمكنه ان يفرق بين التطوير والتبرير. هو عقل قادر على رسم ملامح المستقبل الذي ترسمه اجندات تلك الحكومات، وليس عقلاً حراً بالقدر الذي يصنع في صاحبه ذاتاً ثائرة متمردة قادرة على تغيير واقعها السيء، عارفة بقيمة الكلمة وبدورها في نهضة الامة.
في الواقع يمكن ان نشخص نوعين من العقل الثقافي العربي، عقل يعمل بآلية الولاء الفكري، وعقل يعمل بآلية التجرد الفكري.
ينجذب كل من العقل الديني والعقل السياسي الى العقل الثقافي ذو التفكير الولائي، فنجد الحكومة تقرب اليها المثقفين الذين يشيدون بها، ويبررون لها، خاضعين تماماً لروتينها الإداري القائم على المظهر الإعلامي الذي يقدم الحقائق للناس بالصورة التي تظهر وجه الحكومة أبيضاً ناصعاً في جميع الأحوال. كذلك العقل الديني، فالمؤسسة الدينية تقرب اليها المثقفين الذين يحملون ايديولوجيتها ويتكلمون بعقيدتها.
قبل عصر التقنية كانت الحصة الأكبر في الاختيار بين الانفتاح أو الإنغلاق، بين التراث أوالمعاصرة، من نصيب القوة الأكثر غلبة في ساحة الحياة العامة في المجتمع العربي الاسلامي.
وكان العقل الديني هو الأكثر قوة، فقد كان الخليفة والحاكم والامير ظل الله على الأرض، وعلى هذا الإعتقاد مضت المجتمعات، فالحاكم هو ولي الأمر واليه يرجع الأمر كله كونه الأدرى بمصلحة العامة. أدى هذا الإعتقاد الى منع تطور الثقافة في عالمنا العربي، خصوصاً بعد أن تمكن العقل السياسي من إحتواء العقل الديني وإيهام الناس بأنه يفكر بعقل ديني. اكتشف الناس ذلك الوهم عندما شاهدوا دائرة الظلم تكبر في محيط ديني يحكمه عقل سياسي يُقسم أمام الجماهيرعلى ان الإسلام دينه ومنهجه ودستوره ومصدر تشريعه. المشكلة تكمن في ان المجتمع العربي حين اكتشف هذه الحقيقة المزيفة لم يكن يتمتع بقوة مواجهتها مواجهة رادعة.
اما في عصر التقنية فقد تقلصت فاعلية قوة العقل السياسي واقتصرت على الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب الإداري والمالي. واقتصرت قوة العقل الديني على قضايا المصير. أما شؤون الحياة الاجتماعية فلم يعد الخيار محدوداً بالعقل السياسي والعقل الديني. لقد صار لكل عقل بشري حرية الإختيار بين الولاء والعداء. بين الإتباع والإمتناع. بين القبول والعدول. لذلك كثرت مشاكل الناس وتأزمت الأمور كثيراً ودخل المستثمرون على خط الأزمات، وصاروا يروجون لبضاعتهم من خلال حاجة الناس، فمثلاً يعيش أغلب الناس في العالم العربي تحت ضغوط إجتماعية وإقتصادية كبيرة وكثيرة، فشل العقل السياسي في ازالتها أو تخفيفها لجهله أو لعدم اكتراثه بطبيعة المجتمع، الأمر الذي جعل الناس يبحثون في الإتجاه السلمي عن كل ما يمكنه أن يخفف عنهم هذه الضغوط الكبيرة، وكان من بين أقرب تلك الحلول هو السخرية أو الطرفة أو الترفيه اللفظي والحسي، فظهرت محتويات ثقافية كانت موضع قبول واقبال كثير من الناس وان كانت تلك المحتويات تنطوي على الفاظ شعبية غير مقبولة، أو تنطوي على غايات مريضة، أو تنطوي على عادات سيئة. مع كل ذلك وجدت من يتقبلها، بل ان كثيرين كانوا يروجون لها بمشاركتها على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد انها محتويات مضحكة، مسلية، ساخرة. هنا تظهر الخطورة التي تواجهها الثقافة العربية المعاصرة، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها كتاب ومفكرون صالحون ومصلحون لا تجد جهودهم تجاوباً جماهيرياً يرتقي بطروحاتهم الى مستوى المنهج العملي المؤثر، إلا في نطاقات محدودة جداً إذا ما قورنت بالتجاوب الكبير الذي يبديه كثيرون لمحتوى ضعيف أو تافه. وهنا أمر اخر، هو ان المجتمع ولشدة الضجر الذي يعيشه افراده بسبب فشل العقل السياسي في إنعاش الموقف، فقد صار كثير من الناس يمل من، أو يميل عن سماع النصيحة والحكمة ويعدّها سلعاً قديمة جميلة مكانها في رفوف المكتبات أوعلى الحيطان أو في صفحات الكتب، وليس في الواقع، لأن الواقع مريض الى الحد الذي تورم فيه جسم المجتمع، ومما يعمق المشكلة اكثر هو إظهار إعلام السلطة أورام المجتمع على انها عافية ومنجز يشيران الى حسن إدارة البلاد.
تواجه الثقافة اليوم مسألة تحوّل أزمة الفكر الى إشكالية، ودخول الوسط الثقافي مرحلة خطيرة من شأنها ان تلقي بالمجتمع خارج الوجود الإنساني وتحيله الى ركام حضارة، وبقايا دين، وتجمعات بشرية فاقدة لمعنى المجتمع ولمفهوم المجتمع. يبدو ان مشكلة ثنائية الدين والدولة تكمن في ان السلطة الحاكمة لا تعادي الدين بقدر ما تجد في مواقع التسلط قدرتها على تجاوز وحدة الإنسان التي هي هدف دين التوحيد، الى التعامل مع موضوع وحدة الانسان على انها حاجة وليست هدفاً وهي بذلك ترتكب الشرك في مناخ التوحيد، الأمر الذي تسبب في إرباك جو العقيدة في المناخ الاجتماعي والثقافي والسياسي، الأمر الذي دفع ببعض المثقفين الى تبني فكرة فصل الدين عن الدولة، او جعل الدين على هامش الحياة، وسط دعوات عالمية الى ثقافة كونية تذوب فيها كل الخصوصيات الثقافية في قالب أمركة الثقافة العالمية.
لعل بقاء الثقافة مرتبطة بالسياسة في ادارة الدولة حتى بعد انحراف السلطة عن مشروع الإمامة والقيادة الذي بدأه النبي الخاتم، قد أدى الى انقسام مصادر ثقافة المجتمع الى دينية وسياسية، الأمر الذي نتج عنه فشل حضور الدين كباعث للنهضة الثقافية في المجتمع العربي المعاصر واقتصار سعة الحضور الإجتماعي للدين على ممارسة الطقوس والعبادات. وفي الوقت نفسه فشلت السياسة في حضورها الإجتماعي كقوة حقيقية ساندة وداعمة ومحركة لمشروع تمكين المجتمع ثقافياً، واقتصار دورها في علاقتها بالمجتمع على تمشية وتنظيم امور الناس الحياتية اليومية في جوانبها الامنية والمعاشية.
ان من بين اسباب تأخر المجتمع العربي هو ان الصراع على السلطة يبدأ سياسياً ويستمر سياسياً حتى في جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والدينية و...
في المجتمع الإنساني لكي تتطور الثقافة ينبغي على السلطة التي تبدأ نشاطها سياسياً ان تستمر ثقافية، ولأن هذا الأمر غير متحقق في المجتمع العربي الإسلامي، لذلك تصيب الصدمة جيل الشباب العربي اليوم في عصر التقنية المتطورة والانفتاح على العالم، وهو يرى في بيئته العربية الإسلامية طبيباً بلا إنسانية، أو معلماً بلا ضمير، أو معمماً بلا قيم، أو أكاديمياً بلا اخلاق، أو موظفاً حكومياً بلا أمانة.
في القرن الثامن عشر، قال الكاتب والفيلسوف الألماني فولتير ان بمقدوره إحداث ثورة كبرى في العقول في ظرف سنتين او ثلاث اذا وجد الى جانبه خمس أو ست فلاسفة ومطبعة. أما اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين، عصر التقنية ومشاريع الذكاء الإصطناعي فيمكنني ان اقول ان بوسعنا احداث ثورة في العقول اذا تمكنا من فصل الثقافة عن سياسة الدولة ومنحها سلطة مستقلة.
***
د. عدي عدنان البلداوي