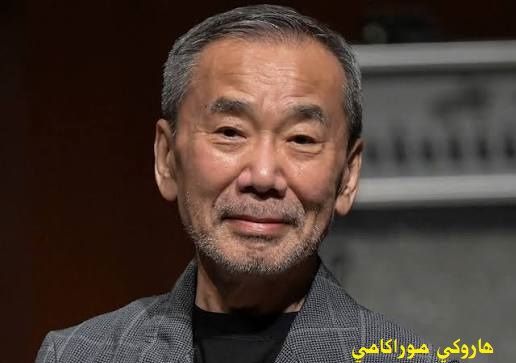نصوص أدبية
ناجي ظاهر: غراميات في المعهد الاسباني

اعتليت المنصّة المرتفعة العالية في المعهد الاسباني القائم في مدينتي المحافظة المقدّسة. تمعّنت في الحضور. لفت نظري صديقي الرسام الفوضوي الممسوس. كان يقف قُبالة لوحته الوحيدة المعروضة هناك على أحد الجدران المنخفضة في القاعة. تمعنت فيه وفي لوحته وانا أفكر فيه وفيها. لقد لامني لان الجميع بمن فيهم اداريو المعاهد البريطانية والفرنسية والأمريكية وآخرهم في بلدتي البشارية المعهد الاسباني، يدعونني بصفتي شاعر المدينة لإلقاء الشعر في معاهدهم خلال هذه المناسبة أو تلك، لامس لومه هذا شغاف قلبي فما كان منّي إلا أن اقترحت عليه أن يرسم ثورًا يواجه مصارعه بقرنين واهنين وعينين دامعتين. نفّذ صديقي ما اقترحته عليه وتمّ الاتفاق على أن تعلقها سكرتيرة المعهد هناك إشارةً وتلميحًا إلى ما امتازت به بلادهم وعُرفت به في مجال مصارعة الثيران. لم يطل انتظاري لأن يلتفت إلي صديقي الرسام الهُمام، فقد رأيت سكرتيرة المعهد الفاتنة تتوجّه إليه.. وتلفت نظره إلى أننا سنبدأ البرنامج وأنني.. أنا صديقه ومرافقه الشاعر اعتليت المنصّة للبدء في القراءة والانشاد.
مشى صديقي الفنان متمايلًا بُسمنته الزائدة نوعًا ما وكرشه يمشي أمامه، سار وراء سكرتيرة المعهد وفاتنته الخلابة، حتى وصلا إلى المقعدين الاولين في الصف الأول، القريب جدًا من منصّة الالقاء. وجلسا. ران صمت جميل اعتدت على مثله في مثل تلك الحالات والمواقف، وكان الوقت قد حان واللحظة أزفت لأن ابتدئ بتلاوة الشعر. ابتدأت في القراءة همسًا، وعندما لاحظت أن هناك مَن يريد أن يسمع في الصفوف الأخيرة من القاعة. رفعت صوتي. رفعته وأخضته.. أخفضته ورفعته.. وكنت أترنّم مثل زاهد متعبّد في محبّة مدينته الغراء. ما إن وصلت إلى ذكر أشجار جبال مدينتي وعيشة أهلها بين ازهارها الساحرة الملونة، حتى رأيت نظرات تلك السكرتيرة الناعمة تنغرس في كلّ كلمة وحرف ومعنى.. متجاوزة عيني إلى ما أتوقعه من مناظر تلك البلاد.. بلادها التي اقام بها أجدادي وأجدادها فيما بعد أكثر من ثمانية قرون من الزمان. غرست عينيّ في عينيها. ولم أعد أرى سواها في القاعة. بالضبط مثلما شعرت. خلال ثوان بتنا نحن الاثنين فقط في دائرة واحدة. وبقيّة افراد الحضور في دائرة أخرى أقرب ما تكون وأبعد ما تكون. انتهيت من قراءة قصيدتي وفوجئت بعينيّ تلك السكرتيرة الفاتنة تطلبان مني أن أعيد القراءة. فأعدتها وأنا أشبه ما أكون بإنسان أثمله الوجد. عند انتهائي من تلك القراءة صفّق لي جمهور الحاضرين بحرارة غير معتادة. غير أنني لم أر من بينهم سوى اثنين، صديقي الرسام المغبون وتلك الفاتنة الاسبانية.
في القاعة الفاتنة التف حولي جَمع من الناس، وطلب بعض منهم أن أوقّع له على ورقة او كتاب كان يحمله بيمينه. وانفض الجمع ليبقى الاثنان المعنيان حولي وقريبًا منّي. السكرتيرة ذهبت إلى شأنها في الاشراف على الأمسية ومواصلة انجاحها لها، وصديقي الرسام توقّف إلى جانبي مثل صنم حائر النظرات وهمس لي:
-ألم تر إلى اهتمام تلك الفاتنة بك.. كانت ستأكلك بعينيها اللامعتين.. ولولا رهبة الموقف لدخلت إلى ازهار جبالك وأشجارك.. لتقيم هناك.
ابتسمت لصديقي وأنا افكّر في ثَوره المطلّ من لوحته على عالم قاس مجنون. لم أجبه. كنت متداخلًا في تلك اللحظة المختلفة في حياتي وأنا أتساءل هل ما رأيته في تلكما العينين كان حقيقة أم حلمًا. بالنسبة لي كنت متأكدًا أنني إنما أعيش واقعًا من أعلى الرأس حتى أخمص القدم. لكن ماذا من ناحيتها. لأنتظر. وقبل أن أتوقّف عن التفكير فيها. اقتربت منّي وبيدها صينية عليها ثلاثة فناجين ملأى بالقهوة العربية الاسبانية المعتّقة. قدّمت الفنجان الأول لي وهي تواصل نظراتها الهائمة في دنيا الشعر ومسقط راسي.. وجبال مدينة الناصرة. بعدها قدّمت فنجانًا لي. هنا أرسلت نظرة إلى صديقي الرسام الواقف متكلّسًا إلى جانبي مثل إله مخذول. وقدّمت اليه الفنجان. رفضه في البداية وعندما ألححت عليه تقبّله وراح يقبّل حفافة وأكاد أقول شفتيه بنهم وجوع فائقين.. أو من عالم آخر. ناولتني فاتنتي الفنجان الثاني، وهي تغمز لي عاتبة وموحية أنها إنما أرادت أن تُقدّم لي الفنجان الأول. وليس الثاني. فهمت ما قالته عيناها. ووعيته تمام الوعي.
اقتعد ثلاثتنا مجلسًا خاصًا حول طاولة لا يمكّن حجمها المحدود المتواضع أكثر من ثلاثة أشخاص من الجلوس حولها. وكنت أفكر في تلك المرأة ولمعة عينيها العمميقة.. بعيدة الغور.. ناسيًا مَن هي ومِن أين أتت، ما هو وضعها الاجتماعي. مِن أي مدينة.. ومَن هم أهلها. كان تفكيري كلّه مُنصبًّا عليها. لكن عندما استفاق الشاعر الذكي الحسّاس في داخلي. خطرت لي خاطرة فكيف ستستمر علاقتي بها؟ وكيف سأحافظ عليها من عيون الرقباء والعذّال في بلدة تحسب على أبنائها كلّ حركة ونأمة؟.. وما هو المطلوب منّي الآن وقد عثرت على جوهرة حياتي ومُستقر أحلامي.. اشعاري وأمنياتي.. وخطرت لي خاطرة ما لبثت أن ابتدأت بتنفيذها. نظرت في عينيّ صديقي الرسم الرانيتين إلى المحبّة بعد حرمان.. والمعزة بعد إذلال.. كان أقلّه عدم الاعتراف به وبرسمه وبالتالي عدم دعوته إلى المنصّات الكبيرة. ورأيت فيهما نوعًا من اللوم. فلماذا أنت وليس أنا؟.. وهنا أمسكت بيده وأنا أدعو فاتنتي وانطلقنا مُجتمعين باتجاه لوحة الثور والمصارع. توقّفنا قُبالتها ونحن نتأمل بها. بعد لحظات سألتها. عن رأيها في اللوحة. وقبل أن تُجيب راح صاحبها.. صديقي المغبون.. يرتّب قميصه فادخل ما خرج من أطرافه داخل بنطلونه، محاولًا إخفاء كرشه. رتّب نفسه وهو ينتظر رأي سكرتيرة المعهد بحيطة وترقب.. فرأيها أهم من كلّ الآراء بالنسبة له على الأقل. ناهيك عن أن هذا الرأي هو مَن سيجعله يتنفّس فوق الماء بعد زمن طال من انتظار التنفس فوقه، وربّما يفتح له العديد إذا لم يكن كلّ الأبواب الموصدة. تمعنت السكرتيرة في اللوحة مركّزة على عيني الثور الرانيتين إلى عيني المصارع فيها. وأشارت إليهما. فهمت بحساسيتي المُرهفة أنها ستسأله عن سبب ذلك الضياع الظاهر في عيني الثور. فسارعت إلى قطع الطريق عليها قائلًا: لقد أحب صديقي الرسّام، وهو بالمناسبة الأقرب إلى نفسي في مدينة التاريخ والحضارة. أن يكرم معهدكم الاسباني بلوحة تقدم شيئًا من حضارته وملامحها التصارعية الرائعة. وصلت رسالتي إلى رفيقتي. فراحت تتحدّث عن مصارعة الثيران وعمّا كتبه شاعر إسبانيا الثوري الإنساني عن صديقه مصارع الثيران بعد صرع ثور هائج له. اندمج ثلاثتنا هذه المرّة في الحديث. وحقّقت ما أردت تنفيذه من فكرة خطرت لي. هكذا بات مُرافقي محور الحديث. وهكذا تمكّنت مِن إخفاء مشاعرنا الجيّاشة، أنا وسكرتيرة المعهد، في حلمها وغرامها المفاجئ، مثل غيمة اسبابانية اندلسية قادمة من مرافئ بعيدة. بسرعة كبيرة تمكّنت من تحويل صديقي الرسام إلى ما تبقى من أحاديث شارك بها آخرون خاصة من فاتنات الجنس اللطيف. وطالت تلك الأمسية متخذة من مصارعة الثيران الاسبانية مدارها في توقفاته واستمراراته. وكنت كلّما لمست من المحيطين أنهم يلاحظون إلى اهتمام تلك السكرتيرة الفاتنة بي، صرفتهم إلى مواصلة الحديث عن مصارعة الثيران وعمّا تقوله لوحة صديقي ومُرافقي الرسام مِن آلام وعذابات. لا تعرفها إلا القلوب المُحبّة المتيمة شوقًا وتوقًا.
***
قصة: ناجي ظاهر