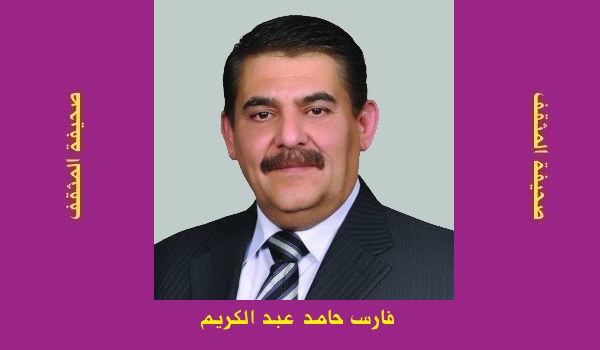كتب ماجد الغرباوي
تحديات العنف - ماجد الغرباوي

الكتاب: تحديات العنف
المؤلف ماجد الغرباوي
عدد الصفحات: 416
الحجم: كبير
الطبعة: 2009 م
اصدار: الحضارة للابحاث ودار العارف
***
رابط بديل لتحميل كتاب تحديات العنف
مقدمة الطبعة الأولى لكتاب: تحديات العنف
ليس العنف طارئا، او غريبا على سلوك الانسان، فماضي البشرية حلقات متواصلة من الحروب، وتاريخها مشهد تراجيدي موشح بالدماء، ونكبات الموت ترسم صورة قاتمة لمستقبل الحضارة الانسانية. وليس في الحياة سوى نكبات متوالية، وكوارث مرعبة. انها ثقافة العنف الذي شكل تحديا خطيرا لوجود الانسان منذ القدم، فراح يهدد امنه وسلامته واستقراره. ويهوي به عميقا في لجة التوحش والانحطاط. وهو اليوم احد اخطر التحديات واكثرها تعقيدا، وقد امتدت تداعياته الى اغلب المدن فسلبتها امنها واستقرارها. واختلطت الاوراق بشكل متشابك وملتبس بسبب ما احدثته تلك العمليات من رعب واستفزاز اجتاح الساحتين الدولية والاقليمية، وبات من الصعب العثور على واحات سلام تسمح بالمراجعة والنقد، وتحري الخطأ وتشخيص الحلول الناجحة لتسوية الازمات، اذ ارتكز الجميع الى فوهات البنادق لتصفية الحسابات، والتشبث بالعنف لتسوية الخلافات. ولم تقتصر حالة اللاوئام على العلاقات الدولية بل شملت ايضا علاقة الحكومات بشعوبها، والسلطة بالمعارضة، والحركات والاحزاب السياسية فيما بينها. حتى صارت بعض الدول تعاني خطرين محتدمين في آن واحد، خارجي يتمثل بالقوات الغازية والمحتلة والمعتدية، وداخلي يتمثل بالممارسات الارهابية والعمليات الانتحارية واعمال التخريب والمؤامرات وتأجيج نار الفتن من خلال الاستمرار في تصعيد وتيرة العنف. اذ اخذت تتصاعد حدة المواجهات كلما اجتاحت العالم موجات ارهابية جديدة، واصبح العنف يواجه بعنف اشد قسوة وشراسة، وبهذا الشكل عاشت الحكومات والشعوب في دوامة من القلق والترقب والحذر مخافة ان يطالها عمل ارهابي يزعزع امنها واستقرارها. وصار العنف والعمليات الارهابية الشغل الشاغل لوسائل الاتصال، فما تمر ساعة الا وتطالعك وكالات الانباء بخبر انفجار هنا او نشوب اعمال عنف هناك، قتال في هذه الدولة ومعارك في دولة اخرى. صراعات دموية تجتاح خطوط التماس، ارهاب مسلح يقضي على مشاريع التعدد والتسامح والوئام. انفجار سيارة ملغومة، تفجير عبوة ناسفة، انهيار مبان ٍ وعمارات سكنية، تخريب منشآت حيوية. قتل جماعي، تعذيب في السجون، تفرد بالسلطة، اقصاء المعارضة. فتاوى تكفير، ضبطية عدلية لمراقبة التأليف والنشر. فلا تجد شيئا يبعث على التفاؤل والامل سوى الترقب والحذر واتخاذ التدابير اللازمة.
وقلما ارتكزت الاطراف المتنازعة (دولة/ دولة، سلطة/ معارضة، حركة سياسية/ حركة سياسية) في تسوية خلافاتها الى لغة الحوار والتفاهم، لا لأنها تجهل دبلوماسية العلاقات وفن السياسة والمداراة ولعبة الديموقراطية، وانما غلبة روح السيطرة والاستبداد ألجأت البعض الى التنابذ والاقصاء والاستخفاف بالاخر وحقوقه المشروعة. خاصة عندما ولج الساحة السياسة التيار الاسلامي بشتى اطيافه. ولا فرق بين دولة واخرى في تعاملها مع المعارضة، اسلامية أو غير اسلامية. كما لا تستثنى الدول الديموقراطية وغالبية الدول الغربية، بعد ان اعتمدت في علاقاتها الخارجية، سيما مع شعوب وحكومات العالم الثالث، سياسة تختلف في انماطها وسياقاتها عن السياسة التي تنتهجها مع دول وشعوب ترتبط معها ايديولوجيا، أو استراتيجيا أو توحـّد مواقفها المصالح الاقتصادية والقومية المشتركة. وهذا اللون من السياسة غير المتوازنة، التي لا تحكمها المبادئ بقدر خضوعها لسلطة المصالح الايديولوجية والاقتصادية، اججت نار الغضب لدى شعوب كاملة في المنطقة واثارت حفيظتها الى حد الزهد بالحياة دفاعا عن النفس والحقوق المشروعة. واذا كانت العلاقة تميل احيانا نحو التهدئة فان الازمة تفاقمت في العقود الاخيرة من القرن المنصرم وهذا القرن حتى تحول العنف الى سلسلة اعمال ارهابية وموجة تفجيرات وعمليات انتحارية طالت مناطق واسعة من العالم. غير أن المؤسف ثمة اسلاميين متطرفين وراء جملة من تلك الاعمال الاستفزازية المرعبة. لذا رافقتها تداعيات خطيرة للغاية انعكست بشكل واضح وسريع عبر صدامات ميدانية وحملات اعلامية مكثفة لتشويه المعالم الاخلاقية والسلوكية والانسانية للمسلمين والنيل من قيم الحضارة الاسلامية. وراح العنف والعنف المضاد يسود علاقة المسلين مع غيرهم. واتهمت الرسالة السماوية بالدموية، حتى بات العنف علامة فارقة تتصف بها الحركات الإسلامية جميعا، ومؤاخذة تلاحق الإسلاميين بل مطلق المسلمين، لا بسبب ما يرتكبه بعض المتطرفين الدينيين من أعمال إرهابية فقط وإنما أيضاً بفعل تحيز وعدم حيادية الاعلام الدولي خصوصا الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التى وظفت كل حدث في معركتها ضد الإسلام والمسلمين، متهمة الفكر الإسلامي والتعليم الديني بتشجيع الإرهاب والعنف. لكن يغفل هذا الاعلام الدور الاوربي في تضخيم ظاهرة الارهاب بل وخلقها كما حصل في افغانستان، اذ عملت هذه الدول على تأسيس وتعبئة ودعم واسناد حركة طالبان بشكل مباشر او عبر وسائط دولية من اجل ضرب الروس وحلفائهم، حتى اذا انتهى دور الحركة وتفاقم خطرها حولتها الى عدو لدود يجب القضاء عليه. كما وقفت تلك الدول الى جانب الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه ضد ايران 1980- 1988وأمدته بكافة الاسلحة والمعدات والتكنولوجية المتطورة، ولما تحول الى خطر يهدد المصالح الاستراتيجية والقومية للدول الغربية ودولة اسرائيل تحالف الجميع ضده . ولولا الدعم الذي كان يتلقاه الطاغية السفاح صدام لما تحول الى دكتاتور مستبد يمشي على جثث الشعب العراقي ويهدر ثرواته وطاقته من اجل اشباع غرائزه في التسلط والقتل والعنف والارهاب، ولما عاش الشعب محنة تواصلت اكثر من ثلاثين عاما.
إن التكثيف الاعلامي المضاد لوسائل الاتصال الحديث، بطريقة متهورة احيانا، ليس اقل خطر من الأعمال الإرهابية ذاتها التي يرتكبها البعض باسم الدين، أو هكذا يحلو لتك الوسائل أن تصفها. حتى تنبـّه ساسة بعض الدول الى خطورة النتائج المترتبة على الأسلوب الاستفزازي للاعلام المضاد. فمثلا دعا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا في حينه وقبله جورج دبل يو بوش الرئيس الامريكي الى توخي الحذر في إثارة حفيظة المسلمين والتمييز بين ما هو إسلامي ينتسب للدين الحنيف وما هو إرهابي يرتكبه بعض المتطرفين باسم الدين، مخافة أن ينقلب المسلمون اشد عنفا إذا ما تمادت وسائل الأعلام في سياسة الطعن والتشويه، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب في صراعها مع الدول المتسلطة، وحقها في التعبير عن ارادتها. وهكذا وضع الاسلام في قفص الاتهام حتى في حالات الدفاع الشرعي عن الذات والهوية.
ولاشك أن التيارات المعادية للإسلام أو تلك التي لها خصومات تاريخية مع الحضارة الإسلامية قد استغلت ممارسة المتطرفين الدينيين لتوغر صدور الشعوب غير الإسلامية ضد جميع المسلمين، حتى أكدت وسائل الأعلام وقوع المزيد من أعمال العنف والتطرف العنصري ضد الجاليات المسلمة في اكثر من دولة من دول العالم إثر كل عملية إرهابية يقوم بها المتطرفون. بل بات المسلم في نظر هذه الشعوب حيوانا مفترسا لا يستحق الحياة، بعد تجرد الإرهابيين من قيمهم الإنسانية وارتكابهم أعمالا مخزية ضد البشرية، أو ضد التطور الحضاري. فصار العنف يشكل تحديا كبيرا للمشروع الإسلامي الحضاري بفعل ضخامة الترسبات وتراكمها في ذاكرة المجتمعات البشرية. وقد اصبح بيد الاخر المختلف ما يستدل به على وحشية الممارسات الاسلامية في معالجة القضايا الراهنة، اذ يعطي هؤلاء للعقل والحوار الديمقراطي قيمة مطلقة في حل جميع القضايا التي تهم المجتمع والدولة قياسا على الاجواء التي يعيشها في بلاده ولا يتفهم الضرورات التي تلجأ الشعوب الى القوة، كالاحتلال والظلم والاضطهاد، بفعل ما يعيشه من تظليل اعلامي، ولا يعي حقيقة ما تقوم به الدول الكبرى من ممارسات لا حيادية تجاه الشعوب والبلدان الاخرى.
ثم ان الأمر يختلف عندما تمارس تلك الدول العنف، فان تقدمها الهائل في مجال العلم والتكنولوجيا إضافة الى دعاوى العقلانية وحقوق الانسان واعتماد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وامتلاكها لمختلف وسائل الأعلام المتطورة، يشفع لها في نسيان أو تناسي ما تقترفه بحق الشعوب، سيما إذا اخذنا بنظر الاعتبار تركيز تلك الدول في تحركاتها خارج الحدود على الشرعية الدولية التي هي صنيعتها بشكل واخر. اما المشروع الإسلامي فانه قائم اساسا على القيم والاخلاق وطالما آخذ الحضارات المادية لعدم التزامها بالقيم الانسانية، فالأولى بالمسلمين ان يكونوا اشد التزاما بالاخلاق والقيم. فارتكاب أي عمل ارهابي غير مبرر من قبل بعض المتطرفين الدينيين تكون له انعكاسات سلبية واسعة على الاسلام والمسلمين، سيما الجاليات الاسلامية في الدول غير الاسلامية. التي تجتاحها مع كل عملية ارهابية أو ممارسة عنيفة، لا تفهم الشعوب مبرراتها، عاصفة شكوك واتهامات تطوق منافذها الحياتية وتحدد علاقاتها العامة، وتضعها في دائرة الشبهة والمراقبة المستمرة لكل مفردات سلوكها الجماعي وربما الفردي.
ان ممارسة العنف واستخدام القوة في الإسلام تجري وفق ضوابط خاصة تطوقها خطوط حمراء ومساحات محرمة واسعة، فهي قوة للدفاع عن النفس والحقوق المشروعة، لا يسمح معها بالاعتداء والتجاوز على العزّل والابرياء من الناس، او الاطاحة بالممتلكات العامة، تحت أي عنوان كان ما لم يجد العنف مبرره الشرعي. كما ان القوانين الدولية الرافضة للارهاب تلتقي مع الإسلام في استخدام القوة دفاعا عن النفس وردعا لتجاوزات المعتدين،وترفض ايضا استخدام العنف اللامبرر.
ان بعض الحركات الاصولية المتطرفة مارس العنف بشكل مريب ومكثف، متخطين بذلك كل القيم الدينية والخطوط الحمراء التي ارستها الشريعة المحمدية، ولم يتوقفوا عن ارتكاب مجازر العنف حتى مع المسلمين، ممن يختلف معهم مذهبيا أو فكريا أو عقديا، ويكفي لتأكيد ذلك مسلسل الاعمال الطائفية التي ارتكبها هؤلاء في باكستان والعراق وافغانستان ضد اتباع المذاهب الاسلامية، بل وابناء المذهب الواحد والدين الواحد والوطن الواحد كما في كثير من البلدان الإسلامية مثل الجزائر ولبنان حتى (أدى التوسع العنيف لادعاءات الهوية التي تستبعد الآخرين الى كثير من المعاناة والتضحيات. ويقدر ان الصراعات بين الدول داخل العالم العربي تسببت بين 1948 و 1991 في مقتل ما لا يقل عن 1.29 مليون نسمة وتهجير نحو 7.3 مليون نسمة) . ناهيك عما حدث بعد هذا التاريخ من مجازر في المنطقة ذاتها. فقد كان ضحية الموجات الارهابية (نفذها الاسلاميون ام غيرهم) في مصر بين 1992- 1995 مالا يقل عن 984 شخصا، كما عاشت الجزائر اضطرابات ارهابية دامية، وقد اعتبر جل الملاحظين ان حصيلة الهجمات بلغت ما لا يقل عن اربعين ألف وربما اكثر . كما حصدت الاعمال الارهابية في افغانستان وباكستان والهند والسعودية ودول اخرى الآلاف من الضحايا، وعندما نصل الى العراق نجد الاعمال الارهابية حولته بعد سقوط التمثال حتى موعد تشكيل الحكومة الانتقالية الى لوحة متشحة بدماء الاطفال والنساء، ومطرزة بجماجم العزّل والابرياء. فلم يبق جزء بما فيها الاماكن المقدسة لدى الشعب الا واستباحته الموجات الارهابية المعادية للسلام والحرية، ويكفي مثالين على ذلك تفجيرات كربلاء والكاظمية ابان الاحتفالات بذكرى عاشوراء التي راح ضحيتها 100 قتيل ومئات الجرحى. كما تركت العمليات الانتحارية في مدينة اربيل في شباط /2004،176 قتيلا خلال مراسم العيد وفي مدينة الحلة العراقية شباط/2005، كانت حصيلة تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبي: 117 قتيلا و143 جريحا . عدا العمليات الاخرى التي استنزفت الطاقات الشابة وقضت على الرحال ومزقت النساء والاطفال، واستهلكت الشعب بجميع فئاته، وعطلت حركة الحياة، وأبادت الاقتصاد والحركة التجارية، وفتت البنى التحتية، كحادثة النجف التي اطاحت باكثر من 650 شخصا بين قتيل وجريح . واخيرا اطاحت حوادث العنف التي اجتاحت المدن العراقية (الفلوجة، كربلاء، تكريت، النجف،الرمادي، الكوفة، كركوك، الناصرية، بغداد، البصرة، العمارة) والتي ما زالت مستمرة باعداد هائلة من ابناء العراق الكئيب. وما زال مسلسل التفجيرات اليومية التي لا حصر لها متواصلة . ورغم عدم توفر احصائيات دقيق عن عدد القتلى والمجروحين، الانه – بلا شك- قد تجاوز عددها الالف بكثير ما عدا المجروحين ، والدمار الكبير الذي عم تلك المدن وضواحيها . بل ارتفعت بعض الاحصائيات بالضحايا الى 30 الف او مئة الف من المدنيين. وفي احدث تقرير ان: 6600 قتلوا و8000 أصيبوا خلال شهرين بالعراق. وفي 2/1/2007 اعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل 12 الف عراقي في عام، 2006، ذكرت ذلك جميع وكالات الانباء.
ويبدو ان وتيرة العنف والعمليات الارهابية في العالم في تصاعد ما دامت بؤر التوتر لم تلامس حلولا موضوعية ولا يقابل العنف الا بعنف مضاد، سرعان ما يتحول هو الآخر الى سلطة فوقية تمارس العنف والاضطهاد .
واذا كان لبعض الممارسات المسلحة ما يبررها، الا ان اكثرها لا يتوفر على مستلزمات العمل المسلح. والغريب ثمة من وجد ضالته في ذبح الشعب العراقي، الذي ما فتئ يعاني مرارة الخطابات الأيديولوجية وتبعاتها الباهضة، فصار يبارك الدماء المستباحة ويشجع على اقتحام الموت من اجل هدف غير واضح، ويسمي العنف والارهاب مقاومة وجهادا في سبيل الله تعالى، امعانا في تحطيم البنية الاجتماعية للشعب وزجه في معركة يعلم جيدا انها خاسرة. ولم يترك لابناء الوطن فرصة للتفكير باساليب حضارية تمكنهم من تجاوز المحنة التي يمر بها البلد . كما شاعت في هذه المرحلة مقولات دفاعية وخطابات سياسية لا تفرق بين حق المقاومة وجريمة قتل الابرياء والمدنيين، فالتبس الامر على كثير من الناس الطيبين والابرياء، حتى اندفعوا ببراءة وراء نوايا عدوانية مغرضة.
ونؤكد لسنا ضد مقاومة الاحتلال، وان كنا نختلف في تحديد اساليبه وآلياته، وانما ضد العنف والارهاب الذي يريد النيل من وحدة الشعب وزعزعة صفوفه المتراصة. والا فالمقاومة قد اعترف بشرعيتها ساسة الدول الكبرى فضلا عن ابناء الشعب، فقد صرح الرئيس الامريكي بوش قائلا بخصوص المقاومة العراقية: (ان الانتحاريين ارهابيون، ولكن المقاتلين الآخرين ليسوا كذلك، فهم لا يتحملون ان يكونوا محتلين) . اذ من حق كل الشعوب مقاومة الاحتلال لكن للمقاومة استراتيجيتها وضروراتها. فاذا كان هناك وسائل اخرى كفيلة بانهاء الاحتلال يجب الارتكاز اليها قبل اللجوء الى العنف حفظا لدماء الناس وارواحهم، لكن يبدو ان البعض لا يهمه ارواح الناس، او لا يعي مدى حرمتها عند الله والاسلام.
وعندما تؤكد الحركات الاصولية عبر وسائل الاعلام مسئوليتها عن بعض الاعمال في اماكن متفرقة من العالم وتفتخر باقترافها يستفيق المسلمون على جملة اسئلة واستفهامات حائرة: ما الهدف من هذه الممارسات؟ هل هي حرب ضد ارهاب الدول الكبرى كامريكا وحلفائها، فلماذا يقتل الابرياء؟ هل هي جهاد في سبيل الله، فلماذا يتقاعس العلماء؟ هل هناك ما يبرر أعمالهم شرعا فلماذا لا تستجيب لهم الشعوب المسلمة؟ من الذي يجيز لهؤلاء قتل الرجال والنساء في كل مكان؟ ومن المسؤول عن فتاوى التكفير ورمي الآخر بالردة والانحراف؟ وهل الرأي الاخر مبرر للقتل والعدوان؟ ولماذا لم يقتل الرسول (ص) جميع اليهود والنصارى بل من لا دين له من العرب وغيرهم؟ وهل الحرب والسيف الوسيلة الوحيدة لنشر الإسلام وبيان الحقيقة؟ لماذا لا يتمكن المسلمون مقارعة الكلمة بالكلمة؟ وهل صحيح إن الإسلام عاجز عن ممارسة الديموقراطية واقناع الآخر بوسائل وآليات حديثه؟ هل حصلت للمتطرفين شبهة عقدية؟ هل يتلقون توجيهاتهم من جهات اعلى؟ من هي هذه الجهات؟ هل هم فقهاء؟ واي فقهاء؟ هل يفقهون الحياة؟ وهل يدركون مقاصد الشريعة وغاياتها؟ وهل يعترفون بدور الزمان والمكان؟ ام فقهاء متحجرون، متغطرسون؟. وغيرها من الأسئلة التي تراود فكر كل إنسان مسلم يقف متحيرا أمام الممارسات العدوانية لبعض المسلمين المتطرفين وباسم الدين. فهل هذا هو النموذج الحضاري البديل الذي نقدمه للبشرية اليوم؟ وإذا عجزنا عن اللحوق بالغرب صناعيا وتكنولوجيا فلماذا لم نتفوق عليهم أخلاقيا وسلوكيا؟ وهل مهمة الدين قتل النفوس ام احياؤها؟ وهل الإسلام يخشى الرأي الآخر كي نلجأ الى العنف أولا؟ وهل ان موضوع الجهاد وقتال البغاة فعلي كي نتصدى لذلك تنظيرا وعملا؟ وهل مارس المسلمون الأمر بالمعروف أم اكتفوا بالنهي عن المنكر؟ أليس للحرب ميادينها فلماذا نغادر ساحات الوغى الحقيقية لنرسم في ذاكرة الاجيال صورة مرعبة عن الاسلام والجهاد في سبيل الله؟ إن معارك العزة والشرف تفتخر بها كل الشعوب، لكن للحرب قوانينها وميادينها واصولها، فمن يطلب العزة والمجد والشهادة والشرف فليواجه العدو في ساحات الجهاد لكي تفتخر به الشعوب الحرة الكريمة وتتباها امام الامم والعالم اجمع.
فهل يعني الجهاد قتل الابرياء خلال ممارستهم لطقوس العبادة والصلاة؟ هل الاختلاف معهم دينيا أو مذهبيا يبرر قتلهم بشكل عشوائي مفجع؟ وهل من الجهاد أن تفجـّر الساحات العامة والمباني والمؤسسات ومحطات النقل؟ وهل من الجهاد قتل الذين يمارسون شعائرهم الدينية باسلوب انساني مسالم؟ وهل من الاخلاق قتل النساء والاطفال وذبح الاسير، من الوريد الى الوريد؟ انها اعمال لا انسانية فكيف يرتضيها دين الاخلاق والقيم الانسانية.
ثم هل كل ما يقوله الفقهاء والمنظرون الدينيون هو الإسلام بعينه أم أنها اجتهادات ووجهات نظر تختلف من شخص الى آخر؟ وإذا كانت كذلك لماذا يتحول الاجتهاد الى مقدس مطلق لا يمكن المساس به؟ ولماذا يبقى كلام الفقهاء حجة على البشرية على مدى الزمان؟ بل لماذا لا نتراجع عن الفكرة أي فكرة (مادامت هي اجتهادا شخصيا) إذا اكتشفنا خطأها؟
اعتقد آن الأوان ان نكون صرحاء مع أنفسنا ومع مجتمعنا وان نقدم على مناقشة كل مفردة دينية أو عقدية مناقشة علمية موضوعية في ضوء القرآن والصحيح من السنة، وان نعلن النتائج امام الملأ العام كي يكون الجميع على بينة من الامر، وان نصّـر على إنهاء مراحل الاستعباد والاضطهاد الفكريين، وفرض القيود العقدية والأغلال المذهبية وتكبيل العقل بمقولات مصاغة وفق خطاب أيديولوجي استبعادي يرفض الآخر ويتعالى عليه، والكف عن منطق الوصايا، والقيمومة على الفكر والدين، واعتبار الناس عواما وقاصرين لتبرير منطق الابوة الروحية والقيمومة الشرعية. علينا مقاربة الاسئلة الممنوعة واستنطاقها لا مجرد الدوران حولها. وننقب في اعماق التراث بحثا عن مكوناته وآليات تكوّنه، اذ ما زال التراث يتحمل القسط الاكبر من مسؤولية التخلف الحضاري للمسلمين. وما زال التراث سلطة ارهابية تقمع أي مبادرة تجديدية أو خطوة اصلاحية.
من هذا المنطلق أجد من المناسب ان نجري حوارا مع الذات عن الخلفية التي ينطلق منها الأصولي والمتطرف في ارتكابه ممارسات إرهابية وإقدامه على عمليات انتحارية ضد الناس الأبرياء، فالتمادي في ممارسة الارهاب المسلح دون مناقشات علمية للبنى العقدية القائمة عليها، سيجعل من الاخيرة مرجعية أو سيرة عملية يرتكز اليها كل من يبغي محاربة الآخر ممن يختلف معهم دينيا أو فكريا أو عقديا. وبالتالي سنشارك في جناية تاريخية تنعكس على الدين الحنيف والقيم الإسلامية العالية. فيكون الدين هو الخاسر الأول في المعركة وسنمنى بخسران مبين تحبط معه جميع اعمالنا (قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة) .
كما يجب اعتماد المنهج القرآني في تقصي الاشكاليات والغور في عمق الاسئلة الراهنة، وان لا نلوذ بالممنوع ونتستر على الاخطاء بل نهتك استار الممنوع ونقتحم الخطوط الحمراء ونتوغل في عمق الجزر المغلقة، ونغور في اعماقها، ولا نقف على اعتاب العقائد والتقاليد والتراث. فالمنهج القرآني كان صريحا في طرح اشكالات الكافرين والملحدين وخاض معهم في اخطر مسألة ليس هناك اخطر واهم منها بالنسبة لجميع المسلمين، أي مسالة وجود الله تعالى ووحدانيته. واعلن في منتهى الصراحة ان لكم مخالفين في الدين والعقيدة، وعلمّـنا اسلوب التعامل الناجح مع الرأي الاخر(ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) . فكل ما يقع خارج وحدانية الله تعالى ونبوة محمد (ص) وحرمة القران الكريم، يحتفظ بتاريخيتة ويخضع للنقاش والمسائلة.
ان ما يحدث في بعض الدول شيء مدهش ومرعب، والذي يستوقف الباحث حقا هو الاسباب الحقيقية وراء موجات العنف المتعاقبة. لماذا لا تتوقف الممارسات العدائية رغم وعي الجميع خطورة تداعياتها؟ ولماذا الاستمرار بالعنف رغم فداحة سلبياته؟ ولماذا لا تركن الشعوب للسلم والحوار، قبل الانزلاق في معارك خاسرة ومكلفة؟.
كل هذه اسباب ظاهرية واضحة، لكننا نبحث اركيولوجيا حفريا عن الاسباب الحقيقية وراء ظاهرة العنف كسلوك يومي تمارسه بعض شرائح المجتمع، فما ان تهدأ الحالة في مكان حتى تثور في مكان، وما ان تخبو نار الفتنة في منطقة حتى تنشب في منطقة اخرى. بل العنف لم يقتصر على الممارسات المسلحة وانما اصبح ممارسة يومية، بدأت تتفشى في صفوف الجاليات العربية والاسلامية وهي تعيش اجواء مفعمة بالتسامح والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني. فما هو السبب؟ وكيف صار العنف سلوكا يوميا، وكيف انقلب الى مشاعر واحاسيس، وكيف تحول الى ثقافة وفكر وعقل ومنهج في التفكير؟ وما هو دور الطغاة والظالمين في تفاقم هذه الظاهرة، حتى بات العنف افضل الخيارات لدى الغالب من الناس، بعد غياب قيم العفو والتسامح والاعتراف بالاخر وحقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته. وهي حالة خطيرة. اذ يمكن القضاء على العنف بعنف اقوى، اذا كان مقتصرا على لغة السلاح والقوة، لكن لا يمكن القضاء عليه اذا كان ثقافة وعقلا وخطابا. أي حتى اذا اختفى العنف كممارسة عملية، فانه سيبقى ثقافة وسلوكا، يتحين الفرص لتأكيد ذاته ووجوده. وهذه ظاهرة اخرى لها اسبابها.
ان اخطر عمل مارسته الانظمة ضد شعوبها هو تدمير نظام القيم الانسانية، واستنبات قيم جديدة اعتمدت العنف واستباحت المحرمات الانسانية والدينية. ولم يبق لدى الفرد ما يؤهله لمقاومة الاضطهاد اليومي الا ممارسة عنف مضاد لتفادي تبعات السلوك العدواني للسلطة والحزب. مما يعني ان العقل والخطاب الثقافي قد تكوّنا في ظل ظروف قامت على اساس قيم العنف والارهاب والاستبداد، فكان من الطبيعي ان تمارس العنف بشكل مستمر، وهي لا تشعر بفداحة خسائره وتبعاته، وكأنه ليس ثمة اسلوب آخر يمكن الركون اليه بديلا عن العنف.
من هنا لا يكفي ممارسة عنف اقوى للقضاء على العنف، او اسكات فوهات المدافع والبنادق بكثافة نارية اكبر، وان كان ذلك امرا ضروريا احيانا، غير ان المهم اساسا هو تقديم خطاب ثقافي جديد، يعمل وفق منظومة قيم جديدة لا يساهم العنف في تشكيلها، كي يجد الفرد بدائل اخرى غير العنف لتسوية الخلافات وفض المنازعات. وهذا بدوره يتطلب ايضا عملا فوريا لتحرير مساحة كافية في العقل كي تمارس قيم التسامح والعفو والرحمة دورها، ويعتاد الفرد على سلوك جديد يتناسب مع المرحلة القادمة، ويحقق للشعب طموحه في الامن والاسلام. وينبغي ان يكون الاعتراف بالاخر، والاصغاء الى مختلف وجهات النظر، اول خطوة على الطريق. مما يعني ان الشعور بالتفوق والتفرد والغاء الآخر وتهميشه بات بضاعة خاسرة لا تحقق شيئا من طموح المستقبل. كما ان الاسلوب الابوي الفوقي المتسلط الذي يطالب الجميع بالانصياع للاوامر وترديد الاقوال، ولا يسمح بمناقشة الافكار والرؤى السياسية والفكرية، كما هو المعروف عن بعض رجال الدين والثقافة والفكر، بات هو الآخر اسلوبا متخلفا يتقاطع مع روح الانفتاح ويتصادم مع قيم الديمقراطية، ويحجم دور المواطن، فيلجأ ثانية لاساليب العنف والقمع والارهاب. بينما ملاحقة طموحات الشعب واشراكه في العملية السياسية والثقافية بعد الاعتراف بحقه ودوره القانوني سيمكن البلاد وشرائح المجتمع من تسلق قمم الرقي والتطور الحضاري ويبعث على الامن والاستقرار والطمأنينة، ويقضي على العنف وظواهره الخطرة. لذا تقع على عاتق النخب السياسية والفكرية والثقافية مهمة تفكيك الخطاب الثقافي القائم على العنف والاستبداد والقمع والتهميش والالغاء، واشاعة منظومة جديدة من القيم في اطار خطاب ثقافي قادر على استنبات مفاهيم بديلة يجب ان تتصدر اسلوب العمل السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي. كما يجب على الشعوب التحلي باليقظة والحذر في التعامل مع أي خطاب تحريضي، مهما كان مصدره.
هذه الدراسة لا تهدف الى اثارة حفيظة الآخرين واستفزاز مشاعرهم وانما تطمح الى اكتشاف البنية المعرفية لممارسة العنف من قبل المتطرفين الإسلاميين، أي محاولة اكتشاف المفاهيم والمقولات والفضاءات الفكرية والعقيدية التي تدفع المتطرف نحو قتل الانسان لا لشيء سوى انه يختلف معه عقديا أو دينيا أو فكريا. كما نحاول التعرف على الخطاب الديني التكفيري الذي يمارسه الفقهاء المتطرفون ضد الآخر المختلف دينيا أو عقديا.
ورغم محاولة هذه الدراسة استقصاء دوافع العمل الارهابي الا انها تأمل ايضا في تحديد شروط ممارسة القوة في الإسلام. فليس العنف مرفوضا مطلقا وانما له مبرراته الموضوعية سيما مع المعتدي الرافض للغة الحوار ولا يفهم سوى منطق القوة والعنف. أو كما في حالات الدفاع عن النفس أو مباغتة العدو المتأهب لقتال المسلمين خشية الاحاطة بهم اذا كانوا قادرين على ذلك. اذن فامتلاك القوة أو ان تكون قويا امرا ضروريا جدا، لان امتلاك القوة لا يعني العنف وانما ( ان تكون نفسك لا غيرك ... وان تمسك بزمام الحياة في عملية ادارة وقيادة .. ان تعطيك الحياة طاقاتها وثروتها لتسخرها كما تريد، وتفجرها كما تشاء، وتصنعها كما يروق لك.
اما ان تفقد القوة ..فتكون ضعيفا .. تفقد القدرة على الصراع وعلى الحركة .. فمعناها ان تكون صورة غيرك.. وظله، كمثل الشبح الذي يبدو، ويزول، ليعود في بعض اللمحات، باهت اللون، ضائع الملامح .. وانك لا تشارك في الحياة الا من بعيد تماما، كاللمحة الخاطفة من الضياء الخافت الاتي من مسافات شاسعة. على خجل واستحياء، منن اجل ان يخترق سواد الليل فلا يخدش الا بعض حواشي الظلام، بكل هدوء) .
كما نأمل بيان المحددات الشرعية والاخلاقية التي تسمح بازهاق النفس المحترمة التي حرّم الله قتلها، ومتى يمكن التضحية بالنفس؟ اذ نشاهد راهنا انتشار ثقافة الموت والكراهية، وهجاء الحياة، والاستهانة بالمستقبل، والاستهزاء بالقيم، والاستخفاف بالارواح. فكيف يقتحم الانسان الموت بهذه الطريقة؟ وكيف أيقن ان موته شهادة في سبيل الله؟ وهل كل من يعشق الموت بالطريقة ذاتها شهيد في سبيل الحق والعدالة، وبالتالي سيضمن الجنة ويحقق مرضاة الله في الآخرة؟
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
ماجد الغرباوي
3 كانون الثاني 2008