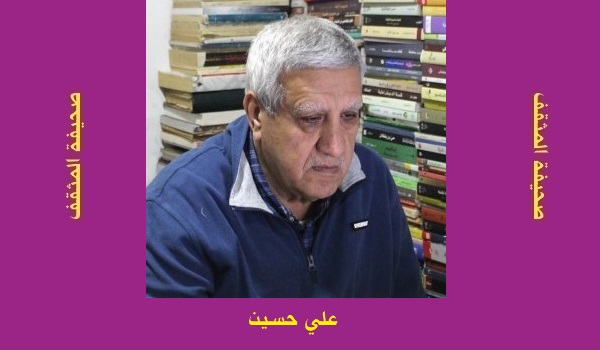أقلام فكرية
حمزة مولخنيف: من العقل المعياري إلى العقل الخوارزمي

تحوّلات مفهوم العقل في الفلسفة المعاصرة
ظلّ مفهوم العقل منذ تشكّله الأول في الفلسفة اليونانية، مرآةً لتحوّلات الوعي الإنساني بذاته وبالعالم، ومؤشرا دقيقا على أنماط إنتاج المعنى وطرائق تنظيم الحقيقة وأشكال ممارسة السلطة الرمزية والمعرفية. ولم يكن العقل في أيّ طور من أطواره مفهوما محايدا أو بريئا، بل كان دوما محمّلاً بخيارات أنطولوجية وأخلاقية ومعرفية، تتخفّى أحيانا خلف ادّعاء الكونية والبداهة. من هنا، فإن الانتقال الذي تشهده الفلسفة المعاصرة من نموذج العقل المعياري إلى نموذج العقل الخوارزمي لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تطوّر تقني أو انتقال أداتي، بل هو تحوّل عميق يمسّ البنية الداخلية للعقل نفسه وحدود فاعليته ووظيفته في إنتاج الحقيقة وتوجيه الفعل.
لقد تأسّس العقل المعياري في صيغته الكلاسيكية على افتراض مركزي مفاده أنّ العقل قدرة إنسانية كونية، تمتلك معايير داخلية للصدق والخطأ، وللصواب والخطأ الأخلاقي، وللشرعية واللاشرعية في الفعل والمعرفة. هذا التصوّر يجد جذوره الأولى في اللوغوس الإغريقي، حيث كان العقل هو مبدأ النظام ومصدر القابلية للفهم، وأداة التمييز بين الدوكسَا والإبستيمي. يقول أرسطو في “الميتافيزيقا” إن العقل هو الذي “يُدرك المبادئ الأولى التي لا يمكن البرهنة عليها، ولكن لا يمكن بدونها البرهان”، وهو قول يكشف عن مركزية العقل بوصفه أساسا معياريا لكل معرفة ممكنة. هذه المعيارية لم تكن معرفية فحسب، بل كانت أخلاقية وسياسية أيضا، إذ ارتبط العقل بفكرة الغاية وبالتصوّر الغائي للعالم، حيث لكل شيء مكانه ووظيفته، ولكل فعل قيمته بحسب مطابقته للطبيعة والعقل.
ومع الحداثة الفلسفية، سيأخذ العقل المعياري شكلا أكثر تجريدا وصراحة، خصوصا مع ديكارت وكانط. فديكارت وهو يؤسّس العقل على مبدأ الوضوح والتميّز، يجعل من العقل معيارا للحقيقة، بل المعيار الأوحد الذي لا يقبل الشك. “العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس”، كما يقول في “مقال عن المنهج”، غير أن هذه العدالة المزعومة ليست سوى افتراض معياري يضع العقل في موقع السيادة، ويحوّله إلى محكمة عليا للفصل في كل ما يُعطى. أما كانط فقد بلغ بالعقل المعياري ذروته حين جعله مشرّعا للطبيعة في المعرفة، ومشرّعا للأخلاق في الفعل. فالعقل العملي بحسب كانط لا يستمدّ قوانينه من التجربة بل يفرضها عليها، ويؤسّس الواجب على مبدأ الكونية والضرورة. يقول كانط في “نقد العقل العملي”: “العقل لا يتلقّى قوانينه بل يضعها”، وهي عبارة تختزل جوهر المعيارية العقلانية الحديثة.
غير أنّ هذه السيادة المعيارية للعقل لم تظلّ بمنأى عن النقد، خصوصا مع تحوّلات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث بدأت الفلسفة تشكّك في ادّعاء العقل الكونية والتجرّد. نيتشه على سبيل المثال، سيقلب الطاولة على العقل المعياري حين يكشف عن جذوره الغريزية والسلطوية، معتبرا أن العقل ليس سوى “أداة في خدمة الحياة”، وأن ما يُسمّى حقيقة ليس إلا “جيشا من الاستعارات”. بهذا المعنى، لم يعد العقل معيارا محايدا، بل أصبح تعبيرا عن إرادة قوة، وعن منظومات قيم تاريخية متغيّرة. هذا التفكيك النيتشوي سيجد صداه لاحقا في الفلسفات التأويلية والتحليل النفسي والنقد الإيديولوجي، حيث سيتحوّل العقل من سلطة معيارية إلى بنية مشروطة بالسياق واللغة واللاوعي والتاريخ.
ومع ذلك فإن ما نشهده اليوم لا يندرج فقط ضمن هذا المسار النقدي للعقل المعياري، بل يتجاوزه نحو إعادة تشكيل جذرية لمفهوم العقل نفسه. فالعقل الخوارزمي لا ينتقد العقل المعياري من داخله، ولا يسعى إلى فضح أوهامه الميتافيزيقية فحسب، بل يعيد تعريف العقل بوصفه قدرة حسابية إجرائية قابلة للنمذجة والبرمجة. هنا لا يعود العقل ملكة إنسانية متعالية، بل يصبح منظومة من العمليات الحسابية التي يمكن نقلها إلى الآلة بل وتفوّقها فيها. يقول نوربرت فينر، أحد مؤسسي السيبرنيطيقا، إن “التفكير ليس امتيازا إنسانيا، بل نمط من أنماط التنظيم”، وهو قول يؤشّر إلى هذا الانزياح الحاسم من العقل بوصفه وعيا ومعيارا، إلى العقل بوصفه معالجة معلومات.
إن العقل الخوارزمي لا يشتغل بمنطق الحقيقة والخطأ كما اشتغل العقل الفلسفي الكلاسيكي بل بمنطق النجاعة والاحتمال والتنبؤ. فالمعيار لم يعد هو الصدق بالمعنى الإبستمولوجي، بل القدرة على إنتاج نتائج قابلة للتوظيف. هذا ما يجعل الخوارزمية كما يلاحظ برنار ستيغلر ليست مجرد أداة تقنية، بل “نمطا جديدا من العقلنة”، يعيد تشكيل علاقتنا بالزمن وبالذاكرة وبالقرار. فالخوارزمية لا تفكّر، لكنها تحسب ولا تفهم، وتتنبّأ ولا تبرّر، لكنها تُنتج مخرجات تُعامل كما لو كانت معرفة.
هذا التحوّل يطرح سؤالا فلسفيا عميقا حول مصير المعيارية نفسها، هل ما يزال للعقل دور معياري في عصر تُفوَّض فيه القرارات إلى أنظمة ذكية؟ وهل يمكن الحديث عن أخلاق خوارزمية أو عن عقل عملي آلي؟ هنا يستحضر كثير من المفكرين تحذيرات هيدغر، الذي رأى في التقنية الحديثة نمطا من “الانكشاف” يحوّل العالم إلى “مورد”، والإنسان إلى “مخزون”. فالعقل الخوارزمي من هذا المنحى لا يحرّر العقل بل يُفرغه من بُعده التأمّلي ويُخضعه لمنطق الحساب الشامل. يقول هايدغر في “السؤال عن التقنية”: “أخطر ما في التقنية ليس التقنية ذاتها، بل أنها تمنعنا من طرح السؤال”، وهو قول يكتسب راهنيته القصوى في زمن الذكاء الاصطناعي.
كما أنّ العقل الخوارزمي يعيد صياغة العلاقة بين المعرفة والسلطة على نحو غير مسبوق. فبينما كان العقل المعياري يُشرعن السلطة باسم العقل والحق، فإن العقل الخوارزمي يمارس سلطة صامتة، غير مرئية، قائمة على البيانات والتوقّعات. ميشيل فوكو لو كان بيننا اليوم، لربما رأى في الخوارزميات الشكل الأقصى لما سمّاه “الميكروفيزياء الجديدة للسلطة”، حيث لا تُمارَس السلطة عبر القوانين والخطابات، بل عبر النماذج الإحصائية وأنظمة التصنيف وخوارزميات التوجيه. إن السلطة هنا لا تقول “يجب”، بل تقول “يُرجَّح”.
ولا يمثّل الانتقال من العقل المعياري إلى العقل الخوارزمي مجرد تحوّل في أدوات التفكير، بل هو تحوّل في صورة الإنسان عن نفسه. فالإنسان الذي كان يُعرَّف بوصفه “حيوانا عاقلا”، أو “كائنا أخلاقيا”، أو “ذاتا عارفة”، أصبح يُعاد تعريفه بوصفه “ملف بيانات”، أو “نمط سلوك قابل للتوقّع”. وهذا ما يجعل السؤال عن العقل اليوم سؤالا أنثروبولوجيا بامتياز، يتعلّق بماهية الإنسان وحدود إنسانيته في عصر الآلة الذكية.
ويتعقّد السؤال أكثر حين ننتقل من توصيف العقل الخوارزمي بوصفه بنية تقنية إلى مساءلته بوصفه أفقا إبستمولوجيا جديدا يعيد ترتيب العلاقة بين المعرفة والحقيقة والمعنى. فالعقل الخوارزمي لا يشتغل داخل منطق التبرير كما هو الحال في العقل الفلسفي الكلاسيكي، ولا داخل منطق الفهم التأويلي الذي راهنت عليه الفلسفات الهرمينوطيقية، بل داخل منطق الارتباطات الإحصائية والتعلّم الآلي. المعرفة هنا لا تُبنى انطلاقا من مبادئ، ولا تُستخلص عبر استدلالات، بل تُستنتج من أنماط متكرّرة داخل كتل هائلة من المعطيات. ولهذا قال كريس أندرسون، في مقالته الشهيرة عن “نهاية النظرية”، إن “البيانات تتكلم من تلقاء نفسها”، وهي عبارة تختزل التحوّل العميق الذي يطرأ على مفهوم العقل. "لم نعد بحاجة إلى فرضيات ولا إلى تأويلات بل إلى خوارزميات قادرة على استخراج الارتباطات ". غير أنّ هذا الادّعاء في عمقه ليس سوى إعادة إنتاج لوهم جديد من أوهام العقل، وهم الشفافية الكاملة، حيث تُختزل الحقيقة في ما هو قابل للقياس، ويُقصى المعنى لأنه غير قابل للترقيم.
إن هذا التحوّل يمسّ في الصميم التصوّر الفلسفي للحقيقة. فالحقيقة في التقليد الفلسفي، كانت دوما مرتبطة بالصدق، أي بالمطابقة بين الفكر والواقع أو بالكشف أو بالاتساق الداخلي. أما في الأفق الخوارزمي فإن الحقيقة تتحوّل إلى درجة من الاحتمال، وإلى ناتج إحصائي يُقاس بمعدّل النجاح. الخوارزمية لا تقول إن هذا صادق أو كاذب، بل تقول إن هذا أكثر احتمالا من ذاك. وهنا يتراجع مفهوم الحقيقة لصالح مفهوم النجاعة. وقد نبّه يورغن هابرماس إلى هذا الخطر حين حذّر من اختزال العقل في بعده الأداتي، معتبرا أن العقل الأداتي، حين ينفصل عن العقل التواصلي، يفقد قدرته على تأسيس المعنى المشترك، ويحوّل العالم إلى مجال للسيطرة التقنية. العقل الخوارزمي في سياقنا هذا، يبدو وكأنه الامتداد الأقصى للعقل الأداتي حيث لا مكان للنقاش ولا للاعتراف المتبادل، بل فقط لقرارات تُتخذ بناءً على نماذج غير قابلة للفهم العمومي.
ومن هنا، تبرز إشكالية الأخلاق بوصفها المجال الأكثر تأثرا بهذا التحوّل. فالأخلاق في صيغتها الكلاسيكية، كانت تفترض فاعلا عاقلا قادرا على التمييز ومسؤولا عن أفعاله. أما في زمن الخوارزميات، فإن الفعل يُوزَّع بين الإنسان والآلة وتُموَّه المسؤولية داخل شبكات معقّدة من البرمجة والتعلّم الذاتي. من المسؤول عن قرار اتخذته خوارزمية؟ المبرمج؟ الشركة؟ النظام نفسه؟ هذا السؤال، الذي يبدو قانونيا في ظاهره، هو في جوهره سؤال فلسفي عن معنى الفعل الأخلاقي في عصر تُفوَّض فيه الإرادة إلى أنظمة غير واعية. هنا، يستعيد طه عبد الرحمن راهنيته، حين أكّد أن جوهر العقل ليس في قدرته على الحساب، بل في كونه عقلا مؤيَّدا بالأخلاق، وأن أيّ عقل ينفصل عن القيم يتحوّل إلى أداة قد تكون مدمّرة. فالعقل الخوارزمي من هذا المنظور ليس عقلا بالمعنى الكامل، لأنه يفتقد إلى البعد الائتماني الذي يجعل الإنسان مسؤولا أمام غيره وأمام ذاته.
ولا يقلّ البعد السياسي خطورة عن البعد الأخلاقي. فالعقل الخوارزمي يعيد تشكيل السلطة بطريقة غير مسبوقة. لم تعد السلطة تُمارَس فقط عبر القانون أو الخطاب الإيديولوجي، بل عبر التحكم في تدفّقات البيانات وتوجيه الانتباه والتأثير في السلوك دون وعي الفاعلين. الخوارزميات التي تقترح وتصفّي وتُرتّب، تُنتج فضاءً عموميا جديدا، تُعاد فيه صياغة الرأي العام على أساس التنبؤ، لا على أساس النقاش. هنا، يتحقّق ما كان فوكو يلمّح إليه حين تحدّث عن السلطة التي “تُنتج الذوات” بدل أن تقمعها فقط. فالذات الخوارزمية هي ذات مُشكَّلة سلفا عبر أنماط الاستهلاك والاهتمامات والميول حتى قبل أن تعي ذاتها. إننا أمام شكل جديد من الهيمنة الناعمة، حيث تُمارَس السلطة باسم التخصيص، وباسم تحسين التجربة، بينما هي في العمق تعيد إنتاج علاقات غير متكافئة من السيطرة.
في هذا السياق، يغدو السؤال عن إمكان استعادة المعيارية سؤالا ملحا. هل يمكن للعقل الفلسفي أن يستعيد دوره النقدي داخل عالم تحكمه الخوارزميات؟ أم أننا أمام قطيعة نهائية مع كل تصور معياري للعقل؟ بعض المفكرين مثل برنار ستيغلر، يرفضون الاستسلام لهذا الأفق التشاؤمي، ويدعون إلى ما يسميه “إعادة تسييس التقنية”، أي إخضاع الخوارزميات للنقاش العمومي، وإدماجها داخل أفق قيمي يضمن عدم تحوّلها إلى أدوات اغتراب شامل. ويرى ستيغلر أن المشكلة ليست في التقنية ذاتها، بل في الطريقة التي تُدار بها خارج أيّ أفق أخلاقي أو تربوي. التقنية في حد ذاتها إمكان، لكنها قد تتحوّل إلى كارثة إذا انفصلت عن التفكير النقدي.
ومن داخل الفكر العربي المعاصر، يقدّم محمد عابد الجابري قراءة يمكن استثمارها في هذا السياق، رغم أنّه لم يعاصر الطفرة الخوارزمية بالمعنى الحالي. فتمييزه بين العقل المكوِّن والعقل المكوَّن يتيح لنا فهم العقل الخوارزمي بوصفه عقلا مكوَّنا بامتياز، أي عقلا تشكّل داخل شروط تاريخية وتقنية محدّدة، ولا يمكن اعتباره قدرا أنطولوجيا. هذا الفهم يفتح إمكان النقد ويمنع تقديس الخوارزميات بوصفها مصيرا لا مردّ له. كما أن نقد الجابري للعقل الأداتي في التراث يمكن أن يمتدّ ليشمل نقد العقل الخوارزمي حين يتحوّل إلى آلية لإعادة إنتاج الهيمنة بدل تحرير الإنسان.
إن الرهان الفلسفي اليوم لا يتمثّل في رفض الخوارزميات أو تمجيدها بل في مساءلتها، وفي إعادة إدراجها داخل أفق إنساني أوسع. العقل إذا كان قد فقد مركزيته المعيارية القديمة، فإنه لم يفقد بعدُ إمكان التجدد. غير أن هذا التجدد لا يمكن أن يتمّ إلا عبر وعي نقدي حادّ، يدرك أن الخوارزمية ليست عقلا بل محاكاة للعقل، وأن الفرق بين الحساب والفهم فرق جوهري لا يجوز طمسه. تقول حنة آرنت إن أخطر ما يهدّد الإنسان ليس الشرّ الجذري، بل “تفاهة الشر”، أي ذاك الشرّ الذي يُمارَس دون تفكير. والعقل الخوارزمي حين يُعفى من المساءلة، قد يصبح الحاضن الأكبر لهذه التفاهة.
وتتّسع الإشكالية أكثر حين نربط العقل الخوارزمي بالتحوّلات الأنطولوجية التي يعرفها الإنسان المعاصر. فحين تُختزل الذات في بيانات، ويُعاد تعريف الهوية في ضوء ما هو قابل للقياس والتنبؤ، فإننا نكون أمام مسار جديد من الاغتراب، لا يقلّ عمقا عن الاغتراب الذي وصفه ماركس، لكنه أكثر تعقيدا وخفاءً. الاغتراب هنا لا يتمّ عبر فقدان السيطرة على وسائل الإنتاج، بل عبر فقدان السيطرة على الصورة الرقمية للذات، تلك الصورة التي تُدار وتُسوَّق وتُستثمر دون وعي صاحبها. العقل الخوارزمي في هذا المنحى لا ينتج فقط معرفة بل ينتج ذوات وأنماط عيش وأشكال رغبة.
إن الانتقال من العقل المعياري إلى العقل الخوارزمي ليس حدثا عابرا في تاريخ الأفكار، بل هو تحوّل بنيوي يعيد تشكيل علاقتنا بالعقل وبالإنسان وبالعالم. لقد فقد العقل الفلسفي الكثير من سلطته المعيارية، لكنه لم يفقد بعدُ ضرورته. فما دام الإنسان كائنا يسأل عن المعنى ويبحث عن العدالة ويتوق إلى الحقيقة، فإن الحاجة إلى عقل نقدي تأمّلي معياري بمعنى جديد ستظلّ قائمة. التحدّي الحقيقي لا يكمن في مقاومة الخوارزميات، بل في منعها من أن تصبح أفقنا الوحيد للفهم. إن استعادة العقل لا تعني العودة إلى نماذجه القديمة، بل تعني إعادة التفكير فيه داخل شروط العصر، دون التفريط في البعد الإنساني الذي يمنحه قيمته. فالعقل عموما، ليس ما نحسب به فقط، بل ما نفكّر به في ما ينبغي أن يكون.
***
د. حمزة مولخنيف